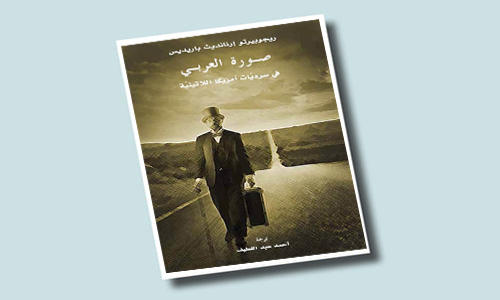عثمان بن شقرون
مقدمة
تشكّل العلاقة بين الإبداع الأدبي والمؤسسة الثقافية إحدى أكثر العلاقات إشكالاً في تاريخ الأدب الحديث. فبينما تسعى المؤسسات، بمختلف تشكيلاتها من أكاديميات واتحادات وهيئات وجوائز، إلى منح الشرعية وتحديد الموقع الرمزي للكاتب داخل الحقل الأدبي، يظل الأدب، في جوهره، فعلاً ينبني على الانفلات من التصنيفات والسعي إلى معنى لا يسمح بتثبيته داخل أي إطار ثابت. هذا التوتر بين الإطار والمعنى ليس مجرد مواجهة خارجية بين الحرية والبنية، بل هو صراع في قلب العملية الإبداعية نفسها. هل تنتمي الكتابة إلى النظام أم إلى ما ينفلت منه؟
يمثل الكاتب السويسري روبير فالزير (1878–1956) حالة نموذجية لفهم هذا التوتر، ليس لأنه نظَّر له، بل لأنه جسّده في حياته وكتابته داخل ما يمكن تسميته بـ”جمالية الهامش”. تهدف هذه المقالة إلى تحليل تجربته من منظور يربط بين السيرورة الإبداعية والاختيارات الوجودية، وإلى إبراز كيف تحوّل “الامتثال الظاهري” لديه إلى استراتيجية لحماية الحرية الداخلية، وكيف أصبحت الكتابة نفسها إطاراً يكفي ذاتَه، مستقلاً عن كل أشكال الاعتراف المؤسسي. وسنقوم في الختام بمناقشة راهنية هذه التجربة، وتحديات تلقي فالزير في زمن هيمنة الصورة والهوية الرقمية، واستخلاص دلالات “الاختفاء” في سياقنا المعاصر.
الإطار والمعنى — نحو تأصيل نظري للتوتر
لفهم التجربة الفالزيرية، لا بد من تأصيل نظري للتوتر بين الإبداع والمؤسسة. ينطلق هذا التحليل من تمييز واضح بين مفهومين يُحددان طبيعة هذا التوتر في الحقل الأدبي: الإطار (Cadre / Institution) وهو مجموع الآليات التي من خلالها تُقنّن المؤسسة الثقافية حضور الكاتب وتوجّه أنماط تلقي عمله. وهنا، يستدعي مفهوم الإطار إرث بيير بورديو في سوسيولوجيا الثقافة، حيث يمثل الإطار الحقل الأدبي الذي يتحدد فيه موقع الكاتب وفق منظومة توزيع قيم الشرعية والرأسمالية الرمزية. يشمل ذلك التنظيم والتمثيل والاعتراف والمكانة وتوزيع قيم الشرعية، ضمن منطق الحقل الاجتماعي. أما المعنى (Sens)، فهو البعد الوجودي والفكري للنص؛ ذلك الذي ينشأ من قلق الكتابة وشكّها وانفتاحها، والذي يقاوم التثبيت ضمن موقع اجتماعي أو تصنيفي محدد.
وفق هذا التصور، يصبح الانتماء إلى مؤسسة أدبية أكثر من مجرد عضوية. إنه قبولٌ، سواء كان واعياً أو غير واعٍ، بآليات التدجين الرمزي التي تفرض، بالمباشرة أو بالمداورة، تهذيباً للخطاب. إن الإطار، بهذا المعنى، يعمل كـ”مصفاة” تحدّ من إمكانات الانحراف الإبداعي لصالح انسجام مطلوب مع قيم الجماعة. وأن رفض الإطار هو، في جوهره، رفض للمساومة بين الاحتياج الاقتصادي والصدق الفني. إن المؤسسات الأدبية تعمل ضمن رأسمالية رمزية تطلب من الكاتب أن يحول قلقه الداخلي إلى منتج ثقافي قابل للتسويق والتقييم. والكاتب الذي يسعى إلى المعنى يدرك أن هذا الاقتصاد، الذي يُعرف أحياناً بـ”اقتصاد الانتباه”، يفرض ثقلاً على الجملة ويجبرها على أن تتخلى عن خفتها، لكي تتوافق مع التوقعات. لذلك، يصبح الهامش هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه ممارسة الشرود الفني بلا شهود أو التزامات اجتماعية. إن تاريخ الأدب يزخر بأمثلة لكتّاب اختاروا المسار ذاته. فرانز كافكا الذي كتب ضد منطق المؤسسة البورجوازية التي ينتمي إليها، وتوماس برنارد الذي رفض حضور حفلات الجوائز، أو هرمان ملفيل الذي انسحب من المشهد الأدبي. في كل هذه التجارب، يتحول الهامش إلى موقع نقدي لا يقلّ إنتاجية عن المركز.
روبير فالزير — الامتثال الظاهري كاستراتيجية للتحرر
إذا كان التوتر بين الإطار والمعنى يمثل إشكالية نظرية في الأدب الحديث، فإن سيرة روبير فالزير تقدم النموذج التطبيقي الأكثر تطرفاً. ينتمي فالزير إلى هذا النسق من الكتّاب المناهضين للمركز، لكن موقعه أكثر تعقيداً؛ فقد اتخذ لنفسه نمطاً من العيش يراوح بين الانسحاب الاجتماعي والتماهي الظاهري مع الأدوار المتواضعة. موظف بسيط و وخادم وناسخ، رجل يؤدي أعمالاً صغيرة بلا أثر ولا جدوى. هذه المظاهر، التي تبدو في السيرة مجرد تفاصيل هامشية، تتحول في القراءة النقدية إلى تقنية للتمويه، تسمح للكاتب بأن يحمي صوته الداخلي من ضغوط التوقعات الثقافية.
إن هذا الاستصغار المُتعمَّد للذات لم يكن مجرد خضوع للقدر، بل كان استراتيجية وجودية للتحصين. ففي نص له من الميكروغرامات بعنوان “اعتراف”، يكشف فالزير عن آلية المقاومة الجمالية الكامنة خلف الامتثال الظاهري، مؤكداً أن استصغار الذات لديه هو فعل خادع لإعلان القوة الداخلية:
“يعتقد كثير من الناس أنه من السهل جدًا أن يجبروني على الخضوع والترويض، إذا جاز التعبير، لكن كل هؤلاء الأشخاص مخطئون للغاية. لأنه في كل مرة يتظاهر فيها شخص ما ببسط هيمنته علي، هناك شيء في داخلي يشرع في الضحك والسخرية وهناك يتلاشى الاحترام بشكل طبيعي، وبدلاً من الذي كان يُعتقد أنه أقل شأناً، ينبثق الأقوى، ذاك الذي لا أُجْليهِ عنِّي عندما يتجَلَّى فيَّ.”
هذا المقطع يلخص ببراعة فلسفته في الامتثال كشكل من أشكال المقاومة. فالخضوع الشكلي يمثل قناعاً يحمي الحرية الداخلية؛ فبتقمص الأدوار الهامشية، يُحرر فالزير نفسه من عبء التوقعات ومن ضرورة النضال ضد سلطة المؤسسة. إنه يرفض لعبة القوة عبر إعلان الانسحاب منها شكلياً، مع الاحتفاظ بالقوة الحقيقية في الداخل.
لم يقتصر الموقف الوجودي لفالزير تجاه المؤسسة على الانسحاب الاجتماعي؛ بل ظهر بوضوح في توتر علاقته مع دوائر النشر المهنية. فبينما كان شقيقه، كارل فالزير الرسام الشهير وصانع الديكور المسرحي، يحاول جاهداً إدخاله إلى الأوساط الأدبية البرلينية، كان روبير ينفر من هذه التجمعات ويقاومها. والأكثر أهمية، أنه واجه الناشرين الذين حاولوا مراراً دفعه إلى “تهذيب” أسلوبه وتغييره ليناسب التوقعات الرائجة أو ليكون “قابلاً للتسويق”. هذا الطلب على التعديل، الذي هو في جوهره محاولة لـ “تدجين” الكتابة لكي تنسجم مع الإطار المؤسسي، كان يقابله فالزير بالانتفاض والرفض الجذري. بهذا المعنى، لم يكن رفض الإطار مجرد خيار حياتي سلبي، بل كان فعل مقاومة إيجابي ضد محاولات فرض الشكل أو النبرة، مما يؤكد أن حماية حريته الداخلية كانت أغلى من أي اعتراف مهني أو استقرار اقتصادي.
وبما أن هذا الامتثال الظاهري لم يكن مجرد خيار حياتي، انعكس مباشرة على جمالية نصوصه. فبينما كان يتقمص أدوارًا هامشية في الحياة، كانت شخصياته السردية تتسم هي الأخرى بالخفة واللامركزية، وغالباً ما كانت تدور حول المشاة العابرين أو الموظفين المغمورين. لقد رفض فالزير ثقل الرواية الملحمية والشخصيات البطولية، واستعاض عنها بـ”ملاحظات المشي” و”السرديات المتواضعة”، تضفي على الخفيف واليوميِّ ثقلاً فلسفياً عميقاً. ففي رواية معهد بنجامينتا جاكوب فون غونتن (1909)، يقول السارد:
“كم أنا سعيد لأنني لم أكتشف أي شيء في داخلي يستحق التقدير أو يثير الفضول! أن تكون عديم الأهمية وتظل كذلك. وحينما سترفعني يد وظرف وموجة وتحملني إلى القمة، حيث تسود السلطة والائتمان، سأدمر الوضع الذي من شأنه أن يكون لصالحي، وسألقي بنفسي في العتمة الواطئة والعقيمة. لا يمكنني التنفس إلا في المناطق السفلى.”
ويضيف قائلا: اسمي جاكوب فون غونتن، إنه اسم شاب، هذا صحيح، ولكن مدرك لكرامته. لا يمكن أن اُعذر، أرى ذلك، لكن لا يمكن أن تُوجَّه إلي الإهانة أيضاً، أنا أعترض على ذلك.”
وهو مقطع يلخص فلسفته. إن الحرية تُستعاد عبر تقليص الظهور لا عبر تعظيمه. هذا النزوع يتعارض جذرياً مع منطق الأدبية الحديثة الذي يربط الكاتب بموقع رمزي و”سلطة تأويلية”. هكذا يصبح “الامتثال” لدى فالزير موقفاً وجودياً، لا خضوعاً، ومقاومة من نوع مختلف: مقاومة عبر التواضع الشكلي.
يصل الموقف الوجودي لفالزير الرافض للتأطير إلى ذروته الجمالية في تقنية الكتابة المتمثلة في الميكروغرامات (Microgrammes). وهي نصوص كتبها بين العشرينيات والثلاثينيات بخط بالغ الصغر يكاد لا يُقرأ دون عدسة مكبرة، وعلى قصاصات ورقية عادية، بعضها خلف فواتير المصحات أو أغلفة الرسائل.
لهذه التقنية بُعدان حاسمان، بعد شكلي؛ حيث الكتابة الصغيرة جداً تعطل تلقائياً منظومة النشر التقليدية، فيصبح النص غير قابل للاستهلاك المباشر أو التوزيع أو التقييم، أي أنه يفلت من آليات الأدب كمؤسسة لإعادة الإنتاج الثقافي. وبعد وجودي؛ حيث الميكروغرامات لا تسعى إلى قارئ؛ بل تسعى إلى أن “تكون”. إنها كتابة تحررت من أفق التلقي، فصارت نصاً بلا جمهور، وبلا رغبة في الاعتراف. بهذا المعنى، تتحول الكتابة إلى حياة ثانية مستقلة عن الشروط التي تنظّم الحياة “الاجتماعية” للنص.
هذا التحول في الشكل ليس مجرد تكتيك أو استجابة لظروف مرضية، بل هو فعل إرادي خالص لتحقيق الحرية المطلقة. عندما يُصبح النص غير مقروء تقريباً، فإنه يتحرر من عبء التمثيل؛ لم يعد مطالباً بتمثيل الكاتب، ولا المؤسسة، ولا العصر. إنه يمثل ذاته فحسب. فالميكروغرام يجسد رفض فالزير فكرة أن القيمة الفنية مرتبطة بالاعتراف الخارجي. إنها كتابة مكتفية بذاتها، تحقق شرعيتها في مجرد فعل الكتابة، لا في القراءة أو النشر. فالميكروغرام، بهذا المعنى، هو الشكل الأكثر راديكالية لرفض الإطار.
التلقي المعاصر ومفارقة الاختفاء: فالزير في زمن الصورة والسرد.
بالرغم من ابتعاده عن المؤسسة وعزلته، يمثّل تلقي فالزير اليوم حالة معقدة وراهنية بامتياز. ففي زمن تُختزل فيه الذات إلى “حضور رقمي” وإلى هوية قابلة للبرمجة، يصبح اختفاؤه المتعمد نموذجاً مضاداً جذرياً. فبينما يُطالب الكاتب المعاصر بإدارة صورته واستثمار ظهوره، يبدو فالزير وكأنه يعرض مقترحاً آخر، وهو أن تكون الكتابة شكلاً للوجود المتخفي الذي يُعرّف ذاته عبر النص لا عبر التمثيل.
لم يتوقف أثر الاختفاء الفالزيري عند حدود التجربة الفردية أو عند لحظة تاريخية منتهية، بل تسلل لاحقًا إلى السرد المعاصر بوصفه هاجسًا وموضوعًا قائمًا بذاته. وتمثل رواية الدكتور باسافينتو (2005) للكاتب الإسباني إنريكي فيلا-ماتاس أحد أكثر تجليات هذا الامتداد وضوحًا ووعيًا. فبطل الرواية، الذي يتقمص هوس الاختفاء، لا يكتفي بالانسحاب من الحياة الاجتماعية أو برفض الاعتراف الأدبي، بل يسعى إلى محو ذاته الرمزية بوصفه كاتبًا، مستلهمًا بشكل مباشر تجربة روبير فالزير، الذي يحضر في النص لا كمرجع أدبي، بل كأفق وجودي للكتابة.
في رواية الدكتور باسافينتو، يتحول الاختفاء من ممارسة صامتة إلى موضوع سردي معلن، ومن موقف وجودي غير مصاغ نظريًا- كما عند فالزير- إلى مشروع واعٍ يختبر حدوده القصوى داخل النص. غير أن هذا الوعي السردي نفسه يكشف مفارقة عميقة، وهي أن الرغبة في الاختفاء حين تُكتب وتُروى، تتحول إلى شكل جديد من الظهور. هكذا، بينما اختار فالزير الاختفاء عبر تقليص الأثر وإلغاء الأفق القرائي، يجد باسافينتو نفسه محاصرًا داخل مفارقة لا فكاك منها: أن يكتب عن الاختفاء يعني، بالضرورة، أن يُرى.
بهذا المعنى، لا تستنسخ رواية فيلا-ماتاس الموقف الفالزيري بقدر ما تكشف استحالته في زمن أدبي مختلف. فالاختفاء، الذي كان لدى فالزير فعلًا صامتًا ومكتفيًا بذاته، يغدو لدى باسافينتو تمثيلًا سرديًا، أي خطابًا حول الغياب لا غيابًا فعليًا. ومن هنا تتضح المسافة الدقيقة بين التجربتين: فالزير يختفي داخل الكتابة، أما باسافينتو فيكتب عن الاختفاء. الأولى ممارسة وجودية تُفلت من الإطار، والثانية مساءلة سردية تكشف حدود هذا الإفلات داخل مؤسسة الأدب المعاصر.
تتيح هذه المفارقة قراءة فالزير لا بوصفه نموذجًا يُحتذى، بل بوصفه حدًا أقصى للحرية الكتابية، حدًا لا يمكن استعادته إلا بوصفه أثرًا أو شبحًا. وهنا تكمن راهنية فالزير القصوى. ليس لأنه قابل للتكرار، بل لأنه يقيم في منطقة يستحيل على الأدب المعاصر، المشبَع بالوعي الذاتي وباقتصاد الظهور، أن يبلغها دون أن يفقد براءته الأولى.
هذه المفارقة تجعل من فالزير كاتباً عصياً على التلقي النفعي السريع، لكنها أيضاً تمنحه راهنية جديدة كـ”نقيض البراند الأدبي” (Anti-Brand). لقد رفض فالزير تحويل حياته أو قلقه الداخلي إلى سلعة أو خطاب تسويقي؛ بل جعل من الغموض والمسافة قيمة فنية في حد ذاتها. لا يجد القارئ المعاصر في حياته الرقمية ما يشبه “حرية الهامش”، ولذلك قد يكون النص الفالزيري دعوة إلى إعادة التفكير في علاقة الكاتب بجمهوره، وفي معنى أن تُكتب كلمة خارج اقتصاد الظهور، معلناً أن أغنى أشكال الوجود هي تلك التي ترفض أن تُحسب وتُعرَّف خارجياً.
خاتمة
تكشف تجربة روبير فالزير، في حياته وكتابته وتقنياته، أن الأدب قد يجد قوته الحقيقية خارج أنظمة الاعتراف التي يفرضها الحقل الثقافي. فالتوتر بين الإطار والمعنى لا يُحلّ عبر الانتماء ولا عبر القطيعة، بل عبر اتخاذ موقف جمالي وجودي يسمح للكتابة بأن تكون إطارها الخاص. من خلال الامتثال الظاهري، والعيش على هامش المؤسسة، ومقاومة تدجين الناشرين، ومن خلال الميكروغرامات التي حررت النص من شروط النشر، أقام فالزير نموذجاً نادراً للكتابة التي تحافظ على حريتها عبر إلغاء الحاجة إلى الموقع.
لكن المفارقة العظمى تكمن في أن هذا الكاتب الذي سعى للاختفاء عبر صمته وتواضعه وخطه البالغ الصغر، تم انتشاله قسرياً وإدخاله عنوة إلى صلب الإطار بعد وفاته. فالمؤسسة الثقافية العالمية، عبر الترجمات الشاملة والدراسات الأكاديمية والاحتفاء النقدي، أعادت “تأطير” فالزير كنموذج راديكالي، محوّلة رفضه المطلق إلى “سلعة ثقافية” جديدة تحمل توقيع “العبقرية المكتشفة متأخرًا”. هذا التأطير المتأخر يطرح سؤالاً قاسياً على المقالة بأكملها: هل يمكن لرسالة الكاتب الرافض للإطار أن تنجو حقًا، أم أن المؤسسة تملك القدرة المطلقة على استيعاب، بل وتأبيد، حتى أشد أشكال الرفض والتمنع؟
في زمن تتعاظم فيه متطلبات الظهور ويشتد فيه ضغط الهوية الرقمية، يبقى فالزير مثالاً لكاتب استطاع أن يحافظ على “المعنى” بالانسحاب من “الإطار”، وأن يجعل من الكتابة فضاءً للمسافة، ولحرية لا تمنحها المؤسسات، بل يصنعها الكاتب من خلال صمته ونصوصه.