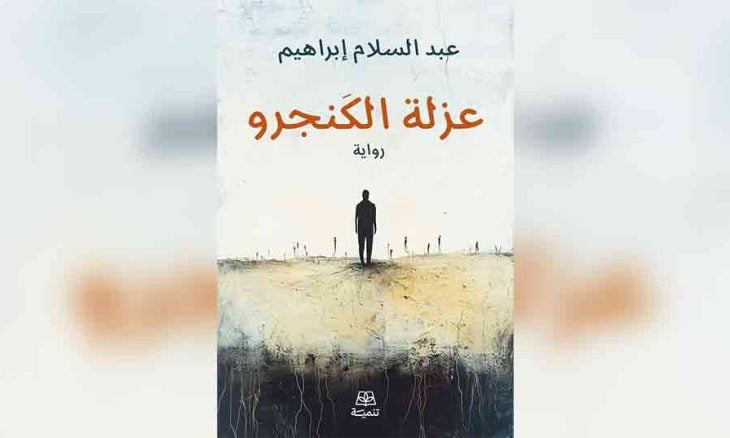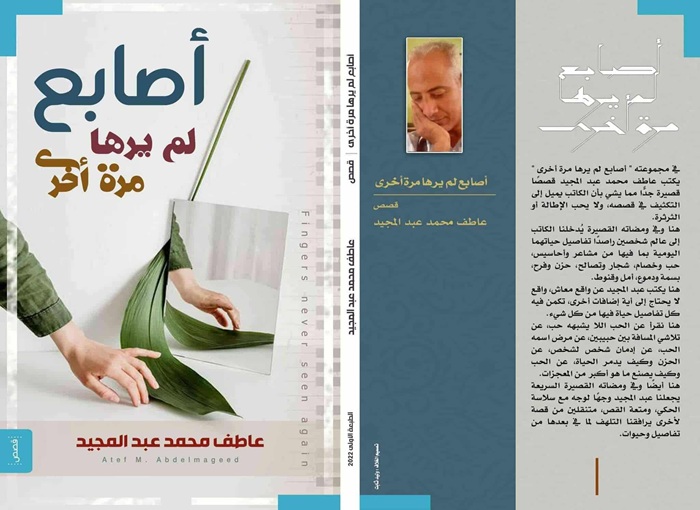صابر رشدي*
يقتحم الروائي المصري عبد السلام إبراهيم مكاناً يعرف أدق خرائطه الجغرافية، ليشيد فوقه عالماً يستند إلى التاريخ الاجتماعي والعرقي والطبقي لأبطاله، كاشفاً عن العادات والتقاليد والأعراف، محولاً الشخصيات والحوادث التي تتوالى تلقائياً إلى محفزات للحبكة، ويعيد تشكيل معنى الحاضر من خلال بنية هذا الفضاء، مرتباً الأشياء داخله عبر إيراد التفاصيل الصغيرة التي تفصح عن تاريخ المكان، من منظور راوٍ محدد، إلا أنه يبحر في حكايات متعددة، فاتحاً عدسة الرؤية على كثير من الزوايا والمشاهد، والحراك الذي لا يخبو.
المكان هنا هو الفعل الروائي ذاته، العنصر الذي يمنح السرد حيويته وواقعيته، ويكشف عن عمق علاقة الإنسان ببيئته، فهو حامل الذاكرة، ومحرك الأحداث، وليس مجرد حيز، أو فراغ بلا معنى، بل نتاج علاقات متداخلة ومتشابكة داخل قرية في جنوب مصر تقع في مدينة الأقصر تسمى «الحدودية». كيان حي يعيد إنتاج الأساطير والتحولات بواسطة التعاطي مع سرد يجعل الزمن دائرياً، وهو يتوقف أمام كل حالة تنصاع لمصيرها تحت ضغط ظروفها الخاصة، وهويات مختلفة، نطالع ثقافتها في أثناء المتابعة، من خلال راوي العمل الذي هو في الوقت نفسه، بطله المشارك. تبدأ الأحداث منه، ثم تعود إليه، فاتحاً نوافذ متعددة تضيء لنا ملامح الثقافة المحلية على هذه الأرض، ماضيها وحاضرها، وربما أيضاً ما ينذر به مستقبلها.
تفتتح الرواية بمشهد دامٍ: جريمة قتل لفتاة تدعى ماهينور، وهي انطلاقة من لحظة متفجرة، محاولة تضفي على الحدث طابعاً أسطورياً، بعد دمجه في عدة عناصر مثيرة تلقي بظلالها على بقية العمل، لنعرف من خلال تتبع ملابسات ما جرى، ورحلة تقصيه، أن الفتاة كانت ترقص «التويست» بعيداً عن الأعين، جوار شجرة عتيقة، مغروسة في بقعة مقفرة. كانت هذه الرقصة هي ما تلجأ إليه البنات قبل زفافهن، على الرغم من كونها رقصة غربية من الأساس، تمثل حرية البشر في مواجهة السلطة الاجتماعية، تتيح الانفراد بالذات، وبالجسد، فهي لا تحتاج إلى شريك، لغياب التلامس عنها، وكأنها تسعى إلى قطع الروابط التقليدية المتعارف عليها، فقد ظهرت في أوروبا الستينيات مع موجة تمرد الشباب وانفجار الثورة الجنسية، وتحولات المجتمع الغربي من الجماعية والترابط الأسري، إلى الفردانية والتمحور حول الذات.
ماهينور تمثل تلك الرمزيات، فهي فتاة هاربة من أهلها بمحافظة أسيوط، رفقة حبيبها، للزواج به بعيداً عن رغبة أهلها، فكانت النتيجة إرسال من يقوم بذبحها لخروجها عن تقاليد الأسرة.
الراوي ربيع برسي، لاجئ سوداني، من أب طونجي وأم فونجية، وهما قبيلتان فرتا إلى مصر منذ عقود طويلة، هرباً من الحروب الشرسة بينهما وبين بعض القبائل في السودان. وهو يعمل مدرساً للغة الإنكليزية في مدرسة «الحدودية الإعدادية المشتركة»، مفضلاً العمل في هذه المرحلة لأن الطلاب أقل إدراكاً وشغباً، أما طلاب المرحلة الثانوية على العكس من ذلك، جموح أهوج ومشكلات لا تنتهي، بينما يعاني المدرسون في مدارس البنات من شطحات المراهقة لديهن، والتي قد تنتهي بفضيحة للمُعلم.
لا بد هنا من الوقوف على بعض صفات هذا الراوي، الذي يعشق العزلة، وينفر من التجمعات البشرية التي تسبب له اضطراباً شديداً، ترتجف له عيناه، ولا يعرف الراحة إلا حينما يغمضهما ويجول في الظلام، كأنه لا يجد ذاته إلا عندما ينسحب من العالم، لأن النور يفضح هشاشته، يجعله يجد في الظلام حصناً بديلاً. فالظلام هنا ليس مجرد غياب للضوء، إنما فضاء للحرية البديلة، فثمة اغتراب وجودي نلاحظه، يتضح من خلال سرده بضمير المتكلم، الذي يجعلنا نلمس هذا الشعور المضني، المتسرب إلى كثير من فقرات الرواية. ربما يعود ذلك إلى عدم تجذره في المكان، وعدم انتمائه إليه، رغم الولادة على أرضه، غير أن الانتماء يظل دوماً إلى الأرض الأم، مسقط رأس الأجداد والآباء، أو ما يمكن تلخيصه وتركيزه في كلمة واحدة: «الوطن».
يبدو ربيع بيرسي كمؤرخ يقظ، لا يُفلت شيئاً، وهو يتابع أحداث «الحدودية». إنه كاتب حوليات أحياناً، ولكنه يفكك الأحداث، يفتتها، ثم يسعى إلى إعادة تركيبها مجدداً، لا يفعل ذلك بحياد، بل يضيف تحليلاته، تعليقاته التأملية، وجهة النظر التي تميز الراوي العليم كلي المعرفة. فهو ليس مجرد راوٍ داخل العمل فقط، بل تحول إلى سلطة سردية عليا، تمتلك الوعي، والحكم على الأشياء. يبدو ذلك واضحاً وهو يعرض ما يدور في القرية الصغيرة، وإحاطته بدواخل النفوس، كحامل للحقيقة، حتى إن بعض الفصول تحمل أسماء الشخصيات: أمجاد الخميسي، ربيكا براون، رضوى سليم، منصور فرحات، رفاعي ياسين، فاوست الركابي، فايزة الكومي.
كأنه صانع بورتريهات، ينفرد بكل شخصية على حدة، للإحاطة بكامل ملامحها، لا يخترع الأحداث، لكنه يرصدها، محافظاً على الحقيقة، تاركاً للخيال إعادة صياغتها، متحكماً في تمثيل الواقع وفقاً لرؤاه، معيداً تفسير هذا العالم على طريقته. يرصد المكان كوطن بواسطة سكانه الأصليين، ثم كمأوى للاجئين من السودان، وملاذ للهاربين من محافظات أخرى، ثم مقر مؤقت لطائفة من الغجر، ومنفى للموظفين الفاسدين المبعدين من القاهرة، وبراح جنسي للسائحات الباحثات عن المتعة مع فتى جنوبي يرى في الزواج بعجوز أوروبية مشروعاً مربحاً لزيادة الدخل.
إذن، فنحن أمام موقع جامع للهامش والمقموع والمُبعد اجتماعياً. ولسنا بصدد إطار جغرافي فقط، بل أمارات على التهميش في هذا المحيط، فسيفساء من الهويات المتناثرة، يتحول فيه هذا الهامش إلى متن سردي، وتبدو فيه الشخصيات كنماذج للإقصاء الاجتماعي والسياسي والثقافي. وكأن الكاتب أراد من خلال راويه استبدال الهوية الثابتة هوية هجينة ومتحولة، إنشاء عالم جديد مليء بالمتناقضات، فضاء ملتبس، تجتمع فيه ثنائيات متضادة: القهر والحرية، الخوف والأمل، الهامش والمركز،قصص الحب المبتورة. كل ذلك من خلال نص مفتوح على عدد من التجارب الإنسانية المتشابكة.
ثمة رفض هنا، يأتي من السكان الأصليين، خوف وقلق، يظهر على لسان شيخ القرية وخطيبها وهو يقول للراوي:
«الحدودية لا تقبل أصحاب القضايا العرفية ولا أصحاب الديانات»، ثم وهو يعلن عن قلقه: «الأقليات هم مصدر القلاقل والحروب؛ فهم يبحثون عن جحور يعيشون فيها مثل الأرانب، وإذا كثر العدد وقويت شوكتها احتلت ما يمكن أن يصادفها من أراضٍ».
ذلك المتحدث يعد في هذه الأوساط صوتاً للجماعة، وهو في عصرنا الحالي يتمتع بمكانة أكثر خطورة، إذ يمثل وجوده رمزاً للسلطة المحلية، وأداة تؤكد الهيمنة، لا يتحدث من فراغ، ويرى في رفض الآخر وإقصائه حماية للذات، وحفاظاً على الاستقرار، ومنحاً لمن حوله شعوراً بالأمان. بعدما حول الأمر إلى جدلية: «نحن وهم»، وكأننا بصدد كائنات تهدد القرية وهويتها الأصلية، عن طريق تشبيههم بالأرانب التي تتناسل بكثرة يضج بها المكان، وصف يستصغر الآخر وينزع عنه إنسانيته، حتى يبقيه مطروداً من الذاكرة الجماعية، راسماً حدوداً للانتماء، من خلال جداول الفرز والتقسيم، ووضع معايير للقبول والإقصاء داخل هذا النظام الداخلي الضيق.
لقد استطاع الكاتب أن يتخفى وراء قناع الراوي صاحب التجربتين: الاقتلاع والإقامة، محولاً إياه إلى موضوع للتأمل، بإسناد سلطة السرد إليه، حتى يستطيع أن يلقي نظرة فاحصة، ليتمكن من إعادة اكتشاف المكان، ورصد التغييرات التي طرأت عليه، حيث نجد مشاهد لا تُفلت التفاصيل، وأُذناً تصغى جيداً، وعيناً تراقب ما يجري حولها بدقة وعمق.
لا تفتقر الرواية إلى قصص الحب، والخيانات الزوجية، ولا تخلو من الصراع الحضاري بين الشمال والجنوب، فهي عامرة بالمحاورات الثنائية بين الراوي وبين العالمة الإنجليزية ربيكا براون، التي حضرت إلى الأقصر للسياحة والمتعة, فثمة نقاشات فلسفية عن الفروق الخفية بين التوازن والاتزان، فتلك السيدة ترى أن الإمبراطورية الإنكليزية حققت الاتزان في حملاتها الاستعمارية، لكنها لم تحقق التوازن، وهذا ما أدى إلى اضمحلالها وغياب الشمس عنها، وأن الإنجليز هم أصحاب الفضل في نشر قيم التوازن في العالم.
كانت نقاشات ممتدة وجهاً لوجه، ثم انتقلت إلى صندوق الرسائل لتسرد فيه المرأة حياتها، مستعيدة قصة زواجها من زميل لها في الجامعة من أصل روسي، والخلافات الفكرية الناشبة بينهما، ليفتح لنا عبد السلام إبراهيم باباً صغيراً للحداثة الرقمية، مؤكداً راهنية الزمن، باستخدام وسائل التواصل، ولا سيما «فيسبوك» تحديداً، كأحد العناصر التي يلجأ إليها بطله للتواصل مع محيطه، مفسحاً المجال لخاصية «ماسينجر» التي يجلس إليها ربيع بيرسي للدردشة مع الآخرين. ويدير عالمه الصغير، ربما هروباً من الحياة الطبيعية، والتواصل مع أصدقاء افتراضيين. فهو يرى أن الوحدة فكرة كونية يعتنقها كثير من البشر. وحدة ليست نابعة من كونه طونجياً غريباً من الأقليات التي يوضع بشأنها علامات استفهام، لكنها نابعة من انفصاله عن عالم يحكمه إنسان آخر، له لون غريب لا يندرج تحت ألوان قوس قزح، قريب من لون الطين.
في بعض الأحيان يشعر أن المكان يضيق به وبقاطنيه، وأن تلك القرية ما هي إلا خمسة أفدنة، تناور بحدودها وتزرع الوهم في قلوب البعض، فقد كان طوال السنوات يبحث عن ظلام يشبهه، يستقي ملامحه منه، يعبئ لونه الأسود من جبهته، يلامس ببشرته اللون الأصلي للفناء، ظلام يركض فيه مثل كَنجرو أعمى يفتقر إلى بوصلة تعوض فقدان البصر، فيتقافز في العتمة، طاوياً الأرض بساقيه الخلفيتين، دون أن يصل إلى نقطة النهاية أبداً.
لذلك ما تلبث فكرة الموت أن تراوده، فيحلم بجنازة مهيبة، يشارك فيها الغجر والنصارى والغرباء والفارون من عائلاتهم المتدنية والباحثون عن مأوى جديد، ومئات من الكَنجرو الأسود تركض في كل اتجاه كأنها تبحث عن مشيعين من كل الأجناس. لكن نهاية الرواية تأتي على صورة غير متوقعة، قفزة حقيقية نحو الانعتاق والتحرر، وعدم الاستسلام لمصائر فرضت على مجموعة من البشر وكأنها أقدار لا فكاك منها. فبعد أن كاد العشق يفقده عقله ويجعله يسعى إلى التفكير في إجراء عملية تقشير للجلد الأسود، مرضاة لحبيبته حتى يتحول إلى اللون الأبيض، منسلخاً من هويته الأصلية. عثر على وثيقة أصدرتها إدارة المحليات، فحواها قرار سري للغاية يقول: «تُعزَل المنطقة الحدودية، التي تفصل بين الأقصر والبياضية جنوبِيِّ مصر، وتظل بلا سكان لمدة خمسين عاماً لمنع المد الطونجي نحو الشمال»، المقصود بالطبع قريته.
لذا سعى إلى أفراد قبيلته في جميع أنحاء مصر، عبر جميع وسائل التواصل، معلناً مبادرة جنونية، وهي التجمع في قرية «الحدودية» لتكون نقطة انطلاق للعودة في موجات متتالية إلى أرض الطونج القديمة، حيث الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت الرواية عن دار تنمية للنشر، ووصلت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025
*نقلاً عن القدس العربي