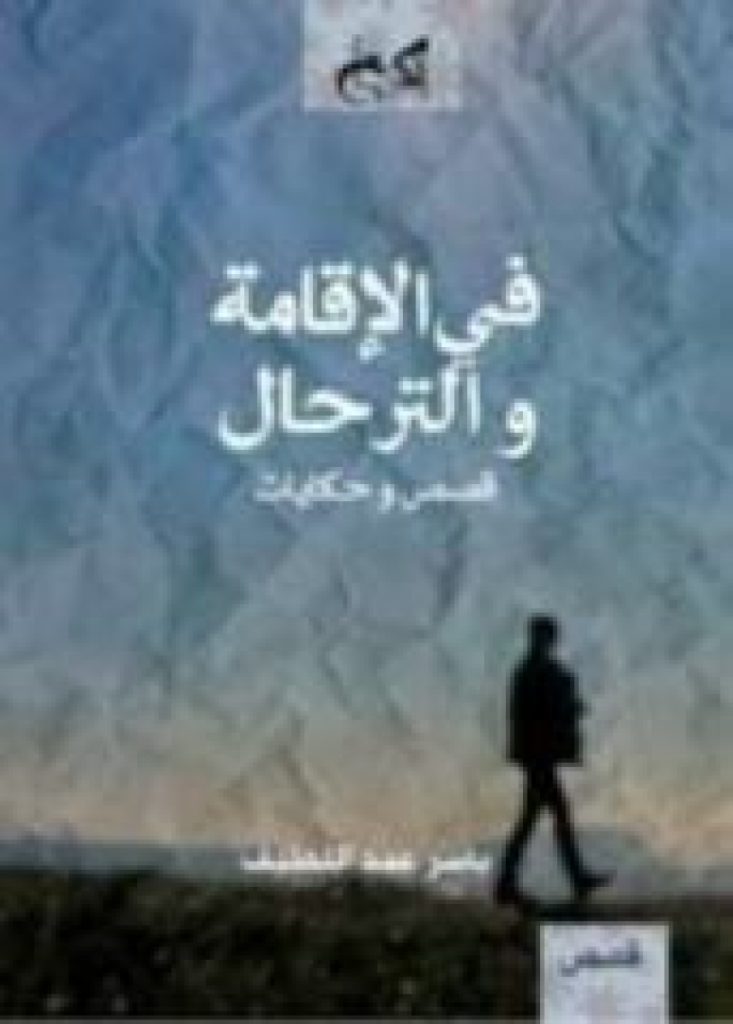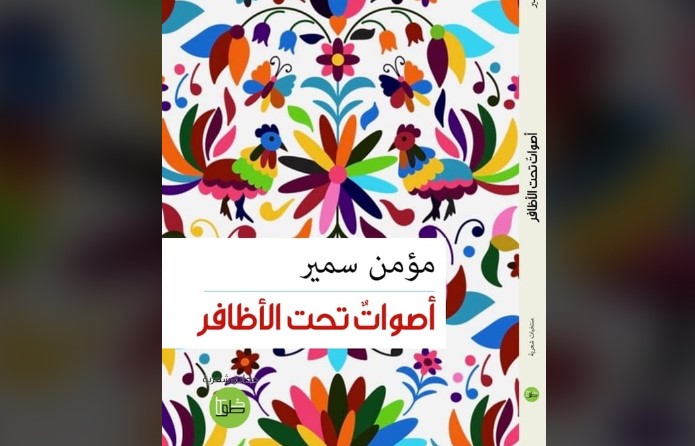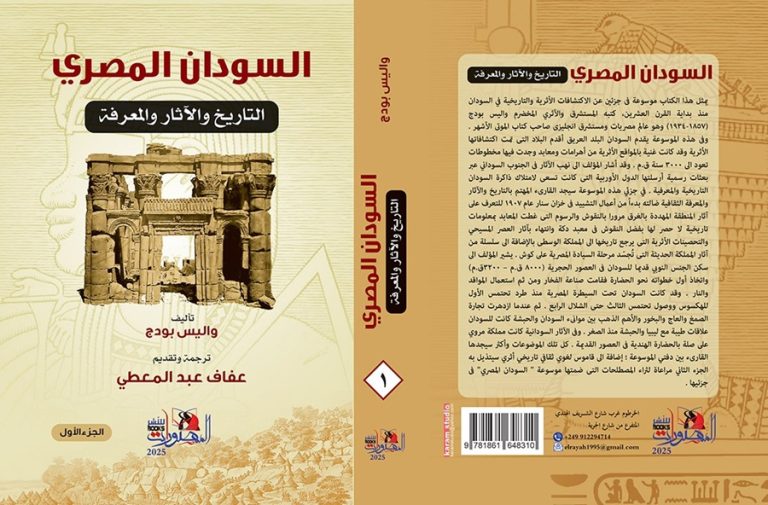ينقسم الكتاب إلى نصوص سردية معنونة ينتمي معظمهاإلى ما يمكن تسميته بنصوص الإقامة أما الآخر فهو نصوص في الترحال ،وتأتي أهمية “المعزوفة القياسية للمتسكع الغريب” في أنها الرابط الذي يجمع بين نصوص الكتاب والذي ربما تظل دونه سردا لبعض وقائع وحكايات وذكريات من السيرة الذاتية للكاتب،تلك المعزوفة هي “الحكاية الأصلية” للكتاب إن جاز التعبير ..
“خرج من باب بيته لا يلوي على شيء، فقط يروم المشي في شمس الربيع الدافئة بعد اعتكاف إجباري طوال الشتاء القارس الذي قضاه يترجم كتابا سخيفاً دفعته إليه الحاجة المادية”
هكذا ولمرة واحدة خلال تسعة وعشرين نصا سيروي الكاتب عن نفسه بضمير الغائب حيث انقسام الذات بين إقامتها وترحالها”لم يعد يعرف أهو المتسكع النهاري يحمل ديوان الشعر الإفريقي وتطن برأسه أغنية راقصة من زمن الأربعينيات أم هو نديم نفسه في حانة الحي الغربي”؟
،هو المهاجر المقيم في مدينة بغرب كندا الأوسط يقرر أن يستحضر “شخصيات عرفها في زمن المراهقة والحماقة الكبرى وأماكن وزوايا من ملاعب الصبا والشباب ،المعادي في الثمانينات والتسعينيات باب اللوق في امتدادها عبر حياته،حوض من الذكريات في سهوب جليدية بلا تاريخ”
مشاهد متجاورة مكثفة :”متوحد جالس على دكة أمام بحيرة عادية بلا أي جمال خاص،المقهى الكندي وقهوته المزيفة وندله منعدمي الشخصية،السهوب الجليدية في الشتاء الأبيض المتجمد وأيامه المتشابهة ،”هكذا يحدثنا ياسر عبد اللطيف عن مكان إقامته الجديد وصمته الذي بلا خيال ولا ذكرى ولا تاريخ ،ألا نتذكركلمات رحالة بعيد يدعى هنري ميشو “من عمق الضجر تولد القوة والحاجة إلى الكتابة” ،إنه الضجر :”إوزة كندا ذات العنق الأخضر تقف على حافة البحيرة في شموخ فتزداد رغبته في ركل صدرها المنتفخ،حصاة يتوهم أنها اخترقت أسفل حذائه فيتوقف عن السير” ،نعم كان الضجر دافع ياسر عبد اللطيف في استحضار ذكرياته وحكاياته ،واستحضار اللحن القديم من الأربعينيات ..لحن راقص للملحن محمود الشريف والمطرب عبد الغني السيد “ايه فكر الحلو بيا باعت بيسأل عليا”،لحن ينتصر للذكرى ويهزم الضجر وحصاته الوهمية.
المنفيّ أم المهاجر؟
يحدد تودوروف أنماطاً عشر للمسافر “المستوعِب،المستوعَب،الغرائبي ،المجازي،المنفي،المنتفع،السائح،الانطباعي،المرتدع،و الفيلسوف”،أما سفر ياسر عبد اللطيف فهو سفر في الزمان وإن كان يحيل إلى أماكن الذكرى الأثيرة في القاهرة ،وسفر في المكان يستبدل فيه صورة بأخرى من صور المسافر حسب تودوروف
يرى تودوروف أن “شخصية المنفي تشبه في جوانب منها شخصية المهاجر وتشبه الغرائبي في جوانب أخرى ،فهو مثل المهاجر يستقر في بلد ليس بلده لكنه مثل الغرائبي يتفادى الإستيعاب “
ويكمل “يهتم المنفي بحياته بالذات بل بحياة شعبه بالذات لكنه لاحظ في نفسه أنه لكي يرجع إلى هذه الغاية سيكون من الأفضل له أن يسكن في الغربة،أي حيث لا ينتمي ،إنه غريب ليس بصورة مؤقته بل نهائية “
يصف ياسر عبد اللطيف انتقاله في الأربعين من القاهرة إلى كندا “بانقطاع مفاجيء في شريط الصوت،وقطع حاد في المرئي أيضاً” هو المهاجر الذي تشبه هجرته نفياً اضطرارياً ،هو المنحاز لصخب مدينته القاهرة محتملا كان أم غير محتمل بل إلى صمتها أيضا فيقول“للصمت صوتٌ في المعادي”.
صورة المسافر /المنفي/المهاجر هي الأقوى حضوراً في نصوص الكتاب الذي قدّم عنوانه الإقامة على الترحال في إشارة لا يخطئها القاريء ،يستعيد الكاتب أصوات مدينته تلك التي “تستخلصها الأذن من الصخب “كصوت أم كلثوم الذي رافقه في بداية المراهقة وأصبح مع السيجارة والقهوة بداية تعلمه ل”فنون المزاج”، ، أصوات صاحبت طفولته ومراهقته :موسيقى الروك آند رول الغاضبة “لو عدت بالزمن إلى سنوات 85 ،86،87 لسمعت تلك الموسيقى تنساب من نوافذ غرف نوم الشباب المعلقة على حوائطها بوسترات لبوب مارلي يلف سيجارة ضخمة من الماريجوانا”
صوت قرع متوال للطبول في حديقة الحيوان،صوت دراجة تسير وخشخشات وطئها للأوراق الميتة بعد غيبوبة مرض ،صوت أجراس المترو الذي يحسب الكاتب الزمن بحساب المسافة بين محطاته!”أربع دقائق في المتوسط بين المحطة والأخرى ،ثماني محطات بين الضاحية والمركز ،بالطقطقات الشهيرة للعجلات على القضبان،بحساب الفلنكات والذهن الشارد من النافذة يعبر جسراً صوتياً من مجالٍ لآخر “
بعد تحليقنا مع كل هذا الصخب يعيدنا الكاتب إلى ضاحية الغرب الأوسط الكندي التي لا يسميها ويصفها بالضائعة في أكثر من موضع في الكتاب“أقف في النافذة أرقب نجيمات الثلج تتكسر على الزجاج لا أحد يمر سوى أرنب أبيض ضخم ،الأرانب هنا هي قطط الشوارع ،الهدوء التام في هذا الخواء السيبيري مسكون بأصوات باطنية :طنين جهاز التدفئة المركزي تنساه ولا تكاد تشعر به وتكاد تتوهم أنك بصدد صمت مطبق ولا تتبين الطنين الذي يسكن رأسك إلا عندما يصمت الجهاز“يملأ الكاتب الصمت باستعادة حوارات قديمة لم تنته ،يترك أطياف الماضي تتداعى قليلا قبل أن “يعود للحياة اليومية مسارها الواقعي”
يحدثنا ياسر عبد اللطيف عن الآلية التي تعمل بها الذكرى حسب باشلار حيث “تعمل على استبقاء لحظات مشحونة من الماضي في الطفولة خاصة تبني حولها شعرية العمر بأكمله ” ومنها ينتقل للحديث عن أماكن الذاكرة ،يمكننا أن نقول ،لا حديث عن البيت في كندا ،في نص يحمل عنوان حكايات الجنيات وما بين سطورها يروي الكاتب بعضا من تلك الحكايات التي سكنت الوعي الأوروبي حيث يتوه الجميع في الغابة !”دائما هناك الغابة،فضاء كثيف ومظلم في الأغلب ،مسرح رحب للاوعي،للمخاوف والكوابيس”،ربما تشبه تلك الغابة غابة أخرى ،مدينة ضائعة في براري الغرب الأوسط الكندي كانت سببا في أن يصاب الكاتب ب”بمرض مهاجري العالم “من نقص قيتامين .د حيث ندرة التعرض للشمس ،تقف أماكن الذاكرة وشخوصها أيضاً في مواجهة مدينة يمثل فيها مهاجري العالم “تمثيل نسبي وقياسي من تنويعة السكان العالمية “،
أيقونات بصرية تصاحب شريط الصوت مخبز شارع فريد وحي عابدين حيث الرحلة اليومية لشراء الفينو مقطع من هجرتك لأم كلثوم ولمحة عين لبوستر محمد منير ،مقهى فتحي بعمارة أنور وجدي ،خنازير مذبوحة ومسلوخة بكامل أجسامها ورؤوسها،تعاليم روجر ووترز الثورية وحائط يقف وحيدا في قلب الصحراء يحمل شكاوى جيل ضائع ،ثم بيت الطفولة في عابدين وبلاطة رخامية منقوشة بنقش إسلامي في قلب فسقية البيت الذي احترق “هل احترق؟” في أحداث ثورة يناير :”إن الأماكن تظل ككتابات،كأنصاب تذكارية،وأحياناً كوثائق”
لا صلات إنسانية حقيقية بين المهاجر ومجتمعه الجديد ،يراقب المهاجر سكان المدينة ويدون مشاهداته عنهم ، لا نكاد نجد حوارا واحدا سوى مع “فاطيما” نادلة البار الهندي ،وفاطيما التي تشارك الكاتب أنتماءها لثقافة أخرى مما جذبه لبدء حوار معها هي النموذج الضد للكاتب فهي رغم أصولها الأفريقية ولدت “هنا” كما تقول له هي “ابنة الجيل الثاني التي تخلصت من لكنتها وربما من مرض نقص فيتامين .د” فاطيما هي المسافر المستوعَب حسب تودرورف والذي أصبح جزءا من ثقافة جديدة ونجح في الإندماج مع مواطنيها،أما الكاتب فيظل هو “نموذج الغريب” بالنسبة لهم “بالرغم من التنوعية العرقية لسكان الحي فإن البار لا يرتاده سوى البيض من أبناء الرقاب الحمراء وأحفاد رعاة البقر ينظرون باندهش للغريب الجالس مع نفسه يكتب في دفترولسان حالهم يقول:أيقصف المهاجرون مثلنا؟”
يستخدم الكاتب شخوص الماضي وذكرياته ليحكي سيرة المكان وتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي ويقف على أزماته الكبرى بدايةً من العائلة ولا سيما الأب الذي لم يوجد هنا بصورته العائلية وعلاقته بالكاتب فقط بل ك”رجل قياسي من جيل الستينات لا ينتمي لمؤسسات الدولة ولا المعارضة”
الأب المثقف الذي ينتصر لصلاح عبد الصبور ويراه “يغرف من بحر “على أمل دنقل الذي ينحت من صخر “انتصر لاستقلاليته وفرديته ليصبح “زمن الشعر الحديث هو زمن القطاع العام” وكأن الشعر الحديث في جزء منه جاء كثورة حقيقية خارجةعلى قوانين النظام وحشده واتجاهه السياسي،
العائلة والأصدقاء لم يكونوا أبطال تلك الكتابة التي احتفت بالعابرين ،فنلتقي بالمطرب اسماعيل البلبيسي في لقطة انسانية تبقى شاهدة على أكثر اللحظات مآساوية في التاريخ العربي وهي غزو العراق عام 2003،و”عم نظمي” المنجد الإفرنجي الذي بارت صنعته فظلت أصوات مساميره الرفيعة في عقل الكاتب وروحه شاهدة عهد ذهبي انقضى،وحمقى قصص ياسر عبد اللطيف وحكاياتهم الغريبة في المعادي القديمة والتي تجعلنا نتساءل عن الوهمي والحقيقي وعن ألعاب الخيال التي تمارسها الذاكرة.
مصاص دماء في مدينة سحرية..
المسافر المجازي هي صورة أخرى من صور الرحالة حسب تودوروف ،وهو الذي يستخدم “شعبا أجنبيا لكي يناقش أمورا لا تتعلق بهذا الشعب فقط بل بشخص المجازي وثقافته بالذات”
بين مدينة الٌإقامة الحاضرة في كندا ،والقاهرة مدينة الكاتب التي شهدت أربعين عاما من صخب حياته تظهر مدنٌ أخرى يمر عليها ياسر عبد اللطيف سائحاً :كولومبيا ،حلب ،نيو أورليانز”،وهو كسائح مثالي يسير متسكعاً بلا ضجر هذه المرة”يتخيل نفسه مصاص دماء في مدينة سحرية يهيم على وجهه” ينقل لناعن عين السائح الأكثر يقظة ملامح تلك المدن لا معمارها فقط بل سكانها وتاريخها وتحولات طالت طبيعتها وأهلها ويخرج من ذلك ليعرج على مصر ،ففي نيو أورليانزمدينة الجاز ندخل شارع بوربون ستريت” بنوادي الموسيقى وبارات الاستماع حيث لم يعد الجاز هو الموسيقى المنتشرة بل نوع رخيص من الروك آند رول السياحي،ويعقد الكاتب مقارنة بينه وبين شارع خليج نعمة في مدينة شرم الشيخ المصرية فكلاهما “يعكس فكرة تعميق ما هو سطحي.
يحل الكاتب ضيفا على مهرجان أدبي في كولومبيا ،بالتحديد في مدينة كارتاخانا مدينة الكاتب العالمي ماركيز ،ويشارك على هامش المهرجان في أمسية شعرية في إحدى المكتبات التي تشبه”بيوت الثقافة في مصر في حي من الأحياء الفقيرة
يحكي الكاتب “الجمهور كان بضع عشرات من السكان وقد جاء بعضهم بالبيجامات وبعضهم بملابس رياضية عدا بعض السيدات في منتصف العمر جئن بما استطعنه من ملابس وزينة”يقرأ عليهم فصلا من روايته فيجلسون في خشوع منصتين ،فيتساءل“عن مدى استيعاب سكان حي عشوائي مماثل بالقاهرة وهم شديدو الشبه بهؤلاء الناس لوجود كاتب أفندي بينهم يقرأ عليهم ما لا يسمن ولا يغني من جوع ،يليه بالضرورة تساؤل عن الفقر ومدى رفاهية الحاجة إلى الجمال،ويليه بالضرورة تساؤل عن فقر الروح”.
يبقى “في الإقامة والترحال” كتابة أجمل من الكتابة عنها وتبقى موسيقاه في أرواحنا بإيقاعاتها الراقصة والصاخبة و الشجية ، فهو وإن كان مغامرة كاتبها ورحلته إلى ذاته عبر البحث عن أماكن الذاكرة في الترحال ، مغامرتنا نحن أيضاً في قراءة ثرية وممتعة ودعوة للبحث عن لحظات كشفية لها طاقة المعرفة المضيئة في تاريخنا الشخصي ومحرضنا على رؤية أخرى لمكان ندعوه دون تأملٍ كاف ب “الوطن “،أو كما يقول ياسر عبد اللطيف “إذ لا تكفي الأذن وحدها /لالتقاط ما هوجهير بهذا اللحن”