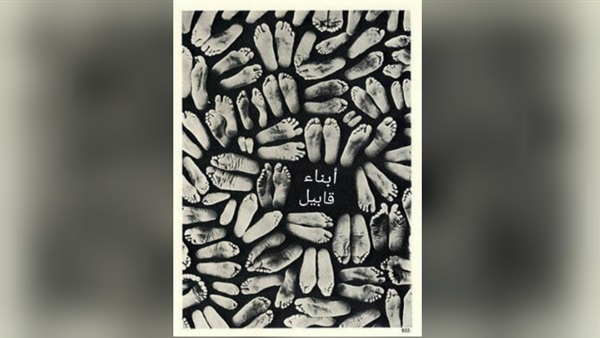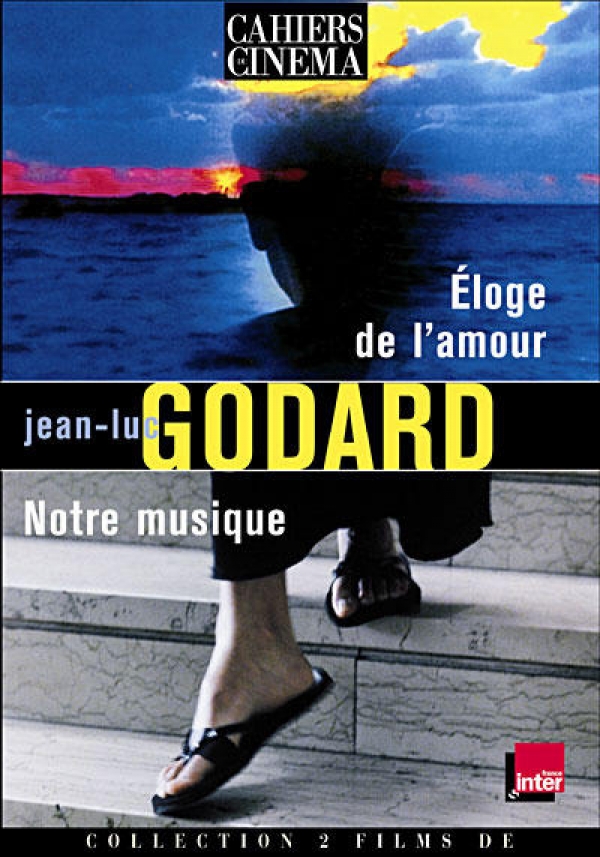الإفيه واضح الإشارة بالطبع ويحمل ازدواجية في المعنى ما بين البطارية والأشياء الحميمية لكنه أيضا يأتي معبرا كتوصيف حقيقي لهذه التجربة الفاترة التي تؤكد على ما سبق أن تنبأنا به من قبل في العام الماضي- حين قدم «على جثتي»- من أن أحمد حلمي فقد الكثير من طاقته الفنية وأن بطاريات الإبداع والتأثير الجماهيري الخاصة به قد أوشكت على النضوب.
لم يحاول حلمي أن يقيم تجربة «العملية ميسي» لنفس السيناريست مصطفى حلمي، والتي قدم فيها صوته على شخصية قرد ولم يحقق العمل أي نجاح أو مشاهدة تذكر وعاد وكرر التيمة في سياق مشابه مع «صنع في مصر»، ولكنه قرر أن يكون حضوره صوتا وصورة، ولما كان في تصور صناع الفيلم أن الصورة أهم من الصوت فقد انحرف الفيلم عن مساره كفيلم للكبار أي للجمهور ما فوق 12 سنة إلى فيلم أطفال ركيك وساذج يحمل بعض الحكم والمواعظ المباشرة على اعتبار أنها رسالة أو هدف والكثير من المواقف الفاترة والسذاجة نتيجة غياب المضمون الجيد أو الرابط الفكري والنفسي المطلوب لبناء أي حبكة درامية معتبرة.
حين تنتقل روح إنسان إلى جسد دمية وتنتقل روح الدمية (إن كان للدمية روح) إلى جسد إنسان يصبح لدى الكاتب، عادة، خياران أساسان: إما أن يتتبع الدمية في حياته وسط البشر بكل متناقضاتهم الحياتية والنفسية أو يتتبع المحنة التي يتعرض لها الإنسان في جسد دمية ليعيد تقييم حياته وأهدافه وعلاقته بالآخرين أو يسير وراء الاثنين في مقارنة فلسفية واضحة المعالم.
في صنع في مصر ولأن صورة حلمي المتمثلة في جسد علاء بروح الدبدوب أهم من صوت حلمي في جسد الدبدوب فقد سار الكاتب وراء حلمي الصورة، وبالتالي وراء روح الدبدوب في جسده، وأصبح هذا الخط هو الخط الأساسي بالنسبة للفيلم، بينما أصبحت شخصية علاء في جسد الدبدوب أزمة ثانوية تلخصت في بعض المشاهد والإسكتشات غير الطريفة والتي تمحورت حول محاولته التلصص على جسد علا، وكأنه استراح إلى فكرة كونه دبدوباً ولم تعد تشغله، بل على العكس وجد استفادة منها في إشباع رغباته الجنسية التفاهة.
من هنا نستطيع أن نقول إن الفيلم ذهب في اتجاه أن يكون فيلما للصغار وليس لأشخاص ناضجين بالغين لديهم الحد الأدني من ثقافة التلقي والاستيعاب، فالأطفال لن يعنيهم تلصص علاء في جسم الدبوب على جسد علاء، ولكنهم قد يهتمون أكثر بالدبدوب الذي أصبح الآن بني آدم يحاول أن يتعرف على عالم البشر ويعيش بينهم، والغريب أن صناع الفيلم لم يتعاملوا حتى مع هذا الخط بالنضج المطلوب لفيلم الأطفال، بل استمروا فقط في استثمار جهل الدبوب بعالم البشر في محاولة إنتاج أكبر قدر من الإفيهات اللفظية السمجة والعتيقة كأن يقول علاء بروح الدبوب لأمه يا بت ولزوجها «يا كاورك» أو يشير إلى سيارة بيضاء على اعتبار أنها تاكسي وهكذا، وهي مواقف شحيحة الكوميديا وضحلة الامتاع وإذا كانت متقبلة في بداية تعرفه على العالم إلى جانب اللغة الفصحى وهي أيضا من العناصر النمطية جدا، واستهلكت في الأفلام التي قدمت من قبل شخصيات أجنبية تتحدث العربية- والدبدوب هنا صيني يتحدث الفصحى- كل هذا متقبل نسبيا في البداية ولكنه يتحول إلى نسق عام للخط الخاص بالدبدوب في جسد علاء حتى ما يحققه من نجاح وقدرة على النهوض بمتجر علاء مرة أخرى ومخاطبة الصين لتصدير عرائس مصرية، فإنه يأتي في مشاهد سريعة عابرة، وكأنها لا تعني صناع الفيلم، وبالتالي لا تعنينا كجمهور، فالمتلقي لا يهتم إلا بما يهتم به صانع الفيلم ويركز عليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بل إن الأزمة الأساسية في الفيلم تصبح أزمة الدبدوب في جسد علاء سواء في مشاعره تجاه علاء أو تسليمه لنفسه وإيداعه في مستشفى المجانين ومحاولته الهرب ثم تهربيه بالفعل.
هنا ندرك أن حبكة الفيلم «سائبة» بالتعبير الشعبي ونعني بها أن غياب المضمون أو التيمة أو الفكرة من الممكن أن تؤدي إلى أن تضم الحبكة عشرات المشاهد التي يمكن أن تتكرر إلى ما لا نهاية فالمواقف التي يتعرض لها الدبدوب في جسد علاء يمكن أن تصبح مئات المواقف دون نهاية أو رابط بينها سوى الإفهيات والاستظراف، فلا يوجد سياق يحكمها أو ذروة تسعى لها ولكن مع انتهاء وقت الفيلم يقرر صناعه التوقف عن هذه المشاهد وإعادة كل روح إلى جسدها بنفس الطريقة الفانتازية ودون أن يكون ثمة سعي حقيقي لا من الدبدوب كي يسترد جسد الدمية ولا من علاء ليسترد جسده.
وحتى ما رأيناه في البداية لمحاولة الاسترداد جاءت سمجة- إمساك سلك كهرباء في حمام السباحة لضمان ظروف التبادل التي جاءت نتيجة تعرض كل من علاء والدبدوب لماس كهربي بسبب الماء في المحل- ويستهلك الفيلم وقتا بعدها في محاولة تجفيف علاء في جسد الدبدوب وتعليم الدبدوب في جسد علاء مصطلحات الحياة التافهة ثم يعودون للقاهرة وبدلا من أن ينشط علاء في محاولة استعادة جسده يستغل كونه دبدوبا ويذهب للتلصص على علا ليضمن صناع الفيلم إبعاده بقدر الإمكان عن سياق السرد وإجلاسه في دولاب علاء وإفراغ المشاهد لوجود حلمي كعلاء بروح دبدوب.
ورغم أننا لا نحاسب صناع الأفلام على المشاهد المحذوفة ولكن بالنظر إلى المشاهد التي قام المخرج بعرضها على الإنترنت نستطيع أن نتبين التوجه الأساسي للعمل ككل فقيام المخرج بحذف مشهد أسلحة «علا» التي تدافع بها عن نفسها هو بلا شك مشهد يلقن الاطفال قيما سيئة عن الأسلحة كما أن مشهد محاولة والد «علا» إحضار التليفون من تحت الدبدوب النائم على السرير وهو المعروف بمشهد التحرش بالدبدوب لا يناسب أيضا نفسية الأطفال الذين لن يستوعبوا فكرة التصاق الرجل بالدبدوب في هذا الوضع والشكل.
في النهاية يحل صناع الفيلم الأزمة بشكل يناسب أيضا عقلية الأطفال حين يعود الدبدوب إلى بيت العائلة وبالصدفة يعرف أن أخته الصغيرة في مشهد متواضع هي التي تمنت أن يصبح الدبوب أخاها وأخاها دبدوب وهو كشف يناسب تماما عقلية الصغار الذين ليس لديهم القدرة على تلقي حل درامي أو ذروة أكثر تعقيدا من ذلك.
السؤال إذن هل هناك ما يعيب الفيلم أن يكون فيلماً موجهاً للأطفال؟
الإجابة هي لا بالطبع، ولكن التجربة ككل نتيجة كونها بلا ضابط درامي أو فني تحولت دفتها إلى أن تصبح فيلماً يناسب عقلية الأطفال ولا يشبع الكبار على اختلاف عقلياتهم وتوجهاتهم، ولم يتم تأسيسها من البداية على أنها فيلم أطفال وهو ما وضح في طبيعة عمل علا في مجال الملابس الداخلية الحريمي أو مشاهد إعطاء والدها الحقنة ووقف علاء خلف مؤخرته والحديث عنها، ومشهد تعليم الدبوب في جسد علاء قضاء حاجته وكيف أن الدبوب بروح علاء يمسكه من الخلف ليقضي حاجته.
وحتى التركيز على قيم معينة سواء سلبية أو إيجابية جاءت في شكل مدرسي جدا كأنه ثقل يريد أن يتخفف منه صناع العمل للتفرغ إلى الإضحاك والهزل وعلى رأسهم فكرة الكسل الكاريكاتوري الذي تعيش فيه والدة علاء وزوجها والذي يطبع على علاء نفسه بقدر ما، فهذه القيمة السلبية لا نجد لها سوى ظواهر سطحية مثل الجلوس على كرسي الليزي بوي وعدم الرغبة في إغلاق سماعة الهاتف ولكنها لا تتطور عبر الحبكة لتصبح جزءاً من صراع الدبدوب في جسد علاء ضدها ولا جزء من صراع علاء في جسد الدبدوب لمقاومتها على اعتبار أنها كانت أحد الأسباب غير المباشرة فيما حدث لها وبالتالي يصبح لها حضور قيمي ودرامي مختلف.
ثم ما هو المقصود بـ«صنع في مصر» كعنوان للفيلم وما هي علاقته بالحبكة أو السياق!!
هل المقصود به العرائس التي قام علاء في جسد الدبدوب بصناعتها في النهاية لكي يضمن عودته إلى جسده مرة أخرى!! صحيح أنها تفصيلة تناسب عقول الأطفال، خاصة أن أمنية الطفلة أخت «علاء» كانت بسبب هذه العرائس الذي لم يكن يحب صناعتها، بالمناسبة فإن الفيلم وضح لنا أن «علاء» رغم وراثته موهبة صناعة العرائس عن أبيه إلا أنه لا يحب هذا العمل وبالتالي هو ليس كسولا فيه بل لا يحبه وهو أمر فارق، ولو أنه كان كسولا فيه ربما لارتبط هذا بكسل أمه وزوجها وأسباب فشله في أن يكون له حياة ناجحة ومثيرة، وبالتالي حين يقرر التخلص من الكسل وصناعة العرائس يتحرر من اللعنة ولكن لم تتم الإشارة لهذا بشكل جيد بل استمر الحديث عن أنه لا يحب المهنة التي أفنى والده عمره فيها ولم تمنحه مقابلاً لذلك.
ولكن ألا يوجد شىء آخر في الفيلم يصلح لكي يندرج تحت هذا العنوان ليصبح ضاما شاملا وليس مقتصرا على حدث تم تهميشه في سياق المواقف المبتذلة والإفهيات الضعيفة.
ربما هناك كل العادات السيئة التي يمارسها «علاء» من كسل وكذب وخمول فهو لا يقوم بتصليح التكييف بل يكتفي بوضع دلو أسفل الماء المتسرب منه، والذي يصبح سببا في إصابته بماس كهربائي وحلول اللعنة عليه- يذكرنا هذا المشهد بالمشهد الشهير لإصابة ميل جيبسون بالقدرة على قراءة عقول النساء بسبب تعرضه لماس كهربي في الحمام في فيلم «ماذا تريد النساء؟».
إن كل القيم الجيدة والنافعة والإيجابية نجدها على لسان الدبدوب القادم من الصين وفي سلوكياته التي تبدو مناقضة تماما لسلوكيات أغلب المصريين في الفيلم حتى علا نفسها وهي الشخصية الإيجابية الوحيدة، هل يقصد صناع الفيلم أن الكسل والخمول والفشل أصبحت هم صناعتنا الوحيدة أضف إليها الطمع وخيانة الأصدقاء والتلصص على أجساد الفتيات وهي الممارسات التي قام بها علاء في جسد الدبدوب طوال الفيلم! ربما وإن كانت المواقف السمجة التي صاغوها أضعفت كثيرا من هذا المضمون غير المباشر.
نعود لحلمي الذي أوشكت بطارياته على النضوب، هنا يبدو أداؤه فاترا بلا مساحة تمثيل أو إبداع جديدة، مجرد استعادة أساليب نمطية للإضحاك قدمها قبل سنوات طويلة في برنامجه «لعب عيال» عندما كان يتحدث مع الأطفال بجدية في أمور هزلية تفاهة، ولننظر إلى الفرق ما بينه وبين كريم عبدالعزيز على سبيل المثال في الفيل الأزرق فكريم ذهب لتقديم شخصية مختلفة عن السياقات النمطية التي طالما قدمها من قبل والتي انحسرت في شخصية «أبوعلي» الهزلية لسنوات، ولكنه هذا الموسم يعود ليلعب في مساحة الميلودراما والتراجيديا وهي مناطق جديدة عليه أما «حلمي» فهو لا يزال يدور في فلك ضيق من صنعه حتى بدا وكأنه يدور حول ذاته في نفس المكان دون أن يتقدم خطوة واحدة منذ سنوات.
ويبدو أن عمرو سلامة استسلم لحلمي تماما فلم يخرج به من تلك الدائرة المغلقة بل خطى إلى داخلها هو الآخر وقدم فيلما بكادرات خاملة، مجرد أشخاص في لقطة متوسطة أو واسعة ثابتة يتحدثون في مواجهة بعضهم، أسلوب أشبه بكروت البوستال ولكن بدون الحركة الحيوية الداخلية أو التنسيق البصري الجيد، ثمة ألوان زاهية في الكادرات تناسب الأجواء الفانتازية التي يدور فيها العمل وتمنح الصورة صفتها الكارتونية الخيالية وهو ما أكد لنا مرة أخرى أن الفيلم يدور في سياق طفولي وكأنه حدوتة ما قبل النوم، وهذا ليس عيبا ولكن العيب أن يأتي الفيلم بين بين.
يقول المخرج دراين ارنوفسكي إن هناك مكاناً وحيداً لوضع الكاميرا في المشهد هو المكان الذي لا يمكن أن تحكي الحكاية بدونه، ولكننا في هذا الفيلم نجد أنه سواء وضعت الكاميرا بهذا الشكل أو ذلك فإن الحكاية سوف تستمر دون اعتبار لزاوية التصوير أو طبيعة الإضاءة أو أماكن الممثلين، إن سلامة على سبيل المثال يصور علا من داخل الدولاب وهي وجهة نظر الدبدوب، حيث كانت تضعه ولكننا نكتشف أن الدبدوب يجلس أمامها على الكنبة وهي تفكر إذا ما كان بني آدم أم لا، إذن ما نفع هذه الزاوية في السرد أو الحكي البصري للفيلم! لا شىء، إن «سلامة» يشعرنا بأنه وضع تصوراً محدوداً جدا للكادرات في الفيلم، حيث في كل مكان من أماكن القصة المكررة نجده يصور من نفس الزوايا وبنفس الأسلوب ونقصد بها محل علاء ومحل علا ومنزل علاء وحجرة علا سوف يكتشف المدقق أن الزوايا وأجحام اللقطات تتكرر بنفس الأسلوب والطريقة في هذه الأماكن وهو ما يخلق حالة من الممل البصري لا يدركها الجمهور غير المتخصص ولكنها تصل إلى أذهانهم التي تمل تلقائيا من التكرار بحكم آليات التلقي الفطرية لأي إنسان.
بالطبع فإن الأطفال لا يعنيهم كل هذا فهم لا يدركون هذه المسألة وبالتالي يمكن أن تشفع له الطفولة السعيدة بالفيلم هذا التكرار ولكنه بلا شك يفضح الكثير من ضعف الإمكانيات الإخراجية لدى مخرجنا الشاب في رابع تجاربه.
يبقى أن نشير إلى أن ياسمين رئيس نقطة إشعاع بصري ووجداني في أي عمل تقدمه، دعونا من الأداء الهزلي الذي يتراوح ما بين الطرافة والاستظراف ولكنها تظل نقطة نور في الكادر وروح حلوة على الشاشة أن نصف موهبتها يكمن في هذه الجاذبية الربانية التي تتمتع بها على مستوى الحضور سواء متحدثة أو صامتة وبالطبع فإن إمكانياتها التمثيلية تفوق بكثير ظهورها في هذه التجربة المتواضعة والتي سوف تسقط سريعا من ذاكرة الجمهور والسينما على حد سواء، وبالتالي هي مطالبة بالحفاظ على بريقها الداخلي المشع كي لا تفقده وسط غبار الهزل والسماجة وثقل الظل الذي يصبغ الفيلم كله.
إن صنع في مصر هو «الشرطة الأخيرة» في بطارية حلمي، فإما أن يعيد شحن طاقته الداخلية الكامنة فيه كممثل موهوب لا يزال يحمل في جراب روحه الكثير وفنان جماهيري له قاعدة واسعة يصر على تفتيتها بتجارب بالية، وإما أن يسير على نفس الدرب الذي سلكه من قبل زميل دفعته ورفيق بداياته محمد سعد فيصبح بقايا ممثل جيد وذكرى تجربة كوميدية لمعت لسنوات قليلة ثم انطفأت سريعا وتجاوزها الزمن والجمهور.
ريفيو:
سيناريو: مصطفي حلمي
إخراج: عمرو سلامة
تمثيل: أحمد حلمي – ياسمين رئيس
إنتاج: نيو سنشري- شادوز
مدة الفيلم: 100دقيقة