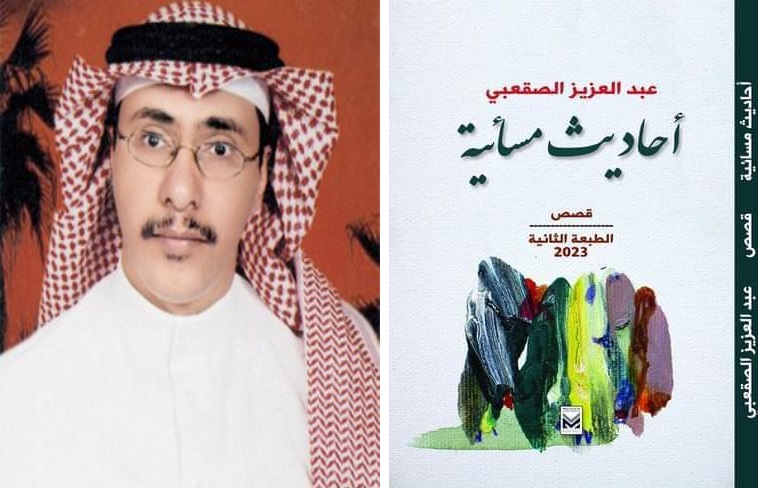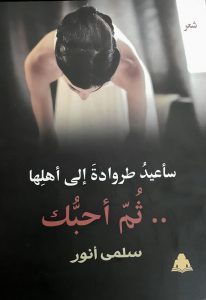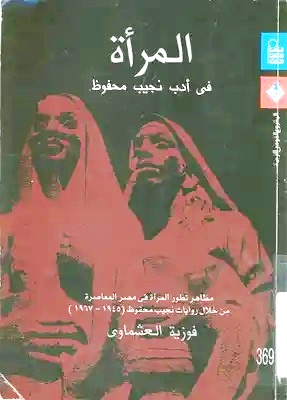انتهيت للتو من رواية شوق الدرويش، الرواية تحتاج للكثير من الكلام، يتجاوز كثيراً الجائزة التي نالتها والأخرى التي وصلت لعتباتها.
الرواية غرست في قلبي ندبة، لا أظنها ستدمل سريعاً، هو جرح يغذيه واقعنا المرير، بما يعج به من فتن طائفية، وبحور من الدماء تجري تحت راية الإيمان، وفتاوي تنتهك حرمة الحياة.
لعنة الله على التطرف أياً كانت الراية التي يرفعها، سواء أكان لنشر الإيمان بمهدي منتظر، أم بسبب الحب والثأر لمعشوق قتل غدراً.
هؤلاء المؤمنون الذين حملوا سيوفهم للفتح ولتلبية دعوة نبي أو خليفة منتظر، حتى تحولوا إلى قاتلين:
“فى يوم ما، لم يحن أوانه بعد، سيجلس الناجون منا ليسألوا أنفسهم كيف نجوا من كل هذا الإيمان، ويتعجبون إنهم ما هلكوا تحت ركام اليقين الذي انهال علينا”.
هكذا يفكر أحد هؤلاء المؤمنون، حسن الجريفاوي، وأظنه هو الفائز الوحيد بين شخصيات الرواية، في البداية ضاق قلبه بالدنيا وتعلق بالإيمان ورسالته وداعيه، فطلّق زوجته، وهجر بيته تلبية للنداء، حارب في صفوف المؤمنين، وقاتل الكفار، وفتح المدن، ولكن بعد حين رأى أهل الإيمان يرتدون كفاراً، وبعضهم أصبح ضيفاً على بيت النوباوي يشربون المريسة ويلعنون المهدية.
تلك الحيرة التي عصفت بعقل وقلب “الجريفاوي” وهو يرى أم درمان مدينة المهدي، والأمراء فيها يكنزون الأموال، والمقربون يكيدون لبعضهم، وفي السوق غش كثير، والمشنقة لا يجف الموت عليها، يمر في شوارع المدينة فلا يعرف فيها ما بايع عليه المهدي.
ورغم كثرة ما قتل، فحينما قتل طفلة في حربه الأخيرة –التي خرج فيها ليجدد إيمانه-وحينما انغرس الرمح بظهرها الهش، ظلت تطارده في نومه وصحوه، حتى ناجى الحسن إيمانه: يا مهدي الله لماذا صرت تركياً؟
صور بشعة لمجازر المؤمنين، ذكرتني بسقوط الأندلس ومحاكم التفتيش والإجبار على التنصير أوالموت، هنا أيضا رسم حمّور زيادة ببراعة مشاهد الإرغام على الدخول في الإسلام، وتزويج “نساء النصارى”الكافرات”” بدون رغبتهن أو سبييهن، وتعذيبهن.
التطرف واحد أياً كانت رايته، بشاعته واحدة، حينما يغيب العقل باسم الإيمان، أي دين هذا الذي يؤشر لأتباعه العبث في أجساد وعقول وقلوب ومصائر البشر؟
“إبراهيم ود الشواك” أكثر من أبغضتهم من شخصيات الرواية، هو لم يحمل سلاحاً، ولكنه لم يكن أقل إجراماً،حينما استغل دعوة الإيمان لصالحه، سواء حينما اشترى “ثيودورا” بالرشاوي، والتي آثارت رغباته الفحولية عندما رآها للمرة الأولى،ببياضها ووجها المنتمي لأرض أخرى، فاشتراها لتكون ملك يمينه،ولكنها آبت، فأرغمها على الإسلام، ثم توعدها بانتقام بغيض، باسم الإيمان: “الغلفاء لا تدخل الجنة”.
هو تلك الشخصية ذات الوجه الورع أمام الناس، من المؤمنين المناصرين للمهدي والذين ساعدهم على الدخول للبلدة، ويتحدث باسم المهدي وخليفته، وحينما جاءه حسن الجريفاوي بشكوكه، دفعه للخروج للجهاد فى الحرب القادمة “لتقوية إيمانه، وتصفية قلبه مما علق به من وساوس الشيطان”.
وكان هو وابنه من الستة الذين تسببوا في مقتل “حواء”ولم تشفع لها استغاثاتها، أو ضعفها وهم ينهشون آدميتها، وحينما ماتت بين آيديهم قال الشيخ:”لله الأمر من قبل ومن بعد، ادفنوها بعيداً.لا نريد فضائح في هذه الليلة المباركة “ليلة الإسراء والمعراج”.
“بخيت منديل” وجه آخر للتطرف، هذا الدرويش العاشق، الذي انتقل من سجن إلى سجن، إلا أن سجنه الأكبر كان عشقه، حيث حوله الحب إلى قاتل ليأخذ بثأر من أحبها. ندمه الأخير أنه لم يستطع الوفاء بديْنه لحواء، عندما نجا من قائمة ثأره “يونس”،ولكنه كان يثق في غفرانها.
وجه آخر للتطرف تبرزه الرواية، ويتردد على طول مسار أحداث الرواية، ظهر عندما كتبت حواء في مذكراتها عن بخيت:أنه لا يشبه هذه المدينة. فهو مختلف. نموذج سيدهش القارئ الغربي أن يطلع عليه.إن سيرته في المحبة جديرة أن يكتب عنها الأدب الغربي.عاشق من مسرحيات شكسبير سقط سهواً إلى هذه البلاد الوحشية،لولا أنه أسود،لولا أنه عبد من الدراويش”.
فكأن تلك الأوروبية التي لم تشفع لها مدنيتها وانتمائها إلى المجتمع المتحضر، تستكثر على الآخر “المتخلف والمتوحش” أن يخرج منه “بخيت” بحبه الذي أحاطها،واعتبرته مجرد استثناء كونه “أسودأ وعبداً”.
الثنائيات التي تتحدث بها شخصيات الرواية: “المؤمن والكافر” “الغرب المتحضر سواء أكان ذلك أوربا أو مصر، والشرق المتخلف والمتوحش” والمتمثل فى السودان وسكانها وأم درمان من الدراويش والفقراء، العبد والآسياد كانت أيضا ضمن ما برز خلال الرواية.
اللغة عند حمّور كانت بطلاً آخر للرواية، تميزه فى خلق صور شاعرية رائقة خاصة فيما يتعلق برسم العلاقة بين “بخيت وحواء”، وقدرة على توليد لغة غير مستهلكة فى الوصف.
قدرته على السرد، وإن سببت طريقته أحياناً ربكة لدى القارئ في تتبع خيوط شخصياته المتناثرة عبر فصوله، ذلك السرد الذي يبنيه حمّور كقطع البازل المتناثرة عبر فصول الرواية السبعة عشر، على القارئ أن يجمعها ويلضمها كعقد من الشخصيات والأحداث، هو هنا يحتاج لقارئ يقظ، قارئ يستطيع الإلمام بالأحداث والتواريخ،وإعادة ترتيبها وتركيبها، فتجده أحياناً يعيدك لسنوات للخلف، ثم ينقلك لمشهد يليه بعشر سنوات، أو لموقف آني.
وتميزت الرواية بعنصر التشويق الحاضر بجدارة، عبر صفحاتها التي تجاوزت ال400 صفحة، فرغم معرفتك في الصفحات الأولى بمصير “حواء” وموتها، إلا أنك تجد نفسك مندفعا للقراءة والمواصلة فى تركيب قطع البازل دون ملل، فلا يوجد مشهد به إطالة، والحوارات ذكية بجدارة، سواء بين شخوص الرواية أوالحوارات الداخلية، حتى تصل لمشهد النهاية.
استطاع حمّور زيادة أن يجعلك تنفر من التطرف، أن ترى واقعك بعنفه واضحاً، أن نكون واضحين جداً أمام مرآة أنفسنا لنسأل ذواتنا وضمائرنا، هل نحن نذكي هذا العنف أم نواجهه بما يكفي من عقل وقيم ووضوح؟