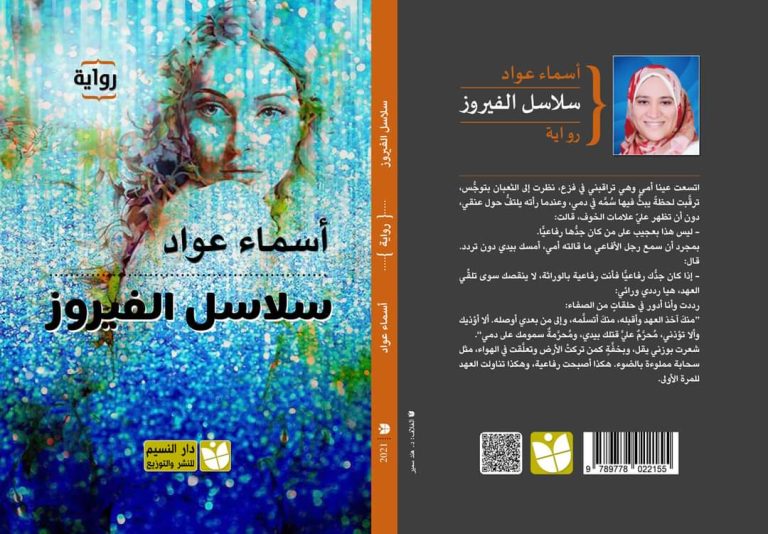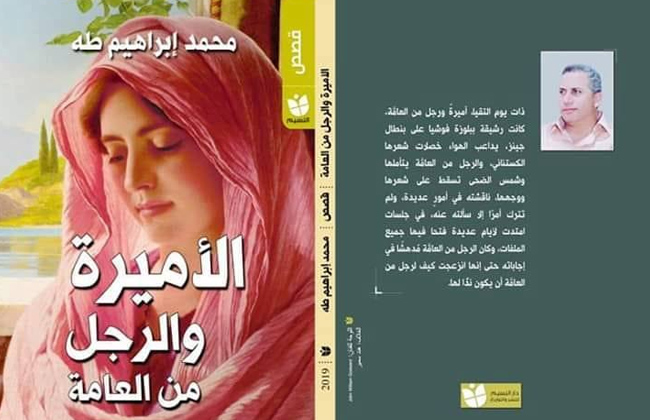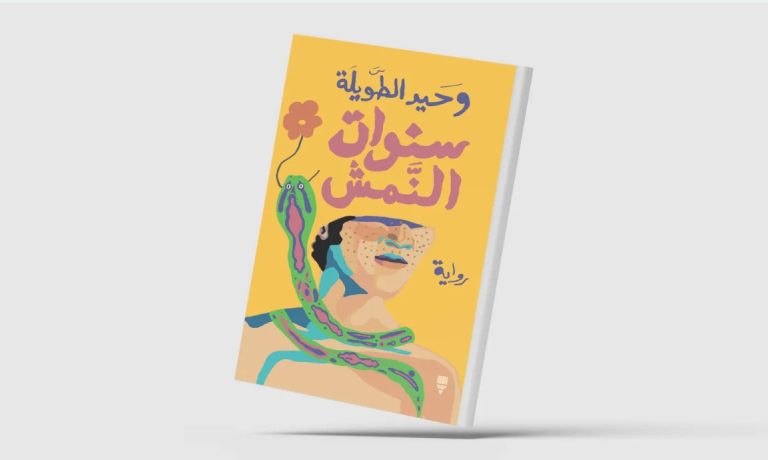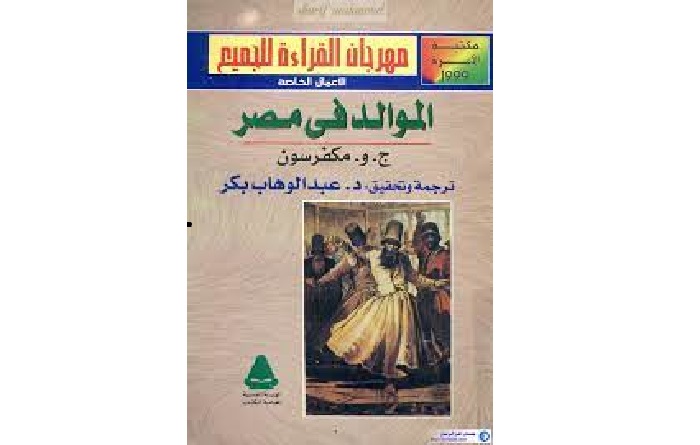المثنى الشيخ عطية
يسحرُنا “العقل الجميل”، لعالم الاقتصاد جون ناش، عندما يوضع في مرآة فنّ الرواية والسينما؛ تسحرُنا عقول البشر الأكثر حساسيّة فينا لما يعترينا من شرور وآثام، فتنبِّهنا إليها بموتها وقيامتها كما أليعازر، بمسيح الروايات، خلال فصامها الذي يصل إلى تداخل الذكر والأنثى الجميل في “مستر نون” نجوى بركات؛ يسحرُنا قبل أيٍّ من هذا، على اختلاف مواقفنا، وقوع نبيِّ الإسلام في سحر أعدائه، وقيامته منه كما عنقاء ترتفع بأجنحة النور؛ ويسحرُنا ما بين أيدينا حقاً من “حجاب السّاحر”: رواية الشاعر المصري أحمد الشهاوي، الأولى، التي تعالج موات العالم بشرور سحر شياطين الإنس، وقيامته الغريبة في محاولة الخلاص، في رحلاتها السندبادية السحريّة الصوفيّة إلى الجزر العجيبة، كما لو كانت داخل ليالٍ أخرى جديدة بعد ليالي شهرزاد، واكتشافها بعد كل هذا العناء أن الخلاص هو البقاء في شَرَك سحر الفصام كعقلٍ جميل يسحرُنا وينجينا من السحر، عبر شخصيتها المحورية الآسرة “شمس حمدي”، العاشقة المعشوقة التي تضربها شرور الأقارب، وتعيش فصام كونها الإلهة المصرية سِخمت، والإلهة إيزيس، في ارتقاء شبحي يمكن لمخيلة القارئ أن تخلقه، إلى كونها مصر المسحورة بشياطين ناسها كذلك:
“لم تكُن شمس نبيةً ترعَى غنماً، ومن ثم تقُود أمماً بعد ذلك، لكنَّها كانت ترى أضواء بيضاء باهرةً وتشعر بالطمأنينة، وهي تخرُج من جسدها متى شاءت، وفي مرةٍ اتصلتْ بي وقالتْ: “الآن سِخْمت تتكلم”، الصَّوت هو الصَّوت، لكن الكلام ليس كلام شمس، إنه كلام ربّة مصرية قديمة.
وفي مرةٍ ثانيةٍ حدّثتني هاتفيًّا، ونبّهتني أولاً إلى أنَّ المتحدثة هي إيزيس، وقالت: “أنا في رحلة رُوح، الناس يعطشُون في البراري، وأنا عطْشَى على شطّ النيل، عُدتُ من مرقدي إلى زمنكم لأُبْعدَ الشرَّ، وأشيعَ السَّلام، وأجمعَ ما تناثر أو تفرَّق على هذه الأرض، التي تستحقُ أفضلَ ممَّا هي عليه الآن.”. وصارت ترى العالم بطريقةٍ أفضل من ذي قبل، وأنها مُتوازنةٌ، وتعيشُ في فرحٍ ونشوةٍ، وأنها الأفضلُ في هذه الدنيا.”.
“حجاب السّاحر” عمر الحديدي، بطلها والراوي الأول لها، وأحمد الشهاوي كما يبدو في الكثير الكثير من فلسفته الشعرية الصوفية في فنّ العشق، روايةٌ تتجاوز ما اعتيد عليه في روايات معالجة الفصام، حتى في روايات الواقعية السحرية، إذ تعالج السّحر بالسحر نفسه وبأهم ما يحمل السحر من دلالاتٍ في مقدمتها اللغة والحروف، التي تجد عمق وامتدادات دلالاتها في لغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بمعالجة السحر، وإذ هي كذلك لا تنطلق من إدانات عمل السحر وكشف خداعات السحرة، وإن فعلت ذلك، وإنما بمدّ المعالجة إلى القيام برحلات سحرية مدهشةٍ لفكّ ربط المسحور (المصاب بالفصام)، تذهِل القارئ وتُغنيه بما يفتح الشهاوي من سجلّات تغوص في عوالم ما رحل وما بقيت آثاره كامنةً وفاعلةً في حياة أهل الواقع الحاضر، ومن سجلّات ثرية كشافةٍ لأدوات ما يحيط بعالم السّحر، من سحرةٍ ورقعٍ تُكتب عليها الطلاسم وكتبٍ تصل إلى كتاب السّحر العظيم لدى ملك الجنّ في جزيرة سقطرى اليمنية، ومن أشجارٍ تصل إلى شجرة دم الأخوين فيها، وعطورٍ تصل إلى مغامرات الحصول على العنبر من بطون الحيتان، ومن أزهارٍ تتقدّمهنّ زهرة اللوتس المقدّسة في رمزها للحياة والتجدّد لدى المصريين القدماء كملكة متوّجةٍ، وأحجارٍ كريمة ليس أقلّها الزمرد والزبرجد واللآلئ، وسجاداتٍ تضيء ألوانُها بالطاقة الإيجابية، وأماكنَ ومدنٍ وقرى وأنهارٍ ومحيطاتٍ مثل المحيط الهندي أو بحر الظلمات، والعديد العديد من العوالم الغنية بتفاصيلها التي لا تُروى كتسجيل يودي بالرواية إلى مخاطر لقاءِ حتفِها، وإنما بارتقاءٍ إلى السّرد الذي يحييها، من خلال أحداث الرواية والحكايات التي تنفتح فيها كما ألف ليلة وليلةٍ. ويزيد ذلك الشهاوي بإدخال عيشه، ومعرفته بفن العشق، ليخلقَ روايةَ حبٍّ يقوم فيها العاشق بما عليه من عشقٍ خارج مفهوم الواجب، بجواب الأرض والسماء والمجرات لينقذ معشوقته وعاشقته من شرور ما علق بها من أدران أفعال البشر؛ ويرتقي فيه بذلك إلى التجرّد من أنانية الذات، والذوبان في ذات المعشوق، في ظلّ عالَم شّرير باردٍ يكاد الحبّ فيه أن يضمحلّ، وتكاد الرجولة العميقة النبيلة فيه أن تنسحق بسطحية الذكورية. وأكثر من ذلك يزيد الشهاوي متعةَ وإثراءَ قارئه بلغته الشعرية الخاصة المعروفة عنه، وبمجازات وإيحاءات عالمه الصوفيّ، الذي يتجنّب “الشرح والتفسير إلى الكشْفِ والتأويلِ، والتدبُّرِ والتأمُّلِ، والمعنى الباطني، والتخيُّل والشَّطْح في التوَهُّم، والحقائق غير الظاهرة”، بالرواية هذه المرة لا الشعر، متخطياً بجرأة سندبادٍ فخاخَ الرواية التي تفتح عشب أرضها لأقدام الشعراء، كي توقعهم في ضلال استيهاماتهم بالإبداع، في أزمان جَزْر أمواج الشعر ومدّ أمواج الرواية:
“لم أذهب إلى الكتابةِ إلّا لإدخال البهجة على نفسي أولاً، ليمتلئَ قلبي مسرَّةً وفرحاً، فمثلي يبْتَهِجُ بِالتَّأمُّلِ والنَّظر عميقًا نحو ما لا يراهُ الآخرون، ساعياً نحو تسجيل أو خلْق عالمٍ موازٍ لحياة شمس حمدي، التي هي من أحسن النساء، ولم تأتِ امرأةٌ منذ حواء أفتن منها وأجمل، وحفظ تاريخها من الاندثار والنسيان، حتى لا يضمحلَّ ذِكْرُها، فهي دائمًا ما تقولُ لي: “لِكُلِّ شَيْءٍ آفَة، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ”؛ وكي تقرأ هي روايتها في حياتها، قبل أن تذهبَ إلى عالمها السريِّ والغامض، حيثُ تعيشُ ما تبقَّى من عُمرها في رحاب ربَّاتٍ قديماتٍ يحيين في غُرفتها، تتقدمُهن سخمت الإلهة اللبؤة، التي تُلقَّب بالمُنتقِمَة من المُخْطِئِين، ويركبن سيارتَها الجديدة التي أسهم أبوها الثري في شرائها.”.
في حجابه الذي على القارئ إن أراد المزيد من متعة عيش الأعمال الإبداعية كشفه، بالفصام داخل القراءة تجزّءاً من ذاتٍ إلى ذواتٍ، والتوحّد، والسير باتجاهين متعاكسين في ذات الوقت إن أراد إبداع عمل يستوحي طاقته من فيزياء الكوانتوم؛ يشكّل أحمد الشهاوي روايته في بنيةٍ يتتالى فيها سبعة وعشرون فصلاً، تركت اكتمالها الرباعيّ إلى مضاعفات الرقم المقدّس سبعة للقارئ، ويفتتحها بفصل: “الإلهة اللبؤة في بيت شمس حمدي”، المقصود كما يبدو بدقّةٍ، من حيث تكوينه كأحد أهم عناصر الرواية، ليس في حمل جانب الشخصية الأخرى، الإلهة سخمت، التي انفصمت إليها شخصية شمس فحسب، وإنما أيضاً في حمله الجانب الفلسفي الفني في الرواية، المتمثل في قلب المفاهيم التي تُراكمها وتُكرّسها الإيديولوجيات، وتُجسّدها في مصطلحاتٍ وحِكَمٍ وأمثالٍ توجّه حياة الكثير من الناس، حول الحياة والمرأة بشكل خاص، وبما تتم معالجته فيما يتفاعل داخل الشخصية من أحداث تمر بها، فشمس العاشقةُ التي تمتلك ما لا يمكن تخيّله من فنون ممارسة الحب، ترتقي من لفظ “اللبوة” المعبّر عن سبةٍ تنال من المرأة الموصوفة به كلعوب خبيثة توقع بالرجال، في الحياة المصرية الحالية، إلى الإلهة سخمت التي تُصورها الفنون الفرعونية كسيّدةٍ برأس لبؤة جالسة على العرش أو واقفة تحمل بيدها مفتاح الحياة، في مكانتها كأحد أعضاء ثالوث منف العائلي: (بتاح، سخمت، نفرتم) وكآلهة أنثى من ألقابها: السيّدة العظيمة، محبوبة بتاح، عين رع، سيّدة الحرب، سيّدة الأرضين، مصر العليا والسفلى، والجبّارة، القوية.
وداخل هذه العناوين التي تعكس شخصية شمس وتَطوّرها في حياة عشقها ومرضها الفيزيائي بسرطان الرحم، ومرضها النفسي بالفصام، تتجلّى فلسفة الشهاوي الوجودية القائمة كما يبدو على وحدة وصراع الأضداد، وعلى “التشابك الكمي” الذي تعكسه عناوين من مثل: “الجنون القمري، كأنها لم تكن، أين هي بالضبط، ويمكن أن تسميها اللاوجود”؛ وتتقاطع هذه الفلسفة مع لغته الشعرية الصوفية الثرية بالتراث الصوفيّ ولغة القرآن.
في حجابه الذي يغلّف منظومةَ سرده، يتكشّف السّرد عن راوٍ عليم هو عمر الحديدي الذي كان ساحراً قبل أن يتحول إلى كاتب وشاعر، يسرد عن امرأة لا مثيل لها هي شمس حمدي، معشوقته التي عانت من اغتصاب عمّها لها وهي طفلة، وأصابها زوج أختها وشريك والدها في مصنعه غازي الشحات، وللاسم دلالته، بشرور السّحر، والدسائس التي تلوّث سمعتها، من أجل الاستيلاء على المصنع.
ويتداخل سرد عمر مع سرد شمس بسلاسة تتداخل مع اختلاف الزمن طيلة الرواية وبما يمنحها الحيوية والتشويق والتنوع.
وفي هذا الحجاب الذي يكشف عن إيمان عمر الحديدي بردّ المظالم وعدم ترك الظالم دون عقاب، وفق فلسفة العين بالعين والسنّ وبالسنّ، تجري الرواية بتشويق عميق، يتضمّن الأبعاد النفسية واللغوية في مسألة تمس وتكشف نظرة المجتمع الذكوري إلى المرأة كوعاء للإنجاب، وتتمثّل في تجربة إصابة شمس بسرطان الرحم، واستئصال رحمها، ومناقشة هذا، بجمع شمس لتسع نساء يبدين آراءهنّ التي تتكشّف فيها نظرة المجتمع ونظرة المرأة إلى نفسها. كما يتضمّن التشويقُ محاولة عمر إنقاذَها بفكّ ربط السحر وكشف الجاني، وتشويق المعلومات الثرية عن عوالم السحر بسحر اللغة والكشف، إلى ختام إبقاء الرواية مفتوحةً بما يثير تساؤل القارئ عن مصير شمس، داخل الرواية وخارجها، حيث “لا ينسى عُمر قولها عندما التقته أوَّل مرةٍ: “أنا لحنٌ لم يُعزَفْ بعد”، “أنا امرأةٌ لن تشهدها مرتين أبدًا”، “أنا امرأة تُخْلَقُ مرّةً واحدةً ولن تتكرَّر أو تعُود”، ويؤمن أنها ستتركُ بصمتَها على ما هو قادم.
.
أحمد الشهاوي: “حجاب الساحر”:
الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2022
344 صفحة
………………
*نقلا عن القدس العربي 16 من أكتوبر 2022