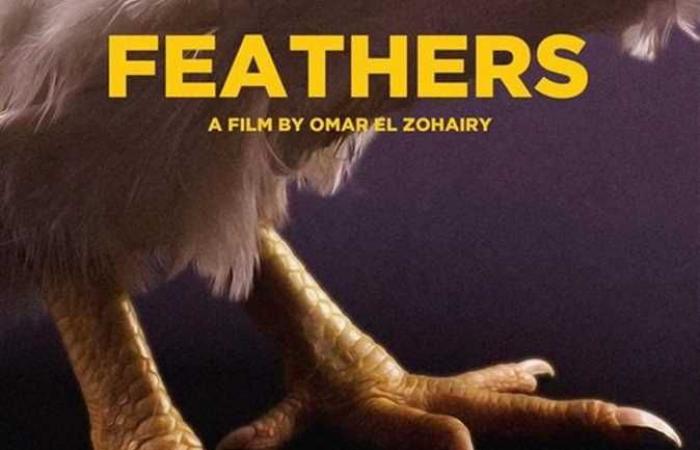وربما كان هامش الحرية الزائف الذي أعطاه لنا الرئيس مبارك منذ فترة ليست بالبعيدة- كوجاهة ديمقراطية زائفة- لا نستطيع التبجح بكوننا ننعم برفاهيتها- قد أدى إلى إنتاج العديد من الأفلام السينمائية التي تحاول نقاش الوضع السياسي والفوضى التي يعيشها المجتمع المصري، ولكن من خلال عدة أسقف لا يجب علينا التطاول عليها؛ وإلا أدى ذلك إلى منع “السيد الرقيب” للعمل الفني بأكمله ومن ثم رفضه ؛ ولذلك رأينا أفلاما مثل “هي فوضى” للمخرج “يوسف شاهين” بالتعاون مع “خالد يوسف” 2007، “حين ميسرة” للمخرج “خالد يوسف”2007 ، وأخيرا “دكان شحاتة” للمخرج “خالد يوسف” أيضا 2009 ، وليس معنى ذلك أن السينما المصرية لم تقدم نقدا سياسيا أو اجتماعيا من قبل، فلقد سبق أن رأينا العديد من الأفلام التي تتعرض لمثل هذه القضايا مثل “التحويلة” للمخرج الراحل “آمالي بهنسي” 1996 ، “البرئ” للراحل “عاطف الطيب”1986 ، “الزمار” للمخرج “عاطف الطيب” أيضا1984 ، والذي أدى ضربه الحائط بأسقف الحرية المتاحة له إلى منع عرض الفيلم تماما من العرض الجماهيري؛ ومن ثم لم يُعرض الفيلم سوى في المهرجانات الدولية ولذلك لم يعلم عنه المشاهد المصري أي شيء، كذلك رأينا فيلم “وراء الشمس” للمخرج “محمد راضي”1978 ، وغيرها من الأفلام التي حاولت نقد الواقع السياسي المصري ولكن من خلال صيغة هادئة، متخفية أحيانا لضمان قدرتها على الانفلات بعيدا عن يد الرقابة؛ إلا أن ما نراه الآن تُعد نوعية تكاد تكون مختلفة عما سبق تقديمه من الأفلام، سواء في درجة حدتها أو نقدها المباشر في قول ما ترغبه نظرا لارتفاع السقف- الزائف- قليلا نتيجة العديد من الضغوط الخارجية.
وهنا رأينا أن رأس المال الذي تم ضخه في السوق السينمائي المصري متضافرا مع هامش الحرية الزائف قد أديا معا إلى إنتاج العديد من الأفلام الجيدة، ذات القيمة، بل ومحاولة التورط الحقيقي مع الواقع، ولكن هل نستطيع القول أن فيلم “دكان شحاتة” للمخرج “خالد يوسف” يُعد من قبيل الأفلام النقدية للواقع بمعناها الذي نألفه؟
أعتقد أن المخرج “خالد يوسف” حاول قول الكثير في هذا الفيلم، إلا أن هذا الكثير الذي سعى جديا من أجل قوله قد أدى إلى إتخام السيناريو بالكثير من الرطرطة التي لم يكن هناك طائلا من ورائها؛ وبالتالي ابتعد المخرج كثيرا عن قصة الفيلم الأساسية، بل وتناسى أن السيناريست “ناصر عبد الرحمن” قد كتب له سيناريو ما، وبالتالي أمسى- خالد يوسف- يصور فيلما خاصا به وحده، لا يقدم لنا ولا يحمل سوى أفكار “خالد يوسف” نفسه حول الفوضى السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المصري، وهنا كان من الأليق “بخالد يوسف” إطلاق عنوان “دكان سياسة” بدلا من “دكان شحاتة” على هذا الفيلم؛ نظرا لأننا لم نر فيه فيلما سينمائيا بقدر ما قدم لنا أفكارا سياسية مصدرها فكر “خالد يوسف” نفسه، ولأنه إذا ما أطلق عليه هذا العنوان- دكان سياسة- سوف نقبل منه أية بضاعة أو تخاريف سياسية يرغب في تقديمها لنا- أليس الأمر مجرد دكان يبيع أي شيء؟-.
ولذلك تساءلنا كثيرا لماذا نحا “خالد يوسف” بفيلمه مثل هذا المنحى على الرغم من أن السيناريست “ناصر عبد الرحمن” قد كتب له سيناريو إنسانيا لا بأس به؛ وبالتالي فهو يستطيع من خلاله تقديم فيلما جيدا يحمل من المشاعر الإنسانية الكثير؟ هذا فضلا عن أن القصة تقترب إلى حد بعيد من قصة “يوسف ابن يعقوب” وكراهية إخوته له نتيجة حب والدهم له وتفضيله عليهم؟
أظن أن رغبة عارمة في محاولة جذب الغوغاء والبسطاء ومتوسطي الثقافة قد هيمنت على رأس “خالد يوسف” وبالتالي قدم لهم الكثير من البهارات/السياسة دون رابط يربطها بالقصة الأساسية في الفيلم، هذا فضلا عن ظهور “خالد يوسف” أمامهم كالمخرج البطل، غير الهياب، والمدافع عن حقوقهم، أقول أن هذه الأمور كانت هي الهدف الأساس في ذهن المخرج الذي بدا لنا في هذا الفيلم وكأنه ما زال يتعلم أبجديات الإخراج السينمائي حتى لكأن هذا الفيلم يُعد التجربة الإخراجية الأولى له في هذا المجال.
ولذلك رأينا أثناء نزول تيترات الفيلم الكثير جدا من العناوين الوثائقية في العديد من الصحف يصاحبها بعض اللقطات الأرشيفية المسجلة في تليفزيونات العالم عن الكثير من الكوارث التي تنهال على هذا العالم لاسيما الكوارث المحلية الخاصة بمصر، إلا أن “خالد يوسف” فضل عرض هذه الكوارث بداية من عام 2013 وكأن هذا العام هو العام الفاصل الذي استطاع “خالد يوسف”- ببصيرته البعيدة والمكشوف عنها الحجاب- معرفة كونه عام الانفجار الشعبي العظيم في مصر- التي لا تنفجر أبدا- ومن ثم بدأ في العد التنازلي عاما بعد آخر عارضا الكثير من تلك الكوارث مثل غزو العراق للكويت، حرب الخليج- هاجسه في فيلمه الأول “العاصفة” 2001 -، إعدام صدام حسين، حريق مسرح بني سويف، أزمة الغذاء في مصر والعالم، حادث الدويقة، غرق العبّارة سالم اكسبريس، الغلاء الفاحش الذي بات يعيش فيه المصريين، الإقبال على مجاعة في مصر، صدامات الشرطة والمواطنين، وفاة المخرج يوسف شاهين، تولي أوباما رئاسة أمريكا، وغير ذلك الكثير مما تعاني منه مصر والعالم حتى يصل في نهاية عرضه التسجيلي إلى عام 1981 – نتيجة عده التنازلي عاما بعد عام- واغتيال الرئيس السادات ومن ثم بداية تولي “مبارك” للحكم، وكأنما يريد “خالد يوسف” القول ( أن كل هذه الكوارث التي حلت بمصر، وكل هذه الأزمات لم تحدث إلا منذ عهد تولي مبارك للحكم حتى الآن) وبالتالي فهذا العهد عهد فاسد منذ بدايته.
وهنا ينهي “خالد يوسف” هذا العرض مع نهاية تيترات الفيلم حينما نرى أهالي منطقة بالكامل يخرجون كي يقطعوا الطريق على قطار بضائع محمل بالقمح ومن ثم يستولون على أجولة القمح في مشهد لا يوحي سوى بالمجاعة الشاملة التي يعيشها الكثيرين جدا من المصريين الآن، الذين لا يستطيعون توفير ثمن رغيف الخبز كي يسد رمقهم.
ربما كان هذا المشهد الذي بدأ به “خالد يوسف” فيلمه يُعد من أهم مشاهد الفيلم؛ وبالتالي فهو يتضافر مع مشاهد النهاية البديعة التي أنهى بها فيلمه؛ فلقد أشعرنا هذا المشهد بأننا أمام جيوش من الجوعى التي لا يعنيها سوى سد جوعها حتى ولو كانت هراوات الشرطة خلفهم، فهم على استعداد لقتل الشرطة بالكامل من أجل ملئ بطونهم الفارغة، ولكم أبدع “خالد يوسف” في تصوير هذا المشهد والتعبير عنه بصدق بمساندة كاميرا “أيمن أبو المكارم”.
نقول أن هذا المشهد يرتبط ارتباطا وثيقا بالنهاية التي رأينا فيها العديد من المشاهد المختلفة التي ترصد فيها “عين الكاميرا” كل ما يدور في بر مصر بعدما تحول الحال فيها إلى فوضى عارمة وشاملة، فنرى المطاوي والسنج والسيوف المرفوعة في كل مكان بينما الناس تجري في فوضى خائفة، ومشهد آخر يصور لنا السطو المسلح على المواطنين، وغيره لأبواب شقق يحاول أصحابها إحكام إغلاقها من الداخل بالعديد من الترابيس فضلا عن إغلاقها بمفتاحها الخاص، ومشاهد مطاردة الشرطة للمواطنين بلا تمييز، وصدامات الشرطة مع الشعب، ومشاهد عربات الأمن المركزي التي لا تحصى في كل مكان وكأنما مصر قد باتت ثكنة عسكرية، ومشاهد تهديد الجماعات الإسلامية لأمن الناس إما بتكسير وتخريب دور العرض السينمائي أو محاولة ضرب الناس لاسيما النساء في الشوارع لإرغامهن على ارتداء الحجاب، وغير ذلك الكثير من الفوضى العارمة التي حلت بالقاهرة ومصر بالكامل حتى لكأنك أمام أكثر مشاهد أفلام الرعب إثارة؛ وبالتالي فلن تشعر سوى بالكثير من الانقباض نظرا لأن ما قدمه لنا “خالد يوسف” من مشاهد تكاد أن تكون حقيقة واقعة بدأ مجتمعنا المصري يعيشها الآن، وربما تكون بالفعل إرهاصا لبداية فوضى حقيقية قد تحل بمصر قريبا جدا، وربما نتيجة لذلك رأينا أن مشهدي البداية والنهاية كانا من أصدق وأفضل ما قدمه “خالد يوسف” في فيلمه “دكان شحاتة” كي يقع بعد ذلك في الكثير من الأخطاء السينمائية، والكثير من الحشو، والأكثر من الاستسهال والسلق في ثنايا فيلمه الدائر بين هذين المشهدين البديعين.
فقصة الفيلم بسيطة تماما وان كانت تحمل قدرا لا بأس به من الإنسانية، ومن ثم نرى من خلال الفلاش باك flash back بعد خروج “شحاتة”(عمرو سعد) من السجن ورؤيته لمشهد السطو على قطار القمح، نقول أننا نرى مولد “شحاتة” عقب اغتيال السادات أي عام 1981 وقد توجه به والده الحاج “حجاج”(محمود حميدة) إلى مسقط رأسه في الصعيد كي تلد امرأته هناك مفضلا أن يولد ولده في الصعيد بدلا من القاهرة التي يعيش ويعمل فيها، إلا أن الزوجة تموت أثناء الولادة؛ وبالتالي يعود الزوج بابنه- شحاتة- وحيدا كي يتكفل هو بتربيته مؤديا في ذلك دوره كأب وأم في ذات الوقت، ونتيجة للاهتمام الشديد الذي يبديه “حجاج”(محمود حميدة) بولده “شحاتة” ومن ثم تناسي ولديه الآخرين اللذين أنجبهما مع ابنته الوحيدة من أم أخرى غير أم “شحاتة”، نقول أنه نتيجة لذلك تعتمل نفس أخويه بالكثير من الكراهية تجاه “شحاتة” الذي يستحوذ على أبيهما كل حواسه ومشاعره.
ولذلك نرى الدكتور “مؤنس”(عبد العزيز مخيون) الذي يعمل لديه “حجاج”(محمود حميدة) كجنايني يحاول نصحه- حجاج- بأن يحاول التقريب بين “شحاتة” وأخويه الآخرين حتى لا يكون بينهما الكثير من الشقاق والكراهية، إلا أن شعور الأب(محمود حميدة) تجاه ولده الأصغر بأنه يستحق الكثير من عطفه نظرا لموت أمه صغيرا، ونتيجة لأنه كان فألا جيدا عليه حينما كتب له الدكتور “مؤنس”(عبد العزيز مخيون) جزءا من حديقة الفيلا باسمه بيعا وشراءا من أجل أن يقيم “حجاج”(محمود حميدة) دكانا لبيع الفاكهة في هذا الجزء بدلا من بيعها في الشارع، نقول أن هذين الأمرين قد جعلا الأب أكثر اهتماما بولده حتى أنه قد أطلق على الدكان الجديد اسم “شحاتة” تيمنا بابنه الذي أسماه بهذا الاسم حينما وُلد لأنه كان “يشحته” من الله على حد قوله هو، كما أطلق هذا الاسم على الدكان أيضا لأنه قد أخذه من الدكتور “مؤنس” عن طريق الشحاتة، إلا أن هذه الأمور وغيرها الكثير من تدليل الأب لابنه دون بقية أبناؤه وغير ذلك قد أدى لكراهية أخويه الذكور له ومحاولة إيذائه معظم الوقت، كذلك نرى “سالم”(محمد كريم) أخو “شحاتة”(عمرو سعد) حينما يذكر لأبيه رغبته في الزواج من “بيسة”(هيفاء وهبي) يرد عليه الأب بأنه قد وعده أن يزوجه إحدى النساء الصعيديات، وحينما يعترض “سالم”(محمد كريم) يخبره أبيه بأنه لا يمكنه الزواج من الفتاة التي يريدها أخوه زوجة لنفسه- قاصدا في ذلك شحاتة- وبأن “شحاتة” هو الذي يستحقها لأنه قد طلبها قبله؛ مما يؤدي إلى ازدياد كراهيته “لشحاتة” لأنه هو الوحيد المتعلم والمرفه والمدلل والأقرب إلى نفس أبيهم.
ولذلك نرى الأخوين يحاولان دائما مضايقة “شحاتة”(عمرو سعد) في العمل بجعله يقوم بكل شيء بينما هما مستكينان لا يفعلان شيئا، بل ومحاولة ضربه والاستهزاء به وإهانته أكثر من مرة، إلا أن “شحاتة” المُحب لأخويه كثيرا والذي يقدمه لنا الفيلم بشكل فيه الكثير من الإنسانية كان كثير التسامح مع شقيقيه، ولكنا لاحظنا أن هذه الإنسانية المفرطة التي قدمها لنا “خالد يوسف” في “شحاتة” لم يكن لها ما يبررها على الإطلاق، هذا فضلا عن أنه لا يوجد إنسان نقيا دائما أو شريرا دائما بمثل هذا الشكل الذي رغب “خالد يوسف” في تقديمه؛ لأن هذا النقاء والبياض المفتعل المبالغ فيه لا يمكن له الخروج من دائرة الهطل والعبط، إلا إذا كان “خالد يوسف” يقصد فعليا وصف بطله بهاتين الصفتين.
على أية حال يخطب “شحاتة”(عمرو سعد) “بيسة”(هيفاء وهبي) في الوقت الذي يشعر فيه شقيقها “المعلم كرم”(عمرو عبد الجليل) بالقلق دائما نتيجة لأنه يرى أن “شحاتة” لن يستطيع حماية نفسه من أخويه أو حتى الحصول على قرش واحد من ميراثه إذا ما مات أبيهم المعلم “حجاج”(محمود حميدة)؛ وربما لذلك يحاول “المعلم كرم”(عمرو عبد الجليل) دائما عدم إتمام تلك الزيجة إلا بعد كتابة المعلم “حجاج”(محمود حميدة) حق “شحاتة”(عمرو سعد) له باسمه- أي يقوم بتقسيم الإرث في حياته- قبل موته ضمانا لحق أخته وزوجها المقبل، ولكن لأن “شحاتة”(عمرو سعد) لا يرغب في إثارة غضب أخويه يرفض ذلك الأمر تماما، إلى أن يموت الأب “حجاج”(محمود حميدة) ومن ثم يقوم الأخوان بطرد “شحاتة” من البيت والدكان، بل وعدم الاعتراف له بأي مليم في الميراث، ولكن لأن “محمود” ابن الدكتور “مؤنس” يحضر من أمريكا ومن ثم يخبرهم أن هناك إحدى السفارات الراغبة في شراء الفيلا وبالتالي يعرض عليهم مليونا من الجنيهات نظير التخلي عن الدكان المحتل جزءا كبيرا من حديقتها، ولكن بشرط اجتماعهم كأخوة جميعا وقت إتمام العقد بما فيهم “شحاتة”، وأختهم “نجاح”(غادة عبد الرازق)، ومن هنا يحاولون البحث عن “شحاتة” ومن ثم يزجون به في السجن بتهمة تزوير ختم والدهم بعد حصولهم على المليون جنيه وحدهم، وبذلك يكونوا قد تخلصوا من “شحاتة” الكارهين له من جهة، وحصلوا على نصيبه من المال من جهة أخرى، هذا فضلا عن أنهم يستولون على النصيب الأكبر الخاص بأختهم “نجاح”(غادة عبد الرازق) التي لا يتركون لها من نصيبها في الميراث سوى 70 ألفا من الجنيهات، وهنا يصر “سالم”(محمد كريم)- الأخ الأكثر كرها “لشحاتة” والأكثر رغبة في خطيبته “بيسة”(هيفاء وهبي)- نقول أنه يصر على الزواج من “بيسة” التي ترفض بكل ما يعتمل في قلبها من حب تجاه “شحاتة”، فتارة تحاول إحراق نفسها بإلقاء الكيروسين على جسدها، وتارة أخرى بالفاء نفسها من الدور السابع، إلا أن أخيها يزوجها “سالم”(محمد كريم) رغما عنها بعد أن يأخذ منه الكثير من المال.
وهنا يبدأ الفيلم في العودة إلى اللحظة الراهنة تاركا تكنيك الفلاش باك flash back فنرى “شحاتة” الخارج لتوه من السجن ومن ثم يشاهد سرقة قطار القمح أثناء ركوبه المواصلات كي يبدأ رحلة البحث عن إخوته الذين يحاولون التخفي منه بأي شكل إلى أن يستطيع الوصول إليهم بهدف الشعور بالدفء بينهم وليس بهدف الانتقام مما جعلنا نتساءل كثيرا، لماذا يحرص “خالد يوسف” على تقديم بطله بهذه الشخصية المازوخية؟ وهل مازوخية البطل بهذا الشكل تعد اثراءا للسيناريو؟ أم أن المخرج عايز كدا؟
على أية حال نرى “سالم”(محمد كريم)- الحاقد والكاره دوما لأخيه- والذي استولى على ماله وعمره وخطيبته يقوم بإطلاق النار على “شحاتة”(عمرو سعد) كي يرديه قتيلا حينما يستطيع “شحاتة” الوصول إليهم.
ربما نكون قد حرصنا على تلخيص قصة الفيلم فقط بشيء فيه بعض الاختزال، ولكنا لم نجد طريقة أخرى سوى هذا التلخيص كي نقدم للقاريء/المتلقي هذه القصة التي ليست في حاجة إلى النقد بقدر ما هي في حاجة قصوى للتأمل المنبعث من الدهشة.
بالتأكيد الدهشة من الفوضى التي قدمها “خالد يوسف” في فيلمه والتي لا تمت للسينما بكثير صلة- وان كانت تقرب من الخطبة السياسية-، والتأمل لهذه القصة البسيطة بهذا الشكل الذي حاولنا تلخيصه والتي بها الكثير من المشاعر الإنسانية، تلك المشاعر التي كان من الممكن تعميقها من خلال السيناريست والمخرج معا وبالتالي كنا سنرى فيلما إنسانيا عميقا يزخر بالكثير من الأحاسيس، إلا أن المخرج “خالد يوسف” رفض ذلك تماما محاولا إقحام فكره الخاص ومن ثم فتح رأسه أمامنا لقراءتها؛ فرأينا الكثير من الفوضى داخلها والتي أدت بدورها إلى فوضى أخرى داخل الفيلم.
فنحن لا يمكن لنا الاقتناع بأن هناك أسرة صعيدية تتكون من أخ “المعلم كرم”(عمرو عبد الجليل)، وأخت “بيسة”(هيفاء وهبي) ويخطبها رجل- “شحاتة”(عمرو سعد)- من أسرة صعيدية أيضا ومن ثم يطلب الأخ من أخته أن تقوم كي ترقص لخطيبها بعد مرور ثوان فقط على خطبتها له، إلا إذا كانت هذه الأسرة من صعيد أوروبا وليس من صعيد مصر، كما أنه لا يمكن تخيل حدوث مثل هذا الأمر في أحد الأحياء الشعبية هنا بالقاهرة، فما بالك بأسرة من الصعيد حتى ولو كانت تعيش في القاهرة كما قدمها الفيلم؟ كما أن المخرج “خالد يوسف” قد انفلت منه زمام الأمر في هذا المشهد؛ فبعدما كان ناجحا في السيطرة على (هيفاء وهبي) كممثلة وبالتالي كنا نرى “بيسة” وليس (هيفاء وهبي) التي نعرفها، نقول أنه فجأة حينما رقصت “بيسة” اختفت تماما لتظهر لنا فجأة (هيفاء وهبي) الحقيقية بغنجها المعتاد ومحاولة تدللها المصطنع.
كذلك ربما حاول المخرج “خالد يوسف” المتاجرة بكون “بيسة” هي الفنانة (هيفاء وهبي) التي تثير حولها الكثير من اللغط والضجيج وبالتالي رأيناها داخل الفيلم ترتدي ملابسا تتنافى تماما مع المنطق الاجتماعي الذي قدم به “خالد يوسف” الأسرة منذ البداية؛ لأني لا أعتقد أن مثل هذه الملابس من الممكن أن ترتديها أية فتاة صعيدية أو حتى أية فتاة عادية تعيش في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.
ولأن “خالد يوسف” حاول تسييس فيلمه بدلا من الاهتمام بالسينما، رأيناه يقع في الكثير من التكرار والرطرطة؛ فتارة نستمع من خلال الراديو إلى المذيع الذي يخبرنا بتولي الرئيس مبارك للحكم وتعهده ألا تزيد فترة الحكم عن فترتين رئاسيتين- وربما كانت تلك إحدى المزح التي نعرفها جميعا كمصريين؛ لأن الفترتين الرئاسيتين عندنا قد تصل إلى ثلاثين عاما- نقول أن هذا الحديث عن تولي الرئيس للحكم قد سبق ذكره في اللقطات الوثائقية التي تخللت تيترات الفيلم وبالتالي لم يكن هناك داع لتكرارها، كذلك رأينا الكثير من الجمع الذي يغلق طريق الصعيد حين توجه “شحاتة”(عمرو سعد) وإخوته لدفن أبيهم هناك، وحينما استفسر “شحاتة” عن الأمر قيل له أنهم أهالي محرقة بني سويف، ولكم كان هذا المشهد شديد الإقحام داخل البناء الفيلمي نظرا لأنه لا داع على الإطلاق له ولا طائل من ورائه ولم يضف أي جديد بقدر ما وصم الفيلم بالمزيد من التكرار نتيجة لأنه سبق وأن تم ذكره أيضا في اللقطات الأرشيفية في بداية الفيلم.
كذلك عرق العبّارة “سالم اكسبريس” التي يذيع نبأها الراديو بعد ذكرها في اللقطات الأرشيفية الأولى، وقتال الناس أمام مخابز رغيف العيش حتى نراهم يكادون أن يفتكوا ببعضهم البعض للحصول على الرغيف، ألم يلاحظ “خالد يوسف” أن هذا المشهد كان شديد الثقل لأنه لا يختلف كثيرا عن مشهد السطو على قطار القمح؟ أم أنه ظنه إضافة؟
أظن أن هذه الأمور قد جعلت المخرج يبدو لنا وكأنه شخص ينسى ما سبق أن قاله وقام بتصويره ومن ثم فهو يعيده علينا مرة أخرى أو بشكل آخر، ولعل هذا يظهر لنا بشكل بيّن من خلال الأغاني الستة أو السبعة التي قدمها الفيلم داخل سياقه والتي تم حشرها حشرا داخل السياق الفيلمي كي توضح لنا وتشرح ما سبق إيضاحه وشرحه، حتى لكأن “خالد يوسف” يفترض في مشاهده الكثير من الغباء وبالتالي فلابد أن يقول له بصبر وهدوء الحكيم (يا حبيبي أنا أقصد كذا وكذا، أوعى ما تفهمش).
إلا أنه من خلال هذه الفوضى السينمائية التي قدمها المخرج نتيجة إصراره على إقحام السياسة والنقد الاجتماعي داخل فيلمه، نراه قد قدم لنا أيضا بعض المشاهد التي بدت من قبيل الخطب السياسية، أو المقالات النقدية السريعة- مقال في كبسولة/مشهد- مثل مشهد طلب الأب (محمود حميدة) من “شحاتة”(عمرو سعد) ضبط صورة الرئيس (جمال عبد الناصر) المعلقة على الحائط فيقول( مد ايدك هات صورة الريس شمال شوية تغطي الشرخ اللي في الحيطة) فيرد عليه “شحاتة” (يابا الشرخ كبير.. الصورة متقضيش) فيرد الأب (أهي تغطي اللي تقدر عليه)، ربما كان هذا المشهد متضمنا هذا الحوار شديد السذاجة والسطحية والافتعال؛ نظرا لأننا جميعا ندري تماما مدى الشرخ الحادث بين العرب الذين كان ينادي “عبد الناصر” بقوميتهم العربية- هذا الوهم الذي انتهى قبلما يبدأ-.
كذلك مشهد “شحاتة” الجالس في الحسين والذي يعطيه أحد السائرين نقودا، فنرى “شحاتة” يقوم ليقول له (خد فلوسك يا بيه، أنا مش شحات) فيرد الرجل (يا ابني كلنا بنشحت من بعض، هي ماشية غير بالشحاتة؟) بالفعل هي لا تسير الآن سوى بالشحاتة التي أوصلتنا إليها حكوماتنا المتعاقبة حتى وصلنا إلى حكومة رجال الأعمال، ولكن هذا الكلام ليس مجاله فيلما سينمائيا بهذا الشكل الفج والمباشر، بالإضافة للكثير جدا من المشاهد النقدية مثل مقتل أحد الأشخاص في الشارع (البرص) وعدم إنقاذه على الرغم من وقوف المئات حوله متأملين دون المشاركة في إنقاذه، وبيع المياه للناس بدلا من الحصول عليها مجانا كحق من حقوق الحياة، فنرى البسطاء يتقاتلون على المياه التي يبيعها من هم مثلهم في بساطتهم والذي يقول( أدينا بنعبي مية النيل ونبيعها للناس)، ووقوف العشرات المتقاتلين أمام المستشفيات العامة للحصول على حق العلاج، إلا أنهم بالرغم من ذلك لا يستطيعون الحصول على هذا الحق، وغيرها الكثير والكثير مما لا يمكن أن يحتمله فيلما سينمائيا، حتى لكأن “خالد يوسف” رغب في ذكر كل ما يدور في مصر من خراب وهوان ومشاكل في فيلم واحد لا علاقة له بالسيناريو المكتوب له بما تم إقحامه فيه؛ ولذلك تساءلت جديا لماذا لم يتحدث المخرج عن حريق المسرح القومي، وحريق البرلمان المصري، أم أنه أرجأ ذلك للجزء الثاني من الفيلم؟
ربما كان النجاح الحقيقي الذي يحسب للمخرج “خالد يوسف” أنه استطاع أن يجعل من (هيفاء وهبي) ممثلة حقيقية، اقتنعنا كثيرا بدورها وبأدائها وبلهجتها المصرية؛ ومن ثم كنا نرى “بيسة” وليس (هيفاء) الحقيقية التي لم نكن نتخيلها على الإطلاق إلا في شكلها المدلل المصطنع، الشديد الافتعال والذي تحرص عليه دوما في حياتها الطبيعية على المسارح والحفلات؛ ومن ثم فنحن نتمنى استمرار (هيفاء) في مجال التمثيل الذي ستقدم فيه الكثير إذا ما استمرت على جديتها تلك، بدلا من مجال الغناء الذي لم تقدم فيه شيئا يُذكر حتى الآن.
كذلك أداء الفنان (محمود حميدة) البديع والذي أدى اختفاؤه في النصف الثاني من الفيلم إلى أن بدا لنا الفيلم خاويا، فاقدا للكثير من اتزانه، إلا أن أداء الفنانة (غادة عبد الرازق) الذي ظهر كثيرا ونضج في النصف الثاني من الفيلم كان هو المقابل لهذا الغياب، وبالتالي كانت هناك ما يشبه المباراة في الأداء البديع بينهما.
على أية حال، ربما أراد “خالد يوسف” القول أن اعتبار القوة كقانون ومنطق هو النتيجة الطبيعية لغياب التطبيق العادل للقانون؛ وبالتالي كان هذا هو السبب في مأساة “شحاتة”، وربما أراد أيضا القول أن مصر الآن تحيا في حالة غليان قد يؤدي إلى انفجار شعبي على الحكم العسكري- لا أعتقده أنا، وان كنت أتمناه- ولكن… ليست بالنوايا الحسنة تُصنع السينما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* روائي وناقد سينمائي مصري
خاص الكتابة