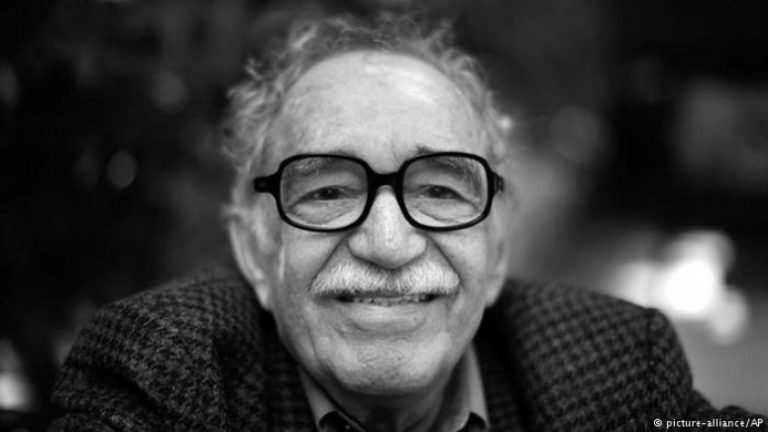يانيس ريتسوس
ترجمة: مبارك وساط
وُلِد يانيس ريتسوس في مونيمفاسيا (اليونان) في الأوّل من مايو عام 1909، لعائلة نبيلة من مُلاك الأراضي.. عانى ريتسوس من حالات فقدان مؤلمة جِدّاً في طفولته، فقد كان لوفاة والدته وشقيقه الأكبر بسبب مرض السل – وهو في سنّ مبكرة- ولإيداع والده في مصحّة للأمراض العقليَّة، وللخراب الاقتصادي الذي طال عائلته، أثرٌ بالغٌ على شعره.
في عام 1931، انضمّ ريتسوس إلى الحزب الشيوعيّ اليونانيّ. خلال احتلال دول المحور لليونان (1941-1945)، وأصبح عضواً في جبهة تحرير بلاده، وقام بتأليف عدة قصائد للمقاومة اليونانية. تشمل هذه كتيّباً من القصائد المكرّسة لزعيم المقاومة آريس فيلوتشيوتيس، والذي نُشر فور موت الأخير في 16 يونيو 1945.
كما دعّم ريتسوس اليسار في الحرب الأهلية التي تلت تلك المرحلة (1946-1949)، وفي عام 1948 أُلقي عليه القبض وقضى أربع سنوات في معسكرات الإعتقال.
يُعتبر يانيس ريتسوس أحد شعراء اليونان المُهمين في القرن العشرين، تمّ ترشيحه تسع مرات لجائزة نوبل للأدب دون أن يحصل عليها، وهنالك مَن يعزو ذلك إلى توجّهاته السّياسية. وعندما فاز بجائزة لينين للسّلام عام 1956 صرّح بأن «هذه الجائزة أكثر أهمّية بالنسبة لي من نوبل».
كتب عنه الشاعر الفرنسي لوي (س) أراغون: «في البداية لم أدرك أن ريتسوس كان أعظم شاعر حيّ في عصرنا، أقسم أنني لم أكن مدركا لهذا. اكتشفت ذلك على مراحل، قصيدة تلو قصيدة، سرّاً بعد سرّ».
**
حِسُّ البساطة
خَلْف الأشْياء البسيطة، أتخفَّى من أجل أن تعثروا عليّ،
فإنْ لمْ تعثروا عليّ، عثرتُم على تلك الأشياء،
وستلمسون ما لمستْ يَدِي،
وآثارُ أيدينا ستترابط.
قَمَرُ شهر غُشت يُشِعّ في المطبخ
مثلما وعاء مطليّ بالقصدير ( السّبَبُ الوحيد لهذا هو
ما قُلته لكم)،
فهو يُضيء البيت الفارغ والصّمتَ الجاثي في البيت
على ركبتيه – الصّمتُ
دائمًا يَجْثو.
كلُّ كلمةٍ هي ذهابٌ للقاءٍ مّا- لقاءٍ
يُلْغَى في أغلب الأحيان –
وهي كلمةٌ صادقةٌ، فَحسب، حين تُؤَكِّد
على لزوم ذلك اللقاء.
**
فتياتٌ نحيلات
فتياتٌ نحيلات
على السّاحل
يَجْتَنِينَ المِلْح، مُنحنيات
فهنّ لا يَرَيْنَ البحر
شِراعٌ
شراع أبيضُ يومئ إليهنّ من عُرْض البحر
وهنّ لا يَلْحَظْنه
يَسْوَدُّ الشّراع
مِنْ فَرْطِ الحُزن
**
سأغادر القمَّةَ البيضاء
سَأُغادر القمّة البيضاء المغطّاة بالثّلج
التي كانت تُدَفِّئ بابتسامة عارية
عُزلتي اللانهائية
سأنُفُضُ عن كتفيّ
رَمَادَ الكواكبِ الذّهبيّ
مثلما تنفُض طُيور الدُّورِيِّ الثّلج
عَنْ أجنحتها.
هكذا، بسيطاً ومستقيماً
فَرِحاً جِدّاً وبَريئاً
سَأُمُرُّ تحت أشجارِ السَّنْط المُزْهِرة
التي لِلَمَسَاتِك
وَأَمْضِي لِأَكِيلَ ضَرباتِ منقار
لِزُجاجة نافذةِ الرّبيع، السّاطعة.
سأكون الطِّفْلَ الوديع
الذي يبتسم للأشياء
ولنفسه
بلا تردّد ولا تحفّظ
كما لو أنّي لم أشهد السَّحْنَة الكئيبة
للشَّفَقِ أيّامَ الشّتاء
ولا عاينتُ مصابيحَ البيوت الفارغة
ولا رأيْتُ العابرين المُتَوَحِّدين،
تحت قمر شَهر غُشت
**
بِألوان الورد
عُصفورٌ صغير بألوان الورد، ومشدودٌ بخيط
بجناحيه المَطويّين يُرفرف وسط الشّمس،
إنْ نظرْتَ إليه مرّة، سيبتسم لك
وإذا نظرتَ مرّتين أو ثلاثاً
ستشرَعُ في الغناء.
**
ما الفائدة؟
ما الفائدة من التّكلّم؟ ما جدوى كثرة التّوضيحات؟
وأنتَ تمشي بِخُطىً حثيثة لتنضمّ إلى أصدقائك
الذين ينتظرونك لأمر شديد الأهمّيّة يعنيك أنت،
ويعني بضعة أشخاص، وأشخاصاً سِواهُم أيضاً،
ها أنت تتوقّفُ فجأةً في منتصف الطّريق
لترى جيّداً
العُصْفورَ الذي يَحُثُّ خُطاه الصغيرة في سَكينة
على الإسفلت،
رافعاً رأسه، منتشياً، وأكثرَ استيعاباً لِما يُحيطُ به،
يحملُ بمنقاره الطّويل
تذكرةَ أوتوبيس.
**
مشهد شامل
الآن، أَتَرَى، هنا ستعيش – قال. هنا
هنا أو هناك،
أيّ أهمّيّة لذلك؟ – أُناسٌ ينزلون وآخرون يَصعدون
السّلّمَ ذاتَه، – لا يلقون بالسّلام على بعضهم. نافذةٌ
تنغلق، أُخْرَى تنفتح. والمشهدُ هو نفسُه: وادٍ، تَلّةٌ،
شيخٌ يرحلُ وقتَ الغروب، وحيداً مع عصاه،
أشجارُ زيتونٍ، كرومٌ، المشنوق، سَرْواتٌ وشَجَرةُ حَوْر،
قُبَّةُ جَرَس، النّهرُ، الكلب، الأوتوبيس، جَرّةٌ،
تماثِيلُ، تماثيلُ، أجنحةٌ كبيرة من المَرْمَر –
حتّى لوْ كانت لديك وعلى كتفيك، أتعتقد
أنّك ستستطيع أنْ تطير؟
**
الشّاعر
مَهْما حَشَرَ يَدَهُ في الظّلمات،
فهي أبداً لنْ تَسْوَدّ. يَدُهُ
لا يَنْفُذُ إليها الليل. وحين سيرحل
(لأن الجميع سيرحلون في يوم أو آخر)
أتَصوّر أنّ بسمةً رقيقةً ستبقى منه في
هذا العالَم السّفليّ،
بسمةٌ لنْ تَكُفّ عن قول “نعم”
ثمّ “نعم”
لكلّ الآمال القديمة والتي يَنْقُضها
الواقع.
**
أَتَراهُ؟
يأخُذُ في كفّيه أشياءَ متباينةً – حَجَراً،
آجُرَّةً مكسورة، عُودَي ثِقابٍ مُحترقَين،
مِسماراً صَدِئاً مِن الجدار المُقابِل،
ورقةَ شَجَرةٍ دخلتْ من النّافذة، قطراتِ الماء
التي تتساقط من أصيصِ الأزهار المَسْقِيّة، القَشَّاتِ
التي طَرَحتْها رِيحُ الأمس على شَعْرِك –
وهناك، في الفِناء، يُنْشِئُ منها شجرةً تقريباً
في “تقريبا” هاته يكمنُ الشِّعر.
أَتَراه؟
**
لا أُحِبُّ طَعم النّعناع في ريقِك
أَسْتَمِرُّ في النّوم.
أسمعُكِ تُنَظّفين أسنانكِ في الحمّام.
وما أَسْمَعُهُ يَشْمُلُ أصواتَ
أَنْهَارٍ، أشجارٍ، جبلٍ صغيرٍ بِهِ كنيسةٌ بيضاء، قطيعِ أغنامٍ
على العُشب الأخضر (أسمع رنّاتِ أجراسهنّ)، حِصانَيْنِ أَحْمَرَيْنِ،
أصواتَ العَلَمِ الذي على قِمّة البُرج، عُصْفُورٍ على المدخنة؛
وتطِنّ نحلةٌ وسط وردة – ترتعشُ الوردة –
آه، كم تتأخّرين. لا تَبدَئِي الآن في مَشْطِ شَعْرِك؛
ما دُمْتُ أقولُ لكِ إنّي أنام في انتظار فَمِك.
لا أحِبّ طعم النّعناع في رِيقِك.
حين أستيقظ، سأرمي بالأمشاط،
بفُرَشِ الشّعر، وفُرَشِ الأسنان
من الكُوَّة.
**
ثمّةَ لَحظاتٌ غَريبةٌ، فريدة
ثمّة لحظاتٌ غريبة، فريدة، وتكاد تكون مدهشةً ومضحكةً.
فهذا رجلٌ يَمشي في الظّهيرة حاملاً سَلَّةً على رأسه،
والسّلّة تُخْفي وَجْهه كُلَّه
فكما لو أنّهُ بلا رأسٍ
أو أنّه أراد التّنكّر جاعِلاً لِنفسِه رأساً مُخيفاً،
بلا عَيْنَيْن،
وبعيون كثيرة.
وهذا آخرُ، يتفسّح حالِماً وقتَ الغروب،
يَعْثُرُ في مكانٍ ما، فَتَنِدّ عنه شتيمة،
ويعود إلى الخلف، ويبحث؛ – إنّه
حجرٌ جِدُّ صغير؛ يرفعه إلى فوق، يَطبع عليه قُبلة،
ثمّ فجأةً يشعر بالقلق: فلربّما كان شخصٌ آخر
قد لاحظ فعله ذاك.
يبتعد في حال مَنْ أَقْدَمَ على ذنب.
وهذه امرأةٌ تُدْخِلُ يَدها في جَيْبِها، فلا تَجد فيه شيئاً،
تُخْرِجُ يدها، تَرفعها، تُمعنُ فيها النّظر:
ترى اليد وقد تكاثر عليها غبارُ الفراغ.
وهذا نادلٌ أغلق راحة يَده على ذُبابة،
فهو لا يَشُدُّها؛
يُنادِيه زبون، يَكون قد نسي الذّبابة،
يبسط كفّه، تطير الذّبابة وتَحُطُّ على الكأس.
وهذه ورقة تتقلّب متحرّكةً في الشّارع بِتردُّد،
متوقّفةً بين الفَيْنَةِ والأُخْرَى،
دون أن تُثير انتباهَ أيٍّ كان – وهذا يُعْجِبُها.
إلّا أنّها، في كلّ لحظة،
تُصدر قرقعةً خاصّة، وبهذا تُكَذِّبُ نفسها،
إذ تبدو كأنّها تبحث أيْضاً
عن شاهدٍ ما، لا يَزْوَرُّ عن الصِّدق
يُعاينُ حَرَكَتَهَا البطيئة، الغامضة
ولكلٍّ من هذه الواقعات جمالُها المنعزل، اللايُفَسَّر،
والألمُ العميق جدًاً الذي تنضَحُ به
إنّما هو نابع من حركاتنا الشخصية، الغريبة
والمجهولة – أليس كذلك؟