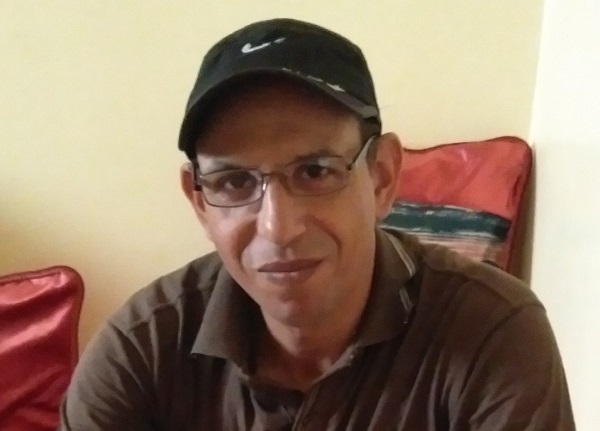حسين عبد الرحيم
أنا هنا وحدي، أقطن وحدي، أعيش وحدي، أسكن ولا أسكن. شقتي هنا.، في مدينة تسمى السلام، هي قريبة من البحر، تؤدي للنيل، وتؤدي أيضاً وفي نفس الاتجاه للأرض الواطئةّ!!، قريبا جدا من النور، وسط الظلمة، قريبا من النار، والموت، في قلب العاصفة التي تخمد لتعود للفوران بعد هياج ذاتي وخروج تاريخي التليد من قلب ماض مفتوح على مصراعيه.
بردان أنا، جسدي يؤلمني، ذراعاي وكتفي وساقاي، وخصيتاي، ويداي، كفي اليمنى ترتعش، واليسرى تتيه في فضاءات رمادية حولي تتهيأ لمخاطبتي علانية، كتبي وكتاباتي وتاريخي المسطور من جديد في هذا المكان، أنا خائف.
الرياح تشتد في الخارج، أبوابي دائما مفتوحة للغرباء وأنا الذي يخشى ظله في الليل، أنا ارتعد، حتما سانكمش يوما وأتضاءل ويزداد خفوتي مثل والدي!!، أبي غائب من زمنا ما، أنا حائر، أجلس فوق فراش لسرير لايكفي إلا لي واحدا احد.
أنا في قلب الأحداث التي لاتنقطع عن مداد الوحشة والقلق، أسمع أصواتهم في الليل، من قبل النيل، من فوق السطوح القريبة من أبواب الله الذي خلقني وحدي لحكمة يعلمها، أنا الذي أحب الشتاء كثيرا بت أخشى أن تاخذني رياح الخريف إلى حيث لا أتوقع ولا أرضى، ألملم حاجياتي وأحصى سنوات عمري الذي لاينتهى ولا يعلم احدا كم من السنوات مرت منذ أن اتيت إلى الدنيا وسكنت هنا، الهواء بارد يصطدم بأبواب النافذة، أتسند على جدار مشروخ لم يسقط بعد، أنظر في تليفوني المحمول ارقاما كثيرة عاودت الاتصال بي لأشخاص أعرفهم وآخرون لا أعرفهم، أرقام مجهولة مثلما هي تيارات الخريف التي أتت باكرة فانتشلتني من رقدتي الطويلة فأقمت أغلق الأبواب المطلة على الشارع الضيق في مدينة السلام، أسمع اصواتا، لمقذوفات نارية ورقص حواة، وطبول وصراخ، زجاجات مولوتوف تصطدم بارض مسلفتة فتتهشم بعيدا في الأحياء المجاورة.
أمي اتصلت بي، هكذا قال لي ثمة وعي من داخلي أكدته نظراتي، عيوني في شاشة موبايلي، عيوني التي لم تعد كما كانت من قبل، خفتت حدة النظر وصارت الهالات الرمادية التي تتحلق وتطوف في حراك شيطاني في دوائر نظري وإلتفاتاتي وتحديقي ليل نهار في عناوين كتب ما تتراص أمام عيناي، أو الادق تتراقص امام ناظري في ركام ضوء محاط بغبش ما يزيد وقت ظهور المغيب وإختناق قوس النور المضيء نسبيا فوق سكني، قمت أوصد الأبواب طمعا في تركيز ما يعينني على استطلاع الخطى في دروب قادمة بلاشك، أعلم أن هذا الهزال سيستمر كثيرا هذه المرة خاصة وأن سيرة ابي لاتترك ذرة واحدة من وعيي إلا وساءلته عن مكانه، جدوى رحلته مساره، كيف كان، مصيره، كيف كانت النهاية، أم أنها لم تأت بعد، أبي، الذي صرت أشبهه كثيرا، أنا تائه ومتردد حيال كل حادث مضى، موقف ما كان يحمل دلالة ما لنهاية الرحلة، قمت أتوكأ على ثمة عظام لقدمي اليسرى، لترى المرآة المذهبة معلقة في مواجهتى، أتأكد من غلق النوافذ، أفيق من سباتي بقطع شريط الماض القريب: أبوك مريض، أبوك يموت، أبوك مات، أسعل وأنا اشعل سيجارتي في الحمام لأفتح صنبور الدش على رأسي وأنا ارتعش. أتلمس دفئا ما في بلاط الحوائط والارضيات التي تنضح بالبرودة، ادعك رأسي بالصابون الـ fa أخلطه بالشامبو فيصير الدفء نسبيا، أتحسس عظام صدري وملامحي التي باتت تتطابق كثيرا مع سحنة ابي، شراسته المخفاه، بؤسه طيبته، قلة حيلته، عنفوانه وضعفه وضحكه الهستيري الدائم والخاتم لكل بكاء يكثر كثيرا في خيباته التي سمعت عنها كثيرا ورأيتها بعيني في وقفات كثيرة لا تنسى وقت ان كنت طفلا وصبي، وشاب ضليل، يسابق الرياح في تيار عكسي يقوده هوى الترحال في فضاءات وامكنة حلمت بها كثيرا، بل تطلعت إليها في منامي وبين يقظتي ووعيي قبل حراكي.
صنعت لنفسي شايا، حبر اسود ،واشعلت سيجارة في ظلام الغرفة لعلني أفوز بلحظة صفاء ما تكون عونا لي في كتابة ما تصلح لفيلمي المنتظر عن حياة العائلة. كيف كانت ومن ذهب ومن راح ومن غادر ولم يعد، من سافر ومن فقد في الطريق الطويل منذ حرب يونيو، ونكسة بلا حراك، وأصوات قطارات تترنح على قضبان عفية تترجرج فوق حصى غليظ وقوي موزع بين الفلنكات وبطول مسارات السفر داخل كل البلاد التي ذهبت إليها. مع إشعالي لعود الثقاب، كانت ثمة رائحة ما لسفر ما جديد لا اعلم شيئا من عن قبلته ولا منتهاه، ولا حتى الغرض منه، قلت اتصل بحسام الدين صاصا،لأجدني وقد رحت في نوبة ضحك هستيري وأنا انظر نتيجة الحائط المعلقة على جدار أصفر بكنار احمر.
انتبهت ان المعني قد مات منذ سبعة عشر عاما كما قالت الصحف، ولكنه يتصل بي، أحضرت موبايلي وطللت من جديد، فكان اتصاله الاخير من ساعتين ونصف، ضحكت وانا احاول الثبات مقررا الخروج من رقدتي في سريري الذي بدأت منذ سنوات سبع، لا اعلم، أسأل نفسي، هل ذهبت بالامس لعملي بباب الخلق، هل هاتفت مدير إنتاجه، ليتحقق من مواعيد صاصا التي قررها لي في آخر مقابلة في وسط البلد، عندما تكلمنا كثيرا عن الشحاذ وعمر الحمزاوي والطريق، ورحلة ريري.وجدوى اسئلة عيسى، وزيارته لإسرائيل وبكاءة وحده في شارع السراي وهو يسترجع أغنية وحيدة يعشقها لإديث بياف، الشوارع تتسع والسماء الحبلى بالبياض تقترب من الطريق حتى وقت السراب وصليل الشمس الحانية وسط المدينة قريبا من النهر. الان فقط اتذكر، صعودنا سويا فوق كوبري اكتوبر والعربة البويك تصرخ على اسفلت الطريق ن والبنات في الحافلات المجاورة يضحكن ويشرن لوجهة باصابع تضيء تحت وهج الشمس في الصيف البعيد وانا انظر تلك الشعور المتطايرة بعبث فوق اكتوبر الذي لاينتهي إلا بوقفة مباغتة رجتنيي وأستوقفت شريط الذكريات والرحلة التي لم تنتهي بعد، عن فيلمي الحلم الذي ابحث فيه عن بطل وحيد منتم / لامنتم، يشبهني لحد ما، يشبه ابي كثيرا، يتواءم مع طبيعة ماحدث مع حسام الدين صاصا في حياته واسفاره وأحلامه وعناده، وشروده، تناقضاته، جنونه وحنوه وتحذيره الدائم لي:
لماذا قتلت بطلك وهو لم يزل عائشا في الحقيقة ؟!، الموت الجسدي لا يعني الفناء ولا العدم، هناك دائما جسور ما للتواصل، إشارات ما، لغة ما، فتوحات لن تأتي إلا من داخلك انت، فاصف وكن كيسا حذرا، وتأمل فحوى تلك الخطابات التي لا تأتي إلا لك، وحدك. فانت المعني بالوصال والتواصل في الخارج والداخل، فلا تكن إلا نفسك بجنونك وجنوحك وعزلتك وخروقاتك وهواك الاثير، قمت وصفير الماء المغلي يتعالي من قبل عين البوتاجاز الكبيرة التي ظهرت لعيني كا قرص الشمس في المحاق وانا أستعيد بعضا من عافيتي وقت أن سحبت الصورة الاولى في الالبوم القديم الممزق، أقلب في رحلة والدي وهو يتهيا للسفر وقد أحاط بذراعيه دركسيون العربة البيدفورد وقت أن أتى السيد الهماص مخبر قسم العرب من شارع النهضة قبل الفجر بدقائق ليزيحه بجانب الباب الأيمن لكابينة القيادة وهو ممسك سيجارته الدانهيل ينفث ثمة بخر يختلط بدخان في لون الغمام قرب الميناء في العام السابع والستين، وأنا أبحث عن تايخ ميلادي الحقيقي.
………….
*من يوميات البناية