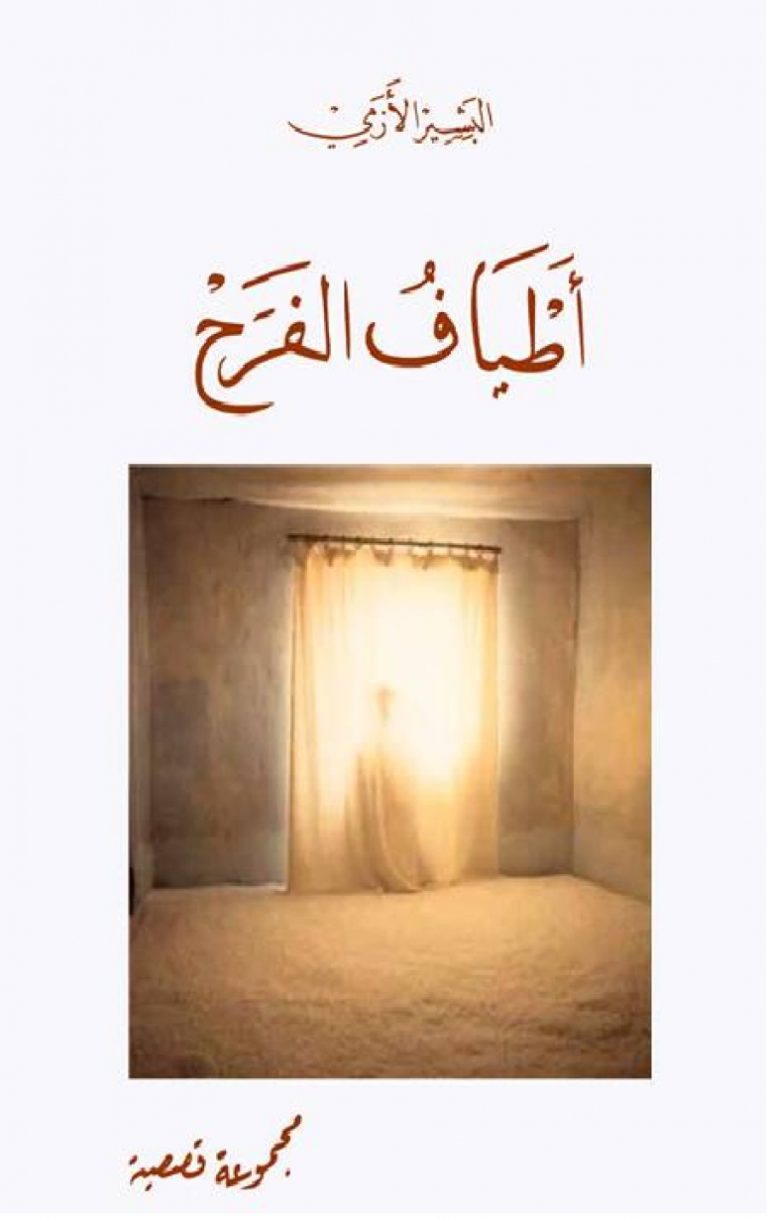وبعد انتهاء يوم عمل طويل كان الوقت يشير أننا تجاوزنا الخامسة بقليل، انتهينا من كل الأعمال العالقة، فاليوم كان مشحونا بمئات الأشياء التي كان يجب الانتهاء منها، فلم يبق على مغادرتنا عائدين للقاهرة غير يوم واحد فقط.
شعورنا بالجوع دفعنا أن نطلب من السائق أن يتوجه بنا إلى أقرب مطعم، فأخبرنا بأهمية أن نتذوق أكلة السمك المشهورة هناك باسم “بلك إكمك” سار بنا إلى أن وصلنا إلى منطقة تاريخية قديمة تدعى “إمنونو” وهي تقع على مضيق البسفور وتتواجد بها مطاعم الأسماك كقوارب في الماء.
قررت وأخي التجول بشوارع إسطنبول وشراء ما يلزم من الهدايا السريعة قبل العودة، شارع الاستقلال المزدحم دائما، المحلات على الجانبين تجذبك جذبا للدخول، تتهادى إلي أذنك أصوات عازفي الموسيقا الفقراء يأخذونك لعوالم أخرى، في مصر نجد القرداتي يمر بقرده ويقوم ببعض الألعاب ولكن في تركيا يصدمك أن تجد من يمر أمامك بدب عملاق تنظر له بدهشة وخوف، ورغم رغبتك في الفرجة إلا أن خوفك يدفعك للمضي قدما بعيدا عنه، وفي النهاية شعرنا بالتعب والإجهاد، وبحكم أن أخي من هواة شرب الشيشة، سئلنا السائق عن أقرب مقهى، فأشار علينا بمقهى ليس ببعيد طلبنا منه التوجه إليه، وهناك فوجئنا أن المقهى يتوسط مقبرة، القبور تحيطك ذات الشمال وذات اليمين سرت في جسدي قشعريرة، وطلبت من أخي أن نغادر المكان لشعوري بعدم الراحة، ولكنه سخر مني، وأشار بيده قائلا:
– المكان مزدحم بعشرات الرواد، ما الذي يجعلنا نختلف عنهم، لا يوجد شيء يخيف في هذا المكان فكلنا سوف نموت يوما.
– ولكن ألا تظن أن وجودنا في هذا المكان يسخر من فكرة قدسية المكان، فتلك الأماكن مخصصة للعظة والاعتبار، وليست من أجل اللهو والمرح ولعب الطاولة وتجاذب الأحاديث.
ضحك ولم يعلق، أحضر الساقي الشاي لنا والشيشة لأخي، وبعد قليل وجدت شخص ضخم الجثة، أصلع الرأس، ورغم ضخامة جسده إلا أن رأسه الصغيرة التي لا تناسب حجمه تجعلك لا تستطيع أن تحول عينيك عن مظهره، شكله كان يبعث في النفس الخوف، يدنو منا ويجلس على الكرسي المجاور لنا… زحزحت كرسيي كي أبتعد عنه قليلا وقد شعرت بالتوتر، ناديت الجرسون وهمست في أذنه متسائلًا عن مدي خطورة هذا الشخص، ولكنه بعث في قلبي الاطمئنان قائلا:
– أنه وديع مثل السمكة، وهو زبون دائم هنا.
ابتسمت، ولكني مضيت أفكر في صفة الوداعة التي أطلقها هذا الجرسون على السمك، فالسمك رغم شكله الفاتن وهو يسبح في الماء، إلا أنه بطبيعته أكثر الكائنات توحشا في هذه الكون، فالكبير منها يأكل الصغير بلا رحمة فمن أين تأتي الوداعة إذا.
لم تمضِ دقائق إلا ووجدت هذا الشخص يدير حوارًا معنا بلا سبب، طبعًا الحوار كان بالإشارة فنحن نتعامل هنا باللغة الإنجليزية، أما هو فكان يبدو جهله بأي لغة غير التركية، كان لسانه الثقيل في النطق يوحي لنا أنه متخلف عقليًا، ذهب الخوف وحلت الشفقة، بدء حديثه معنا وكأنه يعرفنا أشار لنفسه قائلا:
– “Murat” “مرات”
لاشك أنه يقصد “مراد” ولكنهم هكذا ينطقونها بالتركية… ابتسمت له وبإشارة سريعة رددت:
– يحيى ، أحمد.
مدَّ أصبعه الضخم يلاصق صدري وهو يقول بصوت أجش:
– اهمت… اهمت
حاولت أن أصلح له نطق الاسم أكثر من مرة ولكنه كان يبتسم وينطقه بنفس الطريقة، وعندما يئست استسلمت للطريقة التي يلفظ بها اسمي… نظر ناحية المقابر وهو يقول بصوت مخنوق:
– بابا… ماما.
نظر لي أخي “يحي” وهو يخمن:
– الظاهر أن أهله مدفونين في تلك المقبرة.
هل يشعر بالأسى لتواجد قبورهم في هذا المكان الذي لا يعطي الموتى حقهم في التكريم والراحة، بالطبع شيء غير منطقي بالمرة، أخرج محفظة قديمة من جيب الجاكت القديم الذي يرتديه، فتح المحفظة وأخرج صور عائلته وهو يعرضهم أمامي.
– بابا… ماما.
ابتسمت في وجهه ورفعت يدي أقرأ الفاتحة على روحهم، نظر لي نظرة رضا وتبعني في رفع يديه يقرأ الفاتحة.
قفزت هرّة سوداء كالليل البهيم فوق ساقيه، تموء مواء غامضًا… قوست ظهرها فانتفش شعرها، داعبت أنامله رأسها في رفق ليهدئ من تحفزها غمغم بحنان والدموع تترقرق في عينيه:
– ماما… ماما…
نظرت له بحيرة، هل يظن أن تلك القطة هي أمه، مؤكد أن هذا الشخص مخبول تمامًا.
وثبت الهرّة وجرت داخل المقابر لتختفي في عتمة الليل وهي تلتفت له، جذبني من يدي فلم استطع إلا الانقياد له، دخل بي المقبرة، توجه ناحية قبر من المقابر يعلوه شاهد من الرخام الأبيض الفاخر… اقتربت من القبر فوجدت أسماء مكتوبة على الشاهد، دققت في الأسماء تراجعت للخلف في ذهول، ثلاثة أسماء يا إلهي، بحثت عنه بجواري فلم أجده، نظرت للقبر من جديد فوجدت اسمه يحدق بي من فوق الشاهد الرخامي “مراد“