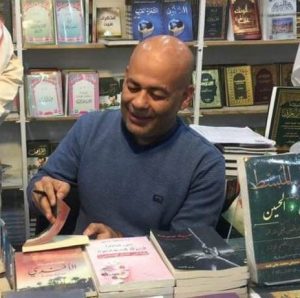نور الدين الشريف الحراق
عندما فتحت المدارس الابتدائية أبوابها أمام المجندين الجدد، سارعوا إلى تسجيلي في مؤسسة بعيدة، حيث لا تزال المقاعد شاغرة. منذ ذلك الحين صرت أستقل حافلة متداعية من هيئة النقل البلدي للوصول إلى المؤسسة.
ذات صباح، وأنا أرتجف من البرد، صعدت على متن تلك المركبة المتهالكة، التي تشبه سفينة نوح بشقوقها التي تنوح على طول الطريق بأزيز مقرف. خلال الرحلة، وفي خضم ضجيج يصم الآذان، كنت منهمكا في مضغ خبز يابس التقفته من درج المطبخ، تحت سماء متصالحة على ما يبدو مع أحكام الوضع الراهن.
فجأة، وهو يغمغم لحن كرنفال، تسلل مراقب هيئة النقل البلدي إلى داخل الحافلة برشاقة وشق طريقه بين الركاب.. كان ينتقل بهدوء وسط الزحام لحشد لا يهدأ، يفيض من البوابة ويتشبث بنوافذ الطوارئ
من الباب الخلفي شق طريقه بصدره وركبتيه وسط الأجساد المتكتلة. كان يستقطع دمغة صغيرة من تذاكر الركاب وهو متفطن لتحركات الشرفاء الذين يخلون الأبواب الجانبية.
في هذه الأثناء كنت متسمرا في مقعدي، وسط الحافلة، متوسدا حقيبتي الكبيرة المليئة بكل أنواع الهراء، وجبهتي على ظهر الكرسي المقابل، حيث تتكلس جميع فصائل البصاق الأخضر. في لحظة ما، بوجهه المتيبس ونظرته الكاسرة، اقترب مني المراقب بخطى ثابتة.
ـ التذكرة، يا ولدي!
لماذا استخدم تلك العبارة؟ أتكون لديه نفس جيناتي؟ يا لها من طريقة سخيفة لمعاينة الأشياء، دون معرفة حقيقة ما نقوله، من خلال ما نتفوه به! أب، أم، أخ، أخت، ابن عم، صفات اعتباطية نستخدمها، كل يوم، في الفضاء العام، لنداء بعضنا البعض وكأننا في حلم وردي لا نفتقد فيه سوى سلف جليل، لتذكيرنا بنسبه! أرهبت قليلاً من تسارع الأحداث، إلا أنني أظهرت نوعا من ضبط النفس، فتظاهرت بالبحث عن شيء ما في جيبي الذي فتشته بدقة، كما أخضعت أصغر الزوايا والشقوق في حقيبتي الكبيرة لتفتيش عام.
أكدت بنبرة ثابتة يمهرها قلق مصطنع:
– سيدي، أنا آسف حقًا! أعتقد أنني وضعت بطاقة عضويتي في غير مكانها!
– لماذا، يا بني، الأمر على هذا النحو؟ رد المراقب وفكاه على وجنتيه في تقلص شديد.
– سيدي، ربما كان السبب هو تسرعي في الذهاب إلى المدرسة! قارعته بروح الدفاع عن انطباع جيد
وكدليل على حسن نيتي، ابتلت عيناي لإنقاذي من ورطتي.
– بالمناسبة، سيدي، السي التهامي، حارس الأمن الذي يشتغل في هيئتكم، هو قريب لي!
– سوف نرى! إلى ذلكم الحين، لا تتحرك من مكانك!
من الواضح أن المراقب كان معتادًا على أنواع المراوغات التي نلجأ إليها لتوفير مصروف الجيب. لم يبد مقتنعًا بنسختي من الحقائق.
بعد حين، سألني بابتسامة عريضة مصحوبة برائحة فم كريهة
– أخبرني، يا بني. ما فئة البطاقة التي حصلت عليها من مؤسستنا؟ تحدث معي بطريقة لطيفة جعلتني أخطئ في تقدير الموقف.
– سيدي، لقد حصلت على البطاقة السنوية! همست بنبرة تشي بالصدق، وملامح بريئة.
عذرًا! لم تكن تلك البطاقة موجودة في عروض الهيئة!
على الفور، ودون سابق إنذار، حاول المراقب الإمساك بي، إلا أنه لم يحصل إلا على ثوب قفاي الممزق من بلوزتي الملطخة بالحبر المغشوش، وكأنها جلدي الثاني. كنت قد قفزت عبر نافذة طوارئ. حيث سحبت معداتي أسفل زقاق محموم وفقدت نفسي وسط حشد غير مبال. ما كنت لأقضي يوما بأكمله في إزالة الشحوم من حافلات هيئة النقل البلدي حيث المخالفون يدفعون ثمن شغبهم!
بعد لحظات، تراءت لي جدران المدرسة من بعيد، عند حدود حقل محترق تغمره رائحة الكبريت. فوق المبنى المتهدم، قطعان الغربان تتقاتل على بعض الزواحف وسط أكوام النفايات.
لسوء الحظ، عند وصولي إلى المدرسة، شعرت وكأن قطيعا من جياد البراري الشاسعة قد دهسني. في الواقع، حدث للتو حدث جلل. فالسي كليلط، مدرس الأخلاق، الذي يسهر على سجل الحضور البدني بشغف خاص، قد غاب بشكل غير متوقع.
من حين لآخر، كانت سكرتيرة المدير، التي تعتني عمومًا بالحياكة، بصحبة زملائها في مهنة الشرف، تستخدم كقطعة غيار. في ذلك الصباح، كالعادة، تولت مسؤولية فصلنا. بقوامها الثقيل وخديها الممتلئين المكسوين بالبقع البنية وشعرها الأحمر الطويل، كانت تبدو كفتاة ريفية من الأراضي المنخفضة. كانت المرأة الطيبة ترتدي طوقا ذهبيًا حول رقبتها، نقش عليه اسم علم لم أعد أتذكره.
في قاعة علوم الأرض والحياة حيث يسود ظلام دامس عرضت الشابة الودودة على الشاشة أمام صفوف صامتة تخترقها النظرات الحائرة مجموعة شرائح تتناول مورفولوجيا الإنسان والتفاصيل التي تميز الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين.
– أستاذة، أستاذة، أريد أن أذهب إلى الحمام!
بسبب تنقلاتها بين المكتب حيث ملفاتها التعليمية والشاشة حيث عرض الرسوم التوضيحية، كانت المعلمة الاحتياطية تمر اضطراريا أمام الكشاف الضوئي. وعليه، فإن الصور الديداكتيكية التي كانت تستخدمها في الفصل انعكست من حين لآخر على معطفها الأبيض. لا يمكن أن يكون المشهد أكثر مرحًا!.
– أستاذة، أستاذة، عضني!
والحالة هاته، عوض الإصغاء لمحتوى الدرس، شرع التلاميذ في الضحك. في واقع الأمر، مشهد الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وهي تتجول بشكل عشوائي على ظهر المعلمة أو سرتها، كانت مدعاة للتسلية حتى الموت.
– أستاذة، أستاذة، سرق قلمي!
في هذه الأثناء، حدقت الشابة الأنيقة في التلاميذ. ثم عبست قليلاً، بطيبوبة اختلطت بنوع من الخجل.
– اخرسوا يا أطفال! أنتم تصدرون الكثير من الضجيج!
فسر التلاميذ تصرفها على أنه استسلام لمناوشاتهم، فقاموا بقذفها بكرات من الورق عبر أقلامهم الفارغة. في نهاية الأمر، أدركت المعلمة عقم الدبلوماسية، فأخرجت القسم كله إلى الساحة.
خلال تواجدي في تلك المدرسة، التي كانت تفتخر بواجهتها الموريسكية، دفعت تكلفة إجراءات قسرية معيبة للغاية. فالسي كليلط، المعلم الأخلاقي الأصلع والمدمن على الكحول كان يسيء معاملتنا، وفق مزاجه المتقلب. نظاراته السميكة الحجم التي تقفز على أنفه المتقرح، وصلعته الذائعة الصيت الذي تتلألأ بانتظام، مع توالي الفصول جعلته أقرب ما يكون إلى خرقة ما في أرشيف متعفن بين المسودات.
في فناء المدرسة حيث سلسلة من الغازات تشير إلى مروره، كان سي كليلط يتسمر من حين لآخر أمام خريطة الوطن المزينة للجدار وهو مزهو بملفات كثيرة تحت إبطه الراشح بعرق أبدي.
مع مرور الأيام، صب معلمنا الأخلاقي مرارة قرفه الوجودي علينا، بطريقة خبيثة تماري جنونه الغاضب، من أعلى برجه العاجي. فطوال العام الدراسي، لما يقضم تلميذ مقطعًا لفظيًا من بعض الآيات الاستشكالية، في خضم سور ماراثونية تكون الصفعات العنيفة والضرب على الردف من نصيبه.
ذات مرة، زوال يوم من أيام فصل الربيع، رآنا السي كليلط نشاغب بعضنا البعض وسط الطريق. من وقت لآخر، كنا نجري حفاة على الإسفلت، من أجل تفادي ملاحقينا المرحين بسهولة أكبر. لما دخلنا الفصل، قام المتخصص في فنون التعذيب بفحص باطن أقدامنا وأمر كل فرد منا اكتشف على باطن قدمه أثرا للقطران أن يمد يده أمام شهود مذعورين.
حينها جلدنا بغصن زيتون وضعه منذ سنين داخل أنبوب بلاستيكي صلب يستخدم عادة لمد شبكات الكهرباء، داخل المباني قيد الإنشاء.
بعد ذلك رفعنا إلى الهواء بعض الحمقى الذين يجلسون بإخلاص في مؤخرة الفصل ولا يولون إلا اهتمامًا ظرفيا للحصص. فحجمهم المهيب يضمن لهم احترام ودعم السجان، على الرغم من قصورهم الفاضح.
صرنا مثل الخرق، ملتصقين بشكل دائري حول مكتبه، رؤوسنا وصدورنا مشدودة بقوة نحو الأسفل لتتعرض أقدامنا المقيدة للضرب اللاسع المختوم بفيض من الدم.
أيام بعد ذلك، في ختام حصة عذب فيها السي كليلط عشرات التلاميذ لأسباب يصوغها من منطقه الخاص، دبج بشكل مقتضب صياغة غامضة على السبورة وطلب منا أن ننسخها بأكثر الطرق روعة على ورقة. كانت من بديهيات الجغرافيا البطلمية حيث مفاهيم الزمان والمكان لم تبرح عصر الظلمات.
أمام هذا المستجد، ولساعات طوال، تحت ضوء مصباح الشارع، قمت بترويض أصابعي على صفحات الدفتر بكل اجتهاد لتزين المعادلة المصيرية بأجمل طريقة ممكنة. بذلت جهدي مع إحساس بالواجب وعزم غير معتاد لدرجة أنني توصلت إلى نموذج وفقًا للمعايير المطلوبة.
في اليوم الموالي، بضمير مرتاح، سلمت واجبي إلى سيد الأخلاق، الذي عبس فجأة، متفحصًا إياي بعين فضولية:
– تعالى، يا صغيري، اقترب قليلاً! لن تقول لي إنك من قمت بهذا العمل! أستطيع أن أرى أنه صعب جدًا بالنسبة لعمرك!
كنت جالسا في مؤخرة الفصل، وغضبت بخجل من تأكيده المبهم.
صرحت له بصوت مرتعش:
– سيدي، ليس من العدل أن تتهمني بالخداع! هذا من شأنه أن يقوض مجهوداتي ويعرض مصداقيتي إلى ادعاء قاسي!
– اخرس أيها الكذاب!
بالتأكيد، فسر السجان اندفاع كبريائي بأنه محاولة للعصيان، مع قلة أدب. مثل ثور، ركض نحوي على الفور. شدني من شعري وطرحني أرضًا وسحق وجهي بحذائه، وهو يؤهل سلالتي بكل العبارات الفاحشة.
في أحد الأيام، لا أدري حينها إن كان السي كليلط قد فطم نفسه فجأة عن حصته المعتادة من المحروقات، صرنا بمعيته هدفًا لانتهاك خاطف من اللامعقول.
لبضع دقائق، تحول الفصل إلى ساحة للهذيان، مع كل وسائل الرعب، لدرجة أن الدم تجمد في شراييننا. على حين غرة، صار ذلك الكائن يهرول حول الزوايا الأربع للفصل، مثل وحش في قفص واللعاب منهمر على ذقنه.
كان يصرخ لمن يريد أن يسمعه: “لماذا الآن؟ لا! هذا غير ممكن! هل تسمعني؟ هذا كثير! دعني وشأني! “
فجأة، وتحت وطأة تشنجات محمومة، بدأ بالصراخ ونهش وجهه بأظافره، وإذا به يضرب بقبضتيه على جدار الفصل، قبل أن ينهار على الأرض، مثل جمل منزوع الأحشاء. وما هي إلا ثواني حتى استرجع توازنه، فتقدم خطوات على رجليه المتخاذلتين نحو مرآة خلف الباب كسرها بنطحة عنيفة انغرست على إثرها شظايا الزجاج في جبهته.
في الإدارة، حيث الافتقار إلى الضروريات مسألة تدبير، أصيب الزملاء بالذعر عند رؤية وجهه الملطخ بالدم. تم اقتياده على الفور عبر دهليز طويل، يربط الباب الأمامي بالفناء المركزي. بمجرد وصوله إلى غرفة انتظار صغيرة، حيث الأرضية مغطاة بسجادات من الدوم، بدأ سيد الأخلاق يتقيأ خيوطا صفراء اللون، من بين قذائف أخرى.
في هذه الأثناء، سارع حارس أمن خاص، له دراية بمثل هذه الأعراض الجانبية، عبر طرده الأرواح الشريرة بدوام جزئي، إلى حشو فم المعني بالأمر بكميات من البصل.
بعدها صار يردد عبارات مبهمة، سكب على إثرها القليل من ماء الورد على وجه الممسوس، حيث أدخل بين أصابعه الملتوية حلقة مفاتيح تضمنت والحالة هاته أصبع مومياء.
بسبب غياب أية نتائج إيجابية فوريا تم اتخاذ قرار الاستعانة بخدمات الطوارئ بالمستشفى البلدي وتم الشروع في البحث عن رقم هاتف المنشأة في عدد كبير من الملاحق والمكاتب.
عندما هرعت سيارة الإسعاف عبر باب المدرسة، بعد ساعتين تقريبا من نداء الاستغاثة، شعرنا بالأسف الشديد للمشهد المأساوي.
في مواجهة الوضع، صرنا نحتج بصوت عالٍ على المخارج البيروقراطية، حيث الخدمات الأكثر صعوبة مجانًا، للدوائر الحميمية.
للحظة، بعيد الانقطاع القسري للدراسة، أعلن الجرس مرحلة التعافي في ساحة صامتة حيث المعيد يسعى إلى تبديد الحشود.