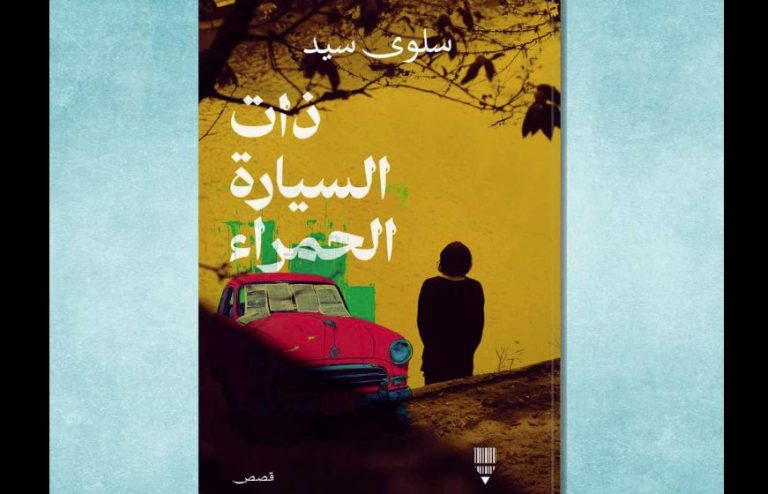هي التي تخرج كل يوم بعد الظهيرة، بقٌلّة الماء الباردة، فتروي عطش الرجال الذين دائماً ما يأخذون قيلولتهم أسفل شجرة الكافور العتيقة أمام بيتها. منذ أعوام طويلة ورجال القرية يقيلون كل صيف تحت شجرتها، وهي تروي عطشهم بقلتها الباردة، وتهب مفزوعة من النوم فتجد نفسها وحيدة لا تجد من يسقيها… طيف ابنها حماد في البيت أمام عينيها في كل لحظة. تجلس على مائدة الطعام، تزدرد لقيمات صغيرة، وتقوم دامعة دون أن تشبع. ينتفض قلبها كلما طرق أحد بابها، تندفع خارجة حاسرة الرأس آملة:” ربما يكون حماد قد عاد”. وإن سمعت جلبة خارج البيت هرولت مسرعة، فربما يكون ابنها قد عاد، وإن تنهد أحد إلى جوارها فزعت وساورتها الشكوك: ” ربما حدث لحماد شيء في غربته، ولا يريد أحد أن يخبرها“.
هكذا قضت الأعوام المنصرمة كلها، تمشي وتنام على شوك الأمل والذكريات. ظل الجميع في الواحة يتحملون لسانها السليط، ويشفقون عليها. كانوا قد فقدوا الأمل في عودته، إلا هي. كانت تعرف أنه سيعود.
عاد” حمَّاد ” ذات صباح بعيد، وهو يجر ابنته ” صابرين ” خلفه. تلك الفتاة التي أنجبها من زوجته القاهرية، التي ظلت معه لفترة. كانت أسوء فترات حياته، فطلقها وفر ناجيا بجلده، وبابنته صابرين.
قابلته في زقاق الطاحونة في صباح يوم شتوي قاس. كانت تسير حافية، غير عابئة بالبرد، وقد أصبحت انحناءة ظهرها الخفيفة أكثر وضوحاً، من جراء حطب الوقود الذي تحمله على كتفها. كان حلمي يسير متأنياً ضجراً. دققت المرأة فيه طويلاً بعد أن ضيقت حدقتي عينيها، محاولة قدر جهدها أن تتعرف عليه :
– أنت حلمي، ولد عبدون. أليس كذلك؟
– نعم يا جدتي.
– لم يعد لدينا ما يكفي من الخبز. سوف تأتيك صابرين بالقمح كي تطحنه. هل أرسلها الآن؟
– لا يا جدة. قال لي الشيخ ” سليمان ” أنه سيرسل أحدهم بالقمح، كي أقوم بطحنه الآن.
– هل ستقوم أنت بطحنه نيابة عن الثور؟ لا فرق، أنت والثور واحد.
– هأ، هأ. كلك ذوق يا جدتي.
– متى أرسل البنت إذن يا مكسور الرقبة؟ قالت العجوز مهددة إياه. لكنه ضحك ضحكته العالية التي يشتهر بها قائلاً:
– إن شاء الله بعد الظهر، هذا إن كان لنا أجل. قال ذلك ومشى يدب الأرض بقدميه الكبيرتين، فقالت العجوز ساخرة:
– لا تدب الأرض هكذا، وأنت تسير يا خروف. ألا تخشى أن تلبسك العفاريت؟
– أين هم العفاريت يا جدتي؟
– ألا تدري يا مغفل؟ الأسياد هنا. وأشارت إلى الأرض ثم تابعت قائلة: “هنا، تحت الأرض “.
– لا أسياد تحت الأرض… نحن الأسياد. الأسياد دائما يكونون في الأعالي. قال ضاحكاً ثم تابع : ” ثم ماذا يضيرني لو لبستني جنية جميلة، فربما تريحني من عناء الحياة هنا… ثم إنني سأطلب منها أن تطير بي مباشرة إلى مصر. أريد أن أرى أم الدنيا.
– متى أتعبتك الحياة يا صغيري. أنت لم تر شيئا بعد. قالت العجوز، ثم تنهدت طويلاً وهي تتمتم : ” اللهم رد كل غائب إلى أهله”.أما هو فقد تركها ومشى… كانت ما زالت واقفة تتأمل ظهره، وبعد أن سار عدة خطوات سمعها تقول: “سبحان الله، نسخة أخرى من عبدون، غير أن هذا “المفعوص” يظن نفسه شيئا“.
عاد حلمي، ووالده من صلاة الفجر. دخل حجرته، واستكان إلى الفراش قليلا، قبل أن يبدأ مشواره إلى الحقل. كان والده يرتل بضع آيات، قد حفظها من كثرة ما سمعها في الصلاة. صوته الأجش يملأ البيت. يبدو صوته هادئا، وصافيا في ذلك الوقت المبكر من اليوم. صوته يجوب الحقول، ويمتد حتى ينتهي عند حدود الصحراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقطع من رواية “الهبوط لأسفل ببطء” صادرة عن دار كيان- القاهرة- 2012م