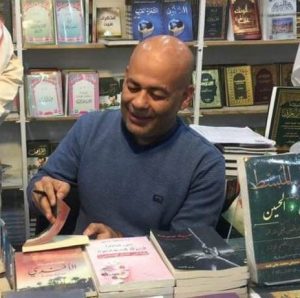محمد فرحات
تمر الشهور، وكلما مر يوم، تَفَتَح باب المحبة أمام وجه سيدي إبراهيم العشماوي، لا يزيد عن طرقة أو طرقتين، تقديم طعام لذي حاجة، أو شربة ماء بارد لسائل، تسبيحة أو استغفار، كلهم يفعل ذلك، فما السر في الفتح المتسارع، السر في الإخلاص والفناء في مراده ستنا زكية، منذ تتويجه ابنا لستنا أمام سيدنا الحسين، وهو لايبارح ساحتها إلا لعمله أو لبيته، وكل ساعة يُمنَح سرا من كلمة، نظرة، إشارة، وكلما صان السر، وحفظه، زادته ستنا سرا فوق سره، فاق سيدي إبراهيم كل أبناء ستنا حتى الذين سبقوه بسنين …
هي رحلة سنوية تقوم بها ستنا، وأولادها، هناك في أحضان جبال البحر الأحمر، حيث تقترب السماء جدا من الأرض، تمد يدك فتصافح الجوزاء، أو تناجي القمر فيصب في عينيك من لجين أنواره، يقطعون المسافات عبر المدقات الصحراوية، بعد رحلة طويلة بقطار الصعيد الذي يسلمهم إدفو، فيركبون الركائب من إدفو حتى حميثرا بوادي عيذاب، رحاب سيدي أبى الحسن الشاذلي…
ولما شرع قطب الأقطاب، وكهف ملجأ الطلاب في رحلة الحج، بشره النبي بلقاء ربه في وادي عيذاب حيث حميثرا، أما يرضيك يا أبا الحسن أن تُقْبَض بأرض لم يُعص الله فيها قط…
ينصبون خيامهم، ويصبون مياههم العذبة في أوانيهم، وطعامهم الذي تزودوا به حينما مروا بسيدي عبد الرحيم القناوي، ينزل عليهم البدو، و الضيف فيحضر مجالس ذكر تتوجها الزكية، ويلهج فيها الذاكرون بأوراد الشاذلية، أمام روضة سيدي أبي الحسن، والتي لم تزد ساعتها عن ضريح فوقه قبة من أحجار الطين اللبن …
لم يكد سيدي إبراهيم ينهي الخدمة بمقر الزكية بالحسين ليلا، حتى تبشرة الزكية بمرافقتها رحلتها لقطب الأقطاب أبي الحسن، يطير عم إبراهيم فرحا، وتخبره أنه سيتخلف عنهم حتى يقوم بالخدمة للظهر ثم يغلق الساحة، ويلحق بهم عند “باب الحديد” حيث القطار…
ينهي عم إبراهيم المهمة متأخرا فاليوم كان مزدحما، يخرج طالبا مواصلة من سيدنا الحسين حتى باب الحديد، لكن ليس في جيبه سوى قرش صاغ واحد لو ركب الحافلة العامة لفاته القطار، وفاتته رفقتهم، والتاكسي بخمسة قروش وليس معه غير قرش، يقف متحيرا ماذا عساه أن يفعل، يغمض عينيه فإذا بالزكية تبتسم مطمئنة، وإذا برجل يتكلم بلكنة صعيدية سائلا عن الزكية،” هي في باب الحديد..” فيشير الصعيدي للتاكسي فيستقلاه ويصلا قبل تحرك القطار بثواني، تستقبله الزكية ببسمتها وتسائله ” فين الصعيدي يا إبراهيم؟” فيلتفت حوله فلا يجده…وكأنه ما قابله، ولا كلمه، ولا ركب معه التاكسي ….
“وفي حميثرا سوف ترى” ، قالها سيدي أبو الحسن الشاذلي مجيبا على ابن أخته سيدي المرسي أبي العباس ، حينما تساءل متعجبا من ضرورة إحضار المسحاة، والفأس، والكفن، والحنوط لرحلة حج اعتادوا عليها سنويا منذ نزوله مصر من بلاد المغرب .
وحين خيموا بجوار مقام سيدي أبي الحسن، وانهمك سيدي إبراهيم العشماوي في الخدمة، يستيقظ مبكرا لإشعال النار، وتحضير طعام الإفطار، وعمل الشاي، والقهوة، وتقديم نفحات أمه الزكية للوافدين مولد سيدي الشاذلي، لا يقطع ذلك سوى الصلاة، حتى تنتهى الخدمة، غالبا، بعد صلاة العشاء، يرتدي سيدي إبراهيم قميصه الأبيض، يتوضأ، يتعطر، ويصعد جبل “حميثرا” مختليا بربه ، مناجيا، يصلي ركعتين ثم يهيم في التفكر، والذكر، ثم يصلي ركعتين وهكذا حتى يقرب وقت صلاة الصبح فيهرول لجلب ماء الوضوء للزكية من بئر سيدي أبي الحسن وهو ماء عسر، يميل للملوحة، وكانت قد نبهت عليه أن لا يأتي لها بماء حلو ما أحضروه معهم من قنا ، فهو خاص للشرب فقط، وبعد صلاة الصبح تبدأ الخدمة .
وكان للحرارة الشديدة، والجهد الذي يبذله عم إبراهيم أثره الشديد على بشرته، فسأل أحد الأطباء الوافدين على الخدمة فأخبره بضرورة الاغتسال اليومي بماء حلو، لكن كيف له أن يغتسل بماء حلو، و الزكية تتوضأ بالماء الملحي…، فإذا بالزكية تأمره بالاغتسال بالماء الحلو فيتعجب كيف علمت ، ولكن فيم العجب وهي من هي، وهو من هو !!
وكان سيدي العمدة يصعد ليلة جبل “حميثرا” في مواجهة الضريح، وليلة يصعد “الجبل الحزين” في ظهر المقام، وسمي حزينا لأنك لو دققت النظر في واجهته لشاهدت ملامح وجه رجل باكي مشكل من أحجار الجبل وانحناءته، أو لأن زوار سيدي أبي الحسن كانوا يفضلون صعود جبل حميثرا لسهولته، ويخشون صعوده لوعورته ، ولكن سيدي إبراهيم كان يجبر بخاطر الجبل الحزين بقيامه الليل عليه، وكان الجبل يستقبله بفرح، وحنو، ويسهل لخطوه عليه، وفي غفوة نوم أخذته جاءه الأمر بلبس “الخيش”، رداء من التيل الخشن يستخدم لعمل الأجوله، صدع سيدي العمدة بالأمر، ونزل من الجبل، حينما هبت نسائم الفجر …وحينما اقترب بماء الوضوء، سمع صوت أمه الزكية في خلوتها، و كأنها تجادل مجموعة أشخاص ” لا، لا ولدي لا يلبس الخيش …” ، ” أنا الزكية بنت الحسين و لدي ما يلبس الخيش …”
تجمد سيدي إبراهيم بمكانه، وكاد يغشى عليه من فرط الدهشة، ولكن علام الاندهاش وأمه الزكية قد علا مقامها، وقد تشفعت له بمجلس الأحكام …
يستأذن سيدي إبراهيم، فتستقبله الزكية بابتسامة حدب، وحنو تذيب قلبه، فيبكي بنحيب، فتضحك الزكية ” أمال يا ولدي أنت فاكر نفسك قليل؛ ده أنت ولدي، ابن الزكية ..”
وتناوله صديري من الخيش يلبسه تحت قميصه القطني الناعم، فقد جاء التخفيف …
تنساب مواكب المريدين، يحدوهم الشوق لابنة الحسين زينب الوقت، وبعد زيارتهم لجدها يسعون حثيثا للزكية، يتبركون، طالبين الشفاء بتلك اللقيمات التي ينفحهم بها سيدي إبراهيم العشماوي، لم يكن يقدم اللقيمات فقط، بل نفحات من نوع آخر ابتسامة، كلمة، إشارة، دعاء مخلص، وهكذا لا يمر أحد لخلوة الزكية إلا عن طريق ابنها الهائم في سموات العشق والأنوار، تتلقفه مملكة الشعر مرحبة، ضارعة، بكلمات وأوزان، وموسيقى، من أين جاءت ؟! تملكت الحيرة أهل الشعر وهم بالعشرات في بلاط الزكية، تتزاحم استفساراتهم “من أين جاء بتلك الروعة ؟” ، فيخفف من غيرة الشعراء ألق العطاء المنفوح به العشماوي، ويسلمون بإطراق ناصية لتلك الموهبة الشعرية الهادرة بلا تعلم، أو دراسة، أو تخصص، فتهمهم شفاهم بهمس، تعلوه نفثات حسد يحتضر”فضل الله، و نفحة الزكية و قبل ذلك إخلاص محب…!!” .
هي أيام المولد النبوي، تنطلق وفود زيارة النبي من مقر خدمة الزكية لمكة والمدينة، هي السفرة المباركة في معية الزكية…يبيتون أياما في الخدمة لحين اكتمال اجتماع الأحباب… عشرات من بقاع شتى يهرعون من صعيد المحروسة، ودلتاها، وعاصمتها، وثغرها…لتتحول خدمة الزكية لحلقات ذكر لا تنقطع، مهبط الكرامات، والأشعار، و الأنوار، وسيدي إبراهيم ينساب كالماء العذب بالطعام، والشراب، و الأشعار، ترمقه الزكية ،تلاطفه، ترفع يدها إلى السماء “اللهم إن هذا ابني، نعمتك التي أنعمت، فأدمه ..”
وسيدي إبراهيم يصدح بنغمات عذبه ” جاني الهوي من غير مواعيد ، و كل مادا حلوته تزيد، محسبش يوم هيخدني بعيد…” لتضحك الزكية و يضحك الأحباب، وتخنق العشماوي عبراته فيسكت، ويسرع للمطبخ و ماهي إلا لحظات يأتي بالصحاف المحملة بالنفحات…
-“هلموا فالسفر للحبيب قد آن ؛ ..! ،
و أنت ياولدي هتستنى، علشان الخدمة ما توقفش ..”، فيصدع سيدي العشماوي بالأمر…”حاضر ؛ يا أمي…”
تنطلق الحافلات في طريقها لمطار القاهرة، محملة بعطر الحسين، و ثمالة الماضي، وبقية الحاضر، وأمنا الزكية مخلفة ورائها شوق يشتعل في قلب العشماوي يتضرم بلهيبه على مهل، ممض، مؤلم…
تتلألأ أنوار الخدمة، تدعو مزيدا من الأحباب، و يهدأ الخطو لينصرف الناس إلى مهاجعهم ، ليبيت العشماوي ليلته في الخدمة، لا ينقطع بكاؤه الصامت، وتضرعه المتيم، لتخطفه أجنحة النوم العطوف المواسي …
-ليه يا ولدي بتبكي ؟
-الشوق يا أمي، كيف تطلع الشمس علي من غير ما شوفك؟
-إزاي؟! وأنت معانا ؟
-تحب تطوف يا إبراهيم دلوقتي؟ ولا تستريح شوية من السفر؟
– لا….، أطوف يا أمي…بس خدي بأيدي خايف أتوه منك في الزحمة ..!
تبتسم الزكية و تشير إلي قلبها، فإذا بالكعبة، والحرم ، وزمزم لتأخذه الزكية من يده، يطوفا بالبيت، تسيل الدموع، وينساب الدعاء، يصلي بأمه ركعتين خلف مقام أبي الأنبياء، يأتي الخدام بماء زمزم تحتويها كؤوس نور، يتضلعا، يصدح قلب العشماوي بالنغمات العلوية، و موسيقي سرمدية لم تسمعها أذن من قبل، تأخذ بيده إلى المسعى، سبعة أشواط، لتلوح المروة محتضنة، ضاحكة ، يتلألأ ثغرها بالجمال، وقد أخذ الجلال الأحباب، يتحللوا يحلق العشماوي و تأخذ الزكية من خصلاتها…
تشرق الشمس على رأس العشماوي العارية من شعره ؛ يدور بين المطبخ، والخدمة، ويقدم النفحات، والضحكات، والأشعار، والدعاء ..