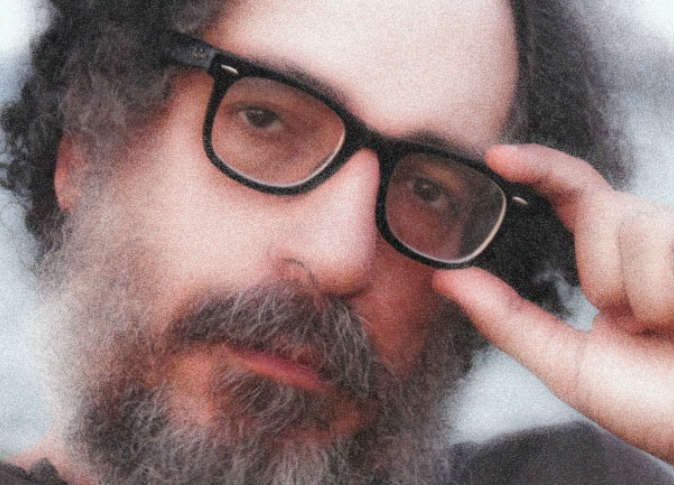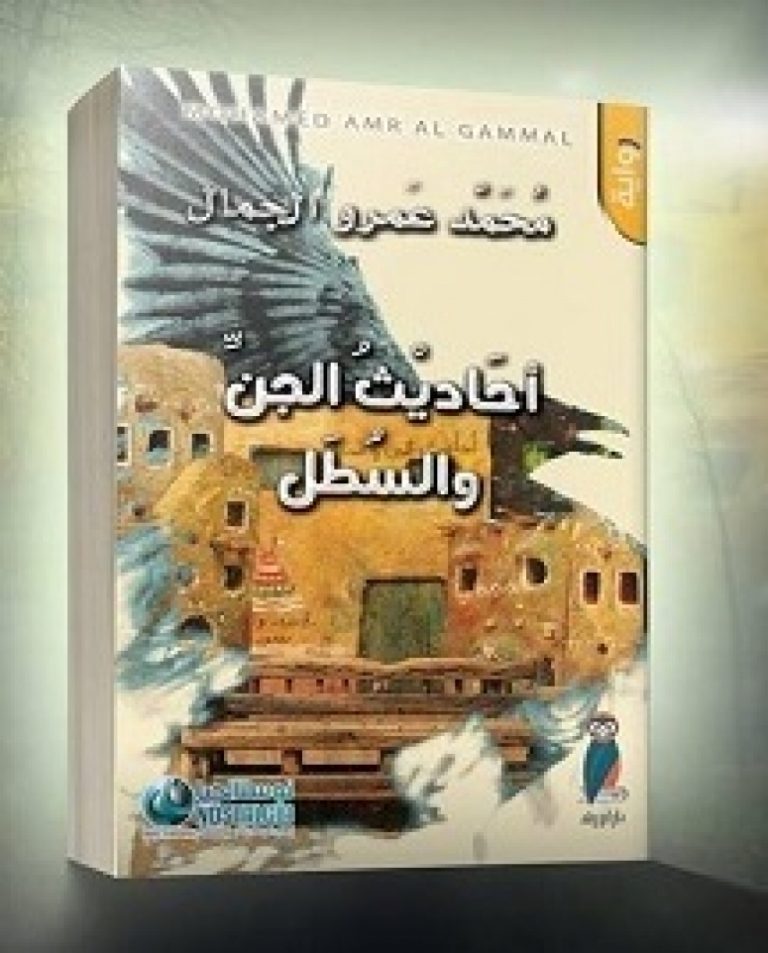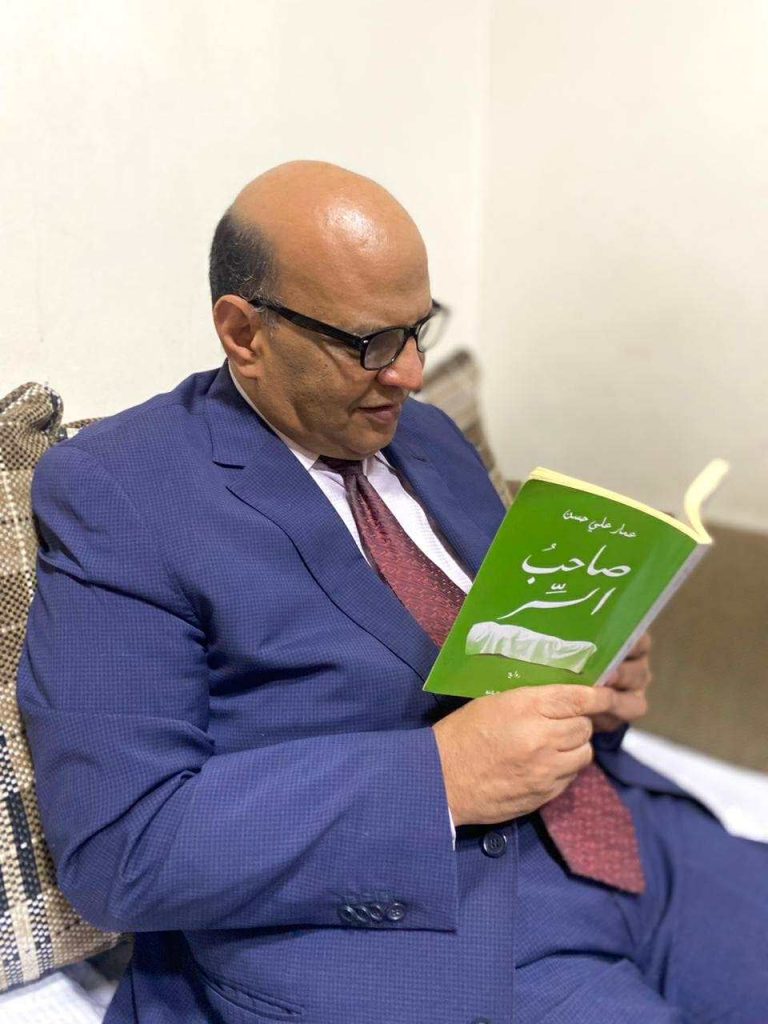د. عمار علي حسن
حين وضعت لافتة “زمن الرواية” أمام عيون كل الأدباء العرب، كنت قد نشرت عددا من الروايات أكبر بكثير من نظيره في كتابة القصة القصيرة، ومع هذا تلقيت هذا الشعار أو هذه الخلاصة بتعجب وخوف واندهاش وحيرة ورفض ورغبة في المساءلة، ظلت تلح علىَّ حتى رفعت لافتة جديدة تقول “زمن القص” أو تؤكد أن “القصة القصيرة هي شعر الدنيا الحديثة”.
في مدار الذات لا يمكنني أن أنسى أن القصة القصيرة كانت طريقي إلى السرد الواسع، وكنت أحسب، على حين غرة، أنها مجرد قنطرة انتقلت بها من الشعر إلى الرواية، لكن مع توالي الأيام، واختمار الفن أو نضجه في وجداني وعقلي أدركت أن القصة أصل لا استغناء عنه، وجذر لا يمكن اجتثاثه، ولون فني ليس بمقدوري التعامل معه على اعتباره مجرد جسر عابر، أو تدريب على سرد أوسع وأعمق، أو مرحلة في حياة كل أديب يجب ألا تطول، إنما الواجب هو الاستقرار في الرواية، باعتبارها نصا سرديا كبيرا، وأكثر قدرة على الانتشار والبقاء، لكن كل هذا ذاب، وأيقنت أنه وهم، حين وجدت نفسي غير قادر على مغادرة فن القصة القصيرة، وأيقنت أنه ليس مجرد نوع أدبي نكتبه بين الأعمال السردية المتسعة مثل الروايات، إنما هو مسار لا يمكن تجاوزه، أو النظر إليه على أنه كتابة محصورة بين روايتين، أو نص قصير لا يشكل سوى استراحة بين نصين طويلين.
أعرف أن هناك كثيرين أخلصوا فقط لهذا اللون، بعضهم حاول في الرواية، وأنتجوا فيها نصوصا لا بأس بها، لكن صيتهم في القصة بقي هو الأساس الذي يتكئون عليه وفي مطلعهم يوسف إدريس، وهناك من حاول كتابة رواية، وأعلن عن هذا في جلسات خاصة، لكن شيئا من هذا لم ير النور، ليظل إبداعه السردي محصورا في فن القصة ومقصورا عليها, مثل سعيد الكفراوي، وهناك من اكتفوا بالقصة القصيرة، وأخلصوا لها مثل إبراهيم صموئيل ومحمد المخزنجي. ورأوا أنها تغنيهم عما عداها، رافضين أن تكون مجرد جسر لغيرها، وأنها فن خالص جدير أن يُقدر ويُحترم ويعلو لذاته.
لكن أدباء كبارا في تاريخ العربية لم يشغلوا أنفسهم بهذه التفرقة، ولم يتوقفوا يوما ليضعوا الرواية في وجه القصة، أو القصة في وجه الرواية، إنما أخلصوا لهذين اللونين الأدبيين ما بقي القلم في أيديهم، وما بقي الوجدان والمخيلة والذهن يفرضون ما شاءوا، ولم يشعر هؤلاء الكتاب قط أن أحد اللونين في وجه الآخر أبدا، أو أن القصة مجرد استراحة بين روايتين، وأن الرواية هي سرد ما بعد الهدنة في حرب ضد نص طويل لا مناص من إنجازه، وأن هذا لا بد أن يسوق إلى تعب ورهق ومسغبة إبداعية.
لقد رأينا كيف ظل نجيب محفوظ ينتج اللونين معا، فمنذ أن أصدر مجموعته الأولى”همس الجنون” والتي هي عبارة مختارات من بين ثلاثمائة قصة نشرها من قبل، ولم يرق للناشر سوى عشرها تماما كي يضمها في مجموعة واحدة، وهو يوازي بين الرواية والقصة، حتى انتهى إلى ما يمكن أن تكون القصة القصيرة جدا في “أصداء السيرة الذاتية” و”أحلام فترة النقاهة”.
وسيقول قائل إن محفوظ لم يكن أمامه سوى هذا المسار بعد أن اعتلت صحته، وخارت قوته، ولم يعد بوسعه أن يجلس إلى مكتبه وهو شيخ طاعن في السن، لاسيما بعد حادثة الاعتداء عليه من قبل شاب إرهابي جاهل، كي يكتب نصا طويلا، يحتاج إلى عناء وبناء، مثلما تطلبت منه رواياته، سواء كانت قصيرة على غرار “الكرنك” أو طويلة مثلما رأينا في ثلاثيته “ملحمة الحرافيش”.
لكن هذا القول ينطوي على زيف شديد، فمحفوظ قبل فوزه بجائزة نوبل، ثم اعتلاله، أنتج لنا مجموعة “صباح الورد”، التي حققت نجاحها في إضافة لبنة جديدة إلى البناء الذي أقامه الأستاذ منذ أول قصة كتبها، وكذلك فعل يحيى حقي في المزاوجة بين القصة والرواية، دون توقف أمام أيهما أولى بالرعاية، وهو سؤال قسري فرضته الأحوال فيما بعد. حتى أن الجيل اللاحق سار على الدرب نفسه، فوجدنا بهاء طاهر وجمال الغيطاني وإبراهيم عبد المجيد وإبراهيم أصلان ومحمد البساطي ومحمد جبريل يبدعون قصصا قصيرة رغم اللافتة العريضة التي رفعت بالشعار الأثير: “زمن الرواية”.
وقد فرض فن القصة نفسه، حتى أن صاحب لافتة “زمن الرواية” وهو الناقد الكبير جابر عصفور، عاد وكتب “زمن القص”، وكأنه به أراد الاعتذار أو الموازنة مع تصوره الأول، حين اعتقد أن الرواية سادت، وامتطت صهوة الأشكال الأدبية كافة، وأنها وحدها السيدة، وأن هذا أمر لا تراجع فيه، ولا فكاك عنه. ويبدو أن عصفور قد استدرك برفع ثانيتهما، إما من باب مراجعة النفس، أو من قبيل تقدير وتقييم جديد للمشهد الأدبي، واعتراف بقدرة القصة القصيرة على المنازعة، وفرض نفسها.
إن الحديث عن “زمن الرواية” يشبه إلى حد ما ما قيل عن “نهاية التاريخ وخاتم البشر”، مع الفارق الشديد بين المقولتين وبنيتهما ومضمونهما وكل من يقف وراءهما والأهداف التي ترميان إليها، لكن ما يجمع بينهما هو التسرع الشديد، الأولى لحساب تصورات أيديولوجية توهمت أن انكسار الشيوعية يعني بالضرورة انتصار أبدي للرأسمالية، والثانية لحساب الانسياق وراء رواج الرواية من حيث الطلب على استهلاكها أو قراءتها، وهي حقيقة لا يمكن إنكار سيطرتها لزمن ما، لكن من العيب أن يتسرع أي أحد بأن هذا التفوق والسيادة بوسعه أن يستمر إلى ما لا نهاية.
وفي الوقت الذي أدرك فيه النقاد غير المرتبطين باستراتيجيات أبعد من الأدب أن قولهم بسيادة الرواية في حاجة إلى مراجعة، لم يدرك أصحاب التصورات السياسية خطأ ما انتهوا إليه زيفا أو تسرعا، أو لم يقدروا على المجاهرة بهذا. ويضع هذا نقطة اختلاف بل خصام بين ما يفرضه عالم السياسة من سياسات وخطط واستراتيجيات هي موضوعة سلفا بغية تحقيق أهداف معينة ومدبرة ومقدرة وبين ما يعن لذهن نقاد الأدب ومنظريه ممن يفكرون بحرية في النصوص التي تنهمر هنا وهناك، ويربطونها بسياق اجتماعي وسياسي وفكري قد يوحي لهم بتصورات ما، يعتقد بعضهم أنها تشكل خط النهاية، الذي لا يمكن للإبداع الأدبي أن يتجاوزه.
وهناك من يدرك أن القصة باقية ما بقيت الصحيفة والدورية الثقافية أو العامة، إذ ليس بوسعها نشر رواية كاملة، وإن فعلت فليس أكثر من فصل فيها، يشار في مطلعه أو آخره بأن هذا “النص المقتطع” ليس سوى جزء من نص أوسع وأعرض هو “رواية كاملة”، لكن قضية فن القصة القصيرة تعدى هذا المسار الوظيفي إلى درب فني لا يمكن لأحد أن يضيقه كي يجعله مجرد مسألة أوسع من الرواية لمقتضيات النشر، أو هو استراحة بين نصين سرديين عريضين، إنما هو فن عصي على التجاهل والنسيان، وأنه مقدر لذاته، بل إن قصة قصيرة واحدة بوسعها أن تترك أثرا في وجدان الناس وأذهانهم أكبر كثيرا من رواية كاملة عابرة.
سأضرب مثلا في هذ المقام، بقصص يوسف إدريس المعنونة بـ “طبلية من السماء” و”النداهة” و”مسحوق الهمس” و”آخر الدنيا” و”حادثة شرف” وغيرها، وليست الاستعانة في هذا المقام بإدريس مصادرة على إبداعه خارج القصة القصيرة، في مسرحيات لا تنسى من أمثال “الفرافير” و”ملك القطن” و”المهزلة الأرضية” أو رواية مثل “الحرام”، إنما أردت أن أقول إن بعض هذه القصص قد بقي في الذاكرة أكثر من بعض محاولات إدريس الروائية والمسرحية نفسها.
وحتى أن البنَّاء الأكبر للرواية العربية نجيب محفوظ إن كنا نذكره دوما برواياته ذائعة الصيت مثل “الثلاثية: بين القصرين ـ قصر الشوق ـ السكرية” و”أولاد حارتنا” و”ملحمة الحرافيش” و”اللص والكلاب” فإن له قصة قصيرة لا تقل حضورا حين يتم استدعاء اسمه، وهي قصة “زعبلاوي” التي جاءت ضمن مجموعته “دنيا الله” وكان من أوائل ما ترجم له إلى لغة أجنبية، وهي الألمانية، وعدها نقاد قصة عميقة المعنى والمغزى، وهناك كذلك قصة “الحب فوق هضبة الهرم” التي عكست تأثير الانفتاح الاقتصادي على الشباب المصري.
وهناك من استطاع أن ينسج من قصص قصيرة عالما متكاملا، يُغني عن كتابة رواية، لا يعبر عنه سواها لامتداده، ودورانه حول مسألة واحدة. وفي هذا المقام تتجلى مجموعة محمد المخزنجي “سفر”، التي تدور حول تجربة واحدة لكاتبها. وسار كاتب هذه السطور على المنوال نفسه في تجربة “حكايات الحب الأول” التي تحوي مائة أقصوصة أو قصة قصيرة جدا تؤدي جميعها وظيفة واحدة وهي التعبير عن هذه التجربة. وسبق أن كتب نجيب محفوظ تجربة “حكايات حارتنا” وهي عبارة عن مائة وسبعة وثلاثين حكاية منفصلة متصلة ترسم ملامح الحارة بشتى تفاصيلها في لحظة زمنية معينة.
إن هذا معناه أن القصة في سعيها للتعبير عن عالم متكامل تتمرد على صورتها المتعارف عليها بأنها سرد مكثف يعبر عن لحظة أو موقف أو حالة، ويكون هذا التمرد عبر دوران قصص المجموعة كلها حول نقطة واحدة، وكأنها تمثل دائرة حول مركز تحط فيه رؤية أو تصور أو حالة أو رغبة أو مسعى أو هدف، وكل قصة تشكل جزءا من هذه الدائرة حتى يكتمل محيطها.
وأنتج هذا المسعى لونا أدبيا جديدا يسمى “المتتالية القصصية”، التي تعني قصصا متتابعة عن موضوع واحد، لتقع في منطقة وسطى بين “الرواية” و”المجموعة القصصية”، في اختلاف عن القصة الطويلة والرواية القصيرة أو “النوفيللا”. لكن حضور هذا اللون لا يزال باهتا، إذ لم يحظ باعتراف تام، لأنه لم يشق إلى الآن مسارا عفيا، وبات متهما بأنه لا يعدو كونه نوعا من الإزاحة التي يقوم بها أدباء أحيانا، ربما دون قصد، حين يكتبون نصا، لا هو بالرواية ولا بالقصص، فيذهبون إلى “تصنيف إضطراري” يسمى “المتتالية”، وكأنها رواية مبتسرة أو قصة متورمة بزوائد متناثرة في جسدها كله.
ولم يؤد هذا التوجه إلى تراجع وجود فن القصة القصيرة، وإن كانت سوق القراءة هي التي خلقت هذا التراجع، فعلى مدار عقدين أو أكثر زاد الإقبال على الرواية بينما ضعف على القصة والشعر، فطالهما أذى كبير، وإن كان النشر في الدوريات وصفحات الأدب بالصحف وحيزه في المواقع الالكتروني ظل مفتوحا على مصراعيه أمام القصص التي تنهمر من هنا وهناك، لكن نشرها في مجموعة يوجب التوجه بها إلى دار نشر، وهنا تبدأ المشكلة أمام أغلبية الأدباء، حيث تفضل دور النشر الروايات، ومثلها أصحاب واجهات وفرشات ومكتبات العرض والبيع، لأن الطلب عليها أكبر.
إن فن القصة القصيرة لا يُنتج في فراغ، وارتباطه بالسياق الاجتماعي الاقتصادي مسألة جلية، ليس من زاوية التقاطه لأفكار وموضوعات ومضامين فقط، بل أيضا ما يتعلق بإبداعه أصلا، حيث يتحدد مدى أو مستوى الإقدام عليه، والإحجام عنه. فالثابت مثلا أن هذا الفن قد انتعش في أوروبا حين راجت الدوريات الثقافية، وكانت سخية في منح مكافآت للكتاب عن قصصهم، فأقبلوا هم على كتابتها إقبالا شديدا، لسد احتياجهم إلى بعض المال، وحين تساقطت هذه الدوريات تباعا تراجع حجم إنتاج هذا اللون الأدبي البديع، لكنه لم يصل أبدا إلى نقطة الصفر.
فالأدباء الكبار الذين تتابع إنتاجهم الروائي، لا تزال القصة القصيرة تمثل لديهم فنًا بديعًا لا يمكن هجرانه، والأدباء الصغار يعتبره بعضهم مسار تدريب على كتابة سردية يمكن أن تطول وتتعقد مستقبلا لتكون رواية، وبين الاثنين هناك من يقصر إبداعه عليها، دون أن يشعر بنقص، بل إن بعض هؤلاء يعتبرونها الفن السردي الأصعب، لما تنطوي عليه من تكثيف للأحداث، وبديهة حاضرة لالتقاط ما يصلح للكتابة من مجريات الحياة، أو ما يهيم به الخيال، أو من مزجهما.
وبعيدًا عن موقف الأدباء ومنفعتهم، وحسابات دور النشر ومصالحها، فإن تسارع وتيرة الحياة مع تقدم التصنيع، وتعزز قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على جذب الجيل الجديد بقوة نافذة، لا فكاك منها، سيجعل القصة القصيرة، والقصيرة جدًا، مطلوبة بإفراط، ولديها مُكنة أكبر على التفاعل والدوران مع “التفكير الشبكي” الذي صنعه الإنترنت، ويزداد تأثيره مع مطلع شمس كل يوم جديد.
فنحن نطالع كثيرًا حكايات مكتوبة على “فيسبوك” هي بنت واقع من نقروا على لوحة الحروف كي تظهر لنا على هذا النحو، بغض النظر عن مستوى إتقانها اللغوي، أو اتساقها مع التصور العام لفن القصة، فأصحابها لم يزعموا أنهم يكتبون هذا النوع الأدبي، ولا يشغلهم كيف نرى ما كتبوا، بقدر انشغالهم بالتعبير عن مواقف مروا بها، وأحوال نفسية عاشوها، ومكنون من تصورات وتأملات اشتغل في أنفسهم واختمر فوجدوا في البوح به سبيلا للراحة، وجلسوا ينتظرون كيف سيتفاعل أصدقاؤهم ومتابعوهم مع ما كتبوه.
أما على “تويتر” فيجب على من يبوح أو يحكي أن يتمتع بقدرة هائلة على الاختزال والإزاحة ثم التكثيف والتثبيت والتثبت، فيقص كل شيء في سطور لا يزيد مجموع حروفها ـ حتى الآن ـ عن مائتين وثمانية وثمانين حرفا، أو يكون مضطرًا إلى أن يقسم حكاياته إلى تغريدات متتابعة، هي أشبه بدفقات كان بعض كتاب القصة يدفعونها، ويرتبونها رقميًا بين البداية والنهاية.
ويمكن للحكاية أن ترد على لسان راو يسجلها بالصوت والصورة على موقع “يوتيوب”، ولا يزيد الأمر في كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الطريقة القديمة في الحكي التي كان يلجأ إليها الناس للبوح والتبيين والتسرية والتسلية في سالف الأيام. فمثلًا كان الفرد يعود في نهاية اليوم من السوق أو المحكمة أو المكتب الحكومي أو ملعب الكرة ليقص على أهله وأصحابه ما جرى له، وكان هؤلاء يتحلقون حوله مشنفين آذانهم، لينصتوا إلى حكايته القصيرة، كي يشاركوه همومه، أو يستمتعوا بها، أو يسدوا له النصيحة.
إن الحكايات الشفاهية التي لم تتوقف، والتي أجبرت وسائط التواصل الاجتماعي على الإنترنت على اختزالها، تؤكد، دون مواربة، أن الحاجة إلى الحكاية/ القصة مستمرة، لأنها تلبي نداء إنسانيا واجتماعيا يتجدد في الأزمنة والأمكنة، حيث لا يوجد شعب بلا قصص، كما يقول رولان بارت.
لا يعني هذا أن المجتمعات طوال تاريخها لم تعرف القصص غير القصيرة التي ترد على الألسنة، إذ إن الروايات الطويلة والملاحم النثرية والشعرية الشفهية تكاد تكون قاسما مشتركا بين الأمم على مدار التاريخ، وبعضها تتقارب موضوعاته، وإن توحدت أو تشابهت خصائصه وطرق التعبير عنه، لكن البشر يميلون بطبعهم إلى القصة التي تكتمل في جلسة واحدة، بل إن هذه تطاردهم في حياتهم اليومية، وتأتي إليهم في مكانهم، بينما يكونوا هم في حاجة إلى الذهاب إلى المكان الذي تروى فيه الملاحم على ألسنة شعراء شعبيين أو حكاءين.
لهذا ظلت القصة القصيرة استجابة لطلب لا ينقطع، وهذه الوظيفة لا أظن أنها ستنقضي أبدًا، ومن ثم يصبح من العبث أن تتحدث النخبة المثقفة عن تراجع فن أدبي يقبل عليه الناس ويصنعونه ويبدعونه ويتداولونه بالطرق التقليدية، وعلاقة الوجه للوجه، أو عبر المسارات الإلكترونية الجبارة التي وسعت المشاركة وأعطتها سرعة فائقة، بشكل لم يسبق له مثيل.
وقد جاءت الأحداث السياسية الفارقة بوصفها “سرديات كبرى” لتجدد نشاط الحكاية أو القصة المحكية, فالثورات والانتفاضات والحروب الأهلية والاضطرابات السياسية الواسعة والفوضى هي أشبه بسرديات كبرى تحوي في باطنها نثارا من حكايات تفصيلية تخص كل من شارك فيها أو شهد عليها أو سمع عنها. وفي السنوات العشر الأخيرة، ومنذ اندلاع انتفاضة تونس وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة، صارت لكل مواطن عربي، ينتمي إلى البلدان التي وقعت فيها هذه الأحداث المغايرة، حكاية أو أكثر يرويها مع أهله وأصدقائه الذين تربطه بهم علاقة وجه لوجه، أو أولئك الذين يتواصل معهم في ساحة العالم الافتراضي الرحيبة.
وهذه القصص، التي تمثل تجارب شخصية أو شهادات فردية وذاتية، إن جمعناها من أفواه الناس وما كتبه كل منهم على صفحته بأي من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يمكنها أن تشكل جانبا مهما في فهم وتحليل ما جرى على مدار عشر سنوات، لاسيما أنها محملة بأشواق هؤلاء وتطلعاتهم وآمالهم ومواقفهم وتوجهاتهم، ولذا يظل هذا أشبه بتاريخ حي، ينبض ولا يموت على صفحات الورق مثل ما هو موجود في الوثائق وقصاصات الصحف أو ما يموت فور ولادته مثل أغلب برامج التلفزيون.
لا يعني هذا أن من حكوا أو كتبوا تجاربهم في اختزال وتكثيف يلائم ما تتيحه مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يناسب وقتا ضيقا لدى الجميع في واقعهم الحياتي، كانوا يقصدون كتابة قصص قصيرة بالمعنى الفني المتعارف عليه، إنما كانوا ينطقون أو يكتبون تحت لافتة الفعل “حكى” والاسم “حكاية”، إلا أنهم في حكيهم هذا رفدوا المجال العام بما عزز وظيفة القصة في تسجيل التجارب الذاتية التي يشكل كل منها نقطة في دائرة واسعة، بينما تمثل كل مجموعة زاوية من الزوايا، وبهذه وتلك يمكن أن تكتمل السردية إلى حد كبير.
إن الحديث عن استمرار القصة مبعثه الأساسي لدي هو الحاجة المتجددة إليها في حياة الناس، بما يجعل الاستغناء عنها، أو تنحيتها جانبها، وإغفالها، ضربا من العبث، وربما المتسحيل. ويمكنني شرح هذا في النقاط الآتية:
1 ـ الثورة مجرد قصص
في العهود السياسية السابقة على الانتفاضات والثورات لم تكن الحكايات ميتة بالطبع، لكنها لم تنهمر بهذه الغزارة، ولم تتسم بهذه الحرارة، التي قد تعني الحماس أو الحميمية أو التعاطف مع الآخرين، وقد تعني الانزلاق إلى صراع محتدم على المكانة والمنفعة. وقبل ظهور ثورة الاتصالات لم اكن للحكايات فرصة للذيوع الذي اكتسبته الآن، وستعزز في المستقبل.
في سنوات ما قبل “الإضطراب” أو “الزعزعة” التي تواكب الفعل الثوري دوما في سبيل إعادة توزيع وترتيب أوزان القوة داخل المجتمعات على أسس جديدة، كانت الحكايات تأتي رتيبة مكرورة
تتلاقى في بطء كي تشكل اللوحة الاجتماعية الكبرى، وبعضها لا يعدو أن يكون تأكيدا لما هو موجود، أو تجويدا له، وهي برمتها تعكس مواقف الناس مما يجري لهم وبهم ومعهم وفيهم.
وحتى أيام الحوليات التاريخية كانت حكايات المؤرخين تقتصر على يوميات الحكام والأمراء وقادة الجند وكبار التجار والوجهاء، وتكون رتيبة بطيئة، تتعلق بموت أبطال التاريخ هؤلاء أو قيامهم بفعل لافت. لكن هذه اليوميات كانت تلتهب بحكايات مختلفة في أيام الحروب والهبات والكوارث الطبيعية والفتن فتتدفق سخية على الورق، وفي الوقت نفسه تنبض بحياة حقيقية، وتفارق الطابع التسجيلي الباهت والمحايد والبارد أحيانا الذي تأخذ في الأوقات العادية، حتى أنها تبدو لوحات ثابتة معلقة على جدران كالحة.
وزمن ثوراتنا نحن ليس استثناء من هذا، فالحكايات الرتيبة والتقليدية سرعان ما تختفي، أو تتوارى في زاوية بعيدة مقصية، وربما منسية أحيانا، مفسحة الطريق لقصص أخرى ذات إيقاع سريع حتى يكون بمكنتها مواكبة الأحداث المتدفقة، التي تنطوي على صور وكلمات وإشارات وإيماءات، ما إن تلوح حتى تختفي ويأتي غيرها. ونظرا لهذا تكون الحكاية عند صاحبها ذات قيمة كبرى، إن كان وحده بطلها أو الشاهد عليها, لاسيما إن تعلقت بحدث مهم، يشغل الذي يؤرخون ليوميات الثورة، أو حين يتم استدعاؤه كشهادة في ساحة القضاء إن كان الحدث يتلاقى فيه قاتل ومقتول، أو معتدي ومصابون، أو مخرب وحطام.
لم يكن الأمر يستدعي بالطبع انتظار الاستدعاء إلى محاكم، فهذا إن حدث يكون للقلة القليلة، إنما تنهمر الشهادات يثرثر بها المحتشدون في الميادين، حين تكل الحناجر من فرط الهتاف، فكل يحكي ما جرى له يوم الزحف الأكبر في الشوارع، والبعض يرددون شائعات أو أخبار خاصة وصلتهم، أو ما رآوه وسمعوه في مناطق معزولة، أو حتى يسردون آراء الأصحاب والأقارب فيما يجري. يخرج كل هذا من الأفواه على هيئة حكايات قصيرة تصور ملمحا أو مشهدا أو زاوية، وتعبر عن حال أو موقف أو مسار واختيار.
هذا الخروج لا يكون بالضرورة منضبطا، يبدأ من نقطة ويصعد إلى الذروة، فمن يحكون وقتها يشغلهم الإخبار والبوح والتعبير عن الفن، وقد لا يدري أغلبهم أنه يصنع فنا شفهيا لا غنى عنه لتأدية وظائف معنية مثل التحفيز والتصبير والتسرية والتقضية للوقت في الاعتصامات والمرابطة.
وإن أردنا أن ندرك مدى أهمية هذه الوظائف التي تؤديها الحكايات فلنتخيل أن الجموع الغفيرة المحتشدة في ميدان ما، واهبين وجودوهم لعمل ثوري أو احتجاجي، قد جلسوا صامتين طوال الوقت، ينظر كل منهم في عيون من حوله، دون أن ينطق ولو بكلمة واحدة، فهل بوسع هؤلاء أن يصنعوا فعلا مقاوما مستمرا؟
إن الحكايات الصغيرة أيام الثورات تؤدي دورا في المقاومة المدنية السلمية، وكذلك المقاومة بالحيلة، ولهذا يمكن أن يُحكى بعضها مختصرا وفي صوت زاعق أحيانا من فوق المنصات المنصوبة في الميادين، أو أمام كاميرات الفضائيات التي تدخل بيوت الناس بالصوت والصورة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وسط “المجموعات” التي تشكل روافع للعمل الثوري أو تنطق باسمه أو تنتمي إليه.
هنا تتاح الفرصة لكل شخص شارك في العمل الثوري أن يكتب ما شاء على صفحته أو حسابه في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كان كاتبا محترفا فبوسعه أن يسجل حكاياته في يوميات مثلما رأينا في كتب “مائة خطوة من الثورة: يوميات ميدان التحرير” لأحمد زغلول الشيطي، و”كراسة التحرير” لمكاوي سعيد، و”أيام التحرير” لإبراهيم عبد المجيد، و”الثورة الآن” لسعد القرش. وكانت هذه اللحظة التاريخية ملهمة لكثيرين من غير الكتاب المحترفين فولدت كتب كثيرة سجلت تجربة كل كاتب مع الحدث الكبير. وعلى التوازي تتابعت على صفحات الجرائد كثير من الحكايات، وكذلك في البرامج المتلفزة والإذاعية.
ولأن كتابة رواية أو شهادة واسعة عميقة متكاملة عن الحدث في جريانه هي مسألة صعبة، اللهم إلا إذا قسمناها إلى مشاهد مثلما فعل كاتب هذه السطور في روايته “سقوط الصمت” وشهادته “عشت ما جرى”، فإن الحكاية/ القصة كانت طيعة وجاهزة لتلبية نداء أصحاب القلم حين تنادوا ليكتبوا عن الثورة، التي هي في خاتمة المطاف من زاوية المعنى والبلاغة والبنية والمجرى والمسار بمنزلة سردية كبرى تطوي في بطنها الآلاف من السرديات الصغيرة، إنها في النهاية مجموع حكاياتنا القصيرة.
2 ـ السياسة عدة حكايات
حين ترد كلمتا “سياسة” و”دبلوماسية” علي أذهان الناس، تحضر معهما غالبا ألفاظ من قبيل: الخطب والبيانات والتصريحات واللقاءات والاجتماعات والمباحثات والمحادثات والمفاوضات والمداولات والمناورات، ولا يعتقد أحد أن هاتين الكلمتين اللتين تحيط بهما هالة من الجدية والصرامة، وترتبطان بمسائل وقضايا غاية في الأهمية والحيوية، يمكن أن تجد الحكايات إليهما منفذا أو سبيلا.
في الحقيقة فإن الحكاية حاضرة بشدة في أروقة السياسات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية، ويتوسل بها الكل في سبيل الاستمالة والإقناع والتزجية والترويح وكسب الوقت، لكن المسؤولين الرسميين حريصون على إخفاء هذا، إما لأنهم لا يريدون الكشف عن إحدى حيلهم الرامية إلى تحقيق أهدافهم، ولو بطريقة ملتوية، وإما لأنهم يعتبرون الحكي قد يقلل منهم أمام الرأي العام، الذي يريد ممن يتولون أمر القرار أن يكونوا واضحين جادين مباشرين يتحدثون بلغة قابلة للقياس.
لكن الجميع يكتشف أن أروقة السياسة والدبلوماسية حافلة بالحكايات، ولا يُستثني من هذا أحد، ولا دولة، ذات نظام حكم ديمقراطي كانت أم غير ذلك. فمن يتولون الإدارة العليا في أي بلد هم في النهاية بشر تستهويهم القصص كغيرهم، كما أن بعض من حولهم يدركون أن امتلاكهم قدرة على الحكي المسلي قد تكون سببا لبقائهم فترة أطول في مواقعهم، وبعضهم يتصور أن تقديم التقارير الشفهية التي تصف أحوال الناس يمكن أن يكون أكثر نصاعة إن تدثر بالحكي، وهناك المشاءون بالنميمة والدسيسة الذين لا بد لهم من امتلاك قدرة على اختلاق الحكايات، وتسويق أكاذيب من خلالها.
ويكتشف الجمهور هذا إن كتب أحد الساسة الكبار مذكراته، فوقتها لا يتوسل فقط بالسرد عموما كي يقدم ما قاله وسمعه وأوصى به وفعله وجرى له، إنما يكون في حاجة إلى أن يقص على القراء بعض القصص من واقع ما حدث. ولا تخلو مذكرات من هذه الخاصية، مهما كان صاحبها يفتقر إلى قدرة على الحكي، إذ إن غريزة هذا النوع من الكتابة تدفعه دفعا إلى السير على هذا الدرب، وعندها يجد الناس أن الأوقات التي كانوا يعتقدون أنها قد مضت مغلفة بصرامة شديدة، وتقريرية دقيقة، كانت غارقة في حكايات حتى الأذقان.
والمصدر الثاني لكشف علاقة الممارسة السياسة بالحكاية تتمل في الإفادات أو الشهادات، وربما الاعترافات، التي يدلي بها مسؤولون سابقون حين يسألهم أحد في برنامج متلفز أو حوار صحفي أو خلال جلسة خاصة. وقد مرت على الجميع في العقد الأخير ألوان من هذا، فبعض اندلاع الهبات والانتفاضات والثورات وسقوط أركان سلطة هنا وهناك، خرج المتصلون بها، والمتنصلون منها، ليرووا للناس الكثير من الحكايات عما كان يدور خلف في أروقة الحكم ودهاليزه. واستمر الأمر نفسه في المحاكمات التي أجريت، حيث وقف كثيرون في ساحات العدالة يسردون أشياء كانت خافية على الناس.
ورغم هذا فإن أغلب الناس لا يسحبون ما سمعوه عن ماضيهم إلى حاضرهم، فيدركون كثيرا مما يجري لهم من واقع فهم واستقراء وتحليل ما كان، بل يتعاملون مع ما يقع على أنه غارق في التقريرية، وأن الغموض الذي يكتنف بعض الأشياء لا يمكن أن يكون راجعا إلى سحر الحكايات أو الفراغات التي تتخللها وتحتاج إلى من يردمها بإتمام ناقصها، وتجلية غامضها، إنما رجوعه الأساسي، وربما الوحيد، هو إلى حجب المعلومات عن الناس، أو الإفراج عن القليل منها، مما لا يشفي الغليل، ولا يشبع النهيم.
إن السياسة والدبلوماسية لا تحلق في فراغ، فهي في خاتمة المطاف من صناعة بشر تجذبهم الحكايات أكثر من غيرها، حتى ولو في أوقات الفراغ، أو بين التجهم وأخيه.
3 ـ الحرب قصص يبدعها المقاتلون
في تاريخ الإنسانية تم تصوير الحروب على أنها ملاحم كبرى، يمكن أن تصاغ شعرا في آلاف الأبيات التي بوسعها أن تشكل مئات القصائد، أو تكتب نثرا في حوليات أدبية، إن صح التعبير، تحوي آلاف الصفحات، التي تتحدث عن البطولات العظيمة التي خاضها فرسان استثنائيون، ربما لم تعنهم الحياة وقت المعركة في شيء سوى تحقيق الانتصار الكبير، الذي يخلد أسماءهم، أو يجعل بلدانهم تقدرهم خير تقدير على ما قدموه في سبيل الوطن من كفاح وتضحيات.
لكن أيا من هذه الملاحم لم يعن كثيرا بالبطولات الصغيرة التي شكلتها، أو نبتت على ضفافها، وبوسعنا أن نرى كل منها بمنزلة قصة قصيرة أو حكاية فردية، ولنقل ذاتية، عن الذين قاتلوا في بسالة وانتصروا، ومن بينهم الذين استشهدوا، أو أولئك الذين أصيبوا، وبقوا على قيد العيش مع الناجين، ليحكوا لنا كل ما مروا به وكابدوه، وليس أمامنا نحن الغائبين عن ساحة المعركة سوى الإنصات إليهم، لأنهم وحدهم الذين خاضوا التجربة في أعمق وأدق معانيها وحال وجودها أو حضورها الطاغي.
لكن ليس بوسع أي من هؤلاء أن يحكي لنا كل ما جرى، طولا وعرضا، وشرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، إنما يمكنه أن يسرد، ووقتها نصدق من زاوية وطنية أو إنسانية، ما جرى له كفرد، رأى ما وقع، وهو ينخرط فيه بكل كيانه، وينشغل ذهنه بساحة القتال العريضة بحثا عن نصر فيها، وتشتعل مشاعره بكل ما يحفظ حياته، ويردي عدوه، وتذهب عيناه إلى الرايات المرفوعة في بلاده، التي تنتظر منه أنه يعود مظفرا.
إن الملاحم الكبري تلك ما كان لها أن تكون إلا إذا كانت هناك حكايات صغيرة أو مفصلة أو ذاتية تخص أولئك الذين كانوا في ميادين القتال، ولم ينتظر أغلبهم شيئا سوى أن ينتصر لبلاده، دون أن يفصل في داخله هذا عن وجوده، لاسيما إن الفهم والتصور والتكنيك العسكري قائم على أساس الحفاظ على حياة المقاتل، أيا كان موقعه ومكانه، فله وحده صممت الخطط القتالية، وصنعت أدواتها من المسدس إلى الصاروخ.
بذا فإن ما يسمعه المقاتل ويراه ويلمسه ويشمه ويتذوقه لا يمكن تجاهله ونحن نؤرخ للحرب، فهي إن كانت رواية طويلة أو ملحمة، فإن صورتها الكلية لا يمكن أن تستقيم إلا إذا شارك في صناعتها المقاتلون الأفراد الذين خاضوا المعارك بالفعل، في النجاد أو الوهاد، ثم علينا أن ننصت إلى كل ما قالوه لنا، أو استغرقوا في روايته عما فعلوه وسط النيران والدماء والضجيج الهائل.
إن الحروب، لاسيما الحديثة والمعاصرة، لا تخاض إلا في ظل خطة حربية محكمة، ينتظم الأفراد في تنفيذها، ويصبح لكل منهم دور محدد في هذا، يجب عليه ألا يتعداه، وإلا يكون قد خالف الأوامر، أو تصرف بما لم تحدده القيادة الميدانية، وفي هذا مخاطرة لا يقدر هو آثارها، لأنه وهو يؤدي دوره المرسوم المحتوم عسكريا لا تتوافر له كافة المعلومات عن الخطة الكاملة، ولا يعرف كل التفاصيل التي تجري في مسرح العمليات بطوله وعرضه.
لكن مهما كان تحكم القادة وسيطرتهم على الميدان، وهو أمر ضروري في أي معركة، فإن لكل فرد مقاتل حكايته، حتى لو خاض مع رفاقه تجربة واحدة، ومارسوا الفعل نفسه، فهو في النهاية يسمع بأذنيه، ويرى بعينيه، ويعمل بيديه، ويقدر ما يجري وفق تصوره الخاص النابع من خبرته وما في رأسه من معارف، وفي وجدانه من قيم، وما يدركه من تصورات هي بنت خبرته وثقافته، ولذا فإن طلبنا منه بعد أن تضع الحرب أوزارها، أو حتى أثناء دوران المعارك أن يحكي لنا تجربته فسيقصها على أسماعنا بطريقة تختلف عن رفيق سلاحه.
إننا لا نقصد بهذه القصص تلك التي يبدعها أدباء شاركوا في المعارك، مثلما حدث في كتابات أمم كثيرة تحت عنوان عريض اسمه “أدب الحرب”، لكننا نرمي مباشرة إلى الشهادات والإفادات الشفهية التي يدلي بها الجنود والضباط المقاتلون، أو تلك التي يمكن أن يدونوها على هيئة “يوميات” في مذكراتهم الخاصة، وبوسع بعضهم أن يسعى إلى نشرها فيما بعد، إن تهيأت الظروف لهذا.
إن المعارك كلها يمكن التعبير عنها أدبيا في عمل ملحمي كبير مثلما تناول ليو تولستوي الحرب النابليونية ضد روسيا القيصرية في روايته الضخمة “الحرب والسلام”، ويمكن أن تكتب بعيدا عن الأدب في مذكرات سردية للقادة العسكريين أنفسهم، أو توجد في التقارير والوثائق الميدانية التي تجمع كأرشيف رسمي كامل للحرب، وفي التغطيات المتلاحقة للمراسلين الحربيين، لكننا لا نقصد أيضا كل ذلك في هذا المقام، إنما نقصد نثار الحكايات وأشتاتها، التي يعبر عنها المقاتلون سردا بعد أن تسكت المدافع.
إن كثيرا من هذه الحكايات تصفو وتنجلي بعد مرور السنين، وعودة الجنود إلى حياتهم الميدانية منغمسين في أعمالهم المدنية وتربية أولادهم وأسفارهم وأوقات فراغهم، ويؤدي انجلائها إلى التخلص من تفاصيل كثيرة غارت في الذاكرة، لتخلص الحكايات من العوالق والشوائب التي قد تكون بنت الهواجس والمخاوف والرغبات والبطولات والعواطف بما تنطوي عليه من ميول وانحيازات، وبذا يمكن لصاحبها أن يستعيدها على نحو مكثف أمام سامعيه، أو يكتبها على الورق فيقرأها الناس، وتصير في كل الأحوال جزءا من التاريخ العسكري الاجتماعي للأمم والدول.
وبالطبع فإن الفرد الواحد لا يسرد حكاية/ قصة واحدة، فهو، على قدر مدة انخراطه في القتال أو أعمال الإمداد والتموين والاستطلاع، يكون قد سمع ورأي وعمل الكثير من الأفعال، وقابل شخصيات عدة، من رفاقه، أو حتى من أعدائه، الذين كانوا يحرصون على قتله بقدر حرصه على قتلهم في الميدان.
ولا يمكن لأحد من هؤلاء أن يستعيد الوقائع والمجريات كما هي، لاسيما بعد مرور زمن طويل على حدوثها، إنما قد يختلط بها شيء من مخيلته، وربما رغباته وأشواقه في تصوير دوره على نحو معين. وما تجود به المخيلة هنا على الحكاية الأصلية من حمولات يضفي نوعا من الأدبية على تلك الحكايات، إذ تفارق طابعها التسجيلي، وتخرج مشبعة بقدرة صاحبها على الحكي، وما يعطيه له من أسلوب سرد يمتلكه ومعان وإدراكات ومفاهيم وتقديرات تتسربل بها القصص المحكية.
وكثير من هذه القصص تتدفق إلى الصحافة، كلما جاءت ذكرى الحرب، إذ أن الأمم المنتصرة تحرص على إنعاش ذاكرة الشعوب بما جرى، خاصة إن كانت أسباب العداء أو الصراع أو النزاع لا تزال قائمة، أو بمعنى أدق كان الطرف الذي حاربته دولة ما استمر يشكل عدوا في العقيدة القتالية لجيشها. من هنا تنتقل الحكايات من مجال الشفاهي إلى الكتابي، وهي ترد بالطبع إلى ألسنة المقاتلين، أو تنسب إليهم حين تنتقل من راو إلى آخر. ويمكن لهذا الانتقال أن يحدث شفاهة أيضا، فالذين خاضوا المعارك يحكون تجربتهم الصعبة تلك، أو ما تبقى منها في ذاكرتهم، لأولادهم وأحفادهم، وهؤلاء ينقلونها بالطريقة التي تحلو لهم إلى غيرهم.
من أجل هذا تكون الحروب منبعا لحكايات عديدة، ولأنها ولدت في أوقات استثنائية بالنسبة لكل مقاتل، فإنها تظل محفورة في ذاكرته أكثر من حكايات أخرى صنعتها أفعاله في حياته الاعتيادية المفعمة بالتفاصيل المتتالية والمتناثرة. كما تلقى حكايات الحروب حرصا أشد على تسجيلها واستعادتها بطرق متعددة، لتتدفق في شرايين المجتمعات الإنسانية، وتستقر حية في القيعان البعيدة، لتثار من آن إلى آخر، فتحضر من غياب، وتستيقظ من سبات لا يطول أبدًا.
4 ـ ما يحكيه الإرهابيون من قصص
وراء أي إرهابي قصة يسكن فيها كل شيء عنه، فإن جمعناها إلى جانب قصص الذين معه ستكون لدينا الرواية كاملة عن إرهاب تنظيم أو جماعة في مكان وزمان ما، فإن مددنا الخط على اتساعه فقد تولد بين أيدينا الملحمة الدموية كاملة، أو خلاصاتها الأساسية.
وما كل واقعة إرهابية، في التجنيد والتعبئة أو التحريض ثم التنفيذ المفضي إلى القتل والتدمير، إلا قصة أو حكاية ما، يمكن أن يرويها صاحبها لمن معه أو الواردين جديدا إلى التنظيم أو أمام أجهزة الأمن والتحقيق حين يتم القبض عليه، أو خلف القضبان النحيلة لقفض الاتهام أمام القضاء في ساحات المحاكم، وقبلها وفي ركابها إلى محامي الدفاع عنه.
ودفع هذه القصص في شرايين التحليلات المتدفقة حول التطرف والإرهاب يعطيها كثيرا من الحيوية، ويقربها من الحقيقة، وينقذها من الجفاف والبرود الذي يفصل الفعل عن أشخاصه وكأنهم آلات قتل مجردة، ويجعلها أكثر مصداقية وإقناعا. وقد توسلت بعض الدراسات الميدانية، والتحقيقات الصحفية والمتابعات بمثل هذه القصص، التي توزعت بين ما يدلي به إرهابيون من إفادات وشهادات أو ما يقوله شهود عيان عن حوادث إرهابية وقعت هنا أو هناك.
وبعض ما يرويه إرهابيون من حكايات ينطوي على قدر من سمات القصة الأدبية عبر ثلاثة أبواب، الأول هو المبالغة، إذ يحرص هؤلاء على الكذب إما رغبة منهم في تضخيم دورهم ومكانتهم، أو إضفاء طابع أسطوري على حالهم بما يغري آخرين بالانضمام إليهم. والثاني هو التوسل بلغة ذات إيقاع وجرس قوي غارقة في المجازات أحيانا تماشيا مع طريقة هؤلاء في التعبير وما تجود به عليهم المعاجم والكتب القديمة التي يلتقطون منها كثيرا من ألفاظهم. والثالث هو استعمال تقنيات الإخفاء والإضمار بغية المراوغة والغموض الذي يفرضه الوضع الأمنى للإرهابيين، وبذا يتركون دوما فراغات داخل نصوصهم، بما يجعل المسكوت عنه حاضرا، في ظل عدم الانشغال بالتفاصيل الواسعة التي يهتم بها الروائيون، وتسد فراغات كثيرة، لاسيما عبر ما يسمى “الراوي العليم”.
إن القصص والحكايات مثلما هي طريقة مثلى للوعظ والنصح والإرشاد والهداية، في الأديان كافة، فإن الإرهاب المستند إلى تصورات دينية مغلوطة، يستعمل الوسيلة نفسها في الدعاية لأفكاره، وتثبيت أنصاره، والكيد لخصومه، وبذا فإن كثيرين من أفراد التنظيم يحوزون ملكة الحكي بطريقة أو أخرى، حتى لو كانت حكاياتهم مرعبة أو مخزية.
وبعض هؤلاء المتطرفين والإرهابيين يتقاعدون أو يتراجعون ويسجلون تجربتهم سردا في عمل طويل، لا يتسم، في الغالب الأعم بالتماسك، الذي تتصف به الكتابة الروائية أو السير الذاتية أو السرد الصحفي العميق، إنما يأتي وكأنه مجموعة من المشاهد الحكائية أو القصصية المتلاحقة، أو هكذا تبدو إن صفيناها من التبريرات النظرية التي يمكن أن يدسها بين ثنايا سطوره، محاولا أن يقلل من قبح الدور الذي كان يلعبه في الماضي، أو يصنع لنفسه صورة أخرى تُسوِّقه في المجتمع الذي عاد إليه، طوعا أو كرها.
ومع تواصل موجات الإرهاب، وكل منها يمكن أن تشكل رواية كاملة في أي دولة اصطلت بناره، تتناثر فصولها ومقاطعها وسطورها في المجال العام إثر تتابع الأخبار التي يصنعها الإرهابيون من تهديد ووعيد واغتيال وقتل وتدمير، ويصبح وراء كل خبر قصة قصيرة، لها مكانها وزمانها والشخصيات التي شاركت في سيرها من البداية إلى النهاية، مغلقة كانت أم مفتوحة.
إن هذه الموجات الدموية، وإن كانت قد رمت إلى المجرى الاجتماعي حكايات غارقة في الدم والدموع، فإنها، من الناحية المجردة بعيدا عن ميولنا الرافضة بالطبع للإرهاب، جعلت المشهد العربي حافلا بحكايات أخرى، نظرا لأن أغلب أفعال الإرهاب تحدث في أرض عربية.
5 ـ التراث حين يُستعاد قصصا
حين يتحدث المختصون في دراسة التراث أو يكتبون فإنهم يأتون بالماضي على أكف الحاضر في صيغة معارف ونظريات صارت مساقات موزعة على علوم حديثة، بعضها قابل للتداول والاستفادة منه مثل الفلسفة ونصوص الأدب والبلاغة وقبلهما بعض الآراء الدينية والتاريخ، وكثير منها لم يعد إلا جزء من تاريخ العلم غير قابل للتطبيق في واقعنا المعيش.
أما غير المختصين، وهم الأغلبية الكاسحة فإنهم يستعيدون التراث قصصا قصيرة، أو حكايات مختزلة، سواء كانت تنحدر من تفسير وتأويل القصص الديني المنصوص عليه في القرآن والحديث النبوي، أو تأتي من باب أولئك الذين يؤدون وظيفة في الوعظ والإرشاد والهداية من العاملين على الدعوة أو دراسة الأديان، أو كانت من الموروث الشعبي، الذي أنتجته القريحة الشعبية الكلية، والنازع في الغالب الأعم إلى الفن والتأريخ والأسطرة.
فالفرد العادي حين يتحدث عن شخصية تاريخية، سواء كانت لقائد عسكري أو فقيه ديني أو متصوف ورع أو سياسي ترك بصمة أو حتى بعض العلماء في مختلف ألوان العلم والمعرفة فإنه لا يتناولها مثلما يفعل المحققون والمؤرخون ومن يكتبون تاريخ العلم أو يستعرضون الأدبيات وينقدونها في مستهل الدراسات والأبحاث والأطروحات الجامعية، إنما يسترجعونها حكايات شفاهية أو كتابية. وفي الأولى تختلط اللهجة العامية بما استقر في الذاكرة من بعض عبارات وردت على ألسنة أبطال الحكايات أو تعبيرات قيلت عنهم من المعاصرين لهم، واللاحقين عليهم. وفي الثانية نكون أمام كتابة تقوم بالأساس على النقول والتحقق.
وهذه القصص لا تُستعاد كما كتبت بالطبع، فضلا عن أن كتابتها لم تكن أبدا تصورها كما جرت في الواقع دون حذف أو إضافة. فالتاريخ اختيار، وما تم تدوينه منه هو مجرد جانب أو جزء أو مسار يعكس رغبة أو مصلحة أو فهم وإدراك وميل وانحياز من كتبه، فإن خرج من الصفحات إلى الشفاه، وساح في الأرض كلاما محكيا ولغة جسدية، انقطعت بعض صلته بما تم تدوينه وتسجيله في الحوليات والكتب، وقامت صلات جديدة هي بين أصل الوقائع ومقتضيات الحكي، وهي فنية بالدرجة الأساسية، أو خاضعة لشروط الفن، أدرك هذا من حكوها أو غاب عن أذهانهم.
بهذا ينساب التراث قصصا قصيرة ويتم تداوله على هذا النحو بين الناس، ليتحول عبر الحكي إلى شيء حي، لاسيما أن من يحكونه بأساليب وطرائق مختلفة، يطلقون في شرايينه الكثير مما تجود به مخيلاتهم وقرائحهم ليصبح قابلا للتداول والاستساغة في زماننا، أو في زمن يأتي.
إن الناس في بلادنا حين يريدون استعادة الماضي فإنهم يفعلون هذا على طريقة “كان يا ما كان”، لكن ليس بوسعهم في مواقف كهذه، أن يصيغوا ما يودون قوله في سرد طويل أشبه بالرواية، إنما يأتي بالطبع على هيئة قصص قصيرة. وكذلك يفعل الدعاة المسلمون في قصهم على الأسماع حكايات الأنبياء والأولياء والصحابة والخلفاء والفقهاء وقادة الجند في زمن الفتوحات. وعلى المنوال ذاته يحكي الوعاظ الكنسيون قصص الحواريين والرسل والقديسين والرهبان والاستشهاديين. وتستعاد كذلك الحكايات غير الدينية من تراث العائلة والعشيرة والقبيلة، حيث يحرص من هم علي قيد الحياة من الأجداد على أن يعرف الأبناء والأحفاد شيئا عن أمجاد عليتهم وكبارهم. وتأخذ الحكايات ما هو أوسع من هذا حين تلتقط من سياق الحضارات القديمة التي لا ينشغل عموم الناس بعطاءاتها العلمية بقدر انشغالهم بما خلفته من حكايات عن البارزين فيها أو تلك التي تغلف الطقوس الموروثة في الأفراح والأتراح، والجد والهزل.
6 ـ العدالة في صيغة حكايات
هل المحاكمات بوسعها أن تتفادى القصص؟ إنها تتجلى كثيرا كحكايات كُتبت في سجلات المحاكم وأضابيرها، أبطالها الجناة والمجنى عليهم وممثلو الدفاع والقضاة الجالسون على المنصات ليضعوا سطر النهاية، ومكانها معروف ومحدد ومتوارث ومتكرر، وزمانها هو كل العقود والقرون التي عرف فيها البشر مؤسسات العدالة الحديثة بمبانيها ومعانيها ومراميها؟!
إن مجموع هذه القصص يحمل في باطنه وظاهره معا مسار العدالة ومصيرها في بلد ما، ويرسخ معالم الخبرة القانونية، التي تصقل فهم اللاحقين مما تركه السابقون في الأقوال والأفعال، من حيل المحامين وحججهم، وبصائر القضاة وتقديرهم، وألاعيب الجناة ومكرهم، ونزاهة الشهود وتزويرهم.
هذه الأطراف الأربعة، المتنازعون والمدافعون والذين ينفوون التهم أو يثبتوها ومن يقضون بينهم، تتكرر في القصص، كأركان ثابتة، حيث لا تخلو منها تقريبا أي حكاية في قضية، لكن الحكايات مختلفة بين الأمكنة والأزمنة والثقافات والجهات والطبقات والبيئات الاجتماعية عموما.
وتخرج هذه القصص على الألسنة من أروقة المحاكم ومكاتب المحامين إلى ساحة المجتمع الرحيبة، فتتردد على ألسنة كل المشتبكين مع العدالة في علاقة ما، وترسم خط العدل في المجتمع، بين راضين عنه، وساخطين عليه، ومتشككين فيه. وهذه الحالات النفسية والعقلية الثلاثة قد لا يمكن البرهنة عليها عند أصحابها إن تجنبوا الحكايات تماما.
إن الناس يسعون إلى المحاكم مقبلين أو مترددين، وفي رؤوسهم نصف الحكاية التي صنعتها القضية التي يهتمون بها، ثم يجلسون في قاعات ناظرين إلى المنصة بقضاتها، والصف الأول بمحاميه، والقفص بالمتهمين، منتظرين أن يضيفوا إلى الحكاية نقلة جديدة، قد يكون استرجاعا أو استباقا في مجريات المحاكمة، وقد لا يعدو أن يكون توسعة وإفاضة في التفاصيل، انتظارا لجلسة أخرى، يحدث فيها تقدم إلى الأمام، وأحيانا تظهر حقائق تعيدها إلى الخلف.
ورغم أن القضية إن كانت واحدة في أوراق المحكمة فإنها تدور في أذهان هؤلاء الساعين بطرق متعددة، فكل منهم يمثل “المتلقي” أو “القارئ” الذي يستقبل سير القضية بفهمه ومصلحته وطريقته في التقييم، وما يتمناه لها من نهاية، والتي تتناقض بين الذين هم من أهل الجاني، والذين هم من أهل المجني عليه، أو تتفاوت بين الواقعين في المنتصف من الأقارب أو الجيران أو حتى أولئك الذين يهوون حضور المحاكمات من الجمهور العادي، وأوسعه أولئك الذين يتابعون أخبارها في الصحف لبعض القضايا، التي قد تتقدم ذيوعا لتصير محل اهتمام الرأي العام.
إن القصص لا تنتهي في كل صنوف المحاكمات والتقاضي، سواء كان يتعلق بالأحوال الشخصية أم القضايا المدنية والجنائية، وقد يلعب قانون الإجراءات هنا الدور الذي تمارسه الحيل الفنية التي يوظفها الأديب في سبيل صناعة المفاجأة والدهشة والثغرة التي يستخدمها في إحداث النقلة التي تسهم في تطوير الحكاية إلى الأمام.
فضلا عن هذا فإن بعض المخالفات والجنح والجرائم يقوم المخططون لها ومنفذوها بصناعة سيناريوهات مسبقة، يتخذ فيها هؤلاء موضع المؤلفين، ويتركون نهايتها مفتوحة، دون أن يدروا، فلمَّا ينكشف أمرهم، يأتي من يضيف إليها خلال المحاكمة، بينما هم يقفون أحيانا عاجزين عن المساهمة في هذه الإضافة، أو مندهشين حيالها.
ومما يعطي هذه القصص أحيانا جانبا من “الأدبية” أو الشروط الفنية للإبداع الأدبي، تلك البلاغة التي تنطق بها أحيانا أفواه الدفاع وأقلامهم، وكذلك ألسنة القضاة في تعليقاتهم وصياغتهم لحيثيات الأحكام، ومن المؤكد أن الطرفين يخرجان فيما بعد ليتحدثا، بطريقة مختلفة، في حياتهم الخاصة، مع ذويهم وأصدقائهم، وبعضهم قد يقوم بتسجيل وصياغة هذه الحكايات.
إن صورة العدالة في أي دولة لا تتجسد فقط في الدستور والقوانين ودقة ونزاهة الأحكام وتوافر شروط التشريع والتقاضي، إنما يصنعها أيضا إدراك الناس لها، وحديثهم عنها، الذي يأتي غالبا في شكل حكايات أو قصص.
7 ـ السرد العلمي
لم يعد اللجوء إلى الحكي في سبيل الإفهام مقصور على الدراسات التاريخية، التي لا يمكنها أن تتجنب سرد الوقائع والأحداث في صيغة حكايات غير فنية، إنما أصبح وسيلة تشق طريقها بثقة وتتعزز في مختلف الحقول المعرفية، منتقلة من الإنسانيات إلى الطبيعيات، بكل يسر وسلاسة واتساق.
فالعلماء والباحثون وجدوا أنفسهم في حاجة ماسة إلى هذه الوسيلة لتوسيع دوائر الانشغال بما يقدمونه، شفاهة أو كتابيا، بعد أن أدركوا وتيقنوا من أن الحكي أكثر قدرة على الجذب والإقناع، لاسيما إن كان ما يقدمونه ذاهبا إلى الجمهور، غير المتخصص، الذي يراد له ألا يشعر باغتراب وهو يطالع مسائل العلم الدقيقة في العلوم الطبيعية، أو الأفكار العميقة في العلوم الإجتماعية.
وقد يعتقد كثيرون أن هذه الوسيلة يتم اتباعها فقط في تبسيط العلوم، أو لدى علماء يبحثون عن شهرة خارج جدران المعامل والمراكز البحثية، لكنها في الحقيقة تعدت هذا بكثير. فحتى أولئك الذين يعرضون افتراضاتهم وتساؤلاتهم ثم استنتاجاتهم ونظرياتهم العلمية في صيغة معادلات صماء، إن طُلب منهم أن يبينوا كيفية التوصل إلى هذه المعادلات أو الخلاصات فإنهم ينخرطون في الحكي، ويستمتعون بهذا، وهم يضفون مسحة من جمال على ما انتهوا إليه من أشياء مجردة أو جافة.
كما أن حقل “علم اجتماع المعرفة” الذي ينظر في الجوانب الاجتماعية التي تقع وراء النظريات والقوانين العلمية ومن توصلوا إليها أو أنتجوها لا يمكنه أن يطرح مقولاته وتصوراته إلا عبر مسارات سردية. فكل معادلة أو نظرية أو فكرة وراؤها حكاية يجب أن تُروى، سواء من قام بهذا كان واعيا لدور الحكي في توصيل العلم إلى الأذهان والنفوس، أو غير مهتم بهذا من الأساس.
وإذا كان العلماء يلتزمون كثيرا بطرق تعبيراتهم المنضطبة حال جلوسهم لكتابتها، فإنه لا يتقيدون غالبا بهذا إن تحدثوا شفاهة عنها، حتى مع أقرانهم أو زملائهم، إنما يتخففون من الضبط والربط، أو الصرامة العلمية، ويطلقون ألسنتهم لتمضي ساردة الكثير من جوانب ما يريدون قوله أو إبلاغ معناه. ولا يعني هذا بالطبع أنهم ينتقلون من طريقة إلى أخرى مغايرة تماما، إنما سيمضي السرد متخللا حديث العلم، ويزيد وينقص حسب الحال.
وتطور الأمر إلى شكل أكثر قربا من الحكاية، بل هو عينها، دون أن يفارق الوقوع في قلب المعرفة العلمية. والحكي هنا لا يعني الإيغال في مشروطية الأدب أو مقتضياته الفنية، باللجوء إلى التخييل أو الإفراط في البلاغة، أو التشكيل الجمالي للغة، إنما نتخذ من الأشياء كالنباتات والحيوانات أبطالا أو شخصيات مركزية نسرد كل ما يتعلق بها، أي نقدم ما يخصها، أو أغلبه، في قالب قصصي، ويمتد هذا أيضا إلى مختلف الظواهر الطبيعية. وهناك من يعطي هذا مسحة أدبية، فيسرد عن الأشياء والظواهر وكأنه لا يتحدث في العلم إنما يبدع في الأدب، وكأن العلم مجرد موضوع لقصة، حتى لو راعى الكاتب الدقة في تناوله، فالتزامه بالموضوعية هنا لا ينزع عنه الذاتية التي يتسم بها الأدب، وهي من خصائصه الرئيسية.
ويحضر السرد عفيا في مجال الطب والوقاية، حيث الحديث عن الأمراض وأعراضها، والعلاج وطرقه، حتى أنه يتحول على ألسنة بعض الأطباء إلى حكايات، يكون أبطالها في أغلب الوقت، هي أعضاء جسم الإنسان، ويكون مقصدهم من سردهم هذا هو أن تصل المعلومة إلى القاعدة العريضة، فتعم الفائدة، إذ إن أغلب الناس ستنفر من الشرح والتوضيح إن جرى أمامهم بالطريقة نفسها التي تجري في قاعات الدراسة بكلية الطب ومعاملها.
7 ـ نهج مغاير في نقد القصص
على قدر اليسر الذي يمكن أن نلقاه في قراءة المجموعات القصصية مقارنة بالروايات الضخمة في عدد صفحاتها فإن تقديم نقد متكامل للقصص يبدو أصعب مما نواجهه مع الرواية، فالأخيرة هي في النهاية، ومهما بلغ حجمها، حكاية واحدة لفكرة وحيدة مركزية، أما أي مجموعة فهي نثار من حكايات وشخصيات وعوالم وقضايا وأفكار ورؤى ومسارات، تتعدد فيه الأمكنة والأزمنة، وقد تتباين الأساليب من قصة إلى أخرى، قصد الكاتب هذا أو جاء الأمر عفو الخاطر.
وإن لم يكن الكاتب قد قصد دوران قصص مجموعته حول موضوع أو مضمون واحد، وهو يجري أحيانا على قلته، فإننا نكون في أغلب الأوقات أمام تنوع وتوالى العناصر والعوامل والأسباب التي تجعل من الضروري أن نبحث عن عنصر حاكم أو مسار واحد لقراءة مجموعة قصصية ونقدها. وهذه العناصر تفصيلا هي:
أ ـ تعدد العوالم: فكل قصة في المجموعة أو بعض من قصصها قد ينتمي إلى عالم أو فضاء اجتماعي وإنساني مختلف عن البقية، سواء قصد الكاتب أن يصنع هذا التعدد، أو إنه انساق خلفه، مستجيبا لكل ما يجذبه إلى مسار صنعته مخيلته أو فرضته شروط الفن.
ب ـ تنوع الحكايات: إذ أن كل قصة في المجموعة حكاية غير أختها من القصص، وتتابع الحكايات متدفقة، ولكل منها مسارها الذي تشقه، ومصيرها الذي تنتهي إليه.
ج ـ اختلاف الأساليب: يمكن للكاتب أن ينوع طريقته في الكتابة بين قصة وأختها، وقد يكون قاصدا هذا أو يطاوع ذائقته ومخيلته وحالته ومساره، بحيث نجد أنفسنا مع الصفحة الأخيرة في المجموعة أمام أساليب وطرائق عدة في السرد والبناء.
د ـ تغير الحالات: التي مر بها الكاتب، أو الأجواء النفسية التي عبرها أثناء كتابة القصص، بين أمل مجنح وقنوط مقبض، وبين رغبة عارمة في تغيير العالم ونكوص عن هذا، وربما عدول وكفر به، وبين إقبال على الفعل وإحجام إلى السكون. ولا أقول أن هذا يجري بالضرورة لدى كل كاتب، مع كل مجموعة كتبها، لكنه على الأرجح هو الذي تصير الأمور إليه.
ه ـ سخاء التجارب: فالمجموعة القصصية الواحدة لدى بعض الكتاب قد تقف خلفها تجارب متعددة، يكتسبها الكاتب عبر زمن الكتابة من حصيلة تأمله فيما كتبه، وما يقرأه عند آخرين سبقوه على الدرب، أو مطالعته لأعمال نقدية في فن القصة القصيرة.
و ـ تبدل الأزمنة والأمكنة: ففي المجموعة الواحدة نجد أنفسنا أمام أزمنة وأمكنة عدة ومتفاوتة، وهذا أمر طبيعي، إذ يمكن للكاتب أن يضم فيها قصصا تدور في أكثر من مكان، وتتعاقب على أزمنة متتابعة.
ز ـ تباين الشخصيات: ففي المجموعة الواحدة نجد أنفسنا، في الغالب الأعم، أمام شخصيات متبانية أو متنافرة بل متناقضة، لكل منها منهله ومشربه ومذهبه في الحياة وأهدافه ومسعاه، ومن دون شك فإن هذا يجعل تحليل القصص في سطور معدودات مسألة غاية في الصعوبة.
ح ـ الكتابة المشتركة: وهذا لون آخر من الكتابة القصصية ظهر في السنوات الأخيرة نتيجة لظور ما يسمى بالورش، أو اقتراب مجموعة أدباء من بعضهم البعض إما لشعورهم بالانتماء إلى اتجاه واحد في الكتابة، أو لرغبتهم في التغلب على صعوبة النشر بتمويل كتابهم شراكة بينهم.
ط ـ مختارات كاتب: وهو اتجاه شاع أيضا، إذ تقبل بعض دور النشر على إعادة نشر مختارات لكاتب واحد من عدة مجموعات قصصية في كتاب. وتكون هذه المجموعات وقصصها قد كتبت على فترات متباعدة، ما يعني أن كل ما سبق من تباينات قد ينطبق عليها.
ي ـ قصد المؤلف: حيث يتوافر دوما احتمال أن يكون الكاتب حريصا على التنوع، فيعمد في مجموعة واحدة إلى عرض قدراته وانشغالاته وطرائقه في السرد والتعبير.
من أجل هذا فإن أغلب من تناولوا مجموعة قصصية بالنقد، لاسيما أولئك الذين كانت محددة لهم مساحة الكتابة في الصحف والمجلات، لم يستطع أي منهم أن يوفي أي منها حقها، فاكتفى بعرض الفكرة أو الموضوع الذي تدور حوله كل قصة، مع الإتيان سريعا على بعض الخصائص الفنية.
وقد حضرت بالفعل حديثا بين أدباء كانوا يقولون إن الناقد لم يفعل شيئا في مقاله سوى عرض القصص، ولم يكن غير قلة منهم تدرك أن السبب يعود إلى أن قصصهم ممتدة فنيا وموضوعا إلى ما هو أبعد من أن يحيط به كاملا مقال أو دراسة قصيرة. وربما هذا يجعل من الضروري أن نبحث عما يمكن أن يؤدي الغرض، أو المقبول منه، في نقد مجموعة قصصية، ولا ينهي ما يعيبه الأدباء على النقاد تماما، إنما على الأقل يقلل منه إلى حد مقبول.
من أجل هذا تولد ضرورة التفكير في طريقة منضطبة، علميا وفنيا، للتعامل الحصيف الواعي مع أشتات من القصص. ولا يعني هذا الانضباط بالضرورة التعبير الكامل عن كل ما ورد في هذه القصص من تفاصيل الحكايات ومواقف الشخصيات ونفسياتها، ومضمون الأفكار واتجاهاتها، ومسارها الفني أو بنائها، إنما يعني بالقطع البحث عن نقطة التقاء، أو مرجع انتهاء، لكل قصص المجموعة على توزعها وتفرقها وتشتتها، سواء تعمد كاتبها هذا أو أنها أتت على ذلك النحو دون قصد منه.
إن كثيرا من الأفكار والتصورات النقدية المهمة الهائمة طالما تاقت إلى نقطة مركزية تنطلق منها أو إطار مرجعي تنتهي إليه، وعند الحد الأدنى سعت إلى ما تعارف عليه الناس بأنه “قواسم مشتركة” وإن كان كل هذا يرد إلى عالم الأفكار والمعارف أكثر من ارتداده إلى عالم الفن. لكن منذ متى كانت الأبواب مغلقة تماما بين ما هو معرفي وما هو فني؟
إن النقد الأدبي وإن تعلق بالأساس بتتبع وسبر أغوار وكشف أبعاد فن يتسم بالمراوغة والتمرد والهيام فإنه يريد في أدنى محاولاته أن يروض المراوغ، ويهيئ المتمرد للانسجام مع تصورات يقررها التفكير العقلاني، الذي لا تعني عقلانيته، بأي حال من الأحوال، مجافاة شروط الفن، إنما تفهمها وتقديرها وعدم الجور عليها.
وهذه “الفنية” أو “الأدبية” هي التي يجب أن تكون أصل أو أساس أي تصور أو تفكير يتعلق بالبحث عن “النقطة المركزية” أو “الإطار المحال إليه”، وهي مسألة قد تكون مستقرة في لاشعور الكاتب وهو يبدع قصصه، فهي وإن تنوعت عوالمها بنت قلم واحد يعبر عن شعور واحد، ولاشعور واحد أيضا، حتى وإن ارتقى ذهن الكاتب من مرحلة إلى أخرى، وتطورت كتاباته بقدر تعدد تجاربه، واتساع مطالعاته، ورغبته في تجويد نصه.
وبذا فإن الانطلاق من نقطة ما، أو الانتهاء إلى إطار معين في التعامل مع أشتات من القصص لا يعني بالضرورة جورا على أدبية الأدب، أو إجبار الفن على الخضوع إلى افتراضات العلم وتصورات الفلسفة، إنما هو امتثال للتعامل الطبيعي مع نص واحد لكاتب واحد، مهما تعاقبت خبراته وتعددت رغباته في الانتقال من عالم فني إلى آخر.
بناء على هذا أعتقد أن بوسعنا أن نقرأ كل مجموعة قصصية في إمعان وتركيز شديدين، ثم نجلس لنتأمل نقطة البداية التي ينطلق منها النقد، أو الإحالة التي يعود إليها. لكن هذا يتطلب التمهل في التفكير الذي يعقب القراءة، موضوعا وفنا، أو محتوى وشكلا، وعندها قد نضع أيدينا على ما يجب أن نبدأ منه أو نخلص إليه، وهو الذي يجعل بمقدورنا أن ننظم القصص كافة، على اختلاف عوالمها وتعدد شخصياتها وزمانها ومكانها، في مسرب واحد، لا يزعم بالضرورة أنه يمثل كل تفاصيلها، إنما بوسعه القول إن قد وضع يده على الصورة الكلية، أو المعنى الجامع، الذي يشغل الكاتب في شعوره أو لاشعوره.
لا يعني هذا أن رؤية نقدية من هذا القبيل بمكنتها أن تحيط وعيا ونقدا بكل تفاصيل القصص التي تحويها المجموعة، لكنها على الأقل تقدم مفتاحا مهما لقراءتها وإدراك معانيها ومراميها، وبالتالي يمكن البناء عليها في فهم التطور الذي ارتفاه الكاتب في مسيرته، أو اللبنة التي وضعها في مسار السرد القصصي برمته.
وقد يحال هذا المفتاح إلى نوع أو جنس من قبيل المرأة والرجل، أو قيمة إنسانية مثل الحرية والعدل والمساواة والانتماء، وحالة كالأمل والرجاء واليأس والفرح والحزن، ومجتمع نعرفه كالحضر والبداوة والقرية والمدينة، وموقف فني وفلسفي مثل العبث والتحقق والغياب والحضور والموت والحياة والتجديد والتقليد، أو تنصرف إلى أشياء ومعان وحالات أخرى يوزعها الكتاب والنقاد والعارفين إلى مسارات متعددة.
لا يعني هذا أن نحدد قيمة أو نوع أو حالة ما ثم نجبر القصص على السير نحوها قسرا، إنما علينا أن ندع القصص نفسها تبوح لنا بمكنون سرها، وعلينا أن نصبر حتى نصل إليه أو نقترب منه، وعندها بوسعنا أن نبدأ في النقد، أو إن صح التعبير، نشرع في الفهم والتعبير والتقريب والتصوير والتحليل، حتى لا تقل أو تتضاءل مزاعمنا حول إمكان نقد قصص مجموعة كاملة، تتعدد قصصها من مختلف الزوايا وإن كان كاتبها بالطبع شخص واحد.
………………………
*نقلا عن مجلة “ميريت” الثقافية