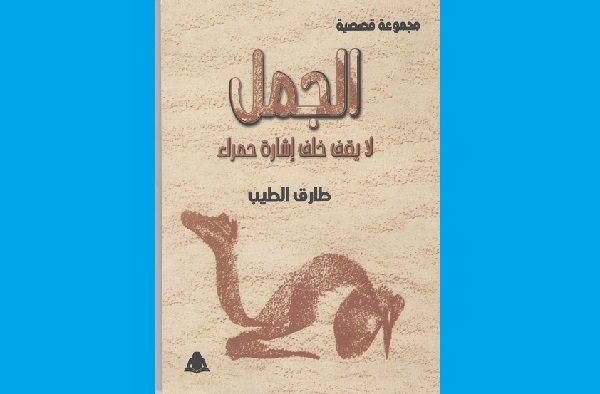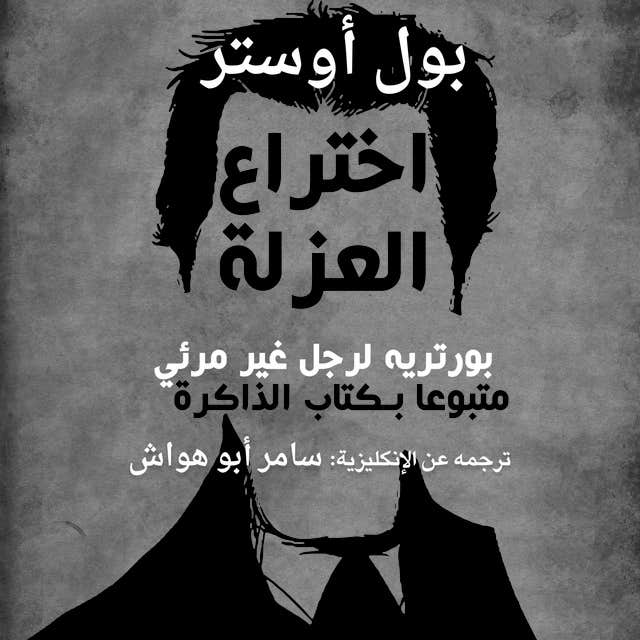محمد المسعودي
تبدو أغلب شخصيات قصص “الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء” لطارق الطيب شخصيات تعيش نوعا من العزلة والوحدة، فهي تحيا في جو متوتر قلق، وحالات تجعلها دائبة البحث عن الألفة، وعما يحقق لها نمطا ما من القرب والتفهم. ومن هنا نرى أن اشتغال القصة لدى طارق الطيب يتخذ تيمة البحث عن الألفة بشتى تجلياتها وإمكاناتها أفقا لتشكيل المتخيل القصصي، وقد كانت المفارقة عنصرا فاعلا في تجلية هذه التيمة، وفي تشكيل العوالم السردية. فكيف يتجلى البحث عن الألفة في قصص المجموعة؟ وكيف تُسهم المفارقة في تشكيل المتخيل القصصي وتجلية حال الشخصيات ووضعها؟
إن المتأمل في قصص “الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء” يلفي اشتغال القصة يتخذ طابع البحث عن أنيس، عن آخر، كيفما كان هذا الآخر لعله يُنسي الشخصية معاناتها، ويُسعفها على مواجهة واقعها الفظ، والخروج من شرنقة وحدتها القاسية. وقد استند متخيل جُل قصص المجموعة إلى هذا البعد في صياغة عوالمه سواء أكانت بيئة هذه القصص عربية (السودان أو مصر.. أو غيرهما) أو غربية (فيينا أو لندن.. أو غيرهما)؛ غير أن هذا الأليف الذي تعثر عليه الشخصية، أو تجده في طريقها يختلف من قصة إلى قصة، فهو تارة إنسان (امرأة حقة مرغوب فيها- طيف امرأة يُلم بالشخصية..)، وتارة أخرى حيوان أليف (كلب- حمامة..)، وقد يكون الأليف شيئا ماديا تأنس به الشخصية وتميل إليه لينسيها حالتها النفسية وشرطها المأزوم.
في قصة “ألذ شاي مع أجمل امرأة” نرى السارد وبطل القصة، وهو عسكري يعيش حياة جمود طويلة طول لائحة الممنوعات الكثيرة في معسكره، يهرب إلى الحلم لينسى وقر وضعه على روحه وثقله على كيانه. وهو يعمل على استرجاع هذا الحلم الذي أيقظه منه زميله العجول وخطفه منه، وقد كان على وشك أن يعرف ملامح المرأة التي كانت في حلمه، وكانت تكرر اسمه في صوت حنون. لقد أمضى العسكري تسعة أسابيع وخمسة أيام في المعسكر الصحراوي بحيث أصبح المكان ضيقا كئيبا على الرغم من أنه براح فسيح؛ وصار الرجل لا يرى في دنياه سوى الغم والوجوه الكالحة والنظرات المسعورة، ولا يسمع إلا الأصوات الرديئة والكلمات البذيئة، ولا يقتات سوى طعام مقرف، ولا يشرب إلا شرابا سيئا، ولا يهنأ بنوم مريح. وهكذا لم تتبق من إنسانيته إلا ذكريات ماضية كان يعمل رفقة زملائه على مزجها ببعض الصبر والأغاني والضحكات الكاذبة رغبة في السلو ونسيان آثار الوحدة والوحشة في المعسكر البئيس. وقد كان هاجس المرأة والحاجة إليها جوهر معاناة شخصية هذه القصة، بحيث تقول:
“..أكاد أنسى صوت المرأة ورائحتها في هذا الحبس. أعيش على الحكايات الكاذبة التي أسمعها، وعلى ذكرى بقايا الأحلام التي تُسرق مني. أحول الكاذب والمسروق إلى أحلام يقظة وأكمل وهم الأيام. ما أبلغ بؤسنا جميعا بعيدا عن المرأة! ماذا نريد أن نفعل بعيدا عنها. أنُجهز أنفسنا لحرب ستقوم يوما ما كي نفوز بأكبر عدد منهن. شيء مضحك. دعوني وحدي مع واحدة ويكفي. لكم الحرب والسلاح والدمار والقتل كي تفوزوا بأكبر عدد منهن. الهذيان يتقدم، واعترافات اللاشعور تتساقط من الإنسانية المعذبة. إنسانيتي التي لم يتبق لي منها سوى خيوط واهنة من المشاعر..” (ص. 22)
بهذه الكيفية يعلن البطل عن مفارقة وضعه، ويُبين مكمن معاناته. إنه يبحث عن أليف واحد وأنيس لا بديل عنه يتمثل في امرأة قد تنسيه وحشة الحياة وتعيد إليه إنسانيته، وتحيي فيه مشاعر المحبة، تلك المشاعر التي وهنت في “ضيق” المعسكر، وقتلتها “شساعة” الصحراء. ولما جاءه تصريح يسمح له بالخروج لمدة ثلاثة أيام، أوقف سلوريز خارجا من أحد المعسكرات ليقفز فيه دون أن يعرف إلى أين سيتجه، ولما كان السلوريز سيدخل معسكر الغرب، فقد نزل منه، ومضى نحو بيوت وشجرة كانت تبدو له في البعيد، يتسمع صدح طيور ونباح كلاب وأصوات بشر غير واضحة. أسرع راكضا نحو العمار ووقف فجأة جوار مدرسة تعلو فيها ضجة التلاميذ، وقد انتشى بأصوات الطفولة التي ضاعت منه، لكن نشوته الكبرى كانت لما رأى امرأة جالسة تُعد الشاي في مكان قريب، ولا يوجد في المكان سوى رجل مسن على بعد مترات قليلة منها، يرتشف شايه في صوت عال مستمتعا بالطعم والسرحان والأحلام. طلب البطل كوبا من الشاي، وهو يترصد المرأة التي اعتبرها “أجمل ما وقعت عليه عيناه في الدنيا”، ويهتز لصوتها الذي لم يسمع ولن يسمع أجمل منه، ويتمتع بالنظر إليها وهي تبتسم له. وطلب من المرأة مرة أخرى أن تضيف إلى شايه أربع ملاعق من السكر، ليسمع صوتها مرة أخرى وكأنه لحن عذب، وهي تردد عبارتها: “حاضر، من عيني”. وظل الرجل يعيش في أحلامه، وهو يتذكر الحلم الذي سرقه منه العسكري السمج حينما أفزعه في نومه. ولما مدت المرأة يدها بكوب الشاي الساخن تعمد أن يلامس يدها، وهو يتنبه على صوت لحن صوتها المعسول برعشة أصوات الجدات الطيبات.
وبهذه الشاكلة تُحكم المفارقة لعبتها لتكشف لنا عن سيطرة الاستيهامات والأحلام على شخصية القصة، وهي تعمل جاهدة من أجل الخروج من شرنقة وحشتها وجحيم عزلتها وحرمانها. ومن ثم نتبين أن المفارقة أدت دورا بينا في تبيان طبيعة الشخصية وحالاتها النفسية والوجدانية، وصراعها الجواني من أجل التغلب على لحظتها المأساوية. وقد تكشف الطيف الذي كان الرجل يحلم به، ويتسقط عذوبة صوته عن امرأة عجوز تكدح من أجل لقمة عيشها، غير أنها كانت بالنسبة إليه أليفا مجسدا أنساه نوعا ما فداحة وحدته، وحدة حرمانه.
ولا يكاد يختلف بطل قصة “مساومة” عن مثيله في القصة السابقة، فهو في أثناء إجازته من الخدمة العسكرية يحلو له مراقبة الحياة المدنية والسلوك البشري خارج أسوار المعسكرات، فيقضي معظم ساعات إجازته مرتادا المقاهي، أو زائرا الأصدقاء، ومحاولا بشتى الطرق أن ينسى قسوة الحياة العسكرية والأوامر الصارمة في الساعات القليلة التي يُجاز له بها. ويعمد إلى تتبع أي حركة تصدر من نوافذ الجيران أو من الشرفات، أو حركة تجري في الشارع، وهو يرقب ذلك من شرفة بيته. وبهذه الكيفية يملأ زمانه، ويشغل أوقاته، طاردا الوحدة، متغلبا على الوحشة التي تطبع حياته. إن البحث عن الألفة، هنا، يتركز على اقتناص لحظات الزمن لتأمل حياة الآخرين ومعرفتها عن بُعد.
وهكذا تحكي القصة عن الرجل وهو يتابع سلوك طفلين صغيرين متجهان إلى مدرستهما، وقد وصل إليه صوتهما الحاد بوضوح وهو في الدور الثالث من العمارة التي يقطنها، وزاد وضوح صوتهما هدوء ساعات الصباح الأولى. ومن خلال رصده للطفلين وإنصاته لحوارهما اكتشف أن مساومة عجيبة تجري بين طفلين لم يتجاوزا بعد السابعة من عمرهما، أحدهما غني والآخر فقير، يقدم الغني قطع الشوكولاتة للفقير مقابل أن ينقل منه بعض الواجبات المدرسية كل يوم، وفي هذا الصباح طلب الطفل الفقير صاحب المخلاة من زميله مزيدا من قطع الشوكولاتة وإلا فسيتوقف عن منح الآخر كراساته لينقل منها واجبات المدرسة. ثم شاهد رجلا يتكئ على عصاه ويمسك بيده حفيدا له ليوصله إلى المدرسة، وكان يبدو على الطفل الصغير كرهه لهذه الرحلة اليومية التي هي رحلة عذاب نظرا لبطء حركة الجد ولأن الطفل يجرجر قدميه في الأرض، ويسبق الجد أحيانا مما يضطر الجد إلى سحبه كالشاة إلى سجن لا يحبه يبقى فيه كل يوم بضع ساعات. وسمع البطل الجد يقول لحفيده:” ستصبح في المستقبل ضابطا عظيما، يحترمك الجميع، وتكون لك الهيبة، إذا ما واظبت على دروسك وأحببت الذهاب إلى المدرسة” (ص. 94)، فضحك من قوله، وتذكر حاله حين ذهابه إلى المعسكر مسحوبا أيضا برباط الالتزام الوهمي الكريه، وأنه لم تتبق له سوى ساعات قليلة ليعود إلى معسكره/ سجنه الكريه. واستمر الرجل باحثا عن مشاهد أخرى في حارته علها تنسيه وحدته، وتكون زاده في أيامه داخل المعسكر، وهكذا دخلت الحارة عربة خضار يجرها حمار، وسرعان ما بدأ البائع ينادي بصوته الشجي معلنا عن بضاعته متغزلا بها كأنها امرأة. وكان الشاب الثلاثيني يُقلب خضرواته واضعا أحسنها في المقدمة متغزلا بها بطريقة ماكرة، خاصة حين يرى إحدى طالبات المدارس، أو امرأة جميلة تمر بجانبه. وحضرت امرأة عجوز صارت تساوم البائع الذي أبى أن يخفض مليما واحدا، ورفض أن يبيع لها، فلعنته ولعنت كل البائعين وترحمت على الأيام الخوالي، أيام الرخص والهناء، ثم سبت الغلاء والحكومة والنظام الذي ترك البائعين على أهوائهم وقلة حيائهم، ولما انصرفت المرأة عاد البائع ينادي على خضرواته مرة أخرى في نشاط بعدما أصابه شيء من عدم الراحة لاستفتاحه السيء على سباب العجوز. لكن مراقبة العسكري لما يجري صارت تامة وقد انتهى من احتساء شايه. وهكذا أبصر امرأة تخرج من مدخل البيت المقابل لمسكنه، امرأة متزوجة حديثا على شيء كبير من الدلال، مس البائع المتجول حبور وسعادة حين رآها، فعلا صوته بالغناء مرة أخرى، وقفز إليها ليساعدها في التقليب والتنقيب عن أفضل الخضراوات. وعلى الرغم من مساومتها ورفضه البيع لها في البداية، إلا أن تهديدها بعدم الشراء، والخشية من أن يفقد اللحظة الهنية التي نادرا ما توافرت له بوجود امرأة جميلة بمفردها أمامه جعله يلين. ولما وقعت بعض حبات طماطم على الأرض، وانكفأت المرأة لترفعها انحسر ثوبها عن صدر حار وملابس داخلية مثيرة الألوان، انخبل البائع وظل مشدودا إلى المرأة التي ربما لم تلحظ ذلك أو أنها تعمدت وتعامت لتلهي البائع، وتجبره على خفض السعر، وفعلا تمكنت من خفض السعر إلى النصف، فاشترت كل ما رغبت فيه، وبالغت في الشراء بسبب التخفيض المفاجئ في السعر، دفعت ثمن ما اشترت، وأغلقت شباك صدرها، وعادت إلى بيتها تقفز في خطواتها، ربما خجلى أو سعيدة، بينما بقي البائع في مكانه لحظات جامدا لا يتحرك ولا يغني، ثم سحب حماره في هدوء نحو مكان آخر وقد تغيرت نبرات صوته. هكذا كان صباح الشخصية المحورية في القصة صباح ألفة، ووقوف على مفارقات جرت أمام عينيه، فكانت عناصر هامة في تشكل المتخيل القصصي وبناء عوالمه. وبهذه الكيفية وقف العسكري على منطق الحياة القائم على المساومة واتخاذ حيل عجيبة قصد تحقيق الغاية سواء لدى الطفل الفقير أو لدى المرأة الجميلة، وهكذا وقف عند مفارقات الناس وانسياقهم وراء تجنب العقاب أو بدافع الخوف وراء فعل أشياء غريبة: رشوة الطفل الغني لرفيقه الفقير، ومنع المرأة العجوز من الشراء وخفض ولو مليم من ثمن الطماطم، والانسياق وراء إغراء الجمال وفتنة الأنوثة وتخفيض الثمن إلى النصف بالنسبة إلى البائع.
وبهذه الكيفية كان الاشتغال بالمفارقة أساس هذا النص السردي الجميل. وهكذا كانت هذه المفارقات التي تم رصدها ملامح تنضاف إلى مفارقة الشخصية المحورية في بحثها عن ألفة مفقودة في واقع الحياة العسكرية التي تفرض عليها نمطا من الوحدة إلى درجة تشبيه المدرسة والمعسكر معا بالسجن الذي يُسحب إليه المرء عن غير رضى، وقد كانت مراقبة الرجل لما يجري في حارته غاية أساس خفية تتمثل في تحقيق نوع من الألفة مع الناس، ومع الواقع الخارجي المحيط به، هربا من خواء حياته.
وعلى العكس من ذلك أراد بطل قصة “هديل العزلة” الاستمتاع بهدوء وحدته، فاختار السكن في حي هادئ بعيدا عن مركز المدينة، في شقة واسعة بأعلى طابق من مبنى حديث، وحين تلبس المدينة ثوب السهرة، ويغوص الهدوء في سكون خاشع، تنقطع صلته بالعالم نهائيا، فيطفئ الأنوار، ويتحد مع رهبة الظلام في صلاة عشق حزينة. وفي الصباح، يقف خلف زجاج غرفة المعيشة المانع للضوضاء، يشهد سكون الساكن، ويتبع حركة المتحرك، ويتحد مع الطبيعة بطريقته، ولا يسمح لأذنه بالتصنت حتى لا يفسد ما يدور في مخيلته من حوارات يختلقها ويركبها كيفما شاء لمن وما يرى. ولكنه حينما تشتد الحرارة، لا يجد مفرا من فتح النافذة لتغيير الهواء الحار ببعض النسمات المنعشة، وحينها يفرض العالم الخارجي وجوده على عزلة الرجل، وتتغلب حاسة السمع على بقية حواسه، فتجبره، بدوره تماما كشخصية القصة السابقة، على الإنصات وسماع ما يجري حوله من شقشقة وحفيف ونباح وضجيج لمحركات عربات لا يراها. وفي يوم من الأيام فتح النافذة للتهوية، استمع إلى صوت جديد طغى على مجموعة الأصوات التي تعود سماعها، كان هديلا واضحا، أطل من النافذة فرأى حمامة تمشي على حافتها العريضة جيئة وذهابا، وتُحرك عنقها أماما وخلفا، ظل يرقبها محاولا ألا يأتي بحركة تزعجها، ولما دخل ليحضر لها شيئا تأكله وعاد لم يجدها، غير أنها ظهرت في اليوم التالي، وفي الوقت نفسه، وظلت في المكان نفسه محافظة على مسافة ثابتة بينها وبينه. وكان قد جهز لها بعض الحبوب وضعها على حافة النافذة، تقدمت ببطء، ثم أكلت. صارت تأتي كل يوم في الموعد نفسه، وتتجاوز بالتدريج حدود الخشية الوهمية.
وهكذا أصبحت شخصية القصة تنتظر الحمامة التي تعودت عليها وحققت نوعا من الألفة معها. وبهذه الشاكلة استطاعت الحمامة أن تفرض ألفتها على المتوحد الساعي إلى العزلة، وظلت هذه الألفة تنسج خيوطها بين الرجل والحمامة طيلة الصيف، وخلال شهر الخريف، إذ صارت الحمامة تدخل غرفة المعيشة لتأكل من الحب الذي ينثره لها الرجل، وهي تراقبه لتعود بسرعة لتقف على النافذة، وتعودت الحمامة على البقاء لوقت أطول، ونجحت في إجبار البطل على تغيير عادة الانغلاق التام تجاه الخارج، ونجحت في إجباره على إعادة استعمال حاسة السمع على نحو جديد، بحيث حببت إليه سماع الهديل.
هكذا نرى أن المفارقة تؤدي دورا حيويا في تشكيل متخيل هذه القصة وبناء عوالمها، فإذا كانت الشخصية المحورية في النص آثرت العزلة والاكتفاء بها بعيدا عن صخب المدينة والناس، فإن الحياة لا تمكنه من تحقيق رغبته، وتقتحم عليه وحدته من خلال الحمامة التي ملأت عالمه وعملت على رده إلى العالم من حوله. ولم يكتف بطل القصة بتحقيق الألفة بينه وبين الحمامة فحسب، بل إنه سعى إلى امتلاكها والاستحواذ عليها عندما خطط للإبقاء عليها داخل غرفة المعيشة، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل، لأن الحمامة حولت غرفة المعيشة النظيفة إلى مكان فوضوي تنبعث منه رائحة غريبة، فما كان أمام البطل سوى أن يفتح النافذة ويفسح لها المجال لتطير خارج الغرفة. وبسبب هذا الفعل المتهور لم تعد الحمامة تأتي إلى النافذة طوال الأسبوع الأول، وظل الرجل يخاتل ألفته المفقودة دون جدوى، ومرت عليه شهور طويلة كئيبة، وأمله يبرد معها كأيام الشتاء الآتية. وفي صباح شتائي سمع، مرة أخرى، هديل الحمامة التي عادت إليه، وكانت تقف على المسافة نفسها التي رآها فيها في المرة الأولى، وتكرر الأمر في اليوم التالي، ولما وضع لها الحبوب في خط يصل إلى داخل الغرفة لم تأكل سوى ربعه ووقفت عند حدود الخشية الوهمية نفسها التي كانت عليها في الماضي، وظلت تفعل ذلك على مر الأيام، إلى أن بدأ العام الجديد وانهمر الثلج بكثرة، فكانت تأتي إلى النافذة لتأكل الحبوب ثم تطير إلى الفضاء، وعلى الرغم من أن النافذة ظلت مفتوحة أياما علها تدخل من تلقاء نفسها، إلا أنها أبت، ومرة اضطر الرجل إلى البقاء خارج المدينة يوما كاملا، وعاد متأخرا، وكانت درجة البرودة في ذلك اليوم مهولة، فتح باب الشقة، وهرع إلى المدفأة ليحرك الدم في أطرافه المتجمدة. وتذكر صديقته الحمامة، فقفز متعجلا ليراها، كانت خلف النافذة مباشرة، مغطاة بالثلج، فتح النافذة بسرعة، وأزاح عنها الثلج، وأدخلها إلى الداخل، وضعها على مخدة صغيرة جوار المدفأة متمنيا ألا تموت، انتظر طويلا غير أنها لم تتحرك، سقطت دمعة كبيرة ساخنة من عينه على ظهر إبهامه، وشعر كأن حجرا سقط على رأسه، لبس ملابسه الثقيلة، وخرج من الشقة لا يعرف أين يذهب وماذا يفعل. وهكذا أحس فداحة الوحشة وثقل فقد الأليف ولو كان كائنا عابرا وأليفا وديعا مثل الحمامة.
ومن خلال هذه القصة نتبين أن المفارقة بين الرغبة في العزلة وبين الألفة التي ينسجها البطل مع الحمامة كانت وراء بناء عالم شجي حزين انتهت إليه الأحداث فازداد بحث الرجل عن الأليف خارج الشقة، بعدما كانت الحمامة قد حققت له بعض الإشباع الوجداني واقتحمت عليه رغبته في الانفراد بذاته وبسكون وحدته.
من خلال كل ما سبق، ومن خلال نصوص أخرى كثيرة في “الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء” لطارق الطيب نتبين أن البحث عن الألفة هاجسا جوهريا لدى أغلبية شخصياته القصصية التي تعيش نوعا من العزلة والوحدة التي فُرضت عليها، أو اختارتها سأما من عالم الناس، لكن الألفة حينما تتحقق تظل في سياق خارجي لا تُمكن هذه الشخصيات من التخلص من وطأة العالم ووقر الوحدة والوحشة والحزن والمعاناة، ولعل هذه القواسم جميعا لاحظناها عند أبطال القصص الثلاث التي وقفنا عندها. كما نتبين أن المفارقة أدت دورا حيويا باعتبارها إمكانية فنية في بناء توتر النص القصصي، وتشكيل متخيله السردي. ونرجو أن نكون قد ألممنا في هذه القراءة ببعض السمات الفنية والرؤى التي تحكم مجموعة “الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء”، وهي مجموعة تتميز بإمكانات فنية وأبعاد دلالية كثيرة، لم نلامس منها إلا القليل، وعلى النقاد أن يكشفوا عن جوانب أخرى فيها. فتحية للمبدع الروائي والشاعر والقاص طارق الطيب على إبداعه الجميل، ونحن في انتظار مجموعات قصصية أخرى تنضاف إلى رصيده القصصي وتغنيه.
………………….
*طارق الطيب، الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2019.