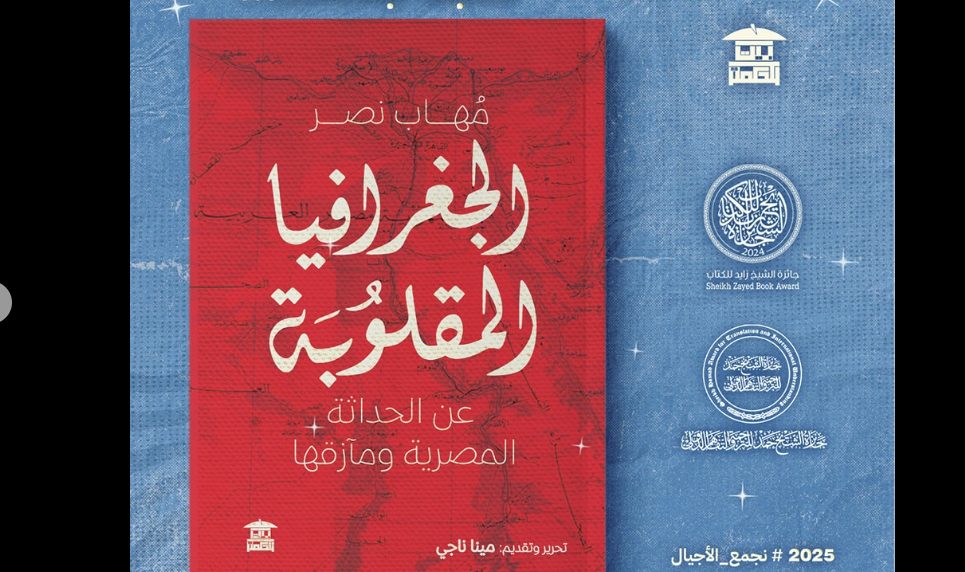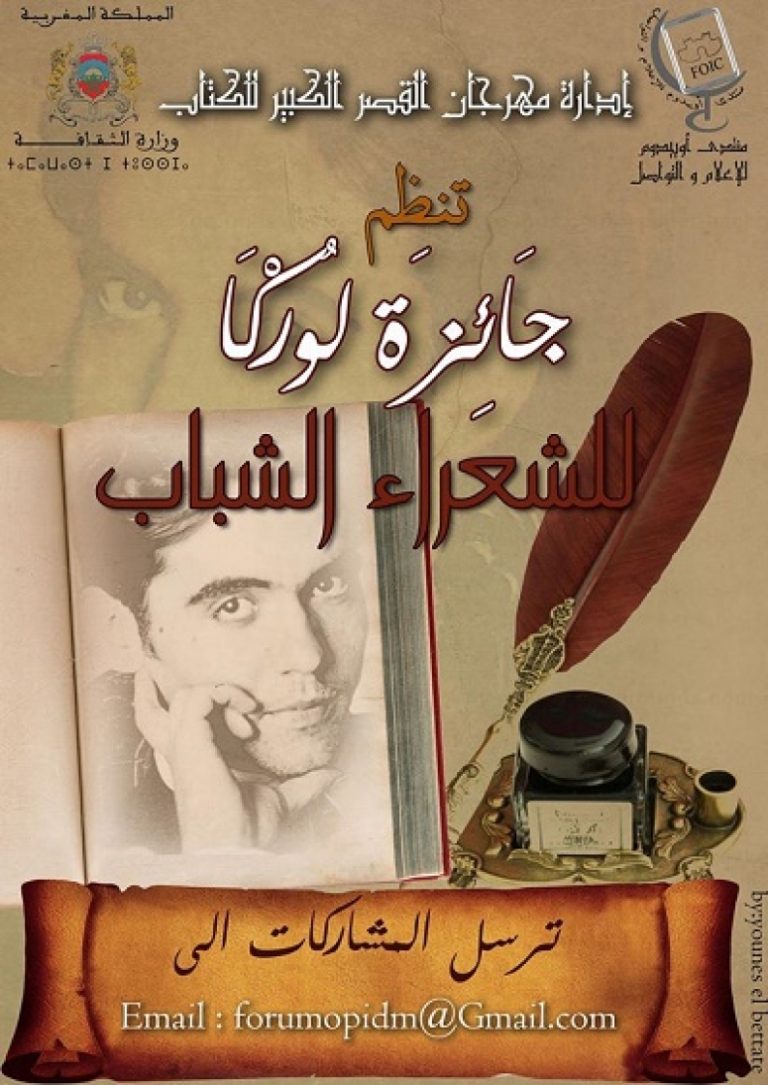مهاب نــصــر
“لن أكتب رواية”… هذا ما قلته لصديقي الذي قرأ ديواني الشعري الوحيد وهو زام شفتيه. كان هو نفسه قد أنجز رواية يمكن القول إنها “لطيفة”. بل كانت جيدة في الحقيقة. أعني أنها كانت من ذلك النوع الذي يجذبك من خلال رغبتنا جميعًا في المبالغة. لكنها، والحق يقال، مبالغة متماسكة رصينة، حتى إنك يمكن أن تغفر لنفسك تلك الساعات التي قضيتها زامًا شفتيك مثل صديقي تمامًا.
لماذا كان يري أن عليَّ أن أكتب رواية؟.. اعتبرت رأيه بلا موضوع. الأكثر أنني رأيته نوعًا من الوقاحة، رغم أنها كانت وقاحة تحدوها نوايا طيبة بلا شك. هل كان يعني أن ما كتبته ليس أكثر من تدريب على الكلام.. الكلام الأكثر أهمية والذي يستغرق صفحات طويلة تقول الشيء نفسه الذي أدركته جملة منذ الصفحات الأولي؟ هل كان يعني أنني بسبيل النضج الكافي لكي أحكي عن نفسي من وراء أقنعة مستعارة؟
كان يعتقد بطبيعة الحال أنني أملك “حدوتة”، وأن أهمية حياتي كلها تقف عند هذا الحد: أن أصنع منها “حدوتة”، وأن لدي الأدوات الملائمة لذلك، وأن قصائدي تبشر بالخير، وما عليَّ إلا أن أزم شفتي لأبلغ رجولة الروائيين.
“لن أكتب رواية”.. في الحقيقة أنا لم أقل ذلك لصديقي مباشرة، بل لم أقله على الإطلاق، وكيف أجرؤ؟!
هززت رأسي هنا وهنا بطريقة لا تعني شيئًا، ويمكن أن يفسرها بحسب رغبته. كان صديقي قد “وجد نفسه” كما يقولون. وفي جماعتنا، نحن الكتَّاب، تعني هذه الكلمة كل شيء، لدرجة أن عبارة “أنا لا أجد نفسي” كانت الأكثر انتشارًا بين جيلنا كله.
كانت هناك “أحداث” في رواية صديقي، ككل الروايات بالطبع. وفي جهة أخري كنت تسمع قعقعات وصرخات قوية لا تأتي من هذه الأحداث نفسها، لكنها تعني أن بطل الرواية كان مثل صديقي يبحث عن نفسه، وفي سبيل ذلك كان يمكن أن يقلد صوت كلب.. نعم، كلب. وكان أحيانًا يتحول إلى سكين. لكنها سكين حائرة، حتي إن حبيبته كانت تنظر إليها وتضحك، وتشير إلي صديقي “ما هذه..؟” كأنها رأت سرواله يسقط. وأهم شيء في الرواية، أو “دلالتها” كما يقولون، كانت تختزل في هذه الحكمة “أن تجد نفسك.. يعني أن تزم شفتيك”.
كان صديقي هذا يؤمن بالنجوم، وبأن مصائرنا كتبت “هناك”، وأن أحدنا حين ينظر في عيني الآخر لا يري إلا عينيه هو على هيئة كوكب. وكان التدقيق في الكوكب المقسوم بين عينين يصيبه بالحول، وهذا ما كان يعنيه بقوله “إنني لا أجد نفسي”. وكان صديقي أيضًا ماركسيًا أي أنه يؤمن بحركة التاريخ. وكان هذا التاريخ لا يعيره أي التفات، لذلك أصبح يحتقر الناس احتقارًا عميقًا، وكان قراره غير الواعي ربما، هو أن يزم شفتيه.
كان هذا يشعرني بأنه حين صعد مرة إلى الكوكب (الكوكب الخاص به)، لم يكتف بذلك، فقفز بلا تريث إلي جوهر الحركة الأولي، وراء نهر التاريخ ودورة الفلك، وأنه رأي شيئًا جعله يشعر بالخزي، لدرجة أنه لم يستطع النطق، وفضَّل أن يزم شفتيه. أو لعله ولد كذلك بسبب نوع من التوعك المزمن والمتوارث، أو بسبب مرض من الأمراض المنتشرة في الريف.
“لن أكتب رواية” كنت أسير إلي جواره وأفكر أنني لم أكن صادقًا تمامًا. فالحقيقة أنني فكرت مرتين أن أكتب رواية. كانتا محاولتين فاشلتين لم أخبر أحدًا بهما أبدا. أقول ذلك الآن بصراحة لأريح ضميري.
كانت الرواية الأولي، هكذا فكرت، تدور حول جثة. أو بعبارة أخري كنت أريد أن أصنع لها حبكة بوليسيَّة، لكنها حبكة تتعلق بجثة. ظلت صورة الجثة تطاردني، مع أنها كانت تقريبًا بلا معالم واضحة. كما لم يكن بجوارها أو حولها دماء حقيقيَّة. وكان المشهد الأول في الرواية يبدأ بحلقة من المحققين تحدق في الجثة من أعلي.
لكن لماذا جثة؟ كنت أري أن هذه هي البداية الطبيعيَّة، سوف تكون هناك أسئلة، وسبابات تهدد، ومخدات عليها آثار أسنان، واستجوابات إلى ساعات متقدمة من الليل، ملفات مختومة وأخري تنتظر التوقيع، عيون منهكة من إعادة النظر في حياتها. وسوف يزم الجميع في النهاية شفاههم لأنهم “وجدوا أنفسهم”، لكنهم لن يتمكنوا أبدًا من قول ذلك.
الآن يبدو واضحًا لماذا لم أكتب هذه الرواية، حتى إنني لم أضع حرفًا واحدًا فيها. لقد سيطرت عليَّ صورة الجثة تمامًا.
كنت أعرف من قراءاتي للروايات أنه لابد أن تكون هناك “أحداث”، أحداث تشبه تلك التي تقع لنا كل يوم، رغم أنها مختلقة تمامًا، بزعم أنها “الأحداث الأصلية”، أو الأحداث التي تكشف ثغرات الأحداث الواقعيَّة. أي أنها مثل صديقي تريد أن تقوم بتحليل مياه نهر التاريخ دون أن تشرَق بها.
كان الروائيون الكبار يسبحون بذراع، وبالأخرى يكتبون روايات عن ما تفعله الذراع الأولي، أو ربما يكتبون عن أذرع لم يروها أبدًا تسبح في جهة غير معلومة، أو بأذرع شعروا بصفعتها علي أقفائهم. كانوا يفعلون ذلك على أمل أن نسبح جميًعا بشكل أفضل وفي اتجاه التقدم، حتى إننا عندها سننسي أننا نسبح، فنضحك ونحب، وتصير لنا عائلات، ونذهب إلي مكاتب بربطات عنق دون أن نبتل.
كان هناك روائيون آخرون بشفاه ساخرة، يستهزئون بأصحاب الشفاه المزمومة. وهؤلاء للأسف كانوا لا يؤمنون بنهر التاريخ، ويقولون “كل هذه أوهام”، ويعتبرون أن النهر الحقيقي هو الكلمات. ومن هناك كانوا يعيدون ترتيب الكلمات بطريقة تجعل النهر يسير باتجاه معاكس، أو يتحول إلى أفرع صغيرة. كانوا يختلقون أحداثًا عجيبة، ويتدخلون في طبيعة الزمن الذي بدوره يتحول إلى ضحكة ساخرة، لأنه حقيقي ومختلق. لكن هذا لم يمنعنا من الشعور أبدًا بالألم، وبأن نتصور المستقبل على هيئة خطوة إلى الأمام علينا أن نقطعها، وأن نري ماضينا مثل نهر، حتى لو انتهي به الحال إلى مصب مالح، أو مقلب للنفايات.
لم أكتب حرفًا واحدًا من رواية “الجثة” لأنني لم أعد أري أي أحداث، ولا كان باستطاعتي اختلاقها. لا صوت، لا كلمة.. جثة. جثة فقط. بقيت صورتها في رأسي، واعتبرت أنها كافية تمامًا.
الرواية الأخرى، أو بالأحرى المحاولة الفاشلة لكتابة رواية أخري، كانت في الحقيقة أسوأ بكثير. لأنني هنا حاولت أن أفيد مما تعلمته. لاحظوا أنني أقرأ كثيرًا، وبالذات تلك الكتب التي لا بد كان أصحابها ذوي شفاه مزمومة، أو مائلة على هيئة ضحكة شائهة. هذه المرة قررت أن تكون هناك كلمات، و”أحداث” حقيقيَّة (رغم أن هذه الكلمة لامعني لها)، وأزمنة تدور حول نفسها أو تقفز من حلقة النار مثل لاعب السيرك، وتخرج منتصرة تمامًا.
“المرآة”.. قلت لنفسي. لكن أي مرآة؟… إن البطل في روايتي لا يحلم، لأنني لا أريده كذلك. أريد أن يتعذبْ كما تعذبتُ، أن يخبط رأسه في الحائط مديرًا ظهره للعالم: “أريد أن أجد نفسي”. رغم أنها موجودة فعلاً. أو موجودة وغير موجودة. لكنه لا يفهم ذلك، أو لا يفهمه بوضوح، أو لا يستطيع أن يتقبله، بل يشعر جراءه بالإهانة. البطل ينظر في المرآة فلا يري نفسه، ليس لأنه يرتدي طاقية الإخفاء ولا لأنه أصبح شبحًا مثلاً.. إنه يشعر بالرعب وهو يتحسس أعضاءه غير مصدق. لكن ليس هذا هو المهين حقًا، بل لعله هذا الوضع كان سيسمح له بأن يتوقف عن سؤاله عن نفسه ليتلصص على الآخرين، أو ليصبح هو ثقب الباب الذي نلصق عينًا وحيدة به، تخبر العين الأخرى بما تراه. لا لا.. هذا سخف، لأنه أخلاقي بصورة فجة. إن مأساة “البطل” الحقيقيَّة أنه مرئي بكامله بالنسبة للآخرين. وكلما أراد أن يتصرف باعتباره غير مرئي انتهي الأمر بصفعة أو فضيحة.
وهنا يجب أن أنبه إلى نقطة شديدة الخفاء في هذه الشخصية، وهي أن شخصًا غير مرئي بالنسبة لنفسه ومرئي بالنسبة للآخرين، سيتصرف تمامًا كأعمى، مهما حاول أن يفرك عينيه، بل إنه سيضيف نمطًا آخر فوق شخصية البطل ذي الشفة المزمومة، والبطل ذي الشفة المائلة على هيئة ضحكة حاقدة، هو البطل الأعمى الذي لا يكف عن فرك عينيه.
لا تخلو هذه الرواية، التي لم أكتب منها إلا صفحات شديدة السخف، من موعظة أخلاقيَّة. فالبطل، مثل كل الأبطال، يريد “أن يجد نفسه”. وهكذا يدخل في مواجهات مع ماضيه تصيبه بجراح واضحة، كل جرح منها يعيد إليه رؤية العضو المجروح. إنه على النقيض من “دوريان جراي”، “المرآة” تعيد إليه حياته، وكما يُرى عالم كبير يحترمه الجميع، تمر الرؤية في المرآة عبر وسيط، إنه هنا التاريخ، الطرف الثالث الذي نتلفت بينه وبين المرآة ونقول له: “انظر..”. لكن مشكلة ما واجهتني. رغم أنني كنت قد بدأت أشعر أصلاً بتفاهة فكرتي وعدم أصالتها. كانت المشكلة هي: بأي عضو أبدأ؟.. ثم كيف سيكون شعور البطل الذي يريد “أن يجد نفسه” حين يري في المرآة ذراعًا طائرة، أو عينًا واحدة تحملق، أو خصيتين معلقتين في الهواء كمصيرنا كله!
“لن أكتب رواية”.. لا أقول ذلك واثقًا، أو لاستدرار العطف. ربما كنت أتمنى..
لكن… كيف سأحتمل نفسي عندها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كتاب “الجغرافيا المقلوبة.. عن الحداثة المصريَّة ومآزقها” تحرير وتقديم: مينا ناجي .. صدر مؤخرًا عن بيت الحكمة ..معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025