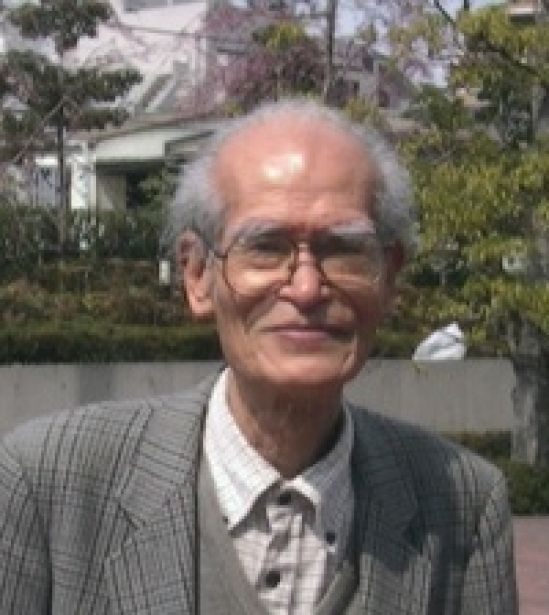15 سبتمبر
من حسن الحظ أن كتاب الجغرافيا، الذي يحتوي على خرائط لكل الأجزاء الرئيسية للعالم، كبير كفاية كي يخفي كتابتي لمذكراتي السرية التي أنجزها في دفتر تحرير أسود عادي. يجب أن أنتظر كل يوم حصة الجغرافيا كي أسجل أفكارا كهذه الأفكار التي، ربما، كانت لديّ صباحا عن وضعي ورفاقي. حاولت الكتابة في أوقات أخري ولم يفلح الأمر؛ فإما أن المعلمة تمشي بطول الممرات (في حصة الجغرافيا، لحسن الحظ، تظل ملتصقة بالقرب من حامل الخريطة في مقدمة الفصل) أو بوبي فاندربيلت، الجالس خلفي، يلكزني في كليتي يريد أن يعرف ما أفعل. فاندربيلت، حسبما اكتشفت من محادثات عابرة في الملعب، متعلِّق بالسيارات الرياضية ومقتنٍ خبير لمجلة رود آند تراك3. وهذا يفسر أصوات الهدير التي يبدو أنها تنبعث من مكتبه؛ مقلدا لألبوم مسجّل يدعى أصوات سيبرينج4.
19 سبتمبر
فقط أنا، في بعض الأوقات (فقط في بعض الأوقات) أفهم أن خطأ تم ارتكابه بشكل ما، أنني في مكان لا أنتمي إليه. ربما تدرك الآنسة مانديبل هذا أيضا، بقدر ما، ولكن لأسباب لا أفهمها تماما، فإنها تجاري اللعبة. في البداية، عندما تم تعييني في هذه الغرفة أردت الاحتجاج، بدا الخطأ واضحا، وأن أغبى مدير مدرسة يستطيع رؤيته؛ وصلت لاقتناع أن الأمر مدبَّر، أنه تمت خيانتي مجددا.
والآن لا يبدو أن الأمر يشكل فارقا كبيرا. فدور الحياة هذا ممتع بقدر دور الحياة السابق الذي كنت أعيشه، كان دور مسوِّي نزاعات لشركة التأمينات الشمالية الكبيرة، وهو منصب أرغمني على قضاء وقتي بين أنقاض حضارتنا؛ رفارف سيارات منبعجة، أكواخ بلا أسقف، مخازن ممزقة، أذرع وأرجل محطمة. بعد قضاء عشر سنين في هذا العمل صرت أميل لرؤية العالم كساحة للقمامة، أنظر لرجل وأرى فقط أجزاءه المشوهة (المحتملة)، أدخل منزلا فقط لأبدأ بتتبع مسار الحريق الحتمي. لذلك عندما تم تركيبي هنا، رغم معرفتي بأن خطأ تم ارتكابه، سايرت الأمر، كنت حكيما؛ أدركت أنه ربما هناك ميزة لأن تتم استعادتي مما بدا كارثة. فدور مسوِّي النزاعات يعلِّم المرء الكثير.
22 سبتمبر
يتوسلون إليّ كي أنضم لفريق الكرة الطائرة. لا أقبل، أرفض أن أحصل على ربح غير عادل بسبب طولي.
23 سبتمبر
باكر كل صباح تتم مناداة القائمة: بستفينا، بوكينفور، برون، براونلي، كون، كويل، كرسيلياس، دارين، ديربين، جايجر، جويس وايت، هيكلر، جاكوبس، كلاينشميت، لاي، لوجان، ميساي، ميت جانج، فايلستيكر. تشبه الابتهال المرتّل أوقات الفجر المعتمة البائسة في تكساس بواسطة أمين المراسم لمجموعة تدريبنا الأساسي.
في الجيش أيضا، لم أنحرف عن المرسوم إلا نادرا. استغرقني الأمر وقتا طويلا بشكل مذهل كي أدرك ما فهمه الآخرين تقريبا من أول لحظة: أن كثيرا مما كنا نفعله كان مجردا من القيمة تماما، بلا غرض. بقيت أتساءل عن السبب. ثم حدث شيء عرض سؤالا جديدا. ذات يوم أمِرنا بأن نطلي باللون الأبيض، من الأرض وحتى أعلى الأوراق، كل الأشجار في منطقة تدريبنا. العرّيف الذي نقل لنا الأمر كان متوترا واعتذاريّا. فيما بعد، مرّ بنا نقيب خارج الخدمة ورآنا، ملطخين بالأبيض ومرهقين تماما، اغتاظ من الأشكال الغريبة التي صنعناها. مضى وهو يسب ويلعن. لقد فهمت القاعدة (الأوامر هي الأوامر)، لكنني تساءلت: من يقرّر؟!
29 سبتمبر
أعجوبة هي سو آن. بالأمس، ركلت كاحلي بشراسة لأنني لم أنتبه لمحاولتها تمرير ملاحظة لي أثناء حصة التاريخ. مازال كاحلي متورما. لكن الآنسة مانديبل كانت تراقبني، ما كان بوسعي فعل شيء. من الغريب أن سو آن تذكرني بالزوجة التي كانت لديّ في دوري السابق، بينما تظهر الآنسة مانديبل كطفل. تراقبني بشكل مستمر، محاولة الحفاظ على المغزى الجنسي لنظراتها؛ أخشى من ملاحظة الأطفال الآخرين للأمر. لقد سمعت بالفعل، من الذبذبات الشبحية التي هي وسيلة اتصالات الفصل، هذه الكلمات “حيوان المعلمة الأليف!”
2 أكتوبر
في بعض الأوقات أتأمل الطبيعة الدقيقة للمؤامرة التي جاءت بي هنا. أحيانا أعتقد أنه تم التحريض عليها من قبل زوجتي في حياتي السابقة، والتي كان اسمها . . . أنا أتظاهر بالنسيان فقط. أعرف اسمها جيدا جدا، كما أعرف اسم زيت محرك سيارتي السابق (كويكراستيت) ورقمي التسلسلي في الجيش قديما (يو إس 54109268). كان اسمها بريندا، والمحادثة التي أذكرها أفضل من غيرها، تلك التي تجعلني مرتابا، حدثت يوم انفصالنا. “تمتلكين روح عاهرة” قلت حينها، لا أعني شيئا سوى الحقيقة الحرفية الواضحة. “أنت” ردت عليّ “ديّوثٌ، أحمقُ، وطفل. سأتركك للأبد، وأنا واثقة من أنك ستهلك بسبب نقائصك. وهي عظيمة!”
أتلوى غضبا في مكتبي كلما تذكرت هذه المحادثة، وتراقبني سو آن بشفقة خبيثة. لقد لاحظَت التفاوت بين حجم مكتبي وحجمي، لكن من الواضح أنها رأت في الأمر علامة على فتنتي، كوني الرجل الغامض وسط العالم العادي.
7 أكتوبر
مرة، مشيت على أطراف أصابعي تجاه مكتب الآنسة مانديبل (عندما لم يكن بالغرفة شخص آخر) وتفحصت سطحه. اكتشفت أن الآنسة مانديبل معلمة من أصحاب المكاتب النظيفة. لم يكن عليه شيء سوى دفتر الصفّ (وهو الذي أتواجد به كطالب في الصف السادس) وكتاب مفتوح على صفحة معنونة بــ جعل العمليات هادفة. أقرأ: ” كثير من التلاميذ يستمتعون بالعمل على الكسور حينما يفهمون ما يفعلون. يثقون بقدراتهم على اتباع الطرق الصحيحة للحصول على الإجابات السليمة. ومع ذلك، فلإعطاء العملية مفهوم اجتماعي كامل، من الضروري إيجاد العديد من المواقف الواقعية التي تتطلب استخدام العمليات. ينبغي حل مزيد من المسائل المثيرة والحياتية المشتملة على استخدام الكسور..”
8 أكتوبر
لست منزعجا من الشعور بأنني مررت بكل هذا من قبل. تتم تأدية الأمور بشكل مختلف الآن. الأطفال، أيضا، مختلفون من بعض النواحي عن الذين صاحبوني أثناء رحلتي الأولى خلال المدارس الابتدائية: “يثقون بقدراتهم على اتباع الطرق الصحيحة للحصول على الإجابات السليمة.” هذا حقيقي بالتأكيد. عندما يريد بوبي فاندربيلت، الذي يجلس خلفي ويملك الميزة التكتيكة العظيمة لأن يناور مختبئا خلف ظلي الكبير، أن يلكم زميلا له في فمه فإنه أولا يسأل الآنسة مانديبل أن تخفض الستارة قائلا إن الشمس تؤذي عينيه. وأثناء قيامها بهذا، بيب! لم يكن جيلي قادرا أبدا على خداع السلطة بهذه السهولة.
13 أكتوبر
ربما أنه في رحلتي الأولى خلال المدارس كنت أعتقد كثيرا أن ما تفرضه عليّ السلطة (من يقرر؟) هو الصحيح والمناسب، هذا لأنني خلطت ما بين السلطة والحياة نفسها. لم يكن طريقي، تحديدا، باختياري الخاص. مهنتي امتدت أمامي كمطاردة على الورق، وكان دوري أن أجمع خيوط الحل. حينما خرجت من المدرسة، أول مرة، وجدت أن هذا التخمين صحيح بالفعل، ودخلت المطاردة بحماس. وجدت خيوط الحل بوفرة: دبلومات، بطاقات عضوية، أزرار الدعاية للحملات، عقد زواج، استمارات التأمين، أوراق التسريح، كشوفات الضرائب، شهادات التقدير. ظهر أنها تثبت، على الأقل، أنني كنت في المضمار. لكن هذا كان قبل خطأي المأساوي في شكوى السيدة أنتون بيتشيت.
أخطأت في قراءة أحد الخيوط. لا تسيئوا فهمي: كانت مأساة فقط من وجهة نظر السلطات. تخيلت أن واجبي كان أن أحصل على تعويض للمصاب، لهذه السيدة العجوز (لم تكن حتى تحمل وثيقة تأمين، لكن مدعية ضد شركة بيج بين للنقل والتخزين) من الشركة. مبلغ التسوية كان 165,000 دولار؛ الشكوى، ما زلت أعتقد، كانت عادلة. لكن دون تشجيعي فإن السيدة بيتشيت ما كانت لتجد حب النفس الذي يجعلها تقدر مصيبتها عاليا هكذا. دفعت الشركة، لكن إيمانها بي، بفعاليتي في الدور، قد تحطم. هنري جوديكايند 5 ،مدير القسم، عبر عن رأيه في بضع كلمات ليست جميعها خالية من التعاطف، وأخبرني في ذات الوقت أنني سأحصل على دور جديد. ما عرفته تاليا هو أنني هنا، في هوراسغريلي الابتدائية، تحت عينيّ الأنسة مانديبل الشهوانيتين.
17 أكتوبر
اليوم سنقوم بعمل تدريب ضد الحريق. أنا أعرف هذا لأني مارشال حريق، ليس فقط لغرفتي ولكن للجناح الأيمن بكامله من الدور الثاني. هذا الامتيازالذي فزت به بعد وصولي بقليل، يفسره البعض بأنه إشارة أخرى لعلاقتي المشبوهة نوعا بمعلمتنا. شارتي، الحمراء والمزينة بحروف بيضاء بارزة تُقرأ حريق، موضوعة في الرف الصغير تحت مكتبي، إلى جانب الكيس الورقي البني المحتوي على الغداء الذي أصنعه لنفسي كل صباح. واحدة من مزايا إعداد غدائي بنفسي (ليس لدي من يعده لي) أنني أستطيع ملأه بالأشياء التي أحب. شطائر زبدة الفول السوداني التي كانت تعدّها أمي في وجودي السابق، منذ سنوات عديدة، تم نفيها الآن لصالح لحم الخنزير والجبن. قد اكتشفت أن نظامي الغذائي تكيف بشكل غامض مع وضعي الجديد؛ لم أعد أشرب الكحول على سبيل المثال، وعندما أدخن، ففي دورة مياه الأولاد، كما يفعل الجميع. وبعد انتهاء اليوم الدراسي نادرا ما أدخن. فقط فيما يتعلق بأمر الجنس أشعر بعمري الحقيقي؛ على ما يبدو هذا أمر إذا تعلمته لا تستطيع نسيانه أبدا. أحيا في خوف من أن الأنسة مانديبل ستبقيني يوما بعد المدرسة وعندما نكون وحدنا، ستصنع موقفا محرجا. ولتفادي هذا أصبحت تلميذا نموذجيا: سبب آخر للبغض اللفظي الذي واجهني في بعض الأوساط. لكنني لا أستطيع أن أنكر أن تلك النظرات الطويلة قرب السبورة تضرم فيّ النار؛ الآنسة مانديبل من نواح عديدة -بشكل ملحوظ على وشك الانفجار-قطعة شهية للغاية.
24 أكتوبر
هناك تحديات متفرقة لضخامتي، لموقفي المدرَك بشكل خافت في الفصل مثل جاليفر 6. أغلب زملائي مهذبون تجاه هذا الأمر، كما كانوا ليصبحوا لو كانت لدي عين واحدة أو قدمان هزيلتان ملفوفتان بالمعدن. يتم النظر إليّ كطفرة من نوع ما لكن بشكل أساسي كنظير لهم. ومع ذلك، فإن هاري برون، الذي تمكن أبوه من أن يصبح ثريا بتصنيع فتحات برون لتهوية الحمامات (والتي يتعرض بسببها هاري للسخرية مرارا، دائما ما يُسأل كيف الحال في مدينة الفتحات) سألني عما إذا كنت أرغب في القتال. مجموعة مهتمة من أتباعه تجمعت لتشهد هذا العمل الانتحاري. أجبته بأنني لم أكن أشعر بالرغبة في ذلك، وكان ممتنا بوضوح لهذا. نحن الآن أصدقاء للأبد. أفهمني على انفراد أنه سيجلب لي كل فتحات التهوية التي سأحتاج إليها بسعر تافه جدا.
25 أكتوبر
“ينبغي حل مزيد من المسائل المثيرة والحياتية المشتملة على استخدام الكسور..” المنظّرون يفشلون في إدراك أن كل ما هو مثير وحياتيّ في الفصل ينبع مما قد يطلقون عليه العلاقات الشخصية: سو آن براونلي تركل كاحلي. كم هو حياتي، كم هو نسائي، اعتناؤها الرقيق بعد هذا الفعل! فخرها بعرجي الذي اكتسبته حديثا واضح؛ الجميع يعرفون أنها قد وضعت علامتها عليّ، أنه نصر في كفاحها الغير متكافيء ضد الآنسة مانديبل لأجل الحصول على قلبي الكبير الناضج. حتى الآنسة مانديبل تعرف هذا، وتواجهه ربما بالطريقة الوحيدة التي تستطيعها؛ بالسخرية “هل أنت مجروح يا جوزيف؟!” تشتعل الحرائق خلف جفنيها، الشوق لمارشال الحريق يغشّي عينيها. أغمغم بأن قدمي تعثرت.
30 أكتوبر
أعود مجددا ومجددا لمشكلة مستقبلي.
4 نوفمبر
المكتبة السرية التي يتم تداولها جلبت لي نسخة من مجلة أسرار السينما والتليفزيون، الغلاف المتعدد الألوان مزين بالعنوان “موعد ديبي الغرامي يهين ليز!” إنها هدية من فرانكيراندولف، فتاة عادية نوعا ما لم توجه لي كلمة واحدة حتى اليوم، نُقلت عن طريق بوبي فاندربيلت. أومأتُ وابتسمتُ من فوق كتفي عرفانا، فخبأت فرانكي رأسها أسفل مكتبها. رأيت هذه المجلات يتم تبادلها بين الفتيات (أحيانا أحد الفتيان قد يتنازل ليتفحص غلافا مثيرا). الآنسة مانديبل تصادر هذه المجلات كلما وجدتها. أقّلب أوراق أسرار السينما والتليفزيون وأتفحصها مليا. “الصور الغير مسبوقة على هذه الصفحات ليست كما تبدو. نحن نعلم كيف تظهر وما الذي سيفعله النمامون. ولهذا من أجل صالح فتى لطيف، نحن ننشر الحقائق أولا. ها كم ما حدث فعلا!” تظهر الصور شابا، معبود سينمائي صاعد، يرتدي بيجاما وعيناهمرهقتان، بينما امرأة شابة تماثله في تشعث مظهره تبدو مشدوهة إلى جواره. أنا سعيد أن الصورة ليست كما تبدو؛ فهي لا تبدو إلا دليل إدانة في قضية طلاق.
ما الذي يفكر فيه ذوو الإحدى عشر عاما والمؤخرات المسطحة هؤلاء حين يمرون، في المجلة نفسها، بالإعلان الذي يحتل صفحة كاملة لــ موريس دو باري، المصدّر بــ “مساعديّ المؤخرة” أو ما يبدو كأنه أرداف مبطنة؟ (عميل متخفٍ حقيقي يشهد بفتنتها، الأفخاذ والمؤخرة، على السواء!) إذا لم يستطيعوا فك شفرات اللغة، فالرسوم التوضيحية لا تُبقي شيئا للخيال. “أثيري جنونه ..” يُكمل الإعلان. ربما هذا يفسر انشغال بوبي فاندربيلت بالــ لانسياس والـ مازيراتي 7؛ إنها محاولة دفاعية حتى لا يثار جنونه.
لاحظت سو آن محاولة فرانكيراندولف للبدء معي، فجذبت انتباهي، وأخرجت من حقيبتها ما لا يقل عن سبع عشرة مجلة من هذا النوع، دفعت بهم نحوي كما لتثبت لي أن أيَّ شيء تستطيع أيٌّ من منافساتها تقديمه، فإنها تستطيع التفوق عليه. أقلب فيهم سريعا ملاحظا الافتتاحيات العريضة:
“أطفال ديبي يبكون”
“إيدي يسأل ديبي: هل سوف .. ؟!”
“كوابيس ليز عن إيدي!”
“ما تستطيع ديبي أن تقوله بشأن إيدي”
“الحياة السرية لديبي وليز”
“هل ستستعيد ديبي رجلها؟”
“حياة جديدة من أجل ليز”
“الحب أمر خادع”
“عش حب إيدي ماركة تايلور”
“كيف صنعت ليز من إيدي رجلا”
“هل يخططان للعيش معا؟”
“ألم يحن الوقت للكف عن التعريض بإيدي؟”
“ورطة ديبي”
“إيدي يصبح أبا مجددا”
“هل تخطط ديبي للزواج ثانية؟”
“هل تستطيع ليز أن تحقق ذاتها؟”
“لماذا سئمت ديبي هوليوود؟”
مَن هؤلاء الناس، ديبي، إيدي، ليز، وكيف أوقعوا أنفسهم في هذه الورطة؟ سو آن تعرف، أنا متأكد؛ من الواضح أنها كانت تدرس تاريخهم كمرشد لما قد تتوقع حدوثه عندما تتحرر فجأة من حجرة الدرس المملة والمبتذلة هذه.
أنا غاضب، أعيد إليها المجلات دون همسة شكر حتى.
5 نوفمبر
الصف السادي في هوراسجريلي هو فرن للحب، الحب، الحب. إنها تمطر اليوم، لكن في الداخل الهواء ثقيل ومتوتر بفعل الشغف. سو آن متغيبة؛ أشك أن تبادل الأمس قد دفعها نحو السرير. الشعور بالذنب يحوّم حولي. إنها ليست مسئولة، أدرك هذا، عمّا تقرأ، عن النماذج المقدمة لها عن طريق صناعة نشر مرتشية؛ ما كان يجدر بي أن أقسو عليها هكذا. ربما هي مصابة بالإنفلونزا فقط.
لم أصادف مكانا مشحونا بالطاقة الجنسية المجهضة كهذا المكان. الآنسة مانديبل عاجزة؛ لا شيء يمضي في مساره الصحيح. آموس دارين تم اكتشافه وهو يرسم صورة فاحشة في حجرة المعاطف. ولأنها حزينة وغير دقيقة، تم تقديمها كعلامة على الحب نفسه ولا شيء سواه. أثارت حتى هؤلاء الذين لم يروها، حتى هؤلاء الذين رأوها وفهموا فقط أنها فاحشة. تطن الحجرة بدغدغة غير مفهومة تماما. آموس يقف جوار الباب، منتظرا أن يتم اصطحابه لمكتب المدير. يتردد ما بين الخوف والسرور لشهرته المؤقتة. من آن لآخر تنظر الآنسة مانديبل لي مؤنّبة، كأنما تلومني على هذا الهياج. لكنّي لم أخلق هذا الجو العام، أنا عالق فيه مثل الجميع.
8 نوفمبر
كل شيء موعود، لزملائي وأنا، أغلب المستقبل. نقبل الضمانات المستحيلة دون أن نرمش.
9 نوفمبر
وجدت الشجاعة أخيرا لكتابة التماس للحصول مكتب أكبر. أثناء الفسحة بالكاد أتمكن من المشي؛ قدميّ لا تبدو عليهما الرغبة في أن ينحلّا بعيدا عن بعضهما. تقول الآنسة مانديبل أنها سترفعه للمشرف. يقلقها حسن تعبيري. هل، تسأل، تمت مساعدتي في كتابته؟ وللحظة أوشك أن أخبرها بقصتي. ومع ذلك يحذرني شيء ما من أن أحاول ذلك. أنا آمن هنا، لدي مكان؛ لا أود أن أفوض أمر نفسي مجددا لنزوات السلطة. أعتزم أن أجعل تعبيري أقل جودة في المستقبل.
11 نوفمبر
زواج محَطَّم، مهنة تسوية محطَّمة، فصل إضافي كئيب في الجيش حيث لم أكن إنسانا تقريبا. هذا هو مجموع وجودي حتى الآن، حاصل محزن. لا عجب أن إعادة التكوين كانت هي أملي الوحيد. من الواضح حتى لي أنني أحتاج تجديدا بشكل جوهري. كم هو رائع هذا المجتمع الذي يوفر هذا لإنقاذ الفاشلين من أعضائه.
منتزعا من حياتي الغير المتفَحَصَة بين آخرين من الشباب الأمريكي البهيج المستميت لجمع المال، مقذوفا للخلف عبر المكان والزمان، أبدأ في فهم كيف أخطأت، كيف نخطيء جميعا. (بالرغم من أن هذا بعيد عن نية من أرسلوني هنا؛ إنهم يطلبون فقط أن أصبح ملائما.)
14 نوفمبر
أشعر أن التمييز ما بين الأطفال والبالغين، بينما هو مفيد لبعض الأغراض، إلا أنه في أساسه مزيف. إنهم فقط ذوات فردية، تسعى بجنون للحب.
15 نوفمبر
أخبرَ المشرفُ الآنسةَمانديبل أن مكاتبنا هي بالحجم المناسب لطلبة الصف السادس، كما حددته لجنة التقييم وأثثت المدارس بواسطة شركة نيو-آرت 8 للتوريدات المدرسية بـإنجليوود، كاليفورنيا. وأشار أنه إذا كان حجم المكتب مناسبا، فحجم التلميذ غير مناسب. الآنسة مانديبل، وقد توصلت لهذا الاستنتاج بالفعل، ترفض الضغط على الأمر أكثر. أظن أنني أعرف لماذا. فالتماس يقدم إلى الإدارة التعليمية ربما سيؤدي إلى إزالتي من الفصل، ونقلي لنوع من المنشآت الخاصة بـ “الأطفال الاستثنائيين). وهذه ستكون كارثة من العيار الثقيل. فالجلوس في حجرة من الأطفال العباقرة (أو الأكثر احتمالا، أطفال متأخرين) سيحطمني نفسيا خلا أسبوع واحد. فلتدع خبرتي هنا تكون من المدى الشائع، أقول، دعني أكون، أرجوك يا الله، نموذجيا.
20 نوفمبر
نحن نقرأ العلامات على أنها وعود. الآنسة مانديبل تستقبل طولي العظيم، صوتي الطنان، على أنني سأحملها ذات يوم إلى السرير. سو آن تفسر العلامات ذاتها على أنني فريد بين معارفها من الذكور، ولذلك المشتهى أكثر، وبالتالي ملكيتها الخاصة ككل شيء مشتهى أكثر. إذا لم تتحقق أي من هذه الافتراضات، فالحياة قد خانت ثقتهم.
أنا نفسي، في وجودي السابق، قرأت شعار الشركة (“هنا لنساعد وقت الضيق”) كوصف لواجب مسوّي النزاعات، مخطئا بشدة في تحديد أعمق مخاوف الشركة. اعتقدت أنه بحصولي على زوجة مصنوعة من علامات الزوجات (الجمال، السحر، النعومة، العطر، الطبخ) أنني قد وجدت الحب. بريندا، قرأت نفس العلامات التي تضلل الآن الآنسة مانديبل وسو آن براونلي، شعرت أنه تم إعطاؤها وعدا بأنها لن تملّ أبدا مجددا. جميعنا، الآنسة مانديبل، سو آن، أنا نفسي، بريندا، السيد جوديكايند، مازلنا نؤمن أن دلالات العلم الأمريكي هي طهارة أخلاقية عامة.
لكنني أقول، وأنا أفكر بأمري في هذه الحاضنة لإنتاج المواطنين المستقبليين، أن العلامات هي علامات، وأن بعضها كذب. هذا هو أعظم اكتشاف للوقت الذي قضيته هنا.
23 نوفمبر
يبدو أن خبرتي كطفل ستنقذني رغم كل شيء. إذا تمكنت فقط من أن أبقى هادئا في هذا الفصل، أدون ملاحظاتي بينما نابليون يكدح خلال روسيا بواسطة صوت هاري برون الطنانيقرأ من كتاب التاريخ. كل الألغاز التي حيرتني وأنا بالغ تكمن أصولها هنا، وواحدا فواحدا أرقمهم وأكشف جذورهم. الآنسة مانديبل سوف ترفض أن تدعني أظل غير بالغ. يداها تستريحان على كتفيّ بشكل حميمي للغاية، أطول من اللازم.
7 ديسمبر
إنها الوعود التي يقدمها لي هذا المكان، وعود لا يمكن الوفاء بها، والتي تربكني بعد ذلك وتجعلني أشعر بأنني لن أصل لأي اتجاه. كل شيء يُقدم كنتيجة لعملية معروفة؛ إذا أردت أن أحصل على أربعة فأنا أصل إليها عن طريق اثنين واثنين. إذا تمنيت أن أحرق موسكو فالطريق الذي ينبغي السفر فيه قد تم تحديده بواسطة زائر آخر. إذا، كبوبيفاندربيلت، أطمح للحصول على عجلة قيادة لانسيا 2,4-لتر ذات بابين، يجب عليَ أن أمر خلال العملية المناسبة، وهي الحصول على المال. وإذا كان المال نفسه هو رغبتي، عليّ فقط أن أحصل عليه. كل هذه الأهداف جميلة بشكل متساوٍ في نظر لجنة التقييم؛ الدليل في كل اتجاه حولنا، في القبح الذي لا يحمل أي تفاهة لهذا المبنى المصنوع من المعدن والزجاج، في خط الحقائق المستقيم الذي تعالج به الآنسة مانديبل بعض حروبنا الأقل في حسن السمعة. من يوضح أنه أحيانا بعض الترتيبات تخيب، أن الأخطاء تحدث، أن العلامات تُقرأ بشكل غير صحيح؟ “يثقون بقدراتهم على اتباع الطرق الصحيحة للحصول على الإجابات السليمة.” لقد اتبعت الطرق الصحيحة، حصلت على الإجابات السليمة، وزوجتي تركتني لأجل رجل آخر.
8 ديسمبر
عملية تنويري تمضي بشكل رائع.
9 ديسمبر
كارثة مرة أخرى. غدا سيرسلونني لطبيب من أجل الملاحظة. سو آن براونلي أمسكت بالآنسة مانديبل وأنا في غرفة المعاطف أثناء الفسحة، ساقا الآنسة مانديبل العاريتان متصالبتان حول خصري، وفقدت صوابها مباشرة. للحظة ظننت أنها ستختنق حقا. اندفعت من الحجرة وهي تبكي، مباشرة إلى مكتب المدير، ومتأكدة الآن أينا هي ديبي، ومن هو إيدي، ومن ليز. آسف لكوني سبب تحررها من الوهم، لكنني أعلم أنها ستتعافى قريبا. الآنسة مانديبل تحطمت، ولكنها محقَّقَة. بالرغم من أنها ستحاكم بتهمة المشاركة في جنوح قاصر، يبدو عليها الاطمئنان؛ تم الوفاء بوعودها. تدرك الآن أن كل ما أخبروها به عن الحياة، عن أمريكا، حقيقي.
حاولتُ إقناع سلطات المدرسة أنني قاصر بشكل خاص، أنني الملوم في الغالب — لكن لم يفد ذلك في شيء. إنهم بلداء كما هم أبدا. زملائي مذهولون من أنني أقدم نفسي بأي شكل خلاف الضحية البريئة. كالحرس القديم 9 ماضيا بين الأكوام الروسية، يمضي الفصل إلى الاستنتاج أن الحقيقة عِقاب.
بوبي فاندربيلت أعطاني نسخته من أصوات سيبرينج، أثناء الوداع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش المترجم:
1ـ الآنسة مانديبل: mandibleتعني الفكّ، إشارة إلى وظيفتها الكلامية في القصة كمعلمة.
2ـ Baritone : الجهير الاول:صوت رجالى اعلى من الجهير وأدنى من الصادح.
3ـ روند آند تراك: مجلة مهتمة بأمر سباقات السيارات، والسائقين، والسيارات نفسها.
4ـ ساوند أوف سيبرينج: هي تسجيلات لسباقات السيارات مع تعليقات عليها، محاورات مع أشهر السائقين، تُسمع فيها أصوات سيارات السباق .. تم إنتاجها في السنوات ما بين 1956 و1964 ما عدا عام 1963 5ـ..وسيبرينج مدينة في جنوب وسط مدينة فلوريدا، مشهورة بإقامة سباقات السيارات.
Goodykindـ : اسمه يعني ذي النوع الجيد، إشارة لأنه النموذج المراد اتباعه في الشركة والمجتمع.
6ـ جاليفر: بطل رواية جوناثان سويفت “رحلات جاليفر” في أحد أجزائها يصل البطل إلى جزيرة أهلها صغار جدا، فيبدو بينهم عملاقا.
7-أنواع سيارات.
8-نيوآرت: Nu-Art ..Nu كلمة يديشية (لغة عبارة عن مزيج من الألمانية والعبرية والعديد من اللغات الحديثة، كانت خاصة باليهود في وسط أوروبا وشرقها قبل الحرب العالمية الثانية، والآن تستخدم بواسطتهم في أمريكا، فلسطين، روسيا) وهي تعني well وتنطق مثل كلمة new..وهي لهذا في الإنجليزية تستفيد من المعنيين: الجودة والجدة.
9- الحرس القديم: هم نخبة جيش نابليون وصفوته المختارة.