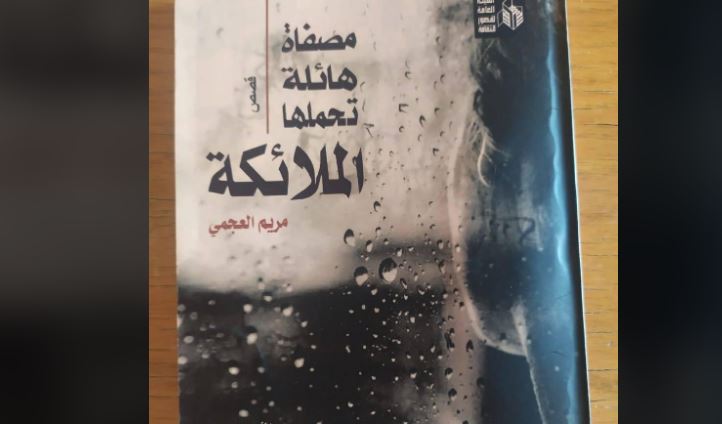محمد فرحات
كان يستيقظ كل صباح كمن يسحب نفسه ثقيلًا من حفرة عميقة لا قرار لها. ينهض ببطء، يتحسس ندبة الخرطوش العميقة عند كتفه، ثم يضغط على صدره براحتِه ليتأكد أن رئتَه ما زالت تعمل… ولو بالكاد.
كل نفسٍ يأخذه يذكّره بيوم الركض في الشوارع وسط الدخان الرمادي، يوم ابتلع الغاز حتى ظن أن رئتَه ستنطفئ.
يجر جسده الثقيل إلى وظيفته القديمة؛ ذات المكتب المعدني البارد، وذات المروحة التي تدور كعجوز تتنهّد، وذات المدير الذي كان يحذّره أيام الثورة من «وجع الدماغ».
لكن العجيب أن الرجل نفسه صار الآن من أشد المدافعين عن «مكاسب الثورة»، ويفاخر بصورته مع المسؤول الجديد الذي كان بالأمس من ألد أعدائها.
نفس المكتب، نفس الكرسي الخشبي المائل ذي الأرجل الأربع إلا قليلًا، نفس الروائح العالقة منذ عشر سنوات… كأن المكان نفسه يرفض أن يعترف بأن ثورة مرّت من هنا يومًا.
زملاؤه الذين لم يشاركوا في شيء صاروا الآن يرفعون رؤوسهم ويتحدثون بثقة جديدة؛ أحدهم صار مديرًا، وآخر أصبح مستشارًا، وثالث يفاخر بأن «البلد اتغيرت». كلهم ركبوا الموجة في اللحظة العبقرية المناسبة.
وكان يبتسم لهم بصمت… ابتسامة شخص يعرف أن البلد لم تتغير، ولا هم… ولا هو.
في المساء، بعد أن انتهى من عمله الثاني محاسبًا في أحد الأفران، عاد إلى البيت، فوجد أباه جالسًا أمام الشاشة، يرصد الوجوه الجديدة، يعرفها جيدًا؛ فهم كانوا رفاق ابنه ذات يوم، لطالما سهروا معه حتى الصبح. كان يحرك مسبحته ببطء.
ما إن رآه حتى تحدث بذات الحديث والنبرة والسخرية التي يعرفها جيدًا:
— كل يوم يا خويا مظاهرات وضرب وخبط وسجن… وفي الآخر؟
هم خدوا المناصب والفلوس، وإنت زي ما إنت.
يا ابني ما عمره الـ… ما نفع نفسه.
إنت كنت فاكر نفسك هتبقى إيه يعني؟ ها؟
خيّبان زي أمك، الله يرحمها بقى؟
كان يسمع، ويهز رأسه، ولا يرد.
لم تعد لديه قوة للشرح، ولا رغبة في الدفاع عن شيء لم يعد متأكدًا منه.
في تلك الليلة، جلس في غرفته. وضع الكأس والزجاجة أمامه، على المكتب الذي ورثه عن أمه هدية نجاحه المبهر في الثانوية العامة:
«كلية اقتصاد وسياسة وتبقى سفير يا حبيبي»
لكن كشف الخلفية الاجتماعية اللعين أحاله إلى موظف في أرشيف الوزارة. ملأ الكأس عن آخرها، وترك الشراب يفيض على مهل، مغادرًا حدود وجود كأسه.
لم يفكر كثيرًا.
لم يسأل نفسه أية أسئلة.
كان التعب أقدم من السؤال… وأثقل من التفكير.
شرب بهدوء.
ثم تمدد على السرير، وترك ذراعيه بجانبه.
كانت هناك راحة غريبة في السكون، راحة لم يشعر بها منذ سنوات.
ظل مستلقيًا.. لا يحرك ساكنًا…