حاوره: خالد النجار
أجري الحواران في بيت يانيس ريتسوس بشارع كوراكا في ضاحية أثينا
**
الحوار الأول
بنضاله سيلتقي الفلسطيني ببلاده وبيته وسمائه وأشجاره وأغانيه
أثينا أم بيروت؟ وأنت تتطلّع إليها من فوق ربوة الأكروبوليس، بين شجيرات الزّان والكاليتوس والحجارة التي خلّفتها الآلهة الضائعة، تعيد السؤال أهي أثينا أم بيروت؟ هذه المدينة الممتدّة من تحتك حتّى الأفق المضيء؛ مدينة مضيئة، ساطعة سطوع المتوسّط؛ مفتوحة، كتوم ومزدحمة. أثينا بأديرتها ذات الجدران البيضاء المطلة على البحر، قلت في نفسي هنا يبدأ الشّرق بالسّيارات الصّفراء وبالقهوة التّركيّة، أين يونان فيثاغورس الصوفي وهيراقليطس الغامض وبوزيدون إله البحر؟ وأبولون الصّاعد من جزيرة ديلوس؟ وأريثوزا إلهة الينابيع… أين هي اليونان التّاريخية، اليونان الحسيّة الوثنية؟ غدا سألتقي ريتسوس وسأطرح عليه كلّ هذه الأسئلة المتعلّقة بالعالم الكلاسيكي الذي اقترنت به اليونان في ذهني، عالم التّراجيديات، والآلهة والميثولوجيا والعقل السّاطع والمذاهب السّرّية والصّوفية، من هرمسيّة1 وغيرها، التي غذت العالم القديم، وما تزال امتداداتها حتّى الآن في الغرب. وهكذا كان الأمر، تلفنت إلى يانيس ريتسوس عند الظّهيرة. كنت أحمل إليه رسالة من صديقي وصديقه الشّاعر لوران غسبار. وجاءني صوته في الهاتف فرحا وبهيّا ومتخما بتجارب السّنين، أو هكذا بدا لي. قال: هل لديك ما يشغلك غدا بعد الظهر؟ قلت ليس لديّ ما يشغلني، فأنا جئت لأراك؛ قال تعال إذن. حزمت أمري بسرعة وذهبت إليه. اللّقاء الأوّل يحدّد كلّ المسارات اللاّحقة للعلاقة الإنسانية. وجدت ريتسوس الإنسان بسيطا، وشاسعا، ويوميا كقصائده. دخلت شقة تكتظّ بالنّحوت والكتب واللّوحات الفنية. أراني منحوتاته، وأراني نافذته. قال: أحبّ الجلوس هنا في مواجهة جبل البرناسوس الشّهير، وأشار إليه بيده في الهواء وعقّب: هو هناك، أنت لا تراه، هناك غيوم تخفيه. قلت في نفسي ها هو جبل البرناسوس الذي قرأت عنه في الكتب موطن الإله أبولون وعرائس الشّعر، ها هو الجبل الذي تسمّت باسمه حركة البرناس الفرنسية في آخر القرن التاسع عشر، بعد لحظة سمعنا دقّات جرس مدرسي. جرس ملأ طفولاتنا وصخب غطّى هذه الأجواء الإغريقية. سألني عن تونس وعن صديقنا لوران غسبار. ابتسم للحظة متذكرا. ثم أنتقل بنا الحديث إلى الشّعر اليوناني الحديث. وبدأ يتكلّم عن مؤسّس الحداثة في الشّعر اليوناني قسطنطين كافافيس، قال: لغة كفافي خليط من اليونانيّة القديمة ومن اللّهجة الشّعبيّة اليوميّة اللاّيكية أي المادية، وهذا الأمر يتوافق بشكل مطلق مع جانبي شخصيته وهما: الجانب العشقي الإيروسي من جهة، والحسّ التّاريخي من جهة أخرى؛ وقد تمكّن كفافي من إيجاد توازن خارق بينهما. نجده أيضا يحافظ على تلك الشّعلة وعلى ذاك الاندفاع الإيروسي بنوع من اليقظة الفكريّة. وهكذا تتحول معاناته الخاصة، يتحوّل ما هو شخصيّ لديه إلى حسّ عام شبيه بالحسّ الدّيني، حسّ يتجاوز ذات الشاعر أناه، ويرتبط بالكونيّ. إنّه أستاذ معلم كبير. وقد تجنّب بكثير من التحكّم والاتقان الجمالي التّفخيم العاطفي والبلاغي؛ لقد قدّم أفكارا كبيرة بنبرة بسيطة جدّا، نبرة نبيلة ويوميّة. ولذالك، فإنّ كلّ شعراء اليونان الذين جاؤوا من بعده أخذوا عنه أشياء كثيرة لصالح الشّعر.

▪ خالد النجار: إذن جاءك من كفافيس هذا الانعطاف الشّعري على أشياء العالم اليوميّة والحميميّة، هذا الحضور الطقسيّ للتفاصيل النّهارية في قصيدتك؟
▪ يانيس ريتسوس: ربّما جاءتني منه هذه البساطة وتلك النّبرة اليوميّة، وأشياء الحياة الألفوية التي تجدها في شعري؛ ولكنّ إشكاليتي تختلف عن إشكالية كافافيس، وبشكل جذري؛ فهي لم تكن أبدا فرديّة ولكن عالمية وبطبيعة الحال اجتماعيّة؛ لأنّي أعتقد أن الشّعر الحقيقي يقع في مكان تقاطع الذّاتي مع الموضوعي؛ وليس هذا فقط، فالشّعر هو أيضا معاناة أبديّة مع الكلمة. ونحن لا نستطيع إرسال أيّ حكم جازم على جمالية الشّعر، معتمدين على العلوم الاجتماعيّة لأنّه يجب ألا ننسى أن الشّاعر لا يتعاطى فقط مع الأشياء العابرة والمتغيّرة، ولكن، وفي الآن نفسه، يهتمّ بالأبدي: بالثوابت، أي بما يظلّ عصيّا عن التّغيير رغم تبدل النّظم الاجتماعيّة.
▪ خالد النجار: ثمّة في شعرك مواجهة وتصدّ لقضايا عصرك الملحّة، فأنت على النّقيض من كفافي الذي عاش هامشيّا وصامتا وغير مبال بقضايا عصره، حتّى أن شعره لم يخرج عن دائرة أصدقائه إلا فيما ندر. هل جاءك هذا من انتمائك الأيديولوجي، أي من خارج الشّعر؟
▪ يانيس ريتسوس: الفن الحقيقي لا يكون هامشيّا؛ أعود إلى قسطنطين كفافيس؛ كما قلت لك سابقا لغة كفافيس مزيج من اليونانيّة القديمة ومن اللّغة اليوميّة الشّعبيّة اللاّيكية2 الحديثة، وهذا يتوافق مع جانبي شخصيّته؛ مع أهوائه العشقية من ناحية، ومع حسّه باللّحظات الباهرة في الماضي الإغريقي من ناحية أخرى، وقد توصّل من خلال هذا المزج إلى معادلة لغوية رائعة؛ كما تحكّم كفافيس في اندفاعه العاطفي، وما يظهر أوّل الأمر عنده من انعطاف على الذّاتي، أي ما هو تجربة خاصة، يتحوّل لديه إلى حسّ ديني جماعي يتجاوز الفرد ليتواصل ويرتبط بالعام؛ لقد تجنّب، وبكثير من الحذر العاطفية السّهلة والبلاغة الفضفاضة؛ وقدّم أفكارا كبيرة بنبرة بسيطة، نبرة نبيلة ويومية، ولأجل هذا فإنّ كلّ الشّعراء اليونانيّين كما قلت تعلّموا منه أشياء كثيرة؛ أمّا بالنّسبة لي، فعلى الشّاعر أن يكون في قلب اهتمامات العالم؛ الفن الحقيقي لا يمكن أن يظلّ مُهمّشا، لابدّ أن يأتي اليوم الذي يضيء فيه العمل الفني شعبا وبلادا. الفنّان ليس إنسانا هامشيا أبدا، مهما بدا ذلك، فهمومه تقع في مركز اهتمامات العالم؛ فإذا كان ما يكتبه يهمّ العالم فإنّ العالم بدوره سيهتم به حتّى ولو تأخّر الزّمن، لأنّه، وفي قصيدة الشّاعر الحقيقي يتعرّف العالم على وجهه الحقيقي؛ ويكون الاعتراف بالشّاعر بقدر ما يتعرّف العالم على وجهه في هذا الشّعر؛ وقد تكون الصّورة قريبة أو بعيدة الشّبه. لقد لاحظ علماء الاجتماع، ومنذ زمن، أن الفنّانين هم معماريو الرّوح الإنساني وقد أثبت آخرون، وعلى نطاق واسع، أن الشّعراء هم الذين يشكّلون المشاعر الاجتماعيّة، وأرى أن ذلك صحيحا، وهنا تأتي مسؤوليتنا نحن الشّعراء لتنظيم هذه المشاعر، حتّى تجيء اللّحظة التي يسود فيها الإخاء والسّلم العالميين.
▪ خالد النجار: عرفنا ريتسوس الشّاعر من خلال ما نقل من أعمالك إلى الفرنسية، ولكن حدّثني صديقك بسيكاريس النّاقد الأدبي في صحيفة ايثنوس أنك ناثر أيضا، وأنّك مترجم نقلت كثيرا من الشّعر العالمي إلى اليونانيّة ما يعني أنّك من أكثر أبناء جيلك نشاطا. ماذا تقول عن أعمالك الأخرى، ولماذا تخفي ريتسوس الروائي والمترجم وراء الشّاعر الذي ملأ المشهد؟
▪ يانيس ريتسوس: لأنّ اكتمال الإنسان يتحقق في الشّاعر. والمثال لدي هو هوميروس ورغم أني عجوز، ريتسوس في في العقد الثامن من عمره فقد نشرت في السّنة الماضية كتابا شعريّا بعنوان إيروتيكا EROTICA عشق، مقاطع في الحبّ. كما نشرت كتابا نثريّا له قصّة غريبة وعنوانه الأرسطو النّبيه يروي لحظات من يقظته ونومه” كتبته سنة 1942 أثناء الاحتلال النّازي، وطبع سنة اثنين وسبعين وتسعمائة وألف، أي بعد أربعين سنة؛ كما ترجمت أشعارا كثيرة إلى اليونانيّة لم أنشر بعضها لأني لم أتممها، وأنا لا أريد أن أنشر أعمالا مبتورة. لقد ترجمت أشعارا من بول ايلوار ومايكوفسكي وناظم حكمت واسكندر بلوك وسيرغي يسينِن، كما نقلت أنطولوجيا أي مختارات من الشّعر التّشيكي وأخرى من الشّعر الرّوماني نسبة إلى رومانيا، وكتابا شعريّا للكاتب السوفياتي الكسيس تولستوي الذي كتب رواية دروب الحريّة وليس مؤلف رواية الحرب والسلم. في الفترة التي كتبت فيها الأرسطو النبيه، أنجزت رواية تقع في أكثر من ألف صفحة عنوانها في سفح الصّمت”. لقد حرقوا اثني عشر عملا أدبيّا من مخطوطاتي أيّام الاحتلال النّازي، ونجت من النار الكتابة الأولى من رواية الأرسطو النبيه التي قدمتها أخيرا للطبع. كتاب EROTICA إيروتيكا هو آخر ما صدر لي، وقد بيعت من هذه المجموعة الشعرية ثلاث آلاف نسخة في شهر واحد؛ كما أرسلت دور النّشر الألمانية الشّرقية والغربيّة تطلب حقوق التّرجمة. كذلك تلقيت طلبا من دار لافون الفرنسية؛ هذه السّنة أنجزت كتابا شعريّا عنوانه الإيماء بالمرافق، وأعني به تلك الحركة الخفيّة التي ننبه بها بعضنا بعضا إلى الأشياء الجميلة.
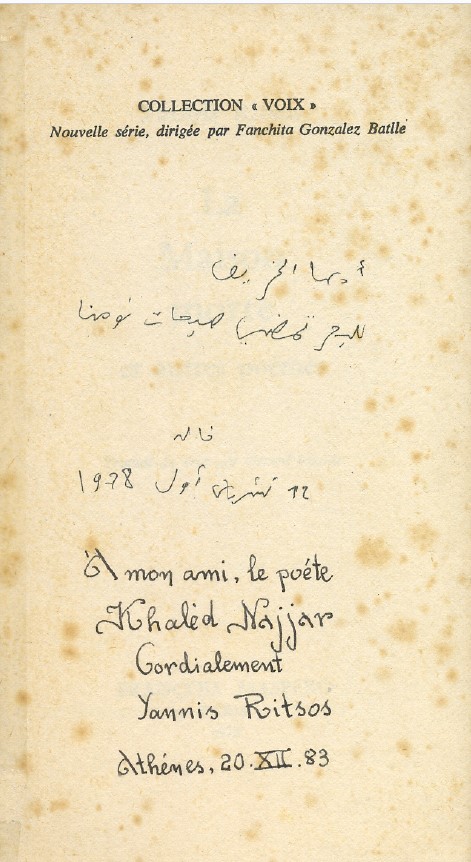
▪ خالد النجار: ثمّة جمال حسّي في قصائدك، تتالي الصّور مادية عارية؛ صور الإسطبلات اللّيليّة، الحجارة، الجبال ذات الجروح، والأصوات، و”نجمة الصّيف ذاتها التي تبكي أمام يديك المدانتين”. ألا تخاف هذا الجمال الذي قال عنه مرّة راينر ماريا ريلكة في مفتتح النشيد الأول من مراثي دوينو بأنّه ليس سوى بداية الرّعب؟
Car le beau n’est que le commencement du terrible
▪ يانيس ريتسوس: الانصعاق والرّعب هما سعادتي، لا أريد أن أعيش دون هذا الرّعب؛ ولكن ثمّة فرق بين الحبّ والجمال، في الجمال نريد مشاركة الآخرين، لا نتحمّل معايشة اللّحظة وحدنا؛ نومئ لمن بجانبنا حتّى يشاركنا الإعجاب بما نرى؛ وهذا هو ما قَصدته من وراء العنوان: الإيماء بالمرافق.
▪ خالد النجار: نعود إلى الشّعر، إلى هذا السرّ المفتوح الذي أسمّيه القصيدة، إلى هذه اللّغة النّادرة داخل اللّغة ما الذي يؤسّس القصيدة؟
▪ انيس ريتسوس: هناك عوامل كثيرة، كثيرة جدّا، عوامل غامضة وغير محدّدة تؤسّس القصيدة، عوامل لا نكاد نحدّدها أو حتّى نلاحظها. لذلك فكلّ تعريف للقصيدة هو خاطئ بالضرورة لأنّ العمل الشّعري يظلّ متعاليا عن كلّ تعريف؛ ومن جهة أخرى نحن لا نستطيع أن نقيّم القصيدة من خلال ما تقوله، ولكن من خلال ما تكونه؛ القصيدة الحقيقيّة تحرّك في القارئ طاقته الذّاتية الخلاّقة، ولا يعني ذلك أن يغترب في القصيدة أو يقلّدها؛ وهذا نوع من تقييم الشّعر باعتبار فعله في القارئ، للقصيدة ألف وجه، وثمّة في عمقها شيء يستعصى عن الفهم ويمنح النقّاد تفاسير متعدّدة ومختلفة، كلّ واحد منها ينطبق على وجه من وجوه القصيدة، بيد أنّ كلّ هذه التّفسيرات مجتمعة هي عاجزة عن استنفاد قصيدة حقيقيّة، لأنّه كما أن الشّعر يحتوي على المعلوم فهو يحتوي أيضا على قدر من المجهول.
▪ خالد النجار: ما هو مدخلك إلى هذه القصيدة؟ كيف تذهب إلى ذاك الصّيد اللّيليّ، كما يصفه غارسيا لوركا؟
▪ يانيس ريتسوس: هناك ألف طريقة، ولي ألف مدخل، ليست لدي وسيلة محدّدة، ولا لحظة محدّدة للكتابة. لحظة التيقّظ هي لحظة انفتاحي على الشّعر؛ وذاك احتمال كلّ لحظة، لأنّه لا توجد برهة خاوية في الحياة، وهنا تنشأ المعضلة. كلّ لحظة شاسعة، وهي تحتمل في الآن أحلامنا ورغائبنا وذكرياتنا وأفكارنا ومشاعرنا وحساباتنا اليوميّة البسيطة، قد تحتمل ظهور أغنية منسيّة في الدّاخل؛ اللّحظة كثافة حيوات وأزمنة، والشّاعر هو الذي يقول هذه اللّحظة التي هي الموازي لكلّ الحياة. لأجل هذا ليس لديّ لحظات شعريّة مختارة؛ فأنا أشتغل في كلّ وقت، في الظهيرة وفي اللّيل وعند الغروب وفي الصّباح. خوفي هو أن تغيب نجمة عن قصيدتي، أن تفلت مني إشارة إنسانية صغيرة، فأنا أريد أن أَقبض على كلّ شيء في اللّحظة.
▪ خالد النجار: لماذا تحاذي الحجارة لديك الكلمة؟ من أين أتاك هذا الوله بالحجر؟ ماذا تعني لك كلّ الحجارة والنّحت؟
▪ يانيس ريتسوس: عندما كنت في المنفى لم تكن لدي وسيلة أُخرى أعبّر بها سوى الحجر. الحجر مادّة الأرض الأساسية؛ ثم هو أيضا رمز الانغلاق والصّلابة. يجب ألاّ ننسى مولمفاسيا قريتي، وهي صخرة مرمية في البحر؛ كنت أريتك قبل لحظات صورة قريتي، إنّها رأس حاد وسط امتدادات البحر الرّخو، البحر الدائم الحركة؛ لأنّه أيضا من الصّخر ومن الرّخام قدّت التّماثيل البهيّة لليونان القديمة، تلك التّماثيل التي مجّدت جمال الجسد والوجه الإنساني، حتّى أننا نشعر بالرّغبة في ممارسة الحبّ مع تلك التّماثيل؛ وشعري يكتظّ بالتّماثيل وكلّ صوري على الحجر كما ترى أجساد ووجوه بشريّة.
▪ خالد النجار: بماذا تشعر بعد كلّ هذه الأيّام المليئة بالقصائد وأعمال النّحت والنضالات والمنافي والجزر. أيّ لحظة روحيّة تعبر الآن؟
▪ يانيس ريتسوس: أحسّ بأني ما أزال طفلا يافعا وفي الآن أن عمري يمتد إلى ملايين السّنين؛ أنا شيخ فتيّ وطفل عجوز؛ فأنا أغنى بما أفقد، وكلّ عام يمرّ أزداد فيه فتوّة بما أكسب، أي بما أفقد؛ أذكر، عندما كنت في الثّالثة والعشرين كتبت قصيدة افتتاحية موسيقية لأجل الضّوء العاري، من مقاطعها:
كلّ صباح أستيقظ وأرى من خلال النّافذة المفتوحة السّماء المزهرة تتمرأى في البحر. أشعر بأني أبديّة أصغر من البارحة.
الآن، وبعد هذه الأعوام الطّويلة تستطيع أن تدرك كم من الأبديات أحمل فوق أكتافي وفي جسدي وروحي. لقد عبرت موتات كثيرة وسأموت أخيرا وأنا أنطوي على بعض الأبديّة.
▪ خالد النجار: هل أنت حزين؟
▪ يانيس ريتسوس : أنا دائما حزين بشكل فرح، وسعيد بشكل محزن. الحزن والفرح محرضان على الابداع؛ أحيانا، يمنحني الحزن أكثر مما يعطيني الفرح. الإحساس بالدّخول في طقس الخلق هو أكبر فرح، إنّه الإبداع، والإبداع ليس فرحا فرديًّا، هو فرح أعيشه ثم أمنحه للجميع من خلال شعري.
▪ خالد النجار: إمكانيّة غياب الطبقات أليس يوطوبيا وحلم هذا القرن العشرين؟ كثيرا ما نقرأ عن عداء الفن للطبقيّة. أنت ماذا تقول عن هذا السّلب، وعن هذا الخسران القائم في حياة النّاس والذي اسمه الطبقيّة؟ هل هو قدر تاريخنا؟
▪ يانيس ريتسوس: الفعل الشّعري فعل اختراق طبقي. الفن هو التحقق اللّحظوي لهذا الغياب. أجل، لقد حقّق الشّاعر في حلمه وشعره غياب الطبقات الاجتماعيّة. في قصيدة أهديتها إلى الشّاعر الشيلي بابلو نيرودا قلت:
العبءُ الأكثر ثقلا هو هذا الضّوء الذي لا نستطيع أن نضيفه للشفق. إنّه الأزرق اللاّطبقي.
▪ خالد النجار: إلى جنب الشّاعر هناك أيضا ريتسوس المناضل الذي عانى السّجن وواجه النّازية ونظام العقداء بشجاعة الإنسان. ماذا تقول عن هذه التجربة؟
▪ يانيس ريتسوس: أحسّ بالامتنان إزاء كلّ ما اعترضني في حياتي من آلام؛ وحتّى الأمراض أيضا. لقد قضيت ثمانية أعوام في السّجون؛ تجربة السّجن خارقة للعادة؛ هناك، في الحياة العاديّة، نستطيع أن نختار بحرية الأصدقاء والنّاس الذين نتعامل معهم وذلك من خلال مقاييسنا التفضيلية، ولكن في السّجن نلقى آلاف الأشخاص الذين ما كنّا لنصادفهم في الحياة العادية؛ قد تلتقي بشرا يشاركونك أيديولوجيتك وأهدافك النضالية؛ ولكن تجدهم في الآن نفسه مختلفين عنك في الرؤيا والحساسية والمسلكية، ووقتها تطفو على السّطح تناقضات ومماحكات كثيرة، والتناقضات توقظ فينا قوى ملتبسة وغامضة؛ وتجد نفسك مرغما على الوصول عبر هذه التناقضات، وعبر عزلة كلّ واحد، إلى مكان لقاء يتواصل فيه الكلّ متجاوزين اختلافاتهم. وهكذا تكتشف أخيرا، وفي العمق عمقا آخر هو التشابه، وتحسّ بشعور غامر بالتواصل مع العالم.
▪ خالد النجار: أنت كشاعر، كيف عشت تمايزك مع السياسي خاصة لدى معاشرتكما في السّجن؟
▪ يانيس ريتسوس: على السياسي أن يواجه الزّمن لحظة بلحظة وبحس كبير من المسؤولية، بينما للشاعر فسحة أوسع أمامه، أمامه كلّ الزّمن، كلّ الفصول؛ تذكّر ما قلناه قبل لحظات من أن الشّعراء هم معماريو الرّوح الإنساني وليسوا صانعي اللّحظة العابرة، ولا تنس أيضا أنّنا إذا ما فقدنا شيئا، أيّ شيء كان، فإنّنا نحصل بغيابه على قيمته ودلالته، وبالحصول على القيمة والدلالة نكون قد ربحنا أضعاف ما فقدنا. نحن لا نرى في زنزانة السّجن المعتمة السّماء والبحر والأشجار والنساء، ولكننا نرى في أعماقنا وعيوننا مغمضة وأجسادنا معذّبة؛ نرى ضوء الأشياء الحقيقيّ، جوهرها، ونحبّها بشكل أعنف، ويتسلّل ذلك الضّوء الذي عانيناه في الدّاخل إلى قصائدنا؛ إنّه أملنا وأمل الآخرين، إنّه موقفنا الإنساني الذي يساهم في تطوير الحياة. أعمالنا ونضالاتنا ليست باطلة لأن الإنسان لا يستطيع أن يناضل لأجل لا شيء؛ لذلك ففي الشّعر الحقيقي توجد قوّة اجتماعيّة وتاريخية مستمرّة.
▪ خالد النجار: كنتَ حدّثتني عن لغة كفافي التّراثية، أنت، كيف تعاملت مع اللّغة اليونانيّة القديمة لغة هوميروس وسقراط وأفلاطون ومع التّراث عموما؟ وكما هو الشّأن لدينا نحن العرب، لنا لغة تمتد على أكثر من خمسة عشر قرنا وتفرض تعاملا ما معها؛ والماضي ليس دائما شيئا نحسد عليه، قد يكون كذلك عائقا، أن تكتب بلغة قديمة تجمّدت ولم تعد تعبّر عن تجاربك ومشاغلك الحديثة فتلك معضلة؟
▪ يانيس ريتسوس: عندما نقول كفافي كتب بلغة هي مزيج من اليونانيّة القديمة والحديثة لا نقصد بالقديمة لغة هوميروس وأفلاطون. اللّغة القديمة بالنسبة إلى عصر كفافي هي اليونانيّة التي كانت سائدة بين المثقّفين قبل قرن أو أكثر وتسمّى كاثاريفوزا في مقابل اللّغة الشّعبيّة التي أكتب بها والتي تسمى ديموتيك وقد تحتوي ألفاظا قديمة. مثلا عندنا مرادفان للدلالة على الصّيف، لغة الدّيموتيك ثرية وحية لأنّها تشمل المشاعر والرغبات والأعماق الدفينة للشعب، هذه الحيوية الشّعبيّة جعلتها مهيأة لاستقبال التجارب الشّعريّة الحديثة. لقد منعنا الاستعمار التّركي وعلى امتداد قرون من تداول لغتنا في المؤسسات الدّينيّة وفي المدارس، لذلك فلغتنا أكثر حيوية لأنّه لم تحفظها القواميس، وإنّما حفظتها الأغنية الشّعبيّة وضرورات الحياة اليوميّة، أي التجربة الحيّة. الشّعب حافظ على التقاليد الشّعبيّة من خلال حاجاته، غنّى بها وجوده وحياته اليوميّة؛ لذلك فأنت تجد في الأغاني الشّعبيّة كلّ تجربته الحضارية وتاريخه وأحاسيسه الوطنية وتوقه للتحرر، وهذه الأغاني بدورها دفعته إلى النّضال لاسترجاع حريته.
▪ خالد النجار: هذا عن اللّغة القديمة ماذا عن التّراث اليوناني؟ كيف تعاملت مع هذا التّراث؟ فالسؤال التّراثي بالمقارنة مازال قائما عندنا والجدال قائم حوله؟
▪ يانيس ريتسوس: طُرح كثيرا عندنا سؤال الماضي هذا؛ وهو كيف نُنجز أعمالا خليقة بهذا الماضي الإغريقي العظيم؛ كانت الإجابة بالنسبة للبعض كالتالي: الماضي تجربة عظيمة مضت ولا سبيل إلى تكرارها، ولكن هذا الماضي محرض على النهوض؛ وقد كتبت قصيدة أقول من خلالها موقفي من الماضي الإغريقي وهي بعنوان مسرح قديم؛ وتتحدّث القصيدة عن مراهق يجد نفسه في قلب مسرح إغريقي أثري، مراهق يعيش اليوم ولكنّه جميل كالأسلاف. وهذا المراهق يطلق صرخة عالية ليس حبّا بالصراخ، ربّما أحسّ بلذّة وهو يصرخ، ولكن وببساطة شديدة حتّى يسمع رجع صوته، ورددت الجبال في الجوار صدى الصّرخة: هاه، هاه؛ إنّه الصّدى الإغريقي الذي لا يكرر ولا يقلد وإنّما يستمرّ، معنى ذلك أن الشّعراء اليونانيين اليوم يواصلون تلك الصّرخة القديمة.
▪ خالد النجار: ماذا تعرف عن الشّعر العربي؟
▪ يانيس ريتسوس: مع الأسف لا أعرف الكثير من شعرائكم، قرأت أخيرا لثلاثة شعراء عرب مُهمّين من بينهم محمود درويش الذي التقيته هنا في أثينا. قال عندما رآني: أنا تعلمت منك أشياء كثيرة. ثم قرأ قصيدة من شعري كان نقلها إلى العربيّة. الشّعر الذي قرأته للعرب مُهمّ وفيه اندفاع قويّ نحو الحريّة وبوسائل تعبيرية متقدمة جدّا. ما قرأته هنا وهناك مترجما إلى الفرنسية أو الانجليزيّة أعطاني الإحساس بأن الشّاعر العربي حافظ أكثر من زميله الغربي على التواصل المباشر والحسّي مع الطبيعة؛ مع الأشجار والأرض والغيوم والأوراق والنّوافذ والشّوارع، وله علاقة كُليّة بالألوان والأشكال والموسيقى، من هنا تنبثق إنسانيّة هذا الشّعر، من تعلقه بالجمال الحسيّ والجسدي لأنّ وسيلة أي شاعر في تواصله مع الزّمن والأبديّة، إنّما هو الحبّ لأن الحبّ ملك الشّعر الذي ليس له ملك سواه.
▪ خالد النجار: الشّعر، هو أيضا مدخل أو بوّابة ملكيّة لمعرفة روح الشّعوب. كيف يتبدّى لك العرب إذن؟
▪ يانيس ريتسوس: أنا أحبّ العرب، وأساهم في نضالهم؛ وكلّ من عرفت منهم حتّى هذه اللّحظات كانوا أناسا منفتحين ومنفعلين بالعالم وممتلئين حيويّة.
▪ خالد النجار: قلت لي قبل لحظات أنك من مناصري القضيّة الفلسطينية، كيف تجد هذه القضية التي في جوهرها قضية استعمار استيطاني مع تطهير عرقي، وليس كما يقول الصهاينة صراع عربي إسرائيلي، وابتلع العرب هذا المصطلح الذي لا يتضمن أي إدانة وصاروا يرددونه؟
▪ يانيس ريتسوس: هي مظلمة كونية أن يظلّ الإنسان منفيّا عن بلاده ولا يقدر الآن أن يكون له بيت وأرض وفسحة من سماء، ولا يقدر أن يغنّي أغنيته في المناخ الذي نبتت فيه هذه الأغنية. ولكن أعتقد أنّه بالنّضال اليومي سيلتقي الفلسطيني ببلاده وببيته وسمائه وأشجاره وأغانيه ويومها سيغنّي أغنية أخرى أغنية منتصرة وعالمية لأن النّضال الفلسطيني يتطابق مع نضالات الشعوب الرازحة تحت كابوس القوى الظلامية، إذن هو نضال من أجل العدالة والحرية لكلّ الشعوب، من هنا فإنّ المسيرة الفلسطينية مسيرة عالمية.
▪ خالد النجار: من أي الشّعراء تحس بقرب روحي؟
▪ يانيس ريتسوس: الشّاعر الأقرب إلى روحي هو هوميروس، كذلك أحسّ بقرب من قصائد دانتي وشكسبير وماياكوفسكي ولوتريامون وبودلير وايلوار وأراغون.
▪ خالد النجار: ماذا تتذكر من أصدقائك الشّعراء: أراغون، ناظم حكمت ونيرودا؟
▪ يانيس ريتسوس: أذكر نيرودا، عندما حصل على جائزة نوبل. قال هناك شاعر يستحق هذه الجائزة أكثر مني، إنّه اليوناني يانيس ريتسوس. تكلّم كثيرا عني عندما كنت في المنفى وفي السّجن. ولكن لم ألتق به. التقيت بناظم حكمت في براغ. وقمنا برحلة سويّة داخل رومانيا، كما قدمنا حديثا مشتركا إلى مجلّة الثّقافة ببراغ، وقد أعيد نشر هذا الحديث مرّات عدّة؛ ناظم حكمت رجل بسيط ومتواضع وإنساني ونبيل؛ لم يكن يشعر بالتّعالي رغم شهرته الواسعة. كان يكبرني بسنوات، وعندما بدأ الصحافي بطرح السؤال الأوّل في تلك المقابلة الشيقة قال ناظم: أريد أن يتكلّم ريتسوس قبلي”، كان جميلا بعينين زرقاوين ذكيّتين، كان كثير الحبّ للنساء الجميلات، كان مليئا بالحبّ لكلّ شيء، يجب أن ترى هذا الحديث لتحكم على أخلاق هذا الرجل، لقد أثرى المقابلة بجمل أساسية وعميقة؛ عندما التقينا أوّل مرّة كان لدينا الإحساس بأننا نعرف بعضنا منذ أحقاب قديمة. أمّا صديقيّ أراغون وإلزا تريولي فقد استدعياني أكثر من عشرين مرّة لزيارة باريس ثم جاءني هنا ليحملني معه. كان يقول للرسّام الفرنسي ماتيس ليس ثمّة شاعر يشبه شعره أعمالك أكثر من ريتسوس. وقد أثبت أراغون قصيدة لي في كتاب عن ماتيس تؤكّد هذا التشابه وهي قصيدة المرأة الزرقاء.
وفي الزّيارة الأخيرة وأنا أودعه لمغادرة اليونان قال لي، وهو واقف بباب شقته بشارع كوراكا: بلغ تحياتي إلى شعبكم، وهو يريد أن يقول أنا أحب العرب.

**
الحوار الثاني
العودة إلى يانيس ريتسوس
الشعر هو أن نلمس الذي لا يفسّر بشكل لا يفسّر
بعد هذا اللقاء الأوّل بسنة عدت إلى أثينا، ذهبت مباشرة إلى حي بلاكا أسفل الأكروبوليس حيث أخذت غرفة بفندق هو أقرب إلى بيوت الشباب منه إلى الفنادق. غرفة صغيرة نظيفة حسنة الإضاءة كما يصف هيمنغواي الغرف المريحة سرير عليه ملحفة بيضاء ونافذة صغيرة ذات إطار أخضر تصلني عبرها ضجة الردهة التي تكتظ بالعابرين شباب أمريكان وأوروبيين في طريقهم إلى تركيا وسورية ولبنان؛ وآخرون قادمون من آسيا الصغرى حيث شبّ ديونيزوس وجاء أرض الاغريق ليدنس أسرة زوجاتهم كما جاء في نصوصهم القديمة… هكذا بدا لي وجودهم كتنافر مع العالم الأثيني الكلاسيكي والأرثوذكسي الشرقي كما بدت أثينا بوابة عبور كبرى…
تزامن وصولي هذه المرّة إلى أثينا مع أعياد الفصح حسب الرّوزنامة الأرثوذكسية. قلت في نفسي لأترك بطاقات البريد جانبا، ولأمضي إلى اليونان الأخرى الحقيقيّة، اليونان القديمة الوثنية ذات الملمح الرّوماني البيزنطي، لأسمع أجراس الفصح الاغريقي. وملت إلى الدّكاكين التي تبيع العاديات، أوان كنسيّة قديمة وصور تذكارات القدّيسين، مشاهد بحيرات ونساء من مسرحيات شكسبير مرسومة على أواني البورسلان وعلى المزهريات، مصابيح نفط زجاجيّة وأيقونات ذهبية وأثاث من الأبانوس قديم بنّي غامق ضارب إلى سواد. لم أصعد إلى الأكروبوليس، فقد ارتبطت شاعرية العالم الكلاسيكي في ذهني بالنّصوص، وبقيت في السفح، في “بلاكا”. هناك ذهبت أبحث عن شاعريّة الحدائق المغلقة، الحدائق القديمة، الخربة والمنسيّة، حيث الآبار المهجورة، وأعشاب الشوكران، بيوت معمارها يعود إلى أواخر القرن الماضي وهي تعيش الآن زمنها خارج الزّمن, تعيش في ذكرى ظلال ورودها الذابلة. وقلت في نفسي هذه هي اليونان الحديثة، مشدودة بين قطبين جاذبين: الكنيسة الأرثوذكسية والطبيعة المتوسّطيّة الحسيّة. لقد تخلت اليونان عن آلهتها القديمة ولم يعد الماضي كما قال لي ريتسوس يشكّل في وعيهم تابو، عائقا للذّهاب إلى المستقبل كما هو شأننا؛ كذلك، ظللت طيلة هذه الزّيارة أتردد على ريتسوس. بقيت في أثينا أربعة أسابيع، وكنت أزوره بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع. كنت أعبر له عن تحرّجي من إزعاجه، وكان يقول لي مادمت في أثينا تعال زرني، وعندما أظهرت له في إحدى المرّات الرّغبة في إجراء حوار، رفض بلطف وقال: لا أريد أن أجلس هكذا أمامك، أنت تسأل وأنا أجيب مثل التّلميذ؛ هكذا وبعفوية شديدة. ثم أردف: لنتحدث مع بعض بشكل عفوي: ولا أخفي أني شعرت في تلك اللّحظة بخجل من جشعي الصّحفي، ولكن ما وقع بعد ذلك كان أروع، فقد أخذت أحاديثنا طيلة الزّيارات مسارات مختلفة، أحاديث تلقائيّة تخللتها أسئلتي، وجاء هذا الحوار عفويا، كما أرادته المصادفة، جاء قطعة من الحياة بلا انتظام.
قلت له وأنا أحاوره: أشياء الإنسان اليوميّة والأبديّة، تلك الأشياء والتفاصيل البريئة والحياديّة التي يقوم عليها كلام النّاس النهاري وهي المتروكة والمنسيّة في غالب الأحيان نجدها وقد اكتسبت دلالة وحياة جديدتين في نصوصك، صارت شيئا كالمطلق، هل هي حاضرة أيضا في نثرك الذي لم نقرأ منه شيئا في التّرجمات الفرنسية؟
قال: كتبت فصلا كاملا في روايتي الأرسطو النبيه” عن الأشياء، وهذا الفصل الذي أتحدّث عنه هو عن الخيط، الخيط مرتبط بطفولتي البعيدة، عندما كنّا نصنع طائرات الورق؛ وكان ذلك جهدنا الأوّل للطّيران كالعصافير، كنّا نسوي طائرات نسميها صقور الورق، وكان ذلك الجهد كما قلت تعبيرا عن نزوع طفولي للطّيران كالعصافير وهذا الصّقر الورقي، كنا نتحكم فيه من الأرض، وبعدها بسنوات طويلة، وفي المنفى، كان أهلنا يرسلون لنا أشياء في عُلب من الورق المقوّى مشدودة بخيوط. كان حرّاس السّجن يفتحون العُلب بحثا عن رسائل سياسية سريّة. كانوا يفتحون كلّ شيء: عُلب السّجائر، وعُلب المربّى، وغيرها. وبحركات سريعة كانوا يقطعون الخيوط، وبعدها يجمع السّجناء هذه الخيوط؛ وحتّى يشغلوا أيديهم بعمل ما، كانوا يصنعون من هذه الخيوط أحذية صغيرة وأغطية موائد وسلالا، وأشياء أخرى. في هذه الرّواية أيّ شيء غريب هو!؟ ثمّة فصل كما قلت لك خاصّ بالخيوط، فصل أتحدّث فيه عن محبّتي لهذه الكلمة ولهذا الشّيء. تحدثت عن خيط الطائرة الورقيّة، وتحدثت عن عجوز يُسمّى أناكساروزاس الذي كان فيما مضى من الأيّام رجلا جميلا وغنيّا أضاع يوما ثروته؛ كان يسكن عند أقارب له بعيدين، ينزل عندهم ضيفا طويل الإقامة، كانوا كلّهم يكرهونه، لا أحد كان يعيره أيّة أهميّة، الأطفال والزوج والزّوجة وحتّى الخدم، وأمّا هو فقد كان وحيدا في عزلته المريرة، كان يرتدي معطفا خلقا وسخا وطويلا يرتديه في كلّ الفصول؛ وكان أناكساروزاس ممتلئ الجيوب دائما بقطع من الخيوط، يأخذها من الخادمة كلّما عادت من السوق. كانت الخيطان صديقته الوحيدة، وأحيانا، عندما يحتاج شخص من البيت إلى قطعة خيط ليربط شيئا، في تلك اللّحظة بالضبط يخرج أناكساروزاس من جيبه خيطا، ويمنحه إيّاه، بحركة نبيلة، وكأنّه ملك يقدم عطيّة. في تلك اللّحظة يحسّ هو المرفوض والمحتقر أنّه ما يزال وللحظة مفيدا للآخرين. لأجل هذا أحبّ كثيرا كلمة الخيط، ولا تنس خيط أريان، فهو الذي يقودنا للعمق السّرّي للشّعر.

▪ خالد النجار: في آخر لقاء معك أتذكّر أنّك قلت لي أن أراغون عقد في كتاب له عن ماتيس مقارنة بين قصيدتك المرأة الزرقاء وعمل فنّي لماتيس؛ وأنا أفكّر بمقارنة أخرى مع الرسّام الفرنسي جورج براك الذي لم يحتف رسّام مثله على امتداد تاريخ الفن بالأشياء الماديّة، الأشياء المنزليّة الصّغيرة. وأنت أيّ وظيفة تقوم بها الأشياء في شعرك؟
▪ يانيس ريتسوس: الأشياء اليوميّة هي الوسائل للاقتراب من التجريد، أي أن تجعل ما لايرى مرئيّا. وقد أجبت من خلال الشّعرفي قصيدة وراء أشياء بسيطة أتخفى. وشرع يقر أ القصيدة في ترجمتها الفرنسية وبنبرته اليونانية:
وراء أشياء بسيطة أتخفّى لكي تجدوني
وإن لم تجدونني هناك
فسوف تجدون الأشياء
وتتلمّسون تلك التي لمستها يداي
وعبرها تتحد بصمات أيدينا.
قمر أوت يسطع في المطبخ مثل قدر مقصدرة
(حتّى من خلال هذا أحاوركم)
ويضيء المنزل الخاوي
وصمت المنزل الخاوي
يظلّ الصّمت قائما
وكلّ كلمة هي منفذ نحو لقاء كثيرا ما يخفق
وتكون كلمة حقيقيّة عندما تؤكد على التواصل
▪ خالد النجار: يقول الشّاعر الإيطالي جوزيب أنغرتي: في القصيدة علينا أن نقدّم الغموض بوضوح، أي المحافظة بكل وضوح على الغموض؟
▪ يانيس ريتسوس: وأنا أقول: أن نلمس الذي لا يفسّر بشكل لا يفسّر، وحتّى لو حاول النقّاد التّفسير فإنّه يظلّ هناك ركن ما داخل القصيدة عصيّا عن الفهم وغامضا. فالشّعر هو التحقّق السّرّي للسّرّ؛ وما أردت أن أُبلّغه تجده في شعري؛ فأنا لا أقول وإنّما القصيدة قالت ما أردت أن أقول؛ في أوّل عمل شعري لي وهو ملاحظات على هامش الزّمن تجد الجواب؛ أنا لا أريد أن أعيد ما سبق أن قلت، لذلك عندما تطلب مني الإجابة عن شيء أجيب: لقد أجبت في شعري. أقول في قصيدة عنوانها تقريبا:
وشرع يقرأ القصيدة في لغة فرنسية منسابة، بذلك الصوت العميق الدافئ
يمسك في يديه أشياء متباينة،
حجر ا مكسورا، عُلبتي كبريت محترقتين
المسمار الصدئ للجدار المواجه
ورقة الشّجرة التي مرقت عبر النّافذة
والقطرات التي تتساقط من أصص الزّهور المروية
والقشّ الذي حطّته رياح البارحة في شعرك هي تأخذه
وهناك، في الفناء تنشئ تقريبا شجرة
وفي هذا التقريب يقع الشّعر. هل تراه؟
▪ خالد النجار: أيّ زمن تعيش أنت. هل تعيش زمن الشّعر أم زمنا آخر؟ أقول هذا لأن شعراء الإيديولوجيا حوّلوا الشّعر عندنا إلى أناشيد عسكريّة، لكلّ شاعر تقريبا أب، زعيم هو تعبيرة حديثة لشيخ القبيلة يملي عليه آخر مواقفه السياسيّة. وهكذا سقطت كثير من القصائد في شرك الآني السّياسي؛ ولم يعد الشّاعر مبدع رؤية وإنّما بوقا سياسيا يعيش كلّ لحظة منفصلة عن الأخرى محكوما بالتحولات السياسية؟
▪ يانيس ريتسوس: الشّاعر لا يعيش في الحاضر التّاريخي، ولا في الماضي التّاريخي، وإنّما هو يهيئ حياة المستقبل. وحتّى عندما أقول أتذكّر فلا يعني ذلك أنّني أتذكّر أشياء من الماضي، ولكني أتذكّر حتّى الأشياء التي لم تقع، والتي ماتزال في المستقبل، في هذا السياق كان عنوان الحديث الذي أعطيته إلى صحيفة الأومانيتي الفرنسية كان عنوانه ذاكرة المستقبل. لقد عايشت مقدما المستقبل، أقول هذا بتأكيد مطلق. ولمّا أقول أتذكّر المستقبل أشعر في الآن نفسه أني أهيء المستقبل، ولا أفعل ذلك وحيدا، وإنّما مع كلّ رفاقي، مع كلّ النّاس الذين يناضلون، مثل الفلسطينيين اليوم، لأجل حياة أجمل، لأجل حياة تسودها الأخوة والعدالة، والحرية والسّلام. حقيقة لقد عشت وأعيش كلّ لحظة، أخوة المستقبل هذه، إنّها حقيقة حاضرة؛ وأنا أستقبلك كما لو أنني أعرفك من زمان بعيد، ونحن التقينا في المستقبل، حتّى ولو لم نلتق من جديد. لأجل هذا كثيرا ما أستعمل في سياقاتي الشّعريّة ضمائر: أنت، أنتم، هم، ونادرا نادرا جدّا ما أستعمل ضمير الأنا.
▪ خالد النجار: قرأت شعرك في ترجمته الفرنسية، بحيث أجهل إيقاعاته الموسيقية، كيف تعاملت مع الأوزان وموسيقى الشّعر؟
▪ يانيس ريتسوس: أمتلك غريزة الإيقاع منذ طفولتي الباكرة، لأنّنا في مدينتي الميلاديّة نغني ونرقص كثيرا، وفي الأغاني الشّعبيّة كما هو الشأن في شعر هوميروس نلتقي بالتّاريخ اليوناني كلّه، وأيضا بكلّ إيقاعات ولغات الإغريق؛ وقبل أن أتعلّم في المدرسة من خلال الكتب، كنت قد استوعبت الإيقاعات واللّغة مباشرة من خلال إنشاد ورقص الشّعب. والآن، فإنّ الإيقاعات بالنّسبة لي ليست مجرّد معرفة عروضية، وإنّما هي تسيل مع الدم في أوردتي، تسيل متناغمة مع نبضات قلبي. صحيح أنّي أستعمل الآن أوزان الشّعر مثل اليانب، والأنابيست، والداكتيليك، والتروكفاييك ( أسماء أوزان الشعر اليوناني) بيد أنّي كنت أعرفها قبل أن أتعلمها في المدارس.
▪ خالد النجار: أسألك، كما سألت في حوار سابق، أيّ تجربة خضتها مع اللّغة، خاصة وأن اليونانيّة لغة عريقة، كُتبت بها أروع الآثار التي كان لها تأثير على مجمل تاريخ الغرب، وحتّى الشّرق العربي؛ وذلك في الحقبة الهلّينستيّة؛ هل تمارس اللّغة القديمة ضغطا عليكم كما هو الشأن عندنا مع اللّغة العربيّة؟ فاللّغة العربيّة اليوم ورغم ادّعاءات المشروع النّهضوي ماتزال في وعينا ولا وعينا الجماعي هي لغة المقدس، لغة كاملة مطلقة، لغة لا تقول في جانب منها تجربة البشري التّاريخية، لذلك أبدع العرب ألف ليلة وليلة باللغة العامية وأكبر كتابنا مثل توفيق الحكيم والطيب صالح يحسون بنزوع غريزي للتعبير بلغة الشّعب في الحوارات الروائية بل إنّ الطيب صالح كتب رواية كاملة بالعامية السودانية؟
▪ يانيس ريتسوس: نحن مررنا في تاريخنا من الآلهة الاثنتي عشرة إلى الدّيانة الأورثوذكسية، لذلك فاللّغة القديمة لا تشكل عبئا بالنسبة لنا، هي ليست تابو؛ لقد تخلينا عن تلك اللّغة. اللّغة التي نكتب بها اليوم هي لغة الشّعب وتسمى اللّغة الشّعبيّة، الديموتيك نسبة إلى كلمة ديموس وتعني الشّعب. إنّها ثروة صاغتها الأغنية وحيويّة وواقعيّة التّجربة التي عاشها الناس. هناك كلمات قديمة ماتزال مستعملة، هناك مثلا لفظتان للدّلالة عن الرّبيع اللّفظة الأولى كالوكوري وتعني الفصل الجميل وكلمة أنيكسي وتعني لحظة انفتاح كلّ شيء، انفتاح القلب والطّبيعة، أمّا الكلمة القديمة فهي إيرا؛ وقد أستعملُ في الشّعر هذه أو تلك من الألفاظ القديمة أو الحديثة كما أرغب؛ فعندما كتبت قصيدتي العشقيّة السمفونيّة الربيعيّة، لم أستعمل اللفظة الحديثة أنيكسيتي وإنّما استعملت كلمة ايريني وهي اللفظة القديمة. الحداثة اليونانيّة تأسّست على لغة “الديموتيك” الشّعبيّة، وهناك مثال ساطع بعد ثورة سنة إحدى وعشرين وتسعمائة وألف بدأنا بتكوين القومية اليونانيّة الحديثة. كان هناك شاعر كبير هو ديونيزيوس سولوموس كان قد درس في إيطاليا وكتب أعماله الأولى بالإيطالية. وفي حقبة الثّورة والاندفاع القومي عاد إلى اليونان وانكبّ على قراءة الأغاني الشّعبيّة وأتقن اليونانيّة وأنشأ صرحا لغويّا جديدا منه بدأ كلّ الشّعر اليوناني الحقيقي.
▪ خالد النجار: والتّراث، الماضي اليوناني، أوما اصطلح على تسميته بالمعجزة الإغريقية والذي هو في حقيقته تراث كلّ الغرب كيف كانت مواجهته؟
▪ يانيس ريتسوس: الإرث الإغريقي ليس تقليدا، ليس إعادة، فهو ما زال مستمرّا فينا مثل الدّم الذي ينساب في عروقنا.
▪ خالد النجار: هناك رغبة لدى الموتى للظّهور باستمرار في قصائدك، هل يشكّلون قوّة أخلاقيّة، أم هم مجرد تذكير بحضور الماضي، أم هي قوّة الموت الذي تكتمل فيه الأشياء؟
▪ يانيس ريتسوس: أنت تعرف أن اليونان تكتظّ بالمعابد القديمة الخاوية، والمفتوحة على الرّيح المطلقة. واليونان أيضا تكتظّ بالتّماثيل المكسورة، وبالبيوت المقصوفة بالقنابل، بيوت كثيرة تمتلئ بالموتى، وهم يلحّون عليّ حتّى أبعثهم في الشّعر، وأن أستجيب إلى مطلبهم المتأكّد بكلّ قوّتي المشابهة لقواهم، وهي نفسها قوى المولودين الجدد، وناس المستقبل. التّماثيل المكسورة تمنحني أيضا الاحساس بالأبديّة وفكرة الأبديّة تماما كما الموتى.
▪ خالد النجار: هل النّحت هو لديك استجابة غامضة لدوافع وراثيّة سحيقة البعد في تاريخ اليونان، وذاك الوله الدّيني بالحجارة أم هو التحرّر من اللّغة والتعامل المباشر مع الأشياء كمادة ملموسة، الأشياء التي طالما استحضرتها في الشّعر؟
▪ يانيس ريتسوس: لأنّ في النّحت تتجلى قوّة الحجارة التي تريد أن ترتفع، كما لو أن للحجر أجنحة؛ وهي رغبة الإنسانية كلّها في الصّعود والعلوّ، كما هو الشأن في الفكر والشّعر، فلماذا نستثني النّحت؛ بدأت أرسم على الحجر في منفاي الأوّل، لم تكن ثمّة أدوات للعمل، ولكن، وبقلم فقط كنت أستطيع أن أعمل، خاصة وأن الحجر كان متوافرا في المنفى. لم أرسم المساجين، ولكن، وفي هذا المناخ المشحون بالقمع والارهاب والقسوة كان هناك الحبّ والحياة والجمال، وكانت ردة فعلي في مواجهة الرجعيّين هي هذه الصّور المفعمة بالحبّ وبالجمال؛ كانت رسوما تقدمية لإنّها تمنح الناس، تمنح المساجين الآخرين الإحساس بأنّ الجمال ما يزال موجودا، وأن الحبّ ما يزال موجودا؛ وباسم قيمة الحياة نستطيع أن نناضل، يعني أنّنا بهذه الرّسوم التي على الحجر نستطيع أن ننمّي الحياة، وأن نمنح أملا جديدا للناس الذين فقدوا الأمل، وهم، وبهذا الأمل سيتمكّنون من مواصلة النّضال؛ نضال بلا أسلحة، ولكنّه نضال حقيقي، بسلاحهم الوحيد الذي هو قوة الرّوح والفكر؛ كما هو شأن الفلسطينيين في هذه اللّحظات، فهم يناضلون بلا أسلحة، ولكن، وبالتّأكيد سيعودون يوما إلى بلادهم، إلى بيتهم، إلى أغنيتهم؛ وحتّى في هذا الضباب، وفي ضجيج الحرب هذ، فهم ما يزالون يعرفون الغناء؛ وفي كلّ مرّة في التّاريخ، عندما يستطيع أيّ شعب أن يغنّي في الألم فذلك يعني أنّه يستطيع أن يتجاوز الألم، وأن يرفع إصبعيه بإشارة النّصر.
▪ خالد النجار: هناك شعراء احتفوا في قصائدهم بالحجر، أتذكّر الآن الشّاعر الفرنسي روجي كايوا، لقد وضع ديوانا كاملا عن الأحجار، أنت ماذا ترى في الحجر؟
▪ يانيس ريتسوس:: الحجر؟ إنّه ردة الفعل في مواجهة لا عدالة العالم، هل رأيت هذا الكتاب الذي صدر في ألمانيا عن منحوتاتي؟
وها هو يقدم لي كتابا صغيرا مربّع الشّكل، وأتصفحه، فأتذكّر أنّه أراني هذا الكتاب في زيارتي الأولى له قبل أكثر من سنة. أنقل النّظر سريعا بين صور الكتاب والمنحوتات المتكدسة حذوه والأخرى التي تنتشر في كلّ زوايا الغرفة: فوق الأرض، وعلى المناضد، وفوق الرّفوف؛ وأقوم ببعض المقارنات، بين الصور والمنحوتات وأحسّ بذاك الانحراف الذي يطرأ على النّحت في الصّورة الفوتوغرافية. إنّه الغياب، غياب الحضور الكثيف للحجر، للمادّة الملموسة التي هي جوهر النّحت؛ وما أشاهده على صفحات الكتاب هو في آخر الامر ليس سوى صور فوتوغرافية…
أعود للكتابة السريعة بذاك الخط الرّديء فأنا أخاف أن تضيع منّي كلمة وفي الأثناء أسمعه يقول لي وأنا منهمك في كتابة الجمل الأخيرة من الحوار:
أنظر، حتّى في الموت تجد التّماثيل واقفة، أبدا لا يوجد موتى ممددون في منحوتاتي.
……………………..
هوامش
- هرمسيّة: نسبة لهرمس المثلث العظمة وهو النبي ادريس وهرمسية Herméneutique أو هرمتية مصطلح نقدي يعني معالجة الغموض كأحد ملامح الكتابة الحديثة. والفيلسوف الألماني هيدغر من أبرز من أعادوا هذا المصطلح للتداول في العصر الحديث
- اللايكية: لدى يانيس ريتسوس تعني في معناها اليوناني نسبة للاووس λαός, laós أي عموم الناس أو العالم الذين ليسوا من رجال الدين من هنا جاء مصطلح اللايكية والعلمانية في الديانة المسيحية ومقابله كهنوتي Laïc و ecclésiastique. والثورة الفرنسية هي التي أعادت الجدل حول المقابلة بين الديني والدولة. فرأس الكنيسة في أنجلترا أي البابا هو الملك نفسه، أي أن السلطة الدينية والسلطة الدنيوية الزمنية بيد واحدة.














