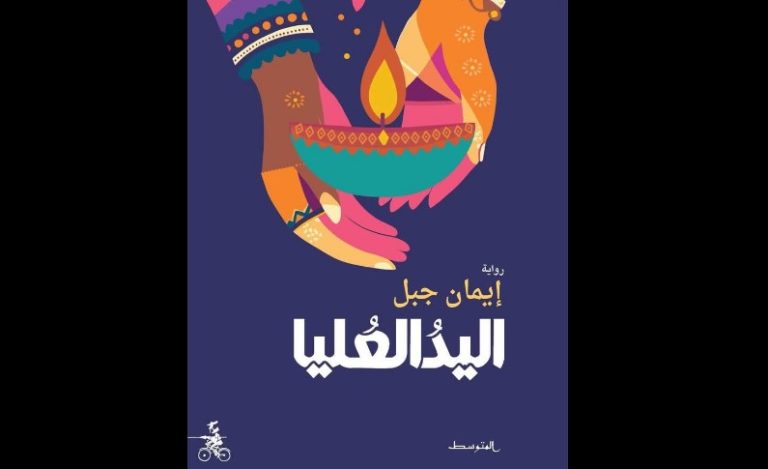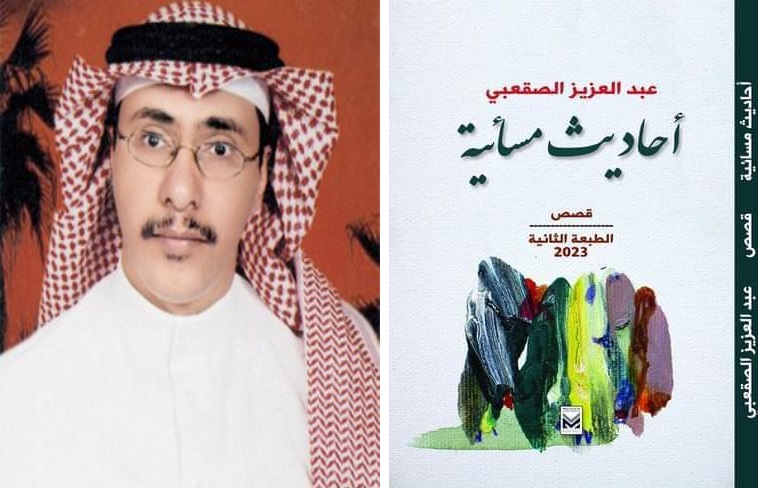في سرد مزاجي، يُفهمنا الروائي، صورة العالم الذي يقف خارج حدود المقهى التونسي، الخائب والخانق والمُغلق على أسرار. من خلال المقهى عثر الكاتب على روايته، وعرف جيداً الإمساك بالخيط الذي قاده إلى الطريقة التي روى بها حكايته. ثمة أوجه للرواية، تتلطى خلف شخصياتها، ومنها موضوعه “الذاكرة” التي تستعيد ماضياً مثلوماً لوطن يسمى فلسطين، على شكل كوابيس ووساوس في النوم واليقظة، كما أن “النسيان” هو أيضاً هاجس، حيث تسعى “الشخصية” إلى نسيان خوفها والعنف الذي لحق بها، كما يُضيف الكاتب وجهاً ثالثاً وهو ذلك الذي يتعلّق بالهوية، هويتنا التي فقدناها.
تشفيك هذه الرواية لأن حديثها واضح، ورغبات ناسها واضحة وترسم لك من خلال “مقهى تونسي” صورة نابضة بالحياة، لنساء ورجال تحسّ بأنك تعرفهم وتخالطهم. عناية الكاتب برسم نساء ذلك المقهى يُسكنك في اللهفة إليهن، وحيدات إلا من مفاتنهن، نفضاً للسأم الذي يسكنهن. و”باب الليل” هو اسم الرواية، والليل مفضٍ إلى المتعة، بها يسترشد كل مريد إلى أحضان النساء ويشق طريقه خارج وحدته في النهار، ويدافع عن نفسه ضد البرد والعجز والاختلالات الداخلية التي شوّهته.
مقهى هو “حالة” قبل أن يكون مكاناً، فيه تلتقط النسوة رزقهن من الرجال الميسورين وغير الميسورين، وتفوز من بينهن من تمتلك “المؤخرة” الأكمل والأجمل.
رغم التوصيف المسهب عند المؤلف، نراه يركز بشدة على الحبكة بكل آليتها من الوقائع والمصادفات غير المرئية والمبالغ فيها. تراكم من مصادفات، لا تنظر إلى تقليد الواقع كما هو، بل لإدهاش القارئ واستثارته من الكاتب “اللعوب”، وهنا تكمن براعته الفنية.
في المقهى الخاص بباب الليل، المجتمع الشمولي في أكثر صوره تطرفاً، ويميل إلى إلغاء الحدود بين العام والخاص. رموز السلطة، والناس العاديين في حيواتهم الشفافة تماماً، وفي لعنة العزلة التي نزلت بهم. المقهى ينتمي إلى مملكة العجائب. الفلسطيني يمكنه أن يفهم غلطة في تاريخ نضاله قذفته إلى ذلك المكان، فيتحول إلى شبح حقيقي باحثاً عن تاريخه الضائع، بينما المرأة تأخذ في هذه الرواية زمام المبادرة وتسيير حياة ناس المقهى، في تيه لا نهائي من المفاتن الشكلية والدهاء الداخلي.
الواقع أن على الكاتب وحيد الطويلة التباهي في روايته، لأنه عثر على قالب نثري خاص بكل جملة، فنثره يخدم سرده الإغوائي ـ المزاجي، وهو رد فعل ضد الجُمل الجاهزة الخارجة أبداً من نفس القالب.
في السرد، ذلك المنطق الجمالي كما لو في تنافس مع جمال وتهتك الشخصيات النسائية في الرواية. في هذا المنطق الجمالي يريد الكاتب أن يحدد لكافة عناصر الجملة، مكانها الأعمق والنهائي. الطويلة، يبدو مهموماً ـ بشكل خاص ـ بالصراع ضد التشويه الذي تفرضه الضرورات النحوية، والاقتضاب الخاص بالرواية الحديثة، فهو يريد أن يعيش الحالة كلها، عبر تركه للجملة بكامل بوحها، ومستوياتها المتنوعة بحالات وظلال الأحاسيس والمستويات التي تُشغلها الأجزاء في روحه.
والخلاصة أن الكاتب يعمل بطريقة على علاقة “بالذاتية”، مع تدخل من الذهن نحو إعادة بناء السرد طبقاً للمعرفة الشعورية والثقافية التي يملكها، وهو بهذا يخلق لنفسه في “باب الليل” سرداً أكثر جرأة في طموحاته وإنجازاته.