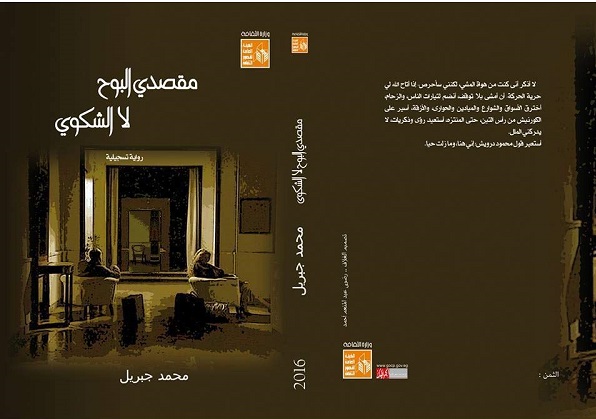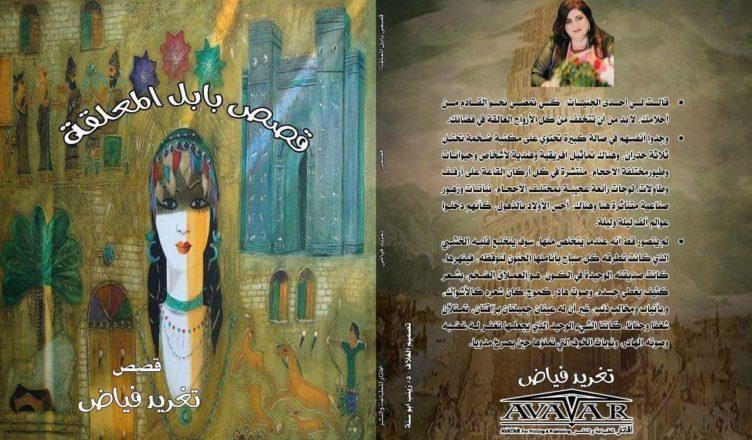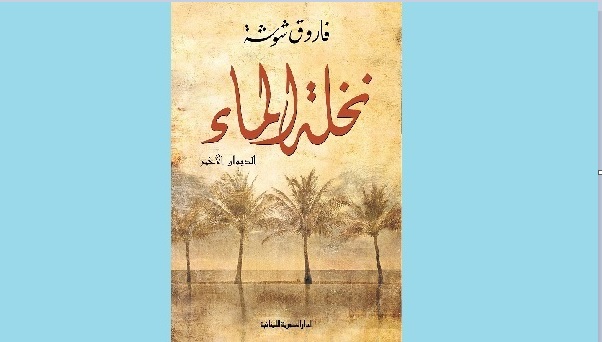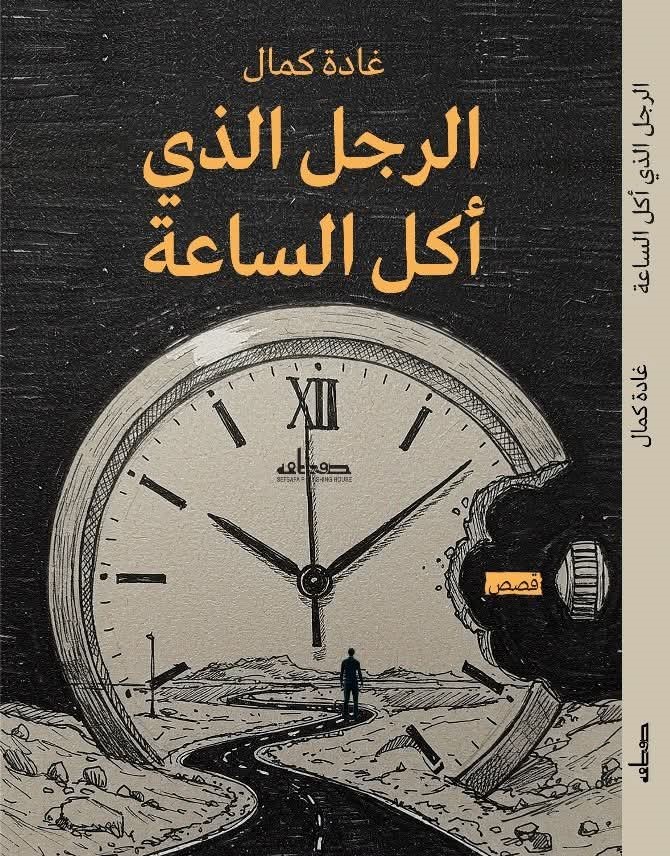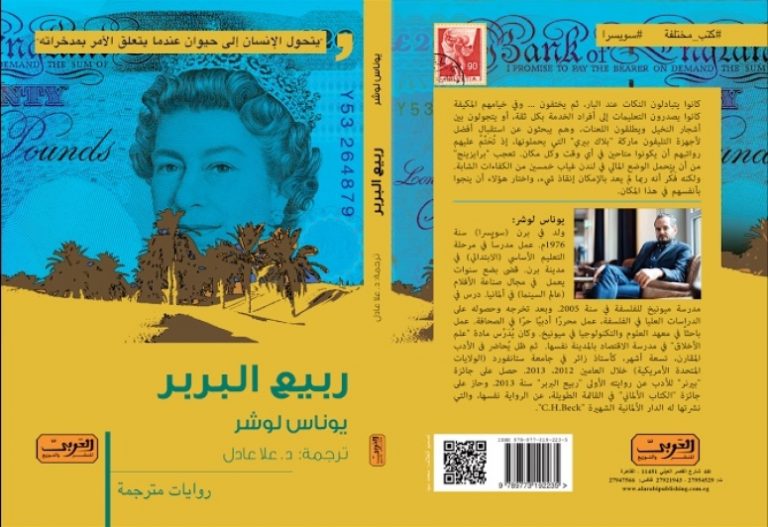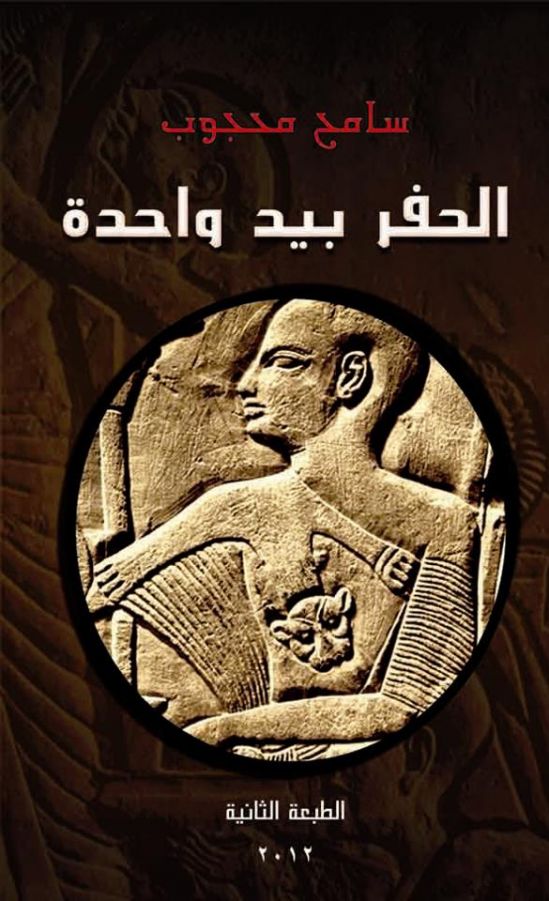د. رضا صالح
يبدأ الكاتب روايته التسجيلية بإهدائها إلى زينب؛ وزينب هى زوجته الدكتورة زينب العسال رفيقة الدرب والونس كما يقول المؤلف؛ ثم يتبع الإهداء بكلمة لتوماس مان يقول فيها الإنسان لا يموت دون أن يوافق على موته؛ يبدو أن الموت الذى يقصده مان هو الموت حياً! فأحيانا نرى الإنسان يعيش كأنه ميت!
ويبدأ روايته بإفاقته من البنج ويشعر كأنما يُبعث إلى الحياة من جديد؛ ويتطلع الى ما حوله كالغريب؛ يحدثنا عن رواية لموليير اسمها مريض بالوهم وعن الصوفى عبد الوهاب الشعرانى الذى يقول إن المريض إذا كتم مرضه عن الطبيب؛ فلن يسعفه بعلاج، يتكلم عن الحساسية –حساسية الصدر –وعن الروائى ادوار الخراط الذى قرأ له كتاباته عن الحساسية الجديدة؛ ويسجل أن الحساسية أنواع منها ما هو عضوى ومنها ما يتصل بالإبداع؛ ومن المعروف علميا أن حساسية الصدر يظل المريض يعانى منها على فترات أو تأتى على شكل نوبات ولها العديد من الأسباب؛ يقول الراوى تم استئصال اللحمية لعلاج الشخير ولكن الحساسية تظل تعالج بالكورتيزون المعروف بأنه سلاح ذو حدين، ويبوح أيضا ببعض النصائح التى كان الأطباء يكررونها على مسامعه مثل الاقلاع عن التدخين والتقليل من النشويات والدهون والامتناع عن أكل اللحم الأحمر والإكثار من الخضر والفواكه وممارسة الرياضة.
يفكر فى عمل تحاليل دورية كما يفكر فى العظماء والرؤساء الذين داهمهم المرض على حين غرة.
كما يبوح ببعض آلامه مع العمود الفقرى والتى تلازمه منذ زمن بسبب جلسته ساعات طويلة إلى الآلة الكاتبة ينقر عليها ربما إلى ساعات الصباح؛ ويذكر لنا ملاحظة عابرة عن جريدة الوطن العمانى؛ والتى عمل فيها سنوات وكان يقف أكثر من 24 ساعة يوم صدور العدد الأسبوعى؛ حتى تفاقمت آلام العمود الفقرى والساق والتى عولج وشفى منها.
ومع ظهور وانتشار الكمبيوتر لا يبادر الكاتب إلى استعماله؛ ولكن ابنه وليد هو الذى شجعه على استخدامه و يعود ثانية إلى تلميذ –كما يقول –يبسّط له وليد عمل الكومبيوتر؛ وذات عصر يشعر بما يشبه النيران تتصاعد فى ساقه اليمنى؛ أثناء وقوفه منتظرا قطار القاهرة فى محطة سيدى جابر، بثقافته الواسعة؛ يخبرنا الكاتب أن دواء دافلون لا يصلح معه لعلاج الآثار السلبية للجاذبية على انتفاخ القدمين والتى يسببها الوضع جلوسا لمدة طويلة.
كما يخبرنا –الأستاذ محمد جبريل –بصدق وحزن شفيف طريق الآلام الذى اضطر أن يسير فيه؛ وعرض آلام الظهر والساقين وسقوط القدم كما أوضح المواقف التى يراها محرجة من وجهة نظره؛ هو شعور الأبطال، كما يذكر الأدوية والوصفات الشعبية والحقن الموضعى وما يتصل بها؛ كما يذكر العديد من الأطباء المعالجين فى هذا المجال؛ وقد قفز الى ذهنى هذه اللحظة أن هذا الكتاب يمكن أن يفيد طلبة الطب -على الخصوص – من نواح عديدة؛ أهمها العيش مع المريض فى لحظات آلامه وبحثه عن العلاج؛ وكذا التحليل النفسى للمريض؛ كما نجد أصناف عديدة من المسكنات وأدوية الأمراض المختلفة؛ و بتنقل بنا إلى إصابته بقرحة الاثنى عشر وإجراء عملية بمستشفى عين شمس التخصصى لوقف النزيف؛ وكذا علاج الشبكية؛
يذهب بنا المؤلف بأريحية؛ ليذكر ذلك الدجال الذى اضطر الى الاستعانة به فى علاج لحمية الأنف فوضع له نقاطا حامية نارية أفقدته حاسة الشم لحظيا؛ أدرك فيما بعد أنها ماء نار كما أبلغه طبيبه الخاص.
يبدو لنا الكاتب فى انتمائه العميق لمدينته البحرية –الإسكندرية –وهو يدخل تعبيرات وتشبيهات (ولادار فى بالى أن ألقى السنارة أو الطراحة فى الموج الحصيرة؛ أسلم نفسى إلى لحظة استرخاء، لا تلبث أن تفقد صفوها بنوة لم تنذر بقدومها، أنسى الموج الحصيرة، والطراحة، أو السنارة؛ واللحظات المسترخية، أنسى ما قد أنسبه الى الوداعة والسكينة؛ أضع همى فى اتقاء النغزة؛ محاولة النجاة من تأثيراتها؛ هذا هو الشعور الذى عاشه سكندرى، يعرف معنى تقلبات الجو، والحرص على الأولويات؛ الأهم فالمهم فى مراحل حياتنا).
يتضايق الكاتب من تعثره فى المشى وسقوطه فى الحمام وأمام باب الجريدة؛ وتلك المشية المهتزة جراء سقوط القدم. ثم ينتقل بنا للحديث عن إضراب الأطباء؛ ويقول (لم أتصور أن الأطباء يعاقبون المرضى؛ حتى يحصلوا على حقوقهم)، كما تحدث عن الجشع والتدليس المادى من بعض جهات العلاج الخاص وخصوصا المستشفيات وعن سلوكيات بعض الأطباء تجاه المرضى يحدثنا عن ذلك الطبيب الذى (كان الإعجاب بالذات يتناثر من رذاذ فمه) وكان مع فريق علاج حسنى مبارك؛ وتعامل بقسوة وسوّد الطريق وسد منافذ الأمل أمام الكاتب؛ حتى أنه طلب مبلغا خرافيا لإجراء عملية لا يوجد فيها احتمال واحد للشفاء!وتحدث عن التأمين الصحى للجميع فى دول الغرب مثل ألمانيا وغيرها.
يعود بنا الكاتب إلى ذكريات الطفولة لنرى شخصيات طبية نادرة مثل د.أنطون المشرف على ولادته؛ والذى بال فى يده؛ وإلى عم محمد حلاق الصحة الذى يثق فيه أبناء بحرى؛ والدكتور مردروس الأرمنى الذى كان طبيب الأسرة وله معه ذكريات حتى وفاة والدته وانتهاء بخروج الأرمن من مصر.
وينطرق إلى الحديث عن الدكتور علاء عبد الحى وعملية الغضروف؛ وشرود ذهنه أثناء توجهه لإجراء العملية إلى ما كتبه فى روايته التسجيلية (الحياة ثانية) وفيها يقول: “لحظات متباينة؛ تلاقت وتشابكت فى لحظة واحدة؛ يصعب أن أصفها: الأمل اليأس والحياة والموت والخوف والإرادة واليقين الدينى والتعاطف والمشاركة والحب والقلق وتوقع المجهول، ثم نغطى ذلك كله برداء من السكينة؛ لا ملامح ولا قسمات ولا صوت، الأبدية مطلقا، لا قبل ولا بعد، التواصل فى الذات، الامتداد إلى الداخل” جذبتنى تلك العبارة الفلسفية ذات النظرة العميقة والشاملة الى أحوال الحياة والموت.
صفحات دسمة من نظرة المؤلف الفلسفية الى الحياة والموت؛ بعد العملية يذكر كلمات لمشاهير أمثال ماركيز وسوفوكليس؛ كما يذكر قول الدوس هكسلى”إذا كنت تخاف من الموت فسوف تموت بالتأكيد” وتتدافع الأسئلة لتولد المزيد من الحيرة والتساؤلات: لماذا يشيخ الانسان ويموت؟ لماذا يولد الانسان ؟ وهكذا بعد العملية يبدأ مشوار من المعاناة لعدم تثبيت الفقرات بعد العملية التى أجراها له جراح المخ والأعصاب علاء عبد الحى؛ يتردد على مراكز وأطباء للعلاج الطبيعى ولكن بدون فائدة تذكر؛ ظل يعنى من الآلام وسقوط القدم وعدم التحكم فى مشيته وأتذكر أنا يوم وقعت على إقرار قبل اجراء عملية لى وفى هذا الإقرار ما يدل على موافقتى على إجراء العملية حتى وإن أدت إلى الوفاة! ولكن ذلك لا يعفى الطبيب من مسئوليته عن المريض.
تؤسرنى تلك اللمسات الانسانية الحانية التى يذكرها الأستاذ محمد جبريل فى سياق حديثه عن رحلة المعاناة؛ تلك اللمسات التى كانت بطلتها زوجته الدكتورة زينب العسال والتى ظلت تنير له الطريق وتخفف عنه من وطأة الواقع؛ يقول فى ص 112: ماذا لو أن زينب العسال لم تظهر فى حياتى؟
ماذا لو أنى واجهت المرض بلا رفيقة تحتضننى برعايتها؟
وهكذا تُختتم الرواية التسجيلية الدسمة بتمنى الشفاء وساعتها سوف يبدأ المشى بلا توقف “أنضم لتيارات الناس والزحام؛ أخترق الأسواق والشوارع والميادين والحوارى والأزقة، أسير على الكورنيش من رأس التين حتى المنتزه؛ أستعيد رؤى وذكريات لا يدركنى الملل”.
شفاك الله وعافاك أيها الروائى الكبير.