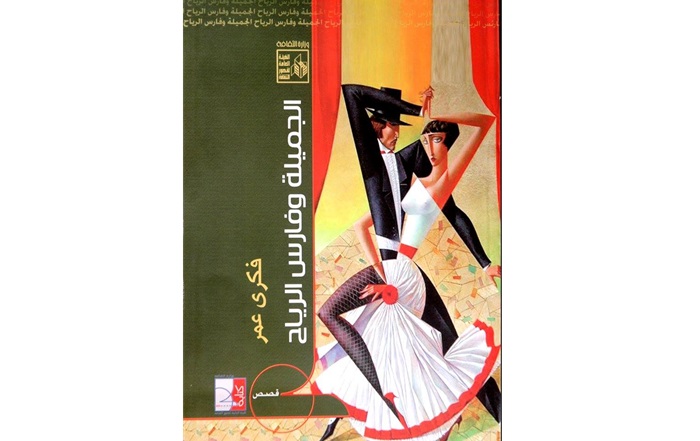المصباح الأبيض فوقي يصب نوراً حليبياً يغمر رأسي وينساب على عينيي فتسبح الأشياء في غيوم بيضاء كثيفة. تقف خزانة الملابس القديمة في أحد الجوانب منهزمة مفتوحة على مصراعيها، خاوية الوفاض. بينما يتمدد السرير الكبير عارياً يغط في نوم عميق، يزفر أنفاس خشب قديم وتتناثر فوقه وسادات تحتضن دموعها وأحلامها الضائعة برفق.
في الخارج يقف سواد الليل متربصاً بالأبنية والطرقات، متسلحاً ببرد الشتاء القارس بينما يتردد خياله الثقيل خلف الشباك الكبير المغلق بإحكام. تنفلت سهام باردة من جعبة الليل وتنفذ من بين شقوق الشباك إلى الداخل.
يبعث من الأرض بردٌ يتسلل إلى قدمي ويزحف ببطء نحو جسدي، فيخدره، ارتعد وأستدير لأواجه الفراغ. أمسح بكفي الغبار الذي سيغطي السطح قريباً، أطوف في الأرجاء وأنفض بقدمي الشباك المعقدة التي ستغزلها العناكب، سيمر فأر كبير خارج الشباك، ستجذبه رائحة الفراغ فينفذ عبر الثغرة، ستتدافع أسراب الفئران وراءه إلى الداخل، ستغزو الفراغ وتحتله. والآن صار علي أن أرحل، سأغلق الأبواب جيداً حتى لا يهرب الفراغ. سأهرب قبل أن يفيق ويتبعني!
يبدو أن الفراغ سبقني إلى الخارج، كيف هرب؟ لا أدري. لعل الفراغ الذي كان بالداخل لم يكن كل الفراغ بل قطعة منه، بينما تناثرت باقي القطع بالخارج. السيارة تطوي بساط الأرض من تحتها، بينما يركض الفراغ خلفها لاهثاً ينتزع الناس والأشجار والأبنية، يعتصرهم بين قبضتي يديه ويقذف بهم وراءه ويواصل العدو. الظلام يُطبِق على الكون ويغرقه في بحر بلانهاية تسبح فيه الأبنية المتراصة كصناديق كبيرة فارغة. بينما تفر الطيور هاربة من الفراغ والظلام إلى أعشاشها في زوايا الأبنية العالية المهجورة، حيث تظل راقدة بلا حراك، تستعذب السكنى فيثقل وزنها وتنكمش أجنحتها فلا تقوى على الطيران، وتنتقل من مكان لآخر سيراً على أقدامها الواهنة التي تكاد تنقصف تحت جسدها الثقيل.
تقدمتُ نحو البناية بحذر، استقبلني هواءٌ باردٌ في المدخل، هواء ينبعث من الرخام الأبيض القديم الذي تتخلله شقوق سوداء كبيرة. بدأت في صعود الدرج، أصعد لأعلى فتزداد برودة الهواء وشدة الظلام. الأنوار مُطفأة، صمتٌ مميت يعم المكان، والدرج أمامي يستطيل ويبدو بلانهاية. في نصف الطريق التقطت أنفي رائحة بخور نفاذة، رائحة قديمة تمتزج بأحلام بعيدة. أخذتني الرائحة إلى ذلك السوق القديم حيث كانت الجموع المحتشدة تشكل دوائر عشوائية حول بضعة عازفين يلتفون حول رجل يرتدي حزاماً من الأصداف ويرقص على إيقاع الموسيقى المنتظم. كانت النغمات تتكرر والرجل يهتز بأصدافه على الإيقاع الذي سرعان ما التقطته أذني وبدأ نبض قلبي يتبعه. واصلتُ الصعود والموسيقى تنبض في كياني، لكن لم يكن ثمة أثر لحياة من حولي. اقتربت من نهاية الدرج، نظرت إلى أعلى فتبينت طاقة مربعة تبرز منها قطعة من السماء تتناثر على طرفها بضع نجوم واهنة ترتعد وتوشك على الانطفاء. وصلت إلى النهاية فأدركت سُلَّما يفضي إلى أعلى، وجدت نفسي أصعد إلى السطح المظلم، مأخوذة بالسكون، مُخدَّرة بالبرد وبفضول عارم يشحذ حواسي لالتقاط أي صوت أو ضوء أو رائحة تنم عن حياة. بدا المكان كملعب مهجور صال فيه الفراغ وجال؛ كان السطح يعبأ بأصص زرع فارغة وأعشاش طيور مهجورة ولعب أطفال بالية وفناجين قهوة مكسورة وأوراق جرائد مبعثرة. وعلى سور السطح، كانت الطيور الثقيلة تقف ساكنة كتماثيل فخارية مصبوبة، اقتربت منها بحذر خشية أن تطير فجأة بأجسامها الكبيرة فتعكر صفو الهواء وتكسر ألواح الصمت، لكن الطيور لم تنتبه لاقترابي ولم تلتفت نحوي بل ظلت ساكنة شاخصة أبصارها إلى الأفق البعيد، إلى الفراغ.
تركت الطيور الفخارية ونزلت، دلفتُ إلى بيتي وأغلقت الباب بسرعة خشية أن تتبعني قطع من فراغ السطح. وفي تلك الليلة، قضيت ساعات أفتش عن النوم في رأسي، أحاول التقاط أطرافه من بين سطور كتاب أو تخليصه من بين أنامل النسمات الصيفية التي تعبث بستائر الشباك. لكن هيهات، ظللت ساهرة أطارد أذيال النوم حتى التقطت بعضها قبيل الفجر. وبعد ساعات قليلة، أيقظتني أشعة الشمس المُصوبة نحو وجهي، فاكتشفت أني نسيت أن أغلق الشباك قبل أن أنام. أطللت برأسي خارج الشباك أتفقد السماء وقرص الشمس الساطع فإذا برائحة قطط تملأ الجو، رائحة فرو قطط، عظم قطط، لابد وأن القطط في كل مكان. خرجت أبحث عن الحياة في الخارج، وعلى عتبة البيت تنبهت إلى صوت ضجة كبيرة آتية من الطابق الأسفل. نزلت سلالم الدرج بحذر تسبقني عيناي، أخذت الصورة تكبر شيئاً فشيئاً حتى اكتمل المشهد الغريب. كان الدور يعج بأعداد غفيرة من السيدات والقطط الذين اصطفوا أمام إحدى الشقق في انتظار أن ينفتح الباب. وما أن انفتح الباب حتى اندفعوا بقوة إلى الداخل. تكرر المشهد في الأيام التالية، كانت كل مجموعة من السيدات تدخل مصطحبة قططاً تتركها بالداخل ثم تخرج لتدخل مجموعة أخرى وهكذا. كانت القطط كبيرة، تأكل كثيراً وتنام كثيراً لكنها لا تموء. كانت السيدات يتركن القطط عند “السيدة قطة”، تلك الجارة التي ظلت تعتني بالقطط وتعلمهم المواء حتى نست الكلام وأصبحت تصدر أصواتاً تشبه المواء، بل إنها أصبحت تشبه القطط ببشرتها البيضاء وملامحها المنمقة وعينيها الخضراوين. كانت تنظر مثل القطط وتتحرك مثل القطط وتختبيء وتظهر مثل القطط. وزادت أعداد القطط المتوافدة عليها فأصبحت حبيسة البيت لا تكاد تخرج منه إلا لتقوم برحلات قصيرة تصطحب فيها القطط التي لا تموء إلى السطح الذي تقطنه الطيور التي لا تطير. كانت “السيدة قطة” تعمل جاهدة على ملء فراغ السطح؛ فكانت تظهر كل صباح بردائها الأبيض ووشاحها الوردي وقبعتها السوداء وحذائها الأسود فتبدو كقطة بيضاء كبيرة تقود كتيبة من القطط مختلفة الأشكال والألوان. وعلى السطح، كانت “السيدة قطة” تروي الطين الجاف كل يوم وتضع أصص الزرع حيث تمتد أذرع الشمس. كما كانت تحمل الطيور المصبوبة بين يديها وترفعها عالياً صوب الشمس وتحرك أجنحتها كي تطير، لكن الطيور لم تكن لتستجيب أبداً، كانت تثقل بجسمها فوق يدي السيدة الضعيفتين فتجبرها على اطلاق سراحها لتعود الطيور إلى جولاتها الكسولة. كما كانت “السيدة قطة” تملأ فراغ الأيام الجديدة بقصاصات أيام زائلة؛ حيث كانت تجلب أحداث اليوم التالي من صندوق “حدث في مثل هذا اليوم” من العام الماضي وتعكف على قراءتها في السطح إلى أن يتنامى إلى سمعها أصوات تناديها فتترك القصاصة في ركن مهمل تراكمت فيه أوراق الجرائد الصفراء، ثم تجمع القطط وتنزل في عجالة لتواجه الضجة التي تتزايد والمشهد الذي يتسع. كنت أتابعها باهتمام لكنني لم أفكر يوماً في التحدث إليها، فلقد بدا لي أنها تدور في فلك منفصل وتسكن في قطعة من الفراغ الخاص بها، فراغ تواجهه بالقطط والطيور والزرع وقصاصات الجرائد. أما أنا فلم يكن لدي قطط، كما إنني لست ماهرة في ملء الفراغ، خشيت أن أقترب منها فتلمس الفراغ بداخلي. كنت أنتظر القصاصة التي تتركها كل يوم بشغف لكي أعرف ما سيحدث في الغد. لم تفوِّت يوماً أبداً. إلى أن جاء ذلك اليوم الذي مر دون أن تزور “السيدة قطة” السطح أو تترك قصاصة اليوم التالي!
جاء صباح الحادي والعشرين من يونيو مشرقاً هادئاً ليعلن على استحياء بداية فصل الصيف. لم يستطع الصيف المبتديء أن يمنع النسائم من المرور بأوراق الشجر العالي أو من التسلل إلى الداخل والعبث بالستائر الخفيفة. لكن النسائم كانت أضعف من أن تملأ قطع الفراغ. كنت أعد نفسي للخروج عندما سمعت صوت ارتطامات قوية متتابعة، أعقبها صوت سقوط جسم ثقيل، تلته صرخة مدوية. لم أستطع استيعاب ما يحدث، لأول وهلة ظننتها قططاً تلهو وتتدافع على الدرج وتتعثر في سلال المهملات؛ تصورت بعض القطط تقفز عالياً وتسقط لترتطم بالأرض، إلى أن اخترقت رأسي تلك الصرخة التي جعلتني أصرخ. أسرعت بالخروج لكنني توقفت عند عتبة الباب، شحذت سمعي لألتقط أي صوت لكن سكوناً قاتلاً كان يحيط بالمكان. فتحت عيني عن آخرهما لكنني لم أجد أمامي سوى الأبواب المغلقة والدرج الذي لا ينتهي. أخذت أتشمم الهواء، كان الجو يحمل إشارات جديدة لم أفهمها. تسللت نحو الدرج وأخذت أنزل السلالم بحذر تسبقني عيوني. توقفت أمام شقة “السيدة قطة” وأخذت أتأمل الباب والعين السحرية. أخذت أقترب من الباب حتى كادت أنفي تلامسه بل إنها لامسته ودفعته فانفتح. الباب لم يكن مغلقاً إذاً! تقدمت بضع خطوات نحو الداخل، كان المكان ساكناً ورائحة القطط تسكن الأرجاء. لم أمتلك جرأة كافية للتوغل أكثر، فأنا لا أستطيع مواجهة “السيدة قطة”، ولا أقوى على التصدي لأفواج القطط التي قد تنقض علي وتطاردني، سأنزل الدرج جرياً. خرجت وبدأت أجري وأفواج القطط تطارد ذهني. تعثرت في سلالم الدرج وسقطت بجانب الحائط. وعلى بعد خطوات شاهدت حذاء أسود ملقى بإهمال. تمالكت نفسي وواصلت النزول، وفي الدور التالي وجدت وشاحاً وردياً يفترش الأرض. واصلت النزول، وفي الدور الذي يليه وجدت قبعة سوداء صغيرة. دارت في ذهني دوامة من الأفكار وأخذت تتسارع بشكل جنوني. نظرت في بئر السلم فاصطدمت عيناي بفوضى عارمة، كانت أوراق الجرائد مبعثرة والقطط تغدو وتروح بينما الطيور تحلق على مقربة من سطح الأرض. تداخلت الأشياء في بعضها وكأنها لوحة ممزقة. وفي وسط الفوضى تبينت عينين زجاجيتين خضراوين وابتسامة واهنة ذائبة في معالم وجه متهالك. لا أتذكر أنني استكملت نزول الدرج، وقفت متسمرة أشاهد نفسي تقترب من “السيدة قطة” الملقاة على الأرض مخضبة بسائل أحمر يخرج من شق كبير في رأسها. وقفت أشاهد الطيور المصبوبة وهي تحلق في الفناء ثم تحط على جسد السيدة بينما تتجول القطط في الفناء وتقترب من “السيدة قطة” لتتشممها وتصدر مواءً طويلاً حزيناً. كانت يد “السيدة قطة” تطبق على قصاصة جريدة تحمل أحداث مثل هذا اليوم منذ بضع سنين، أحداث متكررة بتفاصيل مختلفة حاولت استعادتها عبثاً لتملأ قطعاً من الفراغ!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاصّة مصريّة