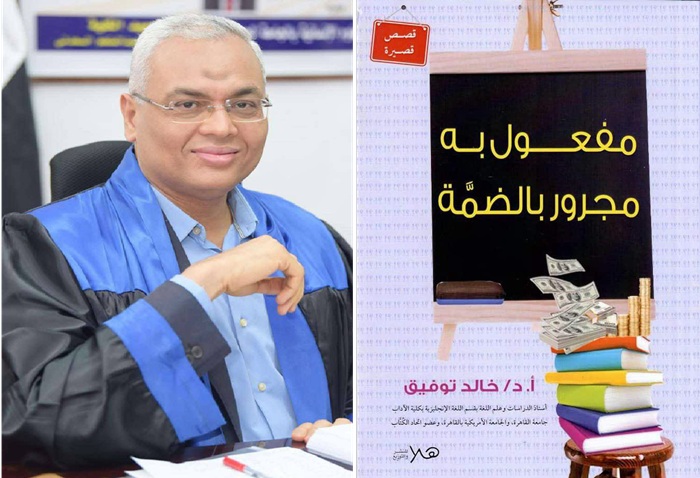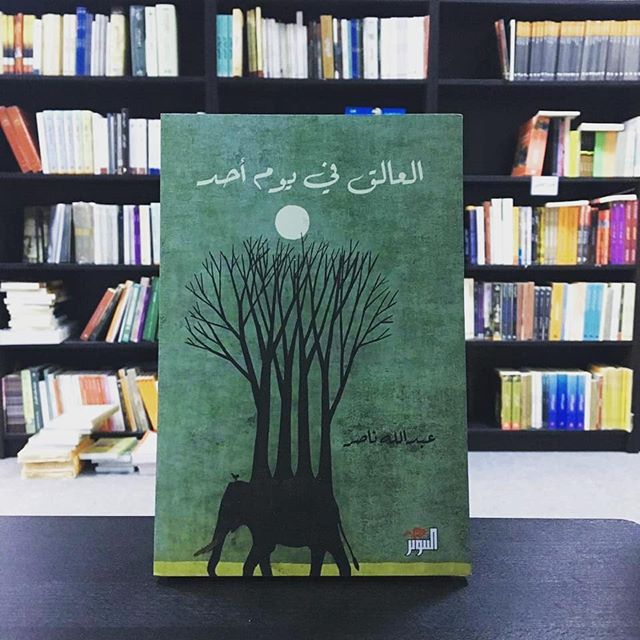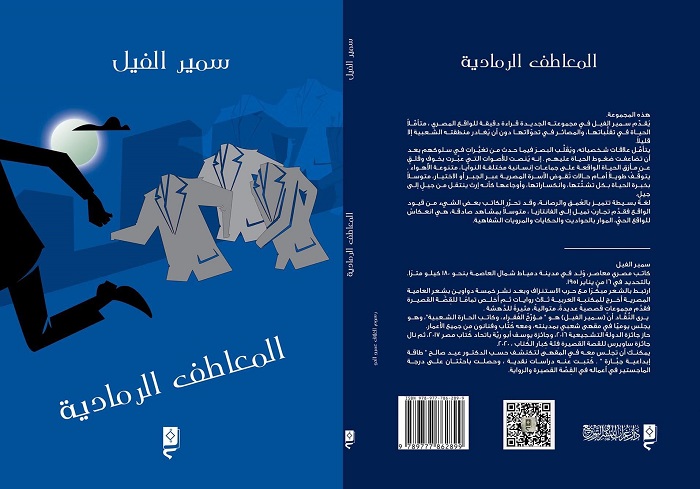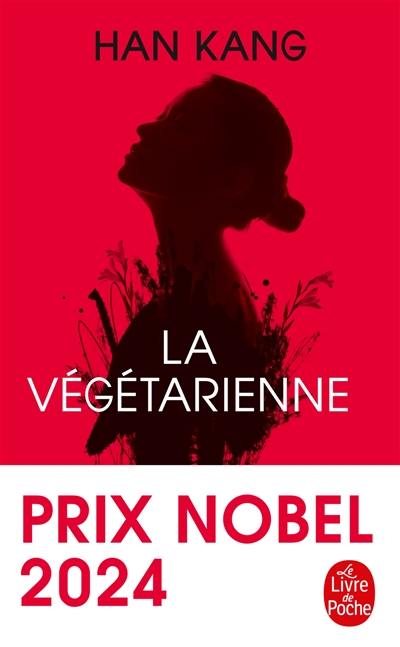فلا هموم ضاغطة، ولا قضايا معضلة، ولا مشاكل وجودية أو واقعية أو حتى فانتازية متورمة، لكن هذا فقط للوهلة الأولى، لأن قراءة هذه المفردات داخل كتابة إبراهيم أصلان يمنحها تاريخا خاصا، نفس الأشياء بمعانيها الاصطلاحية والإجرائية القديمة، ستكتسب بين أصابعه وظائف جديدة يمكنها أن تفسر العالم من ثقب إبرة.
فى هذا الكتاب كتابة مورست عليها كل أشكال التقشف، بدءا من اللغة الوظيفية مقصوصة الزوائد، مدببة الأصوات، والمكان المسور بـ«حجرتان وصالة»، ونافذة فى الغرفة الداخلية تطل على الرصيف ومنه إلى العالم، وحتى الشخصيات التى لا يتكرر فيها سوى البطل وزوجته وشبح ولديهما المتزوجين، إضافة إلى ما يستدعيه الراوى عبر حياة بطله من شخوص، هؤلاء الشخوص يتوهج كل منهم فى الحكاية التى تخصه ثم ينطفئ، إلى أن يعيد أصلان استدعاء كل شخصيات قصصه الجديدة فى القصة قبل الأخيرة «آخر الليل» ليسلموا على الجمهور قبل أن تنزل ستائر الكتاب.
أما الزمن الذى تنامى بخفوت عبر هذه القصص فأعتقد أنه إلى جانب الشعور بالمسئولية الفنية هو السبب فى تصنيف الكاتب لعمله الجديد بالمتتالية وهى: شكل روائى جديد، يتألف من قصص متشابكة منفصلة متصلة لها نفس الراوى المشترك مع اختلاف الأحداث وبعض الأشخاص وإن كان ما يجمعهم مكان واحد.
فى قلب حكاية أصلان المنزلية يسكن الأستاذ خليل وزوجته إحسان، التى شاركته طوال النصف الأول من المتتالية إلى أن «رن جرس التليفون فى الفيلم المعروض بالتليفزيون فى الصالة. وهى سمعت هذا الجرس وقالت: «حد يرد على التليفون يا ولاد» ومالت إلى جانبها الأيمن ولم تقم بعد ذلك أبدا».
لكن هذا لا يعنى غياب إحسان، الزوجة دائمة الضيق والتبرم من زوجها الأقرب إلى غرابة الأطوار، فدورها محفوظ فى أغلب الحكايات التالية، وسيتذكرها خليل وهو يرفع إلى فمه الزجاجة الخضراء التى بلا غطاء ليشرب، وهى التى كان يؤذيها ذلك دائما وتظل تردد:
«يا ريت اللى يشرب من قزازة يرجع الغطا مكانه»،
وسيتذكرها عندما يعود فى آخر الحكاية إلى شقته القديمة ليبعثر الصور مفتشا عن وجهها الجميل بزينتها الكاملة وشعرها المنسدل وبنطلونها القطيفة، وسيظل إلى يوم الأربعين يحكى لأصدقائه أنها ظنت أن رنين التليفون فى الفيلم كان فى شقتهم فطلبت أن يرد أحد، إلى أن قام الممثل عباس فارس ولبس طربوشه ورد، وعندما قام خليل ليخبرها بأن عباس فارس سمع كلامها «من باب الهزار يعنى» كان السر الإلهى قد طلع.
سيبقى خليل وحيدا يروى عنه إبراهيم أصلان مواقفه ولحظاته الإنسانية وصدفه وذكرياته، مع «البواب التخين» الذى لا يُرى إلا نائما، وأم عزت البقالة التى ماتت رغم أنها أصغر من خليل وابنها صاحب السوبر ماركت، والأسطى محمود الإسكافى الذى منذ توفيت زوجته «وهو يقلع هدومه ويقف عريانا فى الطرقة ولا يدخل الشقة أبدا إلا بعد أن يلبس الغيار النظيف»، وزوجته الحاجة ثريا التى لا يموت أحد من أهلها قبل أن يتصابى ويعود بعمره إلى الوراء، ثم يلحق بالأموات فى اليوم التالى، والأستاذ مصطفى وزوجته الأستاذة كوثر العائدة من الإعارة بـ«باروكتها» التى «تلبسها منحرفة مثل الطربوش بحيث تكون مرتفعة عن جبهتها من جانب ونازلة لغاية حاجبها فى الجانب الآخر».
خليل الموظف المتقاعد بهيئة البريد يجرده أصلان فى هذه المتتالية من أبسط حكاياته وأكثرها غرابة، كأن يروى عنه حدوتته مع الكتكوت البنى الذى خرج من البيت «وما رجعش»، وبعدها بفترة طويلة، وخليل عائد من صلاة الجمعة مرورا بالزقاق الجانبى رأى فرخة بنية بنفس لون الكتكوت، فذهب إلى صاحبتها الجالسة «على بسطة السلم» يستفسر عما إذا كانت الفرخة عندها منذ أن كانت كتكوتا أم أنها الكتكوت الذى «هرب من الحاجة زمان».
يمكن للجميع أن يستغرب هذه الحكاية رغم أنها ليست الأغرب من بين بورتريهات خليل الـ(28)، لولاها هذه العبارة الفلسفية الإنسانية، التى فسر بها خليل حكايته للمرأة ذات الكتكوت البنى وللقارئ قائلا:
« شوفى حضرتك. أنا ضيعت ستين سنة من عمرى على الأقل وأنا عندى أسئلة من هذا النوع، نفسى أسألها ولا أقدر، لأنى كنت محرج. ودى مأساة يا هانم، والدليل هو اللى حصل دلوقت، هل فى أى ضرر أصاب حضرتك من السؤال؟»
وهى قالت:
«ربنا ما يجبش حاجة وحشة».
إبراهيم أصلان الذى لا يعرف أنه تقدم فى العمر «إلا من خلال تطلعى فى وجوه الأصدقاء»، ضمن تدوينات خليل قصة غاية فى العذوبة، عن الرجل ذى الشعر الأبيض المنكوش الذى اكتشف فجأة أن «الواد سليمان» ابنه الأكبر قد صار أطول منه وهو الذى كان قبل شهر يماثله فى الطول، الرجل سيكتشف السر فجأة وهو ينظر إلى مرآة الدولاب المعتمة المصقولة فيفاجأ «بالعجوز ضئيل الحجم الذى يتطلع إليه من عمق المرآة»:
«حينئذ غادر الرجل، أو خليل، أو إبراهيم أصلان المكان وعبر الصالة إلى المطبخ. فتح الثلاجة وأغلقها، ورفع غطاء الحلة الموجودة على البوتاجاز ووضعه ثم ترك المطبخ ودخل الشرفة الصغيرة واستند بجسده إلى سورها الحجرى القصير، ورأى النوافذ والشرفات البعيدة الخالية. وهناك، كانت الشمس تغيب مع ارتجافة أخيرة من ضوء النهار فى الأفق البعيد».
يذكر أن هذه القصة التى حملت عنوان «آخر النهار» قد تحولت إلى فيلم قصير قام ببطولته الفنان التشكيلى صلاح مرعى وأخرجه شريف البندارى وحمل عنوان «ساعة عصارى».
وأذكر أن فى هذه القصة وكل قصص الكتاب تبدأ الحكاية قبل أن يعرف القارئ وتنتهى قبل أن يتوقع، لكن الرهان على المتعة، على حيوية وبشرية الشخوص، فهو أصلان الذى يرى أنه «إذا اخترعت شخصية واخترعت لها سيكولوجية.. واخترعت لها مصيرا.. فأنت بهذا قد اخترعت جثة».
أما لغة الكاتب فى هذه النصوص وغيرها فهى سره الخاص، الذى لا يمنح نفسه إلا له ولن «يستطعمها» القارئ إلا منه، هى الكلمات التى تحدث صوتا معينا وتخلق صورة بصرية بعينها تتراص منتجة حياة.
فى هذه المتتالية سيصدق القارئ بشدة تصديرها الذى على غلاف الفنان الكبير «محيى الدين اللباد» حيث «ثمانى وعشرين حكاية منزلية عن زوجين، أودع فيهما أصلان خبرة نادرة فى تخليق نوع من القصص لا تكاد تبدأ قراءاته حتى تكتشف فى الكاتب والكتابة والحياة اليومية درجات من الدهشة ربما لم تلتفت إليها أبدا،ما يجعل هذه الحكايات تعيش فى ذاكرة القارئ طويلا».
أخيرا وكعادة مبدع «مالك الحزين» سينهى إبراهيم أصلان نصه المتقطع بقصة يبدأ فيها نهارا من أوله، بعدما يعود بطله المراوغ إلى شقته القديمة بالحى الشعبى ويتناول الكوب الألومونيا ذا الرقبة الضيقة والشفة العليا المقلوبة إلى الخارج، ويبعث به طفلا من سكان العمارة ليملأه من عند «منصور بتاع الفول»، قبل أن يجلس البطل «منتعشا مثل رجل غلبه النوم فى مكان يعرفه ثم قام ليجد نفسه فى مكان غريب».
هكذا ينتصر إبراهيم أصلان على غربته ويستجيب للنوستالجيا ويعود، بعدما كان قد أعارنا همه فى عمله الفائت «شىء من هذا القبيل» الذى صدره قائلا:
«أُنزع الآن عن إمبابة/ كما تنزع قطعة لحاء جافّة/ وإن كانت حية/ عن جذعها الطرى كى تلتصق بجذع آخر».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاعرة مصرية