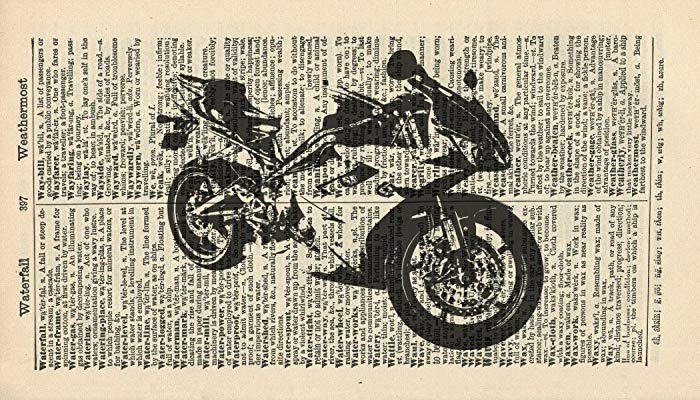محمد العمراني
“إن نجحت في الوصول إلى إسبانيا، فإنني أعدكم بهدايا ثمينة، أصطحبها معي من “فْوِينْلاَّبْرَادَا” عند أول زيارة أقوم بها إلى المغرب بعد السفر”.
كان هذا ما أعلنه حسن لجماعة من أصدقائه؛ أحاطوا به في إحدى زوايا الحي؛ مُقسما على ذلك بأغلظ الأيمان.
ولا يبدو على أولئك “الموعودين” أخذهم للأمر على محمل الجد، ذلك أنها ليست المرة الأولى التي يقدم لهم فيها الشاب مثل هذا الوعد، فقد سبق أن فعل ذلك قبل هذا اليوم، مرة ومرات.
لم يتخل حسن يوما عن حلمه في الهجرة، فهو، ومنذ ما يزيد على عقد من الزمن، ينام ويستيقظ عليه. يتألم كثيرا لعدم نجاحه في تحقيقه لحد الآن، بل ويبكي عندما يكون لوحده. في صلاته تراه يطيل السجود؛ يدعو الله بكل خشوع وإلحاح أن يحقق له أمله المنشود ذاك. لكنه وبالرغم من توالي فشله، فهو لم ولن يستسلم، وسيظل يكرر المحاولة إلى أن ينجح أو يهلك دون تحقيق حلمه ( أو هكذا كان يُصرح دائما).
وقد يُسأَل حسن من طرف البعض عن أسباب هذا الفشل الذي تكرر معه لأكثر من عقد من الزمن، فتكون إجابته هي نفسها دائما “إنه الحظ العاثر الذي يجانب الآخرين دائما ويلقي برحله عند بابي”. وبالتالي فأنت لن تعرف حقيقة الأمر إلا إذا استفسرت عن السبب من أحد مرافقيه في محاولات الهجرة العديدة التي قام بها، ليُسِرّ لك بأن الشاب، ولسُمنته، كان يتعذر عليه إيجاد موقع يناسب حجمه أسفل شاحنات نقل البضائع أو حافلات نقل المسافرين، هذا مع حالتي خوف شديد وضيق في التنفس تنتابانه، إذا ما نجح في التموقع هناك، مما كان يدفع به إلى مغادرة المكان بأسرع وقت.
وبالإضافة إلى هذه الأسباب، فقد حاول والداه ثنيه عن فكرة الهجرة أكثر من مرة، داعيين إياه إلى التركيز على حرفته التي يُشهَد له فيها بالتفوق والتميز، لكن من دون جدوى. وفي هذا السياق، وجب التنويه إلى أن الشاب نجار ماهر، بل هو فنان تُبدِع أنامله تُحفا رائعة، لكن كل هذا كان في الماضي، أي قبل أن يعشش أمر الهجرة في عقله ويصرفه عما دونه.
وبإيعاز من والديه دائما، كان تدخل بعض المهاجرين القدامى في الحي ذات يوم، مُحاولين إقناعه بالعدول عن فكرة الهجرة؛ معلنين له عن تغير أحوال أوروبا وإسبانيا الاقتصادية، مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عقدين من الزمن، فالأزمة والغلاء وانعدام فرص الشغل والعنصرية هي العناوين الكبرى في السنوات الأخيرة، وبالتالي فلا فائدة ترجى من مغامرته تلك. لكنه لم يكن يأبه لمثل هذا الكلام، الذي كان يسمعه على مضض، بل كان يتعامل معه بريبة شديدة، رادًّا إياه إلى رغبة هؤلاء الناصحين في التمتع ب”الكعكة” لوحدهم؛ حسدا وخبثا من عند أنفسهم.
وحتى قبل أن تطأ قدماه أراضي الجارة إسبانيا، كان حسن قد جمع معلومات وافية عن هذا البلد ولغته، فهو، ومع مرور السنوات، غدا قادرا على تحقيق الفهم والإفهام مع مخاطبيه باللغة الإسبانية دون عناء كبير.
وبالرغم من معرفته الواسعة بجغرافية إسبانيا، فإن الشاب المغربي كان يختزل جميع مدن ومناطق هذا البلد الأيبيري في “فْوِينْلاَّبْرَادَا”. ويعود ارتباطه بهذه المدينة الصغيرة- والتي لا تبعد كثيرا عن مدريد العاصمة وتتبع إداريا لإقليمها- لكثرة ما سمع عنها وعن أخبارها؛ مترددة بين المهاجرين من أبناء الحي الذين وصلوا إليها واستقروا بها.
وكخبير بتفاصيل العيش في هذه المدينة، كنت تقف عليه وهو يحاضر وسط من تبقى في الحي من أقرانه: “في “فْوِينْلاَّبْرَادَا” يمكنك الحصول على أضعاف الأجر الذي قد تحصل عليه هنا، لكن عليك بالجدية و”المَعْقُولْ”. الناس هناك ينامون باكرا ويستيقظون باكرا. السبت والأحد هما يوما عطلة، ووجب أن تُحسن استغلال الوقت فيهما بشكل جيد؛ فتُخصِّص السبت للتسوق وقضاء باقي الأغراض، فيما يكون الأحد للراحة والتنزه رفقة الأهل والأصدقاء. الأطعمة والمواد الغذائية متوفرة بكثرة وبأثمنة مناسبة. اللحوم الحلال كذلك”.
وفي “فْوِينْلاَّبْرَادَا” يعتقد حسن بأنه لن يُعاني مثل ما يفعل باقي الناس أمثاله في بلاد الغربة، فله فيها كثير من الأصدقاء “الخُلَّص” الذين يشجعونه على المجيء، ويعدونه باحتضانه في بيوتهم عند قدومه.
ويبدو الشاب مُصدِّقا لتلك الوعود ومتشبعا بها، بالرغم من تحذير ابن خالته “يونس” له، والذي كثيرا ما ردد على مسامعه حكايته مع أولئك “الخُلَّص” الذين، وبعد أن أشبعوه من معسول الكلام في المغرب، تنكروا له جميعا وأقفلوا أبوابهم دونه حينما طرقها في أول أيامه ب”فْوِينْلاَّبْرَادَا”، “الناس في بلاد الغربة ليسوا هم أنفسهم الذين تعرفهم في المغرب يا صديقي. الشعار المرفوع هناك هو: “نفسي..نفسي” فلا تغتر بما تسمعه من جميل الكلام.” هكذا كان يقرر يونس في حديثه مع حسن.
وفي فصل الصيف كانت أحزان الشاب تتضاعف وتشتد أكثر. هكذا، وابتداء من الأيام الأولى من الشهر “السابع”، كان يتوالى تقاطر أبناء الحي المقيمين في الديار الإسبانية، وهم في أغلبهم أصدقاء للشاب؛ سبق وأن رافقوه إلى ميناء المدينة لأيام وشهور قبل أن يبتسم لهم الحظ ويوفقوا في الوصول إلى “الإِلْدُورَادُو” الشمالي.
وكنت تجد الواحد منهم وقد عاد أنيقا في ملبسه، مُتقلدا محفظة جلدية صغيرة، مع رائحة عطر قوية تفوح منه. يحط رحاله أمام البيت فيهرع من فيه من الأهل لاحتضانه؛ مُرحبين به وبحمولته، رافعين أبصارهم نحو باقي بيوت الجيران، وكأنا بهم يُعلنون النصر أخيرا؛ النصر على الفقر والحرمان وعلى “العُدْيَان” كذلك.
ويحرص أولئك العائدون على ألا يكون دخولهم إلى أحيائهم على متن سيارات الأجرة، ولهذا كنت تجدهم يبذلون كل ما في وسعهم لكي تكون عودتهم “المظفرة” تلك على متن سيارات خاصة؛ يقتنونها -في الغالب- قبل حلول موعد السفر بمدة قصيرة.
وخلال أيام إقامتهم ببيت الأهل، كان الكثير منهم يقضون أوقاتهم مرابطين عند السيارات المتوقفة أمام البيوت؛ مُتعمدين ترك أبوابها مفتوحة، وجاعلين أجهزتها الموسيقية تصدح بأغاني “الراي” وبباقي صنوف الموسيقى الشعبية، هذا مع رائحة مُعطرات قوية تُتخذ لإثارة الانتباه إليها.
وبالإضافة إلى هذه المشاهد المؤلمة لحسن، فقد كان حزنه يتعمق أكثر وأكثر عند علمه بقران يعقده أحدهم على فتاة الأحلام في الحي، والتي كنت تجدها وصويحباتها يتهافتن على هؤلاء “الناجحين”؛ منتظرات بشوق جارف تلك اللحظات التي سيركبن فيها البحر نحو “الخاريج”، ملتحقات بأرض الأحلام؛ حيث الأمل والمستقبل والخير العميم (أو هكذا كن يتمثلن الأمر).
يراقب الشاب كل ذلك وهو يتحسر على حظه الذي لم يسعفه في نيل زينب ابنة “عمي إبراهيم” التي لن يستطيع التقدم إليها في وضعه الحالي. وهو مع حسرته تلك، مُتوجِّس من مآلات الأمور مع حبيبة القلب، إذ قد يخطفها منه أحد أولئك العائدين في أي لحظة، وهي طبعا لن تمانع فإغراءات “الخاريج” وأهله لا تقاوم.
……………………………..
* كاتب من المغرب