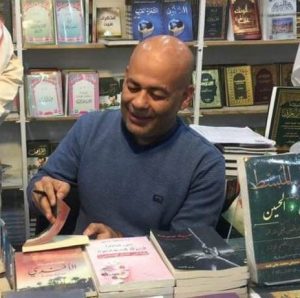تحرير وتقديم: محمد فرحات
مقدمة المحقق
في بدايات العقد الأخير من القرن العشرين (التسعينيات) كنا في أحد المخيمات اليسارية ببيروت لبنان العريقة، وكنت حينئذ، في نهايات العقد الثاني من عمري؛ فتًى يساريًا متحمسًا، في التاسعة عشر من عمره، جاء لتوه من مصر، في أول رحلة له خارج البلاد، وما أن وطأت قدمي أرض المخيم، حتى سمعت لأول مرة أبيات شعر وقعت في أذني، فأثرت بنفسي، وأسرت روحي:
“لا حق لحي إن ضاعت في الأرض
حقوق الأموات..
لا حق لميت إن هُتكت عرض الكلمات..
إن كان عذاب الموت..
قد أصبح سلعًا..
أو أحجبة..
أو أيقونه..
فعلى العصر اللعنة ..
والطوفان قريب..”
فسألت من ألقى هذه السطور الشعرية عن كاتب هذه السطور، فنظر إليَّ متعجبَا، وقال لي بلهجته البيروتية الشامية، “من مصر، ولا تعرف من قالها؟!”، “إنه نجيب سرور يا زلمة!!”..
كنت أول مرة أسمع اسم نجيب سرور، مع ولعي، وتبحري النسبي، وقتئذ بعالم الأدب في مصر خاصة، علمت أن هذا الشاعر العظيم له قصة، وأن قصته واسمه وشعره كانوا محل تشويش وتعمية وتجهيل بمصر، فأخذت في البحث عن نجيب سرور، فوقعت في يدي طبعة بيروتية من ديوانيه “لزوم ما يلزم” و”برتوكولات حكماء ريش” فعكفت على قراءتهما، فإذا بي أمام شاعر فذٍ، ليس فقط بمجال الصياغة الشعرية من شكل جديد، ولكنه مضمون بكر لم يسبقه إليه أحد.
وأخذت بسؤال الرفاق الشوام عن نجيب سرور، وقصته، فعلمت الكثير عن مأساته الشخصية، والتي كان سببها الأول؛ عدم انفصام ما يعتقده نجيب سرور عن قوله وفعله وحتى ممارسات يومه الصغيرة، هذا التطابق بين الاعتقاد والممارسة في بلادنا هو تذكرة الدخول لأبواب الجحيم الدنيوية، وذلك العالم السفلي لممارسات السلطوية التي لن ترحم شاعرًا يساريًا صادقًا مؤمنًا كل الإيمان بقضيته، وحريصًا على طرحها كشاعر وممثل ومخرج ومؤلف مسرحي وناقد وأستاذ لفنون المسرح، وعلمت ساعتها لماذا كان نجيب سرور ومنجزه محل تجهيل وتعمية من قبل الأنظمة السلطوية في عالمنا الرأسمالي المتوحش.
وحينما عدت إلى القاهرة، عكفت على قراءة ما أتيح لي من مسرحيات مطبوعة لنجيب سرور، فوقعت على رباعيته المسرحية الشهيرة، فزاد يقيني بعبقرية هذا العملاق.
علمت الكثير والكثير حينما طالعت رباعياته الهجائية غير المسبوقة في تاريخ الأدب قديمه وحديثه “أميات”، وكنا وقتها في مرحلة غليان سياسي وحراك اجتماعي بدأ في 2005 بحركة “كفاية” وانتهت بذلك الحراك الثوري المجهض ب 25 يناير 2011، وكانت “أميات” سرور توزع كمنشورات سرية على رفاق الحراك، وكانت نبوءة صادقة لما سيحدث وما حدث بالفعل.
كان “نجيب سرور” أيقونة روحي وفكري، ربما فقط على النظاق التنظيري، فلا طاقة لي على هذا التطابق الصارم بين الاعتقاد والممارسة كما فعل نجيب!
وفي يناير 2022، تموت “ساشا كورساكوفا”، زوجة نجيب سرور وحافظة خزينته الأدبية وناشرتها الأولى، إيزيس العصر الحديث، في أجواء حزينة مأساوية، فأتعرف على الأستاذ “فريد نجيب سرور” أعلم ساعتها أن روح نجيب سرور قد اختصني بدور وبرسالة، وبالفعل يعلن “فريد سرور” مشروعه لرقمنة تراث “نجيب سرور”، فأجد نفسي مدفوعًا بقوة للمشاركة، وأنا كهل في نهاية الأربعينيات من عمري.
فإذا بي أمام كنز من المخطوطات التي تحمل أفكار ومعتقدات “نجيب سرور” الشعرية والمسرحية والنقدية، مخطوطات تربو عن الخمسين ألف ورقة، تحتوي على المسودات والأعمال الكاملة وحتى الوريقات الصغيرة المتناثرة التي كان يكتب عليها “نجيب سرور”، كعادته حينما يكون في مكان غير ملائم للكتابة.
هذا الخزانة تعد بتقديم الجديد من أعمال لم يعرفها القارئ العربي من قبل لنجيب سررو، وجدت نفسي وبتوصية من الصديق فريد نجيب سرور، أمام ثمانية كراريس مخطوطة بخط نجيب سرور، الكراسة الأولى والتي تحتوي على أربعين صفحة مكتملة تحكي عن مأساة القبض على نجيب سرور وإيداعه مستشفى العباسية عام 1969، وفلاش باكز، تحكي عن لمحات من حياته في قريته، وحكاية أبيه وأمه، بطفولته المبكرة، وهي المخطوطة الوحيدة المكتملة من التسعة مخطوطات، والتي لم تأخذ شكل المسودات التي سادت في باقي المخطوطات، ولعل ما يثبت ذلك أن إحدى المخطوطات هي فوتو كوبي لذات تلك المخطوطة الأم المكتملة، ربما صورتها ساشا لتقديمها لأحد الأدباء أو الصحفيين.
* دراسة ظاهرية مختصرة للمخطوطات.
عنون الصديق فريد نجيب سرور المخطوطة الأولى باسم “فارس آخر زمن”، وهي عبارة عن ثلاث وأربعين ورقة فلوسكاب، عنونها الراحل “نجيب سرور” بخط يده، “فارس آخر زمن” “رواية”.
أما المخطوطة الثانية فقد عنونها الصديق فريد سرور تحت عنوان،”مشروع كتاب جديد، 4a00″ وهي عبارة عن تسع عشرة صفحة فلوسكاب، تسودها روح المسودة، إذا يكثر فيها تكرار العبارات، والشطب والإثبات.
وقد كانت المخطوطة الثالثة هي ذات المخطوطة الأولى ولكنها فوتوكوبي، ربما صورتها السيدة الجليلة ساشا كورساكوفا، لتقديمها لأحد الأدباء، خاصة وأن الأستاذين طلال فيصل وحازم خيري يكثران من الاقتباس منهما، بدون إشارة للمصدر!
والمخطوطة الرابعة عبارة عن عشر صفحات فلوسكاب، بخط يد الأستاذ نجيب سرور، عنونها فريد “مشروع كتاب فارس آخر زمن” a4. وهي أيضًا مسودة بخط يد الأستاذ، يكثر فيها الشطب، وإعادة الفقرات والعبارات.
والمخطوطة الخامسة عبارة عن صفتحين من مسودة كتاب”دراسة في ثلاثية نجيب محفوظ” وهي رسالة الدكتوراة التي كان ينتوي الراحل تقديمها لكلية آداب ولغات جامعة موسكو، الاتحاد السوفيتي.
والمخطوطة السادسة وهي الأضخم وهي عبارة عن تسع وخمسين صفحة، ولكنها وللأسف عبارة عن دراسة نقدية عن الشاعر “مالك نوري” ولا تمت لموضوع مشروع الرواية بصلة. وقد عنونها الصديق فريد تحت اسم”كراسة حساب بني”.
أما المخطوطة السابعة التي عنونها الصديق”كراسة حساب سوداء” فهي عبارة عن صفحتين كراسة حساب مربعات، وهي مخطوطة لقصيدة من ديوان “إنه الإنسان” والتي سبق أن حررناه في عمل مستقل.
والمخطوطة الثامنة وهي عبارة عن ثلاث عشرة صفحة من الرواية، وهي بخط يد الأستاذ عبارة عن سرد عن أوصاف أبيه وعلاقته بزوجاته وأبنائه وبناته، وعنونها فريد تحت اسم “كراسة حساب كبيرة”.
أما عن المخطوطة التاسعة والأخيرة “فهي عبارة عن صفحتين، تحكي عن لقاء الأستاذ نجيب سرور بمدير المخابرات المصرية “أمين هويدي” والسبب الرئيسي لاحتجازة بمستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية، وعنونها فريد تحت اسم””من مشروع كتاب فراس آخر زمن.”
منهجنا في التحرير.
وقد حرصت كل الحرص على إثبات كل كلمة كتبها الأستاذ بخط يده، حتى العبارات والفقرات المشطوبة أعدت تحريرها، التي ربما كررها الأستاذ حوالي الخمس مرات، بألفاظ وأساليب مختلفة.
مما أسفر عن أبع وخمسين صفحة a4، وحوالي تسع عشرة ألف كلمة، هي كل ما كتبه الأستاذ بمشروع روايته الوحيدة، مما يعد مذكرات حقيقية كتبها الأستاذ، وقد اقتبس منها الكثير كلٌ من الأستاذين حازم خيري في مقدمة دراسة الأستاذ نجيب المعنونه”تحت عبائة أبي العلاء المعري”، والتي حررها الأستاذ حازم خيري، ونشرها المجلس الأعلى للثقافة، ط1، 2008، القاهرة، مصر.
وربما اقتبس منها طلال فيصل في روايته “سرور” الحائزة على جائزة ساويرس، ونشرتها دار “الكتب خان للنشر والتوزيع” 2013.
وعلى الرغم من عدم اكتمال المخطوطة، إلا إنها تعد وثيقة ثرية، ونادرة عن تفاصيل من حياة الشاعر والمسرحي والناقد العظيم نجيب سرور، تستحق بكل جدارة نشرها، واطلاع القارئ العربي عليها، لأنها تؤرخ عن فترة تاريخية كبرى من تاريخ مصر والوطن العربي من الفترة 1932 إلى 1969.
محمد أحمد فرحات.
الشهداء.
20 ديسمبر 2022.
************
فارس آخر زمن
رواية لنجيب سرور
“1”
عند مدخل شبرا، أحاطت به أربع سيارات سوداء، كان في التاكسي، وكان في طريقه إلى الإسكندرية، اقتحم ثلاثة رجال طوال القامة التاكسي، جلس أحدهم بجوار السائق، وجلس اثنان في الخلف، أحدهما على يمينه، والآخر على يساره، ودون كلمة تحرك التاكسي، وكان السائق يعرف الطريق-بحكم العادة- وبعد دقائق وجد نفسه في أحد أقسام البوليس، جذبته الأيدي الثقيلة إلى خارج التاكسي، ثم عادت فدفعته إلى مدخل القسم، ثم إلى السلم.
ارتقى السلم، ومشى في طرقة صغيرة ودخل، فوجد نفسه أمام مكتبين يجلس على كل منهما أحد الضباط الشبان، أجلسوه على أريكة بين الضابطين، وأغلقوا الحاجز الخشبي الذي يفصل بين المكتبين، ومدخل الغرفة الضيقة، فجأة رنّ جرس التليفون، رفع الضابط الذي على يمينه السماعة..
-أيوه يا افندم..أيوه.مفهوم..
والتفت إليه، ثم وضع السماعة؟! إنهم لا يضيعون الوقت حين تدعو الضرورة إلى الاستعجال، ويبدو أنهم في عجلة من أمرهم هذه المرة، كان يعرف مصيره جيدًا، ولذلك قرر بينه وبين نفسه ألا يترك العالم دون فضيحة، لم تمض دقائق حتى امتلأت الغرفة الضيقة بعشرات من النسوة والرجال والصبيان من كل المهن، من أين جاءوا بهذه الكثرة؟! وفي هذه المدة القصيرة؟!!
كادت الغرفة الضيقة تنفجر بالضوضاء حين قال للضابط بصوت مرتفع:
-اقدر أعرف إنتو جايبني هنا ليه؟
فردّ الضابط بحدة:
-اقعد ساكت!
-اقعد ساكت، يعني إيه؟!
-يعني تخرس!
-إنت اللي تخرس، وتتلم، وتكلمني كويس..
هدأت الضوضاء في الغرقة، وتحولت إليه كل العيون، ونظر إليه الضابطان بذهول، ثم كتم الضابط غيظه للإهانة، وانكب على دفتر كبير أمامه، وراح يفر أوراقة بعصبية.
**
أصبحت الغرفة والطرقة وسلم القسم أشبه بخلية نحل، وكانت الضوضاء أشبه بضوضاء السوق، توجس شرًا، فمن الجائز أن كل هذا مدبر للتغطية على صراخه فيما لو بدأوا جولة التعذيب الأولى. أم أن البخت الأسود سيخلف ميعاده هذه المرة، ولهذا جاء كل هؤلاء الناس من كل الأصناف والأعمار، ليكونوا شهود إثبات على جريمة توشك أن تتم!
راح يتأمل العيون المحدقة فيه، كان فيها أسًى وأسف، قرأ في بعضها نظرت تشجيع صامتة مكتومة، في لحظات الضعف والوحدة، لحظات المصير، نتشبث بالأمل في أي شئ!
تراهم يعرفون ما سيحدث له؟! كم مرة حدث بعلمهم هذا الشئ الذي يوشك ان يحدث، وهو مارقمه في السلسة الطويلة، في الفهرس الطويل ممن حاصرهم الرجال ذوو القامات الطويلة والأيدي الثقيلة، في الأزقة والحارات والشوارع والورش والمصانع والمدارس والمنازل! لهذا لابد أن نكون نحن أيضًا هنا لاهم فحسب. لابد أن نكون في كل زاوية وركن مثلهم تمامًا، نرى كل شئ، ونسمع كل شئ. حتى ولو بدا أننا عاجزون عن فعل أي شئ، إلى حين تحين لحظة الحساب فنفر نحن أيضًا دفاترنا كما يفعل حضرة الضابط الآن!
شعر بالراحة قليلًا وهو يتأمل العيون، الوجوه المصفرة، العيدان الهزيلة الذابلة، الأيدي المعروقة المتسخة، الملابس المهلهلة، لمح رغيفًا وقطعة جبن في يد صبي صغير!
جائع “هو” وعطشان! أدار بصره في الغرفة، كانت فوق رأسه مباشرة نافذة صغيرة تتربع فيها قلة، لمحها وهم يدفعونه أمامهم منذ قليل إلى الضابطين، نهض وتناول القلة دون إذن وشرب!
نظر إليه الضابطان مرة آخرى وفي عيونهما الغيظ، أحس بالشماتة في الضابطين، على العموم لقد تمكن من الشرب رغم أنفهما!
تذكر عندما كان أجيرًا في أرض الباشا ولفحه العطش الشديد، طلب من الخولي أن يسمح له بالذهاب إلى الترعة ليشرب، لكن الخولي أصر على أن ينتظر حتى القيلولة، الميعاد المحدد للأكل والشرب، كان صغير السن لدرجة لا تحتمل فهم العطش والقيلولة والخولي، انتظر لحظات حتى ذهب الخولي إلى آخر صف الأنفار، وجرى مسرعًا في اتجاه الترعة، رآه الخولي فراح يناديه، إرجع يا ولد، يا ولد إرجع، إرجع يا ابن الكلب، واستمر هو في الجري غير عابئ، وانكب على ماء الترعة يشرب ويشرب في لهاث، ثم عادّ، فسلم نفسه للخولي، وتلقى ضربات الخيزرانة على كل جزء من جسمه العاري إلا من جلباب كستور مقلم كان يرتديه على اللحم الطري..
**
-نبيل محمد منصور!
جاءه النداء من الخارج، ثم دخل عسكري إلى الغرفة، وكرر النداء، فردّ نبيل:
-افندم..
-قوم فزّ تعالى..
-على فين؟!
نهض الضابط الذي على يمينه، وجذبه بشدة، فأوقفه، ثم جذبه مرة آخرى، ودفعه أمامه بقسوة إلى خارج الحاجز الخشبي، فتلقفه العسكري من ياقة قميصه، وضيق على رقبته الخناق، وسحبه إلى الطرقة الخارجية.
كانت الطرقة تنتهي إلى بلكونه صغيرة، تطل على ساحة خارج القسم رآها من التاكسي، مزدحمة بالمارة والباعة والسيارات، ولاحظ محل أحذية صغير متواضع، على يمين الداخل إلى القسم، ودون تفكير ترك قميصه في يد العسكري، ووقف في البلكونة يصرخ، كان صوته جهوريًا:
-نبيل منصور الشاعر، ينشنق ليه؟!
نبيل منصور..
راح يكرر هذه العبارة كالأسطوانة، وبأعلى ما وهبته الطبيعة من صوت، وقف المارة أمام القسم، وازدحمت الساحة كما لو كانت هناك مظاهرة، كان يقف في البلكونة، بحيث يمكنه أن يرى ما وراءه داخل القسم، وما أمامه في الساحة، وقف الضابطان والعساكر والناس في الطرقة ينظرون إليه، ولا يتحركون، فهم يخشون الاقتراب منه، فربما قذف بنفسه من البلكونة إلى الساحة، وهو مازال يكرر نفس العبارة، فتحت نافذة فوق رأسه، وناداه صوت:
-تعالى يا نبيل، إطلع أنا عايزك..
قال أحد العساكر:
-سيادة المأمور عايزك..
صرخ نبيل:
-عايزني في إيه المامور؟ عشان يبقى الشنق دكاكيني؟..لأ..خلوها كده ع البهلي، على عينك يا شايف، نبيل منصور الشاعر يتشنق ليه؟
لا تكفّ عن الصراخ حتى الموت، إلعب بكل ما تبقى لديك، حتى بأنفاسك الأخيرة و”العيار اللي ما يصيبش يدوش” هم يلعبون بالصمت والرعب، إلعب بالصراخ والجنون، أنت تعلم المصير الذي ينتظرك، وكنت تعلم منذ زمن بعيد، وها قد حانت لحظات النهاية، ولن يغير منها شئ أن تخرس، أو تبدو عاقلًا أو معتوهًا أو مهذبًا أو قليل الأدب، المصير نفسه عاجز عن أن يأتي إليك بأفجع مما جاء به طوال أربعين عامًا، أربعين عامًا بين قريتك والقاهرة وموسكو وبودابست ودمشق، كنت دائمًا تتوقع النهايات الفاجعة، كنت تسير في الشارع فتحس إحساسًا عميقًا يقينيًا بأن إصيص زرع سيسقط من إحدى البلكونات ليسحق رأسك، أو أن سيارة ستصعد فجأة إلى الرصيف، لتصنع منك مع الحائط “ساندوتش” أو أن أحد أسلاك التروللي أو الترام سينقطع فجأة، ويسقط عليك سقوط الصاعقة، أو أن الموس سيتمرد على يد الحلاق ليحز رقبتك، أو نك ستجد نفسك متهمًا في جناية يحكم عليك من أجلها بالإعدام، بلا سين ولا جيم، أو أنك ستقضي حياتك في أحد الليمانات دون سبب مفهوم، أو أن البلكونة ستسقط بك دون باقي بلكونات العالم، وها أنت اليوم هنا في قسم شبرا بعد رحلة العذاب بلا سبب معقول، كل شئ في هذا العالم يحدث بلا سبب معقول، ترى متى اكتشفت هذه الحقيقة!
متى اصطدمت بالجنون لأول مرة! نعم..نعم..تلك الليلة..من زمان يا دنيا!!
كان العيد يقترب، وكنت صغيرًا جدًا، وتعمل أنت وأخوك بتنقية دودة القطن، نفس الجلباب الكستور المقلم، ومنديل تربطه أمك، إلى رسغك كل صباح على قطعة من الجبن القديمة المغموسة في المش. هذا كل طعام الأيام الشاقة..
كان يعود كل مساء ليضع في يد أبيه أجرة اليوم، خمسة قروش كاملة، خمسون مليمًا، وذات مساء قال الأب للصغيرين:
-أنا مش حاخد أجرتكم من هنا ورايح، العيد قرب، كل واحد فيكم يشتغل، ويكسي نفسه على دخلة العيد..
كانت تلك اللحظة في حد ذاتها عيدًا للصغيرين، وفعلًا، بدأ الصغيران يضعان أجرتهما كل منهما في برطمان خاص به، وبدأت النقود ترتفع في البرطمان يومًا بعد يوم، لم يكن نبيل يراها نقودًا بل كان يراها خيوطًا للجلابية، وكان يتحسس البرطمان كل صباح وهو ذاهب إلى الغيطان تقذفه قرية وتتلقفه قرية، وكل مساء وهو عائد مع الإجهاد والغروب، لكن مرأى الجلباب في البرطمان كان كافيًا كل مساء ليمسح آلام الصبا، وذات مساء جلس الأب والأم والصغيران إلى طبلية في صحن الدار، يتناولون العشاء، وباب الدار مغلق عليهم كالعادة، دقّ الباب، كان هو قريبًا منه، قام وفتح، وعادّ يجلس إلى الطبلية دون أن يرى من القادم، ثم رأى امرأة عجوزًا في ذيلها صبي يربط ذراعه اليسرى المكسورة الموضوعة في الجبس إلى عنقه..
-منصور أفندي هنا؟
كان أبوه أفنديًا، ويعمل مدرسًا بالمدارس الإلزامية..
-هنا يا ستي، اتفضلي الأكل..
قالها أبوه..
-بالهنا والشفا
-خير يا ستي!
-خير يا منصور أفندي، بس، ابنك كسر دراع ابني، وكلفني جنيه بحاله عند المجبراتي..
التفت الأب تلقائيًا إلى الابن الأكبر خالد، كان من عادة خالد أن يضرب عيال القرية كلما مرّ أحدهم من أمام الدار. أما الابن الأصغر نبيل فكان في حاله دائمًا، وإن كان عيال القرية قد اعتادوا أن يضربوه هو انتقامًا لشقاوة أخيه، كذلك كثيرًا ما كان يضرب في صباه بلاسبب معقول، إلا لأنه له أخًا يضرب أولاد الناس بلا سبب معقول أيضًا.
-كده يا ابن الكلب!!
صرخ خالد:
-مش أنا يابا!!
وأغاثته العجوز:
-لأ مش خالد يا منصور أفندي..
التفت إليها الأب في دهشة غير مصدق، فلم يكن يخطر بباله ما قالته العجوز فورًا..:
-نبيل..نبيل هو اللي كسر دراع ابني..
صرخ نبيل كمن لدغته أفعى:
-أنا يا خالة؟
ردّ الصبي:
-أيوه انت!
لم تصعقه نظرة أبيه الذي أخذ على غرة، ولكن صعقته صرخة الصبي واثقًا فيما يقول، فعاد نبيل يصرخ:
-أنا يا بني كسرت دراعك؟
-أيوه إنت..
قال الأب:
-نبيل ولا خالد يابني؟
-نبيل يا عم منصور..
-طيب يا ابن الكلب..
أنا حاواريك، صعد الأب إلى الغرفة العليا، وعاد ومعه برطمان نبيل، فأفرغ جلباب العيد في حجر العجوز.
-ابقى وريني بقى حاتعيد ازاي، خرجت العجوز بالجلباب، ونبيل في خرس الذهول، يحدق في البرطمان الفارغ، قام عن الطبلية، ولم يكمل عشاءه.
ويقسم حتى هذه اللحظة، وهو في بلكونة قسم شبرا أنه لم يكسر ذراع ذلك الصبي، بل ولم يكن قد رآه قبل تلك الليلة، ودخل العيد عليه بنفس الجلباب الكستور المقلم القديم، والغريب أن خالدًا أخاه يقسم على نفس الشئ، أيمانات تجمد المياه.
من أين أتت تلك العجوز! لقد ظلت في حياته شبحًا غير مفهوم، تمامًا كأشباح الحواديت، أمنا الغولة والنداهة والجنيّة، عجوز شمطاء غريبة ظلت تطارده، ومازالت تطارده حتى الآن، وأيضًا بلا سبب معقول!
**
فوجئ بأبيه يقف في الطرقة بين الضابطين، طويل القامة يشع رجولة وكبرياء، وسمعه يقول لهما:
-اسمه بره زي الطبل..
هدأ قليلًا، ولكنه لم يطمئن تمامًا، ما يحدث، وما سيحدث له يمكن أن يحدث لأي إنسان دونما فرق بين ابن وأب، تراجع خوفه على نفسه إلى الوراء أمام خوفه على أبيه، إنه يمكن أن يتحمل أي شئ، إلاأن يتعرض أبوه لأية إهانة من العساكر أو الضباط
-لماذا جئت يا أبتي؟ أنا أعلم أنني المقصود فلماذا تقذف بنفسك في وجه التيار الذي لا يرحم!! متى استدعوك، ولماذا؟!
اقترب منه أبوه بطيء الخطو حتى وقف إلى جواره في البلكونة، كف هو عن الصراخ المنهال على الساحة، رأى السور الدائري لقصر الأمير محمد علي.
ولمح أحدهم يكفن سيارة مرسيدس بيضاء بغطاء من القماش، اشتم رائحة الموت منبعثة من القسم، ومن قصر محمد علي، ومن الساحة المنبسطة على مدى البصر، لم ينطق أبوه بحرف، نظر في عينيه الضيقتين، فقرأ فيهما غضبًا أبويًا يعرفه جيدًا، منذ زمن بعيد، هكذا تبدو عينا أبيه كلما غضب، ارتسمت على وجه الأب ابتسامة باهتة منتزعة، ومع ذلك ثبت في كيان نبيل بعض الأمن والطمأنينة.
**
طالما انتظر أباه قبيل الغروب على السكة الزراعية عند مدخل القرية، وهو في صغر العصفورة، كان أبوه يعمل مدرسًا بإحدى القرى البعيدة، وكان يزورهم كل خميس، وطالما منتهم الأم بالهدايا واللعب التي سيأتي بها الأب، وفي كل مرة كان يجئ خاوي الوفاض، إلا من كراريس فاضيه وأقلام رصاص وأصابع طباشير، وإردواز، وأساتيك، لم تكن تشبع آمال الصغير في عودة الأب الغائب، فيعود لينتظر الخميس التالي.
**
أحس وهو في بلكونة القسم بأنه يرجع إلى الطفولة والصبا، وكاد يرمي بنفسه في حضن أبيه، كالهارب من وحش، حين جاءه الصوت الرخيم ردًا على دموع فرت بغتة من عينيه..
-خليك راجل زي ما كنت طول عمرك..
-إنت جاي ليه؟
-طلبوني من البيت بالتليفون..
-وعرفوا إزاي تليفونك؟
-مش مهم..المهم تكون راجل..مهما حصل.
وجاء أحد العساكر بفنجان قهوة، أخذ الأب الفنجان وناوله لنبيل..
-إشرب القهوة..
نظر نبيل إلى الفنجان في شك وتوجس استفادهما من تجارب له سابقة. ثم نظر إلى أبيه الذي قال بلهجة حازمة.
-إشرب القهوة حتى لو كان فيها سم هاري!!
-حاضر..حاضر يابا..
تناول فنجان القهوة امتثالًا لأمر أبيه، وبدأ يشرب بطريقة توحي بالتحدي لكل شئ!
**
دبّ الهدوء في أوصاله، لم يكن قد نام منذ أيام، بل لم يكن قد نام ملء عينيه منذ شهور، كان يشرب ليل نهار، ويمشي في شوارع القاهرة ليل نهار، وينام في الحدائق، وعلى الأرصفة إلى أن يطرده رجال البوليس او أمناء الشرطة أو يأخذوه”تحري” إلى أقسام البوليس حيث يقضي يومين أو ثلاثة، حسب ما يتراءى لأصحاب الضبط والربط، وكان كثيرًا ما يقضي آواخر الليل في الشهور الباردة مصلوبًا بأحد محلات ميدان التوفيقية المعتادة على السهر، ليريح قدميه المتورمتين النازفتين فيما هو يواصل شرب البيرة.
**
في ذلك اليوم كان يشرب كالعادة في بار فيينا بشارع عدلي عندما لاحظ حركة غريبة ومريبة أمام البار وبداخله، لم يعلق على الأمر أهمية، واستغرق في الشرب، ثم فجأة ضربت في دماغه أن يسافر إلى الإسكندرية. ليستريح أيامًا عند شقيقة له هناك، دفع الحساب في عجلة، ونهض وأسرع خارجًا من البار، وأشار إلى تاكسي، واتفق مع السائق على أن يوصله إلى الإسكندرية بالعداد، وافق السائق، لاحظ أن له لحية كلحى السلفيين، استدار الساق واتجه إلى شاررع عماد الدين، وأمام مسرح محمد فريد توقف التاكسي، وفي الناحية الآخرى توقف تاكسي آخر، تبادل السائقان الكلاكسات، ثم التفت السائق إليه وقال:
-أنا متأسف يا افندي، مش حا اقدر أكمل معاك لاسكندرية!
-ليه يا اسطى؟!
-أصل افتكرت إن وراي مشوار تاني!
تقدر سيادتك تاخد التاكسي اللي واقف قصادنا ده، دفع البنديرة، ونزل واتجه إلى التاكسي الآخر وركب، وانطلق التاكسي في طريقه إلى الإسكندرية.
**
أخذه أبوه من يده برفق، فأعطاه نفسه كالحمل الوديع، تركه بين أيدي العساكر والضباط في الطرقة وهبط السلم.
بعد لحظات هبطوا به إلى غرفة الحبس في القسم، كان بالغرفة أربعة في هيئة العمال، أغلقوا الباب الغليظ، كانت بالباب فتحة صغيرة أطل منها رحل مخبول، أو يمثل الخبل وراح يصرخ، شعر كأنما الرجل يقلده، حين كان يصرخ في البلكونة، وخطر بباله مرة ثانية أن الضجة التي يفتعلها الرجل ما هي إلا نوع من التغطية على ما سيحدث الآن، أو ربما بعد قليل في نفس هذه الغرفة، وأمام هؤلاء الرجال الأربعة، لمح المرحاض على شماله في ركن الغرفة، وحنفية مياه مربوطة بسلك، أحس بآلام في الكلى، تعاوده كل حين “نهض ليتبول” أحس بانحباس البول في بادئ الأمر، خجلًا من العيون التي تسمرت عليه، واصل الرجل المخبول الصراخ.
-يا ولاد الكلب يا كفار، افتحوا الباب..افتحوا الباب..افتحوا الباب يا ولاد ال..
ضحك للفظة أخيرة نطق بها الرجل، كانت جارحة، وكانت لهذا مضحكة.
-مساء الخير يا افندي..
قالها أحد الرجال الأربعة، وردّ هو التحية بصوت مكتوم:
-مساء النور..
مرت فترة قبل أن يسأله آخر:
-أمال حضرتك جاي في إيه؟
كان قد اعتاد على إجراءات التعارف الأولية هذه، لكثرة تردده على الأقسام في الشهور الأخيرة على الخصوص، وبخبرته الطويلة كان يدرك أنهم ليسوا متهمين، هم مجرد ديكور بشري يقوم في كل قسم أو سجن برسم الجو المناسب لجر أطراف الحديث مع”الزبون” الجديد الذي يصطاده الرجال طوال القامة ثقال الأيدي و”المرشح” لما يلي ذلك، من إجراءات أكثر قسوة وعنفًا، لذلك لم يكن يعلق أية أهمية على أحاديثهم الملقنة لهم سلفًا، ولا على جرأتهم البالغة في سبّ الحكومة، وتبجحهم الوقح في وجه الضباط وعساكر القسم، أي قسم، إنهم على أية حال، أو في الأغلبية العظمى منهم مجرد ممثلين، ولكنهم لا يجيدون التمثيل، لذلك لم يكن ينخدع فيهم، متسولين كانوا أو ماسحي أحذية أو مرضى أو تجار مخدرات أو خضراوات، فهم هنا للتعرف عليه لا للتعارف به، فكثيرًا ما التقى ببهضهم جرسونات في المقاهي والبنسيونات والخمارات وبائعي السميط وموزعي كبريت وباعة حجر الولاعة “رونسون” وأمواس حلاقة وجوارب وغير ذلك، إذن فهم يمارسون مهنة آخرى تمامًا أبعد ما تكون عن مهنهم الظاهرة”واللي يعيش ياما يشوف، واللي يخش أقسام البوليس يشوف أكتر”.
-جاي في كبسة مخدرات..
-كام وقيه؟
-أربعة..
هم يعرفون-وهو واثق- أنه “جاي” في السياسة، وقد دربوا جيدًا كما تدرب الكلاب..
-أربع وقيّات مرة واحدة؟
قال آخر:
-لأ جدّ..جايبينك في إيه يا افندي؟
-قلت في أربع وقيات..
-بس مش باين عليك يعني!!
-كمان شويه يبان..
-بس دول بيقولوا إنك جاي في السياسة!
-هما مين اللي بيقولوا؟
-العساكر بره..
كان الرجل المخبول مازال يصرخ، وإن كان قد بدا عليه الإجهاد،فجلس وراء الباب، وراح يقرأ آيات متفرقة من القرآن، بلا ترتيب، وبلا اختيار، وكيفما اتفق، فتح الباب، وأطل اثنان من العساكر، يحمل أحدهما عددًا من الأرغفة وورقة بها قطعة كبيرة من الجبن، وراح العسكري الآخر يضع في كل رغيف قطعة صغيرة من الجبن، ويقذف به في حجر كل من الرجال الأربعة، ثم في حجر الخامس الذي توقف فورًا عن قراءة القرآن، وراح يلتهم الرغيف من جوع بادٍ، ثم في حجر نبيل الذي تناول الرغيف بما فيه، وأعطاه لقارئ القرآن، وراح يدير بصره في غرفة الحبس.
**
كان أبوه هاربًا من القرية بعد أن دسّ له أحدهم تحت عقب الباب رسالة صغيرة، يخبره فيها أن الباشا قرر قتله، كما قتل آخرين من قبل، ودخل رمضان، وصممت أمه على أن تظل الدار مفتوحة، ومنورة طول الشهر المبارك، حتى ولو لم يكن رب الدار موجودًا، استأجرت أحد الفقهاء، وأنارت الكلوب كالعادة كل سنة، وظل النور ينبعث من نافذة الدار في قرية تنام كلها بأمر الباشا عند الغروب، استشاط الباشا غضبًا، وأرسل فرقة من الشراقوة، أسهم في إخراجهم من الليمان، وبسط عليهم حمايته، في مقابل قيامهم بقمع الفلاحين، كعادة الباشوات في ذلك الزمان، جاء الشراقوة إلى الدار ملثمين ومسلحين بالبنادق، واقتحم اثنان منهم صحن الدار، ورفعا أريكة أخرجاها من الباب، وجلس عليها الجميع، كانوا خمسة، رأت الأم هذا المنظر فاهتزت غضبًا، بينما راح جده لأبيه، الذي جاوز التسعين يرتعد، لا يدري حتى الآن-هو نبيل- أكان جده يرتعد خوفًا أم غيظًا، ولم تمض ثوان حتى صعدت الأم والصغير في ذيلها إلى الغرفة العليا، وفتحت خزانة الخبز، وأزاحت طبقات من البرسيم والخبز عن كمية من السلاح، أخذت مسدسًا، وحشته كأنها مدربة على هذا العمل منذ زمن بعيد، هبطت السلم عائدة والصغير متعلق بذيل جلبابها، يشده، وطفولته ترتعد خوفًا على أمه، قطعت صحن الدار، وخرجت حاسرة الرأس إلى الشراقوة الملثمين المسلحين، وصوبت المسدس إلى صدورهم..
-قوم انت وهوا من هنا أحسن أفرغ الطبنجة دي في بطونكوا..
-ادخلي ياست انتي، واحترمي نفسك..
-انا اللي احترم نفسي ولا انتوا؟
-احنا مستنين واحد!
-اللي انتوا مستنينه مش هنا، ومش جاي، فز انت وهوا من هنا خللي ليلتكوا تفوت..
-سعادة الباشا محّرج ع الكل ماحدش يولع كلوب، اطفي الكلوب، واحنا نقوم..!
-سعادة الباشا محرم ينقري كتاب ربنا في رمضان؟! قول لسعادة الباشا، الكلوب مش حاينطفي في دار منصور افندي، والقرآن مش حايبطل، خليه يعمل اللي يقدر عليه!
كان أخوه خالد يقف بجوار أمه، حاول أن يخطف المسدس من يدها، فدفعته بعيدًا، لو كان أمكنه هو أن يخطف المسدس ليلتها لفعل ما كان ينوي خالد أن يفعله، فهو لا يشك في أن خالدًا كان سيطلق عليهم الرصاص..
-اسمعي الكلام وادخلي دارك..
رفعت الأم المسدس، أحس الصغير أنها ستطلق الرصاص، غاص قلبه إلى قدميه، جاء الآذان من جامع القرية”الله أكبر”..كانت خيوط الفجر تنسج الصباح الطالع، ظهر أمام الدار فجأة الشيخ إسماعيل”شيخ كتاب القرية، في طريقه إلى الجامع لصلاة الفجر، نادت الأم:
-شيخ إسماعيل..
-أيوه يا ستي!
أطفأ الجد الكلوب، وتسلل المقرئ خارجًا من الدار في خوف شديد، وانسحب الشراقوة الخمسة الواحد تلو الآخر..
في الليلة التالية، أشعل الصغير الكلوب في الموعد، وجلس إلى مصحف كبير وراح يقرأ القرآن، ويتغنى به كما علمه الشيخ إسماعيل في الكتاب، كان صوته الحلو يُسمع على بعد، فكان الفلاحون العابرون يتوقفون لينظروا إليه من النافذة، ويستمعوا لحظات، والأم والجد يجلسان بصحن الدار، بينما خالد يلعب الكرة في تلك الليلة القمرية بأحد أجران القرية، ولكن، جاء إلى الأم من أفضى بمخاوفه على الصبي الصغير من إصراره على قراءة القرآن، واحنا مش قد الباشا، وفرقة الشراقوة، ولم يكف هو عن القراءة إلا بعد أن تعمدوا أن يقنعوه بأن صوته قبيح، وبأنه يخطئ في النحو، وهذا حرام!
**
استيقظ في الصباح الباكر على صراخ الرجل المخبول:
-ياولاد الكلب افتحوا الباب..
كان الأربعة الآخرون يرتدون جلابيبهم وبنطلوناتهم بعد أن خلعوها، وناموا بملابسهم الداخلية..
-صباح الخير يا افندي!
-صباح النور.
وراحوا يتحدثون عمّا ينتظرهم من إجراءات، وتصدى أحدهم-كالعادة- للإفتاء القانوي فيما يدري، وفيما لا يدري، مطمئنًا الجميع إلى “بساطة” جميع المسائل، مما يدل على خبرته في التردد على أقسام البوليس والنيابة والمحاكم!
لا يدري نبيل لماذا أحس في ذيول كلماتهم بغمغمة ليست مصرية، غمغمة أقرب ما تكون إلى العبرية! كان قد لاحظ هذه الظاهرة على كثيرين في أماكن ومناسبات مختلفة، وكان يكذب أذنيه في بادئ الأمر، غير معقول! ولكن تكرارها بهذا الشكل جعله شديد الحساسية إزاءها، بل وشديد الرعب، أنت لا تخشى غير العدو المقنع، المتنكر، أما العدو السافر الوجه فيستفز فيك التحدي حتى الموت!
أتكذب أذنيك أم عينيك، ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من أين؟ إنهم يبدون من فئات الشعب الكادحه الفقيرة، وهذه هي الخدعة، هو الفخ المنصوب لك ولكل السذج من أمثالك، هذه أصواتهم، خصوصًا في المقاطع الأخيرة تحمل نغمات بومية كريهة، لا يمكن أن تصدر عن أولاد البلد!
لو صارح أحدًا بما سمع ورأى، لسخر به، بل لظن به الجنون، اصرخ..اصرخ في صمت حتى تجنّ، اطرق على الباب بشدة كذلك المخبول، وازعق..
-افتحوا الباب يا ولاد ال..
على أية حال ليس هذا أغرب شئ لاحظته أو سمعته أو رأيته في السنوات والشهور والأسابيع الأخيرة! انتظر ما تأتي به الأيام من مفاجآت، ولكنك لا تدري على التحديد، أتحلم أنت الآن، أم كنت تحلم قبل أن تتعلم الشك في كل شئ، أهو حصان طروادة؟ أم غابة مكبث؟ أم غابة زرقاء اليمامة؟! هكذا إذن هزمت مصر، هكذا أخذت القلعة من الداخل لأن الفيران كانت قد خربت أسوارها، ومع أول هزة انهار كل شئ، وجاء الطوفان مع الخامس من يونيو، وملأت المسرح عويلًا ونواحًا ولطمًا، وكانت التدريبات تجري يومها على إحدى مسرحياتك الفاجعة! ملئٌ هو تاريخك يا مصر بالمسرحيات..ودائمًا نفيق بعد فوات الآوان، فنبكي على القلعة المنهارة بعد أن تكون الفيران قد أتت على كل شئ، وبعد أن يكون حصان طروادة قد أفرغ ما بحوفه ليلًا في المدن والقرى، وبعد أن تصبح الغابة على بعد أشبارٍ فلا يبقى في وسعنا نحن المحاصرين غير النواح والعويل..
-افتحوا الباب يا ولاد ال..
**
كانت الولادة دائمًا لأمه عملية عسيرة، قال لها الطبيب إنك تعرضين نفسك للموت المؤكد إذا حملت مرة آخرى، وعدته بأنها لن تفعل، ولكن كان نبيل جنينًا يجتاز اليوم الخامس عشر من عمرهّ! دون أن تدري الأم! ومرت شهور الحمل، ولعجب الأم كانت الولادة هذه المرة يسيرة! وفي الأول من يونيو رأى نبيل الحياة، بقيت أربعة أيام فقط على الهزيمة!
فتح عينيه طفلًا ذات مرة، فوجد نفسه على سرير بسوسته، وعلى شماله وجد جدته لأبيه، ناولته فطيرًا بسكر، من يومها وهو يكره الفطير بالسكر، فقد ارتبطت ذكراه بذكرى مرضه القديم، الالتهاب الرئوي، الذي ترك أثرًا مقلقًا في حياته، تلك الكحة المزمنة التي تعاوده بالمخالب كل شتاء، تذكر أيضًا أنه يكره الينسون، لارتباطه بشربة زيت الخروع، كما يكره “الششم” الذي أصاب بصره بالضعف!
رأى نفسه كومة من اللحم، أجلسوها في “السبت” كذلك الذي يحملون فيه الرحمة والنور إلى الجبانات، حملت العمة السبت، ووضعته على رأسها، وركبت الأوتوبيس، وعادت به ذات غروب إلى قريته “إخطاب”، دخلت به الدار، كانت أمه تجلس إلى طشت العجين، دوت في الدار زغرودة الأم، ثم تبعتها زغاريد، وقبل أن تضع العمة”السبت” على أرض القاعة، كانت أمه قد اختطفته، وراحت تضمه بيديها الملطختين بالعجين، وتقبله وتبكي، عرف فيما بعد أن الطبيب أكد لها أنه لن يعيش طويلًا، فعادت إلى القرية تحمل يأسها وحزنها وتركته بجوار جدته لأبيه، وقبل أن تناوله الجدة الفطير بالسكر، لا يذكر نبيل شيئًا على الإطلاق، هناك، بعيدًا، وراء حدود الذاكرة، لا شئ غير الظلمات!
-افتحوا الباب!
مدّ أحد المحبوسين يده إليه بموس حلاقة، فإنه قد نسي أن لحيته طويلة، فهو يكره الحلاقة خوفًا من فلتة الموس! ولذلك ظن أن الرجل يسهل له مهمة الانتحار قبل أن يأخذوه إلى حيث لا يعرف الذباب الأزرق له أثرًا، ولكنه فهم فيما بعد أن الرجل كان يناوله الموس لكي يحلق لحيته! كيف له أن يتوقع خيرًا من هذه الفيران التي تتحدث بصوت عبري، والتي تثير رعبه!
-متشكر..
-خد احلق دقنك!..الموس حامي!
-حامي بارد ما تفرقش..
-طب خد احلق!
-قلت لك مش عايز احلق..
-يا راجل خد!
ملعون هو الإلحاح، وملعونة هي الرتابة، في لحظات كهذه، ولسبب تافه كهذا، ينجح فأر في أن يجعلنا نود لو أن السماء انطبقت على الأرض، لو أن الصواعق أمطرت البشرية، لو أن البحر غمر القارات، لو أن النجوم تهاوت، لو أن الإنسانية انقرضت، لو أن الأرض أخرجت أثقالها، لو أن الفأر كفّ عن الإلحاح..
-خد احلق!
-واحد شايل دقنه، وانت تعبان ليه؟!
كم قتلت هذه الفيران من أمثالك، بخناقات مفتعلة ومدبرة، في غرف الحبس أو الزنزانات؟! كم شاركت في تعذيب أمثالك بأقسى مما يفعل الزبانية المختفون وراء المكاتب والمناصب! كم تخلى الزبانية الكبار عن مهامهم الدموية لأمثال هؤلاء من الزبانية الصغار مطمئنين إلى أن الأخيرين أقدر على فنون تعذيب الزبائن أو النزلاء أو الضيوف، وخصوصًا “الأفندية” المشتغلين بالسياسة! كم من الأبرياء كانت تهون عليهم فنون التعذيب، إلا أن يمارسها معهم هؤلاء الفيران ممن يحسبون على الفئات الشعبية الكادحة، وهؤلاء كم عذبوا من أبناء الفئات الشعبية الكادحة؟! تلك هي الخدعة..الفخ..الواقع المعكوس! وأنت تفهم هذه اللعبة، ولذلك لا يخدعك مظهرهم، ولا أحاديثهم المدروسة، ولا أقنعتهم الشعبية المرسومة بدقة والمكشوفة في وقت واحد!
غرفة القسم مجرد مسرح، مسرح صغير، تمامًا كمسرح الجيب، وأنت خبير في التجريبية، وخبير في التأليف والإخراج والتمثيل والديكور والملابس والمكياج والإكسسوار والمؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية:
-افتحوا الباب يا ولاد ال..
فتح الباب الغليظ فجأة، ثم صوت خشن زاعق:
-نبيل منصور!
-أيوه!
-تعالى قوم!
قام وخرج العسكري، لاحظ أنهم لم يستجوبوه، إذن لم يكلفوا أنفسهم حتى أعباء تسجيل اسمه في دفتر الوارد، يعني مهدور الدم! جذبه العسكري من قفاه، وخرج به من القسم، تلقفه عدد من العساكر، ودفعوا به في لمح البصر إلى سيارة “جيب” تقف مباشرة أمام ورشة الأحذية المجاورة لمدخل القسم!
**
وقفت السيارة “الجيب” أمام مستشفى الأمراض المستوطنة بشبرا في شارع عريض مقفل! هنا غاص قلبه إلى قدميه من الرعب، كان يتوقع كل شئ، حتى الشنق، إلا هذا، كله إلا هذا، ولذلك أحس كما لو كان أُخِذ على غرة! قفزت إلى ذهنه ألوف الصور التي طالما رآها في الكتب والمجلات لما فعله النازيون بأطفال العالم، والتجارب الميكوبية التي أجريت على الزهور والعصافير! إلا هذا يا ذئاب!
إذن لن يقتلوك كما توقعت، وإنما سيحقنوك بالميكروبات ليتركوك حيًا ميتًا مشوهًا كالمومياء، يا بلد التحنيط! هذه إذن نهاية المشوار، الأمراض الوطنية، آسف يا سادة، الأمراض المستوطنة، لقد أجهدت البلهارسيا والانكلستوما وغيرهما طفولتك وصباك وشبابك، فماذا لو حقنوك بميكروب ال..ووردت في ذهنه شتى أنواع الأمراض، وراح يتذكر ما قرأه في كتاب قديم كان قد عثر عليه في ركام الكتب على سور الأزبكية، “قصة المرض والميكروب” أحس ببدنة يقشعر كما لو كانت كل ميكروبات العالم قد هاجمته من الداخل والخارج! شعر بأورام والتهابات واحتقانات في كيانه كله، ثم بمغص شديد ثم بسخونة شديدة، ثم ببرودة الملاريا، ورأى نفسه محشوش الوسط يتوكأ على عكازين، مشى بخياله في شوارع القاهرة، طاف بأنديتها ومقاهيها، قبل أصدقاءه من الكتاب والفنانين والأدباء..انظروا إليَّ جيدًا، هذا ما أنتم مرشحون له جميعًا، بالدور، الصف بعد الآخر، حين يأتي الوقت! حين تحاصركم فجأة، ومن حيث لاتدرون العربات السوداء والرجال الطوال القامة الثقال الأيدي، فحذار، حذار يا أعزائي أن يأتي الوقت، أوقفوا الزمن، أفيقوا..أفيقوا قبل فوات الآوان! قبل أن تجروا جرًا كالذبائح إلى مستشفى الأمراض المستوطنة، إن لم تكن في الفن، في الأدب، في الثقافة، في الفكر، في الفلسفات جدوى أن تجنبنا هذا المصير، مستشفى الأمراض المستوطنة، فلا جدوى لشئ على الإطلاق، ولا معنى لأي شئ، إلا أن يكون التكرار الأسطواني اللحوح الممل، وإلا أن يكون العبث، واللامعقول، والجنون والصراخ المذبوح وراء جدران الصمت!
لم يتحرك السائق-العسكري- وحيد في السيارة الجيب! والشارع العريض المقفل هادئ، وصامت، وفارغ. أين ذهب العساكر الثلاثة الذين كانوا يجلسون معه؟! ولماذا لا تتحرك السيارة؟ ولماذا لا يتحرك السائق؟ وكم مضى من الوقت؟! هل يتيحون له فرصة الهرب؟
إنهم على كل حال من أبناء هذا الشعب، ويعلمون بأمر الأمراض المستوطنة، وبحكم العمل اليومي يعرفون ما هو مبيت لك! ترى لهذا السبب تمتلئ مصر بالمشوهين وذوي العاهات، هنا إذن إحدى الورش التي تُصنع فيها العاهات! إنهم جميعًا من مشوهي الحرب، أية حرب؟ وكم حرب؟ ومنذ متى؟ إنها حرب ميكروبية صامتة لم تضع أوزارها منذ بناء الهرم، وربما قبل ذلك بزمن طويل، زمن نسيته أو أنسيته، فليس من المرغوب فيه أن نتذكر التاريخ، ولا أن تكون لنا ذاكرة، كل شئ يعمل على إفقادنا القدرة على التذكر، وبالتالي على التفكير، وبالتالي على الحذر، لكي يهبط القدر فجأة، فتجد نفسك هنا، على عتبة مستشفى الأمراض المستوطنة!، والمستوطنون كانوا منذ لحظات يتحدثون بغمغمة عبرية في ذيول الكلمات المصرية اللهجة، والسائق أمام عجلة القيادة لا ينطق! والوقت يمر، وخطوة واحدة قد تفصل بين مصير ومصير أو قد تحدث معجزة!
ماذا لو انتهز الفرصة المتاحة عن عمد أو غير عمد وقفز من السيارة وراح يجري ويصرخ في الشوارع؟! ولكن إلى أين؟ وكيف المفر؟!
التفت السائق إليه، ثم ترك عجلة القيادة، ودار حول السيارة، وجاءه من الخلف:
-انزل يا افندي!
هل ضاعت الفرصة؟! هل ملّ العسكري الانتظار؟! أم أنهم أوقفوا السيارة عمدًا أمام المستشفى ليتأكدوا من أن أحدًا لا يلاحظ شيئًا، ومن باب الاستيثاق من أن الجريمة كاملة”وتمام التمام”!
أم أنهم تركوه في السيارة تلك المدة الطويلة كمجرد”طعم” للإيقاع بمن يخيل إليهم أنه وراء نبيل أو بمن قد يتعاطف معه من أبناء المنطقة التي اعتادت-فيما يبدو- على هذا المشهد الجنائزي الصامت كل صباح، وكل مساء بين القسم والمستشفى؟! أم أنهم تعمدوا أن يتركوا له الفرصة ليهرب، وهم من ورائه، ليعرفوا إلى أين يلجأ وإلى من؟! مازال هو”الطعم” الصغير التي تصاد به الحيتان!
كان يحس من أعماقه بأن وراءه قوة، لا بد أن تكون وراءه قوة هائلة مجهولة غامضة تراقب وتتابع وترصد كل شئ في صمت! نعم ماداموا يفعلون كل شئ في صمت، فلنعلمهم فن الصمت!
في تلك اللحظة، وفي أمثالها من اللحظات، وعندما يشعر أنه ليس وحده، ينقلب إلى عملاق، يتحدى المخاوف، أما عندما تتزعزع في داخله هذه العقيدة فإنه يصبح مجرد صرصار تستطيع أية قدم أن تسحقه، ولهذا قال للسائق في استسلام الأعزل:
-حاضر!
وهبط من السيارة ببطء، كأنما يحمل على كتفيه جبالًا من اليأس! أخذه السائق من يده ودخل به إلى المستشفى، عاودته قشعريرة الرعب، أجلسه السائق على أريكة بيضاء عند باب آخر داخلي، نظر حوله، رأى وجوهًا يرتسم عليها خليط من القلق، والخوف، والهزال، والتشجيع، كان منظر السائق بملابسه البوليسية مع الأفندي في المستشفى ملفتًا للأنظار! لم تمض دقائق حتى عاد السائق يقول:
قوم!
وأخذه بيده، وعاد به مرة آخرى إلى السيارة الجيب، ثم دار حولها، وجلس في مكانه من عجلة القيادة، صامتًا، بلا حراك، تاركًا إيّاه في الخلف!
ها هو العسكري يتيح لك فرصة الهرب مرة آخرى، ومرة آخرى إلى أين؟! أولاد الحلال كثيرون! هذا كلام نظري! لابد أن تحدث معجزة، والمعجزات في حياتك كثيرة الحدوث، حتى لتكاد تؤمن بأنك ورثت “البركة” عن أمك التي تنحدر من سلالة أولياء الله!
هل ستلجأ إلى الله بعد تلال الكتب التي قرأتها بحثًا عنه دون جدوى؟! أنت كفرت بالله حقًا، منذ تلك الليلة، البرطمان، النقود، الجلباب، دخلة العيد، العجوز الشمطاء، أمنا الغولة، الصبي ذي الذراع المكسورة، كفرت بالله ليلتها، ولكنك أبدًا لم تشرك به أحدًا، لم تقل أبدًا بأن هناك إلهين أو أكثر بل ولا حتى أقل! ومع ذلك لا تدري لماذا ظلت في أعماقك لؤلؤة لا تنكسر أبدًا، وإيمان غريزي غامض وبعيد الجذور بأن وراء هذا الكون قوة عاقلة وعادلة وواحدة، قوة هي “س” تلك التي لا تعثر لها حتى هذه اللحظة على جواب! يا “سين” يا “سين” يا “سين”!!
رأى جيشًا من النساء والرجال والأطفال يحيط بالسيارة الواقفة أمام المستشفى، والعيون محدقة به، اكتشف أنه كان يبكي، شعر بالخجل! تذكر حديثًا قديمًا بينه وبين أمه، كان يستذكر دروس التوجيهية، وجلست أمامه تأكل رغيفًا بقطعة من الجبنة القديمة، وكانت أمه “نباتية” لا تقوى على مرآى الذبح والدم واللحم، ولذلك كانت تعد لهم صنوف الطعام من باب الواجب، ثم تنفرد بالرغيف وقطعة الجبنة القديمة..
-فيه ربنا يا امه؟!
-فيه طبعًا، هيه دي فيها شك؟!
-هوه فين؟!
-يعني إيه؟
-ما اعرفش، إنما أعرف إن فيه ربنا، وإنه واحد أحد، ومالوش شريك!
-يا امه دي كلها تخاريف!
-بكره يغلبك!
-هو مين؟!
-ربنا!
لم تكن تفك الحرف، وماتت قبل أن يتحقق أملها في تعلم القراءة والكتابة، كانت شهور الحمل الأخيرة يوم جاءت بأحد النجارين، فصنع لها سبورة، واشترت الطباشير وبدأ نبيل يعلمها الأف باء، كم كانت فرحتها يوم نجحت في أن تعرف الفرق بين الألف والمئذنة ثم..ثم ماتت في ولادة عسرة!
اندفع بالغريزة فقفز من السيارة، ودخل إلى محل صغير بجوار مدخل المستشفى يبيع الزيت والسكر والجاز والرز، بدأ يصرخ بأعلى صوته:
-نبيل منصور الشاعر، جايبينه المستشفى ليه؟ عشان يحقنوه؟
راح يكرر الصراخ في سعار محموم!
تجمعت أمواج الأهالي أمام باب المحل، وبسرعة مذهلة تشكل طابور طويل من الزبائن:
كيلو زيت!
-نص كيلو سكر..
-لتر جاز..
-كيلو رز..
هدير..هدير..هدير..
حاول العسكري أن يقتحم المحل فتصدى له سد بشري! بينما واصل نبيل الصراخ، ناوله صاحب المحل قلة مقطوشة، فشرب منها بعد عطش شديد!
هدأ قليلًا، أجلسوه على مقعد، كفّ عن الصراخ، راح يتأمل الوجوه، الرجال، الصبايا، الصبية، تذكر أهل قريته، لا توجد فروق كبيرة بين الملامح هنا والملامح هناك، أطل وسط الزحام وجه صبية جميلة السمرة، ثبتت عينيها في عينيه بنظرة مشجعة، وكأنها تقول له:
-اثبت، خليك راجل!
غابت الفتاة لحظة، بحث عن وجهها في الزحام، عادت بعد لحظة ومعها سندوتش فول، مدّت ذراعها بالسندوتش عبر السكر والأرز، أخذ منها الساندوتش، وبدأ يأكل والدموع تتساقط على فمه كقطرات الزيت! كم يكره هذه الدموع، إنها تفضحه، تشكك الآخرين في رجولته، وكان حريصًا جدًا أن يعيش ويموت رجلًا من ظهر رجل، والخطأ في هذا كله خطأ أبيه، فلكم طارده بالنواهي منذ صباه الباكر بعبارة واحدة”الراجل ما يعملش كده”! لم يقل له مرة “الراجل يعمل إيه”!!
كأنما حكم على الرجال ألا يفعلوا شيئًا، وبخاصة ألا يبكوا، وبالذات أمام عيون الآخرين! قل لي يا أبتي ماذا يفعل الرجال عندما يجدون أنفسهم بغتة في محل لبيع الزيت والسكر والجاز والأرز بجوار مستشفى الأمراض المستوطنة!
العيون محدقة به، طابور الزبائن يزداد تراصًا، الزحام يشتد أمام المحل، ويحجب المصنع الصغير المواجه للمستشفى! نشاط داخل المحل، لمح رجلين يجلسان القرفصاء على أرض المحل، ويقومان بفرز وترتيب البطاقات!
أفق إنه مجرد الزحام على”التموين”، فكفّ عن أملك المعتوه في المعجزة، لم يعد العصر عصر المعجزات، آن لك أن تدرك أنك تعيش آخر زمن! النقائض تنقلب في ثانية فتصبح متجانسة، المتجانسات تصبح نقائض، كل شئ يختلط، ويتكور، ويدور، كل شئ يفقد معناه، لونه، طعمه، رائحته، كينونته؛ المسموعات، المشمومات، المذقات. لعينٌ هو الخل الممزوج بمرارة، أنظر إلى هؤلاء الناس، ذئاب أم حملان؟ أفاعي؟ أم حواه؟! إنهم يغيرون جلودهم كل لحظة، والمصنع الصغير المقابل يواجه المستشفى، فركة كعب، مجرد عبور الشارع العريض المقفل، في لحظة زحام مفتعل عل الزيت والسكر والجاز والأرز، حين تقع البقرة تكثر السكاكين، وحوائط بشرية، ديكورات، إنك مازلت في مسرح الجيب، وجريمة تتلوها جرائم، وتضيع الآثار تحت وطأ الزحام، وتضيع الصرخات في الهدير، والبقية صمت كما قالها “هاملت بعد الطعنة المسمومة! ويدخل “فورتنبراس” على المذبحة، بعد أن مُهدت له مؤثرات المسرح، ليجلس على عرش الدنمارك. ولا ينس في لحظة كرم نادرة وتمثيلية أن يشيع بكل جلال ومهابة جثمان الأمير الغبي إلى مقره الأخير، ها أنت قد عدت إلى حصان طروادة، إلى غابة مكبث، إلى غابة زرقاء اليمامة، وأبناء البلد يغمغمون بالعبرية، والعبرانيون يرطنون بالبلدي، والعصر موبوء، وقصّ قصتي يا هوراشيو!!
عاد يبحث في الزحام عن الوجه الأسمر الجميل، كان قد اختفى، دخل السائق ومعه ثلاثة عساكر إلى المحل:
-قوم معانا يا نبيل!
غمزت له عين امرأة يبدو أنها تعرف كل شئ، فليحدث ما يحدث، ليست بالمرة الأولى ولن تكون الأخيرة، قم معهم، لست الوحيد ولن تكون الوحيد، كل الذين يتزاحمون على المحل قد فعلوا هذا عشرات ومئات المرات وألوف المرات! كلهم مرت لهم رقاب على نفس الموس!
قم معهم، كثيرون من قبلك قاموا معهم إلى مستشفى الأمراض المستوطنة، أو إلى الجحيم، أو إلى “سكة اللي يروح ما يرجعش”، لا يهم، المهم أن تكون رجلًا، وأن تظل رجلًا حتى النفس الأخير، وليفعلوا بجثتك بعد ذلك ما يشاؤون! قم معهم، هكذا خيل إليه أن المرأة تقول وهي تغمز له بإحدى عينيها!
قام معهم، وركب السيارة، وعادت لتقف به أمام ورشة الأحذية المجاورة لمدخل القسم!
ترى متى تصبح للإنسان ذاكره؟!
هناك لحظة تولد فيها الذاكرة لدى كل طفل، لحظة تفصل بين ملايين الأشياء قبلها، وملايين آخرى بعدها، لحظة تبدأ الذاكرة فيها تمارس وظيفتها، اختزان كل ماهو تالٍ لها أو كل ما يترك أثرًا على صفحتها من اهتزازات الطفولة!
أنت تذكر أنك فتحت عينيك صغيرًا، صغيرًا جدًا، فوجدت نفسك مستلقيًا على ظهرك، وعينيك معلقتين إلى سقف من القماش به كوة صغيرة ينسل منها ضوء باهت، التفتَ عن يمينك وعن شمالك، فرأيت صفين من العساكر والضباط المسلحين يحيطان بك، وسمعت دويًا لم تفهمه حينذاك، ثم رفعك أحد الضباط، وحملك بين يديه، وفتح الباب، ودخل الضوء، نزل الضابط من سيارة”بوكس” أخذك أحد العساكر من الضابط:
-عنك يابيه!
بعد دقائق كنت في أحضان أمك، في دارك، في قريتك”إخطاب”!
كيف أمكنه أن يتذكر لحظة نزوله من السيارة”البوكس”، وكيف لا يتذكر حتى الآن متى ركب السيارة مع هؤلاء الضباط والعساكر، ولا من أين؟ كثيرًا ما سأل أمه وأباه وعمته وجدته عن هذا اللغز المحير في مراحل متباعدة من عمره، فلم يكن يظفر منهم بجواب، كأنهم اتفقوا على أن يظل هذا السر مكتومًا في ركن أسود من حياته لأمر ما لا يستطيع فهمه، ولكنه لم ينس ذلك الحادث! بل يذكر أنه ظل يتباهى على أقرانه من صبيان القرية بأنه جاء في “عربية مخصوص” وكانت العربيات المخصوصة وقفًا على الباشا وأبنائه البكوات، وعلى قلة قليلة من أعيان القرية، بل وحين كان مجرد رطوب الأتوبيس يعتبر حادثًا جليلًا في حياة صبيان القرية، يذكر للمحظوظ الذي نزل “البندر” بكل فخر!!
**
صعد العساكر والسائق إلى السيارة “الجيب” بعد قليل، صعد رجل طويل القامة شديد سمرة الوجه، أزرق العينين، يرتدي لبدة وجلبابًا بلديًا يميل لونه إلى الاخضرار، ذكره بالقتلة المحترفين الذين كان يأويهم الباشا من خريجي الليمانات! كان الرجل قلقًا بشكل ملفت للنظر، وكان يدير بصره بين داخل السيارة وخارجها ثم يثبته على الضحية!
بينما أخذ نبيل ينقل بصره من الرجل إلى الكماشة في يد صانع الأحذية الذي استغرق في خلع المسامير من كعب حذاء قديم.
هذا إذن هو الجلاد..
هذه العيون الزرقاء، مع السمرة الشديدة هجين غريب، لا يمكن إلا أن يكون دمويًا، ولا يمكن إلا أن يتنكر وراء اللبدة، والجلابية البلدي، بل والصديري، وعينا لص لا تستقران بين داخل السيارة وخارجها، وبهذا القلق الشديد خشية أن يترك اللص وراءه بصمات!
إذن هذه هي النهاية، في سيارة جيب، مادامت البداية كانت في سيارة “بوكس”، ها أنت للمرة الأخيرة، تركب”عربية مخصوص” تزفك في جنازة صامته إلى حيث مثواك الأخير هنا في القاهرة، في البندر، ليتك لم تهبط البندر، لقد عشت في البندر لسنوات طويلة ماكرة خبيثة، وكنت تشتري “الترام” كل يوم، كل ساعة، كل لحظة!
على أي حال آن لك أن تستريح، هذا حقك، ولن يلومك أحد، اللهم لا شماتة ولا اعتراض، كم من الكتب قرأت، كم من الكتب لم تقرأ بعد، كم من الكلمات كتبت، كم من الكلمات لم تكتب ولن تكتب، يا خسارة، لو كنت تدري لدونت قصتك منذ البداية حتى هذه اللحظة، وأحد العساكر يأتيك بكوب ماء، مع أنك لم تطلب الماء، ولم تعد في حاجة إليه، ولكنه يخبرك بكوب الماء عن المصير الذي ينتظرك، لا يهم أين، ولا كيف، اشرب، هذا هو الجزمجي يدق المسامير بمطرقة رتيبة في نعل الحذاء القديم، لكأنه يدقها في رأسك، في قلبك في كيانك كله، ومع ذلك، إثبت ولكن رجلًا، أنظر في عيني جلادك، سمر عينيك في عينيه، تحدهـ أقطع ذراعي أنك لست مصريًا، ما أنت إلا ذئب هبط ليلًا على قرية نائمة، ها أنت تعود إلى حصان طروادة!!
أعاد الكوب إلى العسكري، وانطلقت السيارة، ودارت دورة قبل أن تغيب بين أمواج السيارات التي تتحرك ببطء في اتجاه محطة مصر، ولمح إحدى سيارات الجيب البضاء التابعة لقوات هيئة الأمم المتحدة.
-3-
كان يجلس بجوار أبيه في مقدمة رتل من السيارات الحاملة للمودعين في الطريق إلى مطار القاهرة، موفدًا في بعثة فنية إلى روسيا!
أخيرًا استوفى أوراق السفر، كم كلفه هذا من أعصاب، وهواجس، ومخاوف! كانت كل ورقة في نظره صخرة تزاح من طريقه، هو الذي يتوقع دائمًا أن تنهار الصخور على رأسه من حيث لا يدري أو يدري!
ما أشبه رحلته مع الأوراق بين المكاتب والإدارات بسباق الموانع الذي بدا أنه لن يجتازه مطلقًا، كان يتوقع في أية لحظة أن يرفع أحد الموظفين رأسه من بين الأوراق، ليهبط عليه بالصاعقة”أنت ممنوع من السفر”!
استرق نظره إلى أبيه..
كان يبدو عليه الحزن والقلق للفراق المتوقع!
خمس سنوات سيقضيها ابنه بعيدًا عنه، في الغربة، وفي روسيا بالذات، وقد سمع الكثير من المبالغات عن الطقس في روسيا، ومازال الناس يعتقدون أن البرد هو الذي هزم هتلر، كما هزم نابليون من قبل! وبقدر ما كان أبوه فخورًا سعيدًا بظفر ابنه بالبعثة، وبقدر ما أوشك أن يطير من الفرحة بقدر ما هو حزين الآن، وقلق بسبب ذلك البرد الذي يجمد الدم في العروق!
منذ ساعات كان أبوه يلقي قصيدة في المودعين الذين ملأوا الشقة بالجيزة، قصيدة نظمها خصيصًا للمناسبة، هو الذي ودع الشعر إلى غير رجعة.
لقاء منذ مطلع شبابه يوم اصطدم يديكتاتورية الأسماء الكبيرة، التي تسيطر على المنابر الثقافية، وتحيط بها إحاطة الأخطبوط! فقد توجه إلى مسرح رمسيس، وهو في العشرين من عمره، ومعه مسرحية شعرية كتبها احتذاءً لمسرحيات أحمد شوقي اسمها”يوسف وزليخة”، قابله الفنان الكبير بعد إلحاحه الشديد في التردد على أبواب المسرح يومًا بعد يومٍ:
-يا بني ما اقدرش أقدم مسرحيتك!
-حضرتك قريتها؟
-وحتى لو قريتها، وعجبتني، برضو ما اقدرش أقدمها، هات لي مسرحية عنوانها “ريان يا فجل” بس عليها اسم كاتب معروف، وأنا أقدمها، إنما مسرحيتك أواجه بيها الجمهور إزاي؟ أقول له تأليف مين، اسمك إيه؟
-اسمي مكتوب ع المسرحية، وعلى كل حال ما فيش لزوم تعرفه، النسخة لو سمحت!
ناوله المسرحية، أخذها في صمت، حبس دموعه، وبهدوء مزق المسرحية، ثم ألقى بها في سلة مهملات الفنان الكبير، وانهارت كل آمال العشرين ربيعًا!!
حكى الأب هذه الحادثة لابنه مرارًا، كان قد وضع آماله كلها في نبيل، وبينما كان يدفعه بقسوة إلى القراءة في كل شئ حتى في الفلك والعطارة، لم يكن ينسى أن يحذره من أن يتخذ الأدب حرفة أو مهنة:
-لو كنت استمريت أكتب شعر ومسرحيات لحد دلوقتي، كانت أمك زمانها خدامة في بيت الباشا، وكنت زماناك بتنقى دودة القطن، ولا من عمال التراجيل!
كان الأب قد ترك التدريس الإلزامي، والتحق بمدرسة الصيارف، ثم أصبح يملك ثلاثة عشر فدانًا! ظل هذا جرحًا غائرًا في قلب الابن يستحي أن يواجه به نفسه أو يواجه به أباه،كيف تأتى لك يا أبتي أن تملك تلك الفدادين؟! إنه لا يستطيع أن يتخيل أن أباه أيضًا كان يبتز الفلاحين، فأبوه بالنسبة إليه معبود، يعلو على المآخذ الأخلاقية، ولا يمكن أن يكون هو والباشا شيئًا واحدًا!
كثيرًا كان ينتقل مع أبيه من قرية لقرية، ومن مدينة إلى مدينة بين الوجهين البحري والقبلي، وكان البيت دائمًا مقرًا لأعمال الصرافه، وملتقى لأفواج الفلاحين، القادمة لآداء التزامتها الثقيلة، وكأنها تقف في طابور الخراج، أو في قوافل عرس قطر الندى!
لا يمكن أن يكون أبوه قد شارك في امتصاص الدم من هذه الوجوه الصفراء، هذه المومياوات المتحركة،هذه العروق البارزة كالقنوات في الأرض الشراقي! ولكنه كان يحس في داخله-وفي نفس الوقت- بأن ذلك ممكن، وممكن جدًا.
فيشعر بالخجل الشديد، ثم لا يلبث أن يطرد الفكرة هروبًا من قسوتها؟! عاد ذات مرة إلى قريته، وجلس بين الفلاحين على رأس حقل تلتقي عندها أرض أبيه بأرض الباشا، ثم راح يشرح لهم تاريخ تلك الأرض، وكيف أنها ملك لآبائهم وجدودهم، وكيف تم انتزاعها منهم، أو تطفيشهم منها، وأن عليهم أن يستردوها، وأنهم لا يكونون بذلك لصوصًا، فالذي يسترد ما سرقه اللصوص لا يمكن ان يكون لصًا إلا في ظل قانون اللصوص، يومها ضحك الفلاحين، وصفعه بالواقع المر!
-يا ريتك يا نبيل أفندي تقول الكلام ده لابوك!
-كلام إيه؟!
-يعني تقول له يرجع الأرض لأصحابها، يمكن يتنازل لنا عن التلاتاشر فدان!
وانفجر الجميع بالضحك..
أبي؟!..نبيل أفندي؟!
وهل المشكلة الآن هي تلك الفدادين الثلاثة عشر التي يملكها أبي، أم الستة آلاف فدان التي يملكها الباشا؟! ترى هل يغير من واقعكم في شئ أن يتنازل أبي-دون خلق الله- عن أرض اكتسبها بعرق جبينه؟! المصيبة أنكم ترون الأرض التي يملكها أبي، ولاترون الكون الذي يملكه الباشا، وكأن للباشا حقًا في أن يملك، وليس لأبي أن يملك شيئًا! من أين تبدأون، من أبي أم من الباشا؟ أم أنهما شئ واحد؟
انظر ها أنت بدأت تدافع عن أبيك، مازلت ملوثًا من الداخل، أنت ترى فرقًا لا يرونه بين أبيك والباشا! ما الفرق بين اللص الصغير واللص الكبير؟!
انظر كيف انهارت ثقافتك أمام صفعة من فلاح طالما تصوره جاهلًا متبلدًا جلفًا عديم الإحساس؟! ثم انظر كيف تراجع تصورك للعدالة أمام محبتك غير المحدودة لأبيك؟! كل يغني على ليلاه..
كل يفكر بطريقته، وهؤلاء يفكرون بغريزة البقاء، غريزة الحياة، غريزة الصراع، ولهم خبرة طويلة مريرة بالكلمات الحلوة، وبالأفندية المتعلمين من أمثالك، طظ في الكتب، طظ في كلية الحقوق، أنت ملوث، انت أقذر من أن تحتمل الراية، في موكب هذه الجموع الحسيرة أنت في عالم، وهم فيعالم آخر، لا عليك ان تقطع مشوارًا طويلًا لتفهم كتب العالم أجمع، تنتهي عند رأس هذا الحقل!
عليك أن تعترف أن أباك لص، تمامًا كالباشا، ولا قيمة بعد ذلك لحجم اللصوصية، فللقانون أيضًا حجمه، وللعدالة على رأس الحقل مساحتها! عليك أن تدرب نفسك بعنف على مواجهة خيبة الآمال والقيم والمثل، حتى في أبيك العزيز!
فيم إذن كانت معاركك يا أبي ضد الباشا؟! فيم إذن كانت بطولاتك؟ّ! لماذا أصبحت زعيمًا في القرية؟ لماذا طاردوك في قرى ومدن مصر؟! لماذا كنا ننتظرك وأنت طفشان كالعصفور المحترق العش، ونتوقع”خبرك” في كل يوم، كل ساعة، لسنوات طويلة، لماذا كانت فرقة الشراقوة من القتلة المحترفين في انتظارك دائمًا، حتى في رمضان..الشهر الحرام؟! لماذا؟ لماذا؟
كان قد اقترب من مطار القاهرة، وأبوه إلى جواره ينظر إلى ما لانهاية، والمودعون من خلفه في رتل السيارات! وأحس كما لو كانت سيارات المودعين تطارده، صحيح أن أوراقه مستوفاه، ولم يبق إلا بضع دقائق، ويركب الطائرة ليخرج من مصر، ولكن من يدري؟ قد يحدث شئ يقطع عليه الطريق، قد يمنعونه فجأة من دخول المطار، من ركوب الطائرة، قد يتلقى المطار مكالمة تليفونية أو إشارة مفاجئة بإعادته في الحديد إلى مبنى وزارة الداخلية، فليس معقولًا أن يكون كل شئ على ما يرام!
وأن يسمحوا له بالسفر، وإلا كانوا مغفلين ومضروبين على أقفيتهم، فهو قد أقسم بينه وبين نفسه على ألا يعود إلى مصر فيما لو أتيحت له فرصة الخروج منها، بالرغم من أن أباه أوصاه في قصيدة الوداع التي ألقاها بين المودعين بأن يعيش دائمًا بعقله وقلبه ووجدانه في وطنه مصر، مهما باعدت بينهما المسافات والسنوات!
أخيرًا غفر له أبوه أنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية مع كلية الحقوق، وغفر له أنه ترك دراسة الحقوق في السنة النهائية ليتفرغ للمعهد، بعد أن عرف أن هناك نية لإيفاد بعثات إلى الخارج أو إلى وسيا بالذات، فقد كانت طرق البعثات إلى لندن وباريس مغلقة عقب حرب 1956.
بعثة إلى الخارج ودكتوراه، قد تحمي ابنه من الضياع في عالم الفن والأدب بين أذرع الأخطبوط الذي كان يوشك هو أن يضيع بينها في مطلع شبابه، حين كان يكتب الشعر والمسرحيات! ويحمل مجرد شهادة من مدرسة المعلمين!
**
إنه حادث صغير، فقد دعاه بعض الأصدقاء إلى “سَكْرة”، وكان حديث العهد بالخمر، أو لعلها المرة الأولى التي يستطيع أن يقول فيها إنه شرب خمرًا، والحق أنه شرب ليلتها كثيرًا، كثيرًا جدًا، ثم غابت عنه المرئيات، وسقط في جبِّ عميق، إلى قاع جب عميق، وفقد الوعي، وبعد ذلك بأيام صارحه أحد الأصدقاء بعد تردد، مخالفًا بذلك عهدًا قطعه على الآخريين بما صدر عنه في تلك الليلة، ليلة فقد وعيه، فقد حدث-والعهدة على الراوي- أن انفجر صاحبنا في نوبة بكاء، وهو يصرخ، ويضرب على صدره، ويصرخ مستغيثًا”حوشوا الدود، حوشوا الدود، الدود هايكلني، الدود أكل أمي، الدود أكل أمي!”
حتى تقيأ، ونام كالجثة، كان لهذا الحادث أثر كبير في حياته، فقد وضعه وجهًا لوجه أمام مشكلة كان يعانيها داخليًا، دون أن يجرؤ على مواجهتها صراحة، والحق أنه اجتاز بعد ذلك فترة رعب قاسية، كمن اكتشف فجأة أنه كان نائما على ثعبان، يصحو فجأة فيكتشف أنه كان نائمًا على ثعبان، ولعله لم يتعذب في حياته، كما تعذب بعد مصارحة الصديق، فقد بدأ يجري على نفسه عملية تحليل قاسية صارمة، وينبش الجذور المدفونة.
**
لنسمة رطيبة؟ أو ليبصق، إن عليه أن يعبر المساحة بسرعة الضوء في أقل من لمح البصر، لكن هذا قد يلفت نظر الملعون، فيخرج ليستطلع الأمر، إن لم يفهم على التو! لا، سيعبر ببطء!! الكارثة أكثر احتمالًا، سيراه، وسيعدو وراءه، وسيقسم بالطلاق، ليقسم. سأقسم أنا أيضًا بالزواج أني لن أحلق الليلة، وسأعده أني سأحلق غدًا، لكم قال له المعلم “إنت بتحاربنا في أرزاقنا! لو كان كل الزباين زيك، كنا قفلنا، وشفنا لنا شغلة تانية”. الحلاق قبل البقال، وعليه أن يمر بالحلاق أولًا، لو كان دكان البقال قبل دكان الحلاق، لاستطاع أن يأخذ السجائر، ثم يلف لفة طويلة ليصل في النهاية إلى مقهى”عبد الله” دون أن يمر بدكان الحلاق، الأمر لله، خطا إلى اليمين متلصصًا، ثم وقف عل حافة النور، كأنه يتهيأ لقفزة واسعة، واستجمع كل قواه، وأفلت مسرعًا دون أن يلتفت وراءه، ودلف إلى دكان البقال! وخرج وفي جيبه علبتان من الوينجز، كان يتنهد دائمًا بارتياح كلما اطمأن على مؤنة الليلة من السجائر، فلم يكن يرعبه شئ كما يرعبه أن يمكث خرمانًا، سيأتي على إحدى العلبتين في القهوة، ويأتي على الآخرى حين يعود إلى غرفته آخر الليل، ويطفئ النور، ثم لا ينام، ولا يصحو، وإنما يدخن، ويدخن حتى الصباح!
وفتح إحدى العلبتين، وأشعل سيجارة، ومضى متثاقلًا إلى المقهى، عابرًا بعربات الباعة والدكاكين، دون أن يلتفت إلى شئ!
**
وتتابعت المقالب، والمكائد، والتلفيقات، واضطر مرة إلى ضرب إحدى الممثلات، وكانت تحترف إلى جانب التمثيل مهنة الدعارة، أو لعلها سعت إلى الاشتغال بالمسرح، لتخفي مهنتها الحقيقية، كتغطية لمهنتها الحقيقية، وساعدها هو على الالتحاق به لحاجة الفرقة إلى العنصر النسائي، ولانشغله حينذاك بإخراج مسرحية “صلاح الدين الأيوبي” وحاجته إلى من يلعب فيها الدور الأول “دور الملكة”، يعدها فيما يعد مع مسرحيات آخرى بمهرجان المسرح الشعبي، وكان قد بقى على الافتتاح حوالي أسبوعين، صبّ في إخراج المسرحية كل أعصابه، طوال ثلاثة أشهر في عمل متصل، ولم تكن تلك الممثلة تدرك ألف باء تمثيل، تستطيع أن تقرأ فحسب، فعلمها الآداء والحركة والإشارة، وكان هو يقدم هو يعلق آمالًا كبارًا على المهرجان، فللمرة الأولى يقدم المسرح الشعبي “عروضًا كبيرة” كان منها مسرحية آخرى عالمية، وحين لم يبق على الافتتاح غير حوالي أسبوعين، بدأت المرأة تلعب بذيلها، وكانت تحترف الدعارة إلى جانب التمثيل، كانت تملك سيارة خاصة، تسوقها بنفسها، وترتدي ملابس فاخرة، وكانت على جانب كبير من الجمال، و لعلها سعت إلى الاشتغال بالمسرح تغطية لمهنتها الحقيقية، وساعدها هو على الالتحاق به، لافتقار الفرقة إلى العنصر النسائي، وقالت المرأة أنه راودها عن نفسها، وبدأ سين وجيم، وأجرت عنايات التحقيق معه للمرة الثانية.
**
حتى أنجزها، وكان يهدف لجعله مسرحًا حقيقيًا باسمه، مسرحًا شعبيًا، واقترح على أستاذه إخراج “الحقيقي” لجوركي إلى العامية، فعكف على الترجمة حتى أنجزها، ثم تطرق إلى الداخلية الخبر إلى وزارة الداخلية، قبل أن يبدأ العمل فيها، تناقل خبرها المخبرون على المسرح، وبدأ بعد ذلك سين وجيم، وكاد نبيل يطير فيها، لولا أن…، ثم بدأت مشاكل الروتين، وبدأت المعركة بين المديرين، وانقضت أحلام الجميع، واتضح أن الكفاح ضد الحدود المرسومة للمسرح الشعبي، كمحاربة طواحين الهواء، عبث وباطل الأباطيل، ورغم أن مشروع “الحقيقي”كمشاريع الروايات الآخرى العالمية، إلا أنها قد تحطمت على الصخور الصلبة، ودفنت في الأدراج، ولم تقدم الرواية المسرحية إلى الرقابة للتقرير بها، إلى أن نسيت تمامًا، إلا أن النبأ تسرب إلى وزارة الداخلية، فبدأت عملية طويلة من سين وجيم، وكاد نبيل أن يضيع فيها، لولا أن أستاذه قال إن الترجمة قد تمت بتكليف منه شخصيًا، بل وبمساهمته، وأنه لا مجال للسؤال مادام أن المسألة كانت مجرد فكرة، مالبث أن عدل عنها، وأن النص لم يقدم إلى الرقابة، ولم يطلب التصريح به حتى يمكن أن يثور بشأنها السؤال، وفي النهاية استقال الأستاذ من المسرح الشعبي، وعاد إلى الفرقة الحكومية، وأخطر نبيل وزملائه إلى البقاء، حرصًا على أكل العيش.
وعين هو سكرتيرًا فنيًا يجوب القرى، ليمثل تمثيليات عن مضار البلهارسيا، هو الذي يعيش مع تشيخوف وشكسبير وأبسن وشو وسوفوكل، وحلم بأفاق لم يتطرق طموح إليها من قبل.
وكان هو الوحيد في مجموعته الذي حصل على درجة الامتياز في فن التمثيل، فبيض وجهه أستاذه بين أساتذة المجموعات الآخرى من طلبة الدبلوم، ولذلك كان يكن لنبيل حبًا خاصًا، وحين شكا إليه المدير الإداري والمحققة أحاطه علمًا بما حدث، لم ينس الأستاذ أن ينبهه إلى ضرورة التحكم في أعصابه وإلا فسيحطم مستقبله، وأن يعرج بلغتين أو ثلاث على المدير الإداري الذي كان يطلق عليه “الحمار الحصاوي” وأن يلومه على اصطلاحه بعنايات بالذات “السكرة” على حد تعبيره..
-سكرة مين، دي بنت كلب قليلة الأدب..
وتوسط الأستاذ بينه وبين عنايات، وفشلت مساعيه في إجباره على الأعتذار إليها، وأخذ بيده معه، وحدثها عن مواهبه المتعددة، وعن كونه طالبًا بليسانس الحقوق، وتوسط بينه وبين عنايات، وعرف هو بذلك بأن أستاذه حدثها طويلًا عن حساسيته الشديدة وأعصابه المرهقة واعتزازه الشديد بنفسه، وشاعريته، واطلاعه ومقالاته النقدية، وأخبرها أنه طالب بالحقوق “يعني هايبقى زيك محقق في الإدارة القانونية” وليس ممثلًا من حثالات المسرح الشعبي، وعرف أنها سرت بوجه خاص لكونه طالبًا بالليسانس، فضلًا عن دهشتها لوجود شاب بمثل مواهبه بين “صعاليك” المسرح الشعبي أجل لم يكن أحد يعتبر ممثلي المسرح الشعبي فنانين، لو يكن أحد يعتبر المسرح الشعبي مسرحًا، حتى مدير المصلحة، وحتى وكيل الوزارة، وحتى الدولة التي تنفق عليه، كان ملجأ للمثلين القدامى من بقايا فرق ما قبل الحرب العالمية الثانية.
**
كان أنور يكتب في مجلة “الرسالة” مقالات بدت شيئًا جديدًا طازجًا بالنسبة لما كان ينشر فيها من مقالات محنطة عن موضوعات ميتة ينتمي أكثرها حداثة للقرن الثالث الهجري، وكان أنور يكتب حينذاك عن شاتوبريان والرمانسيين، ويهاجم الدكاترة من أساتذة الجامعة بوجه خاص، وينادي بمذهب جديد، وأسماه “الآداء النفسي”، ويتذكر نبيل أنه قرأ مقالات “أنور” بشغف، وهو بعد تلميذ في ختام المرحلة الثانوية، ثم داوم على شراء المجلة وتتبع مقالاته، ثم أغلقت المجلة أبوابها لأنها لم تكن تغطي مصاريفها، وحُرم أنور من النافذة الوحيدة التي كان يطل منها على القراء، ومن يومها وأنور في الشارع، لا يجد مكانًا يكتب فيه وذلك لانعدام المجلات الأدبية، ولعدم اتساع المساحات المخصصة للنقد في غيرها من المجلات الآخرى، فهاجر بقلمه يكتب في إحدي المجلات اللبنانية مقالًا واحدًا على الأكثر في العام، وحين يعود نبيل إلى مقالات أنور القديمة لا يملك إلا أن يضحك من ضحالتها وسذاجتها وضيق أفقها وعن إعجابه القديم بها، ومنذ توقف أنور عن الكتابة في “الرسالة” توقف أيضًا عن القراءة، أو لعله توقف عن القراءة منذ أن بدأ يكتب، فها هو نهر الأفكار والمذاهب والنظريات يجري بلا توقف ويقذف كل يوم بجديد أما أنور فمازال يعيش في القرن..إنه يرفض كل جديد ويتعالى عليه، في الشعر وفي القصة، ولكنه يرفض دون أن يحاول تبرير هذا الرفض، ولا يستطيع أن يستوعب أن “أولاده” قد خطوا خطوات جعلته خلفهم بمراحل، وكان من أشد المتعصبين للعقاد،وخاصة في كراهيته للشيوعيين، وإن اختلف عنه في ميوله الديمقراطية، وبغضه لكل مستبد، هو رجعي التفكير إلى حد العمى، ولكنه يقدس الحرية، وكان إلى ذلك “شديد التقديس للحرية الفردية، شديد البغض لكل أنواع الاستعباد، يؤمن أن الأصالة في الشذوذ لا في القاعدة، وفي الصفوة لا في القطيع، وكان إلى ذلك-أو ربما بذلك- شديد التقديس لحرية الفرد، شديد البغض لكل مستبد.
**
ثم هو أفضل بكثير من سائر أفراد الشلة، إنه رجعي، هذا صحيح، ويكره الشيوعيين بوجه خاص، وفردي، ومغرور، كل هذا صحيح، ولكنك تفضله على الآخرين، فهو لم يبع قلمه كما باعه الداعرون، فهو يعتز بقلمه، ألم تكف أنت أيضًا عن القراءة؟! إنك تنزلق إلى مصيره، نفس النهاية، إنك تنزلق، والفرق بينكما أنه انزلق أعمى، وأنت تنزلق مبصرًا، تنزلق عن عمد، أليس أنت أسوأ منه بكثير، إنه أحق بالعطف، فلم نتمادى في العناد، إن الظروف تقسو علينا فلنرحم بعضنا البعض، لنتسامح.
**
إلى أين؟!
تساءل في امتعاض، ويأس حين لفظه البيت إلى الشارع المظلم الضيق، شارع عليش، المتفرع من شارع الربيع الجيزي، كانت الساعة تقارب الثامنة، وكان عليه كل مساء في مثل هذه الساعة أن يواجه نفس السؤال، ولم يطل به التفكير هذه المرة، فقر رأيه على مقهى الكمال، ولم يكن في جيبه أكثر من ثلاثة تعريفه، والمقهى في ميدان الجيزة غير بعيد عن بيته، ولن يتكلف إليه مواصلات، هذا فضلًا عن أنه سيشرب هناك كوبين أو ثلاثة من الشاي تضاف إلى الحساب الذي يواظب على دفعه كل شهر للجرسون، وسيوفر الثلاثة تعريفة للذهاب غدًا إلى المصلحة!
لم يكن ذلك لأن اليوم يوافق الخامس والعشرين من الشهر إذ لا فرق بالنسبة إليه بين الخامس منه، والخامس والعشرين، فقد كان دائمًا مفلسًا، ما يكاد يقبض مرتبه حتى يسدد بعض ما عليه من ديون، ويقتنص سهرتين للتفاريح، يتزود بهما طوال الشهر، ويشتري بالباقي كتبًا لا يقرأها، ثم يعود فيستدين، وينتظر أول الشهر.
كانت النقود تتبدد من يده بسرعة غريبة لا لضآلة مرتبه فحسب، ولكن لأن كفه مخرومة منذ صغره، كما يقول أبوه، ولقد ضاق به أبوه، كما ضاق هوبنفسه، وبمن اخترع النقود التي تنفد، وبالعفريت الذي يركبه كلما تيسر في جيبه مبلغ، صغر أو كبر، وأصبح التبذير مرضًا من أمراضه الكثيره المزمنة الميؤس من علاجها، ومع أنه لم يكن يستطيع –رغم توفر النية- أن يسدد كل ديونه، إلا أنه كان شديد الحرص على أن يسدد للبقال المجاور للبيت ثمن ما يسحبه من سجائر طوال الشهر، لخشيته من أن يمنع عنه البقال السجائر، إذا ما تأخر شهرًا عن السداد، فإن حرمانه من السجائر يشكل في ذاته كارثة بالنسبة إليه، فهو لا يخشى شيئًا كما يخشى أن يمنع عنه البقال السجائر، لأنه مدمن على التدخين، يتعاطاه بسعار، ويشعل السيجارة في ذيل السجارة، كأن أحدًا يجري وراءه، بل ويستطيع أن يمتنع عن الأكل والشرب أيامًا، ولكنه لا يستطيع أن يكف عن التدخين ثانية، ورغم أن حرمانه من السجائر يشكل في حد ذاته كارثة بالنسبة إليه.
إلا أن الأمر لن يقف عند هذا الحد فيما لو تأخر شهرًا عن سداد البقال، فسوف يهرع هذا إلى أبيه يطالبه بالدين، وتصبح الكارثة مضاعفة، صحيح أن أباه يعلم بأنه يدخن، فقد كانت أصابعه مصفرة بشكل ملفت للنظر، كما لو كان يغمسها في صبغة اليود، وكانت أسنانه تجمع بين اللونين الأصفر والأسود في مزيج غريب ومقزز، وزاد من بشاعتها اتساع المسافات بينها، بحيث يبدو كما لو كان قد فقد نصف أسنانه، هذا فضلًا عن انسحابه من مجلس أبيه بين الفنية والفنية كلما ألح عليه المزاج، وتسلل إلى إحدى الغرف، أو إلى المراحيض ليخطف نفسين من سيجارة على عجل، مما لفت نظر الأب ذات يوم فقال له بلهجة ذات معنى”إنت يا بني عليك العذر؟!”.
ولما سأله يومًا عمًا إذا كان يدخن رغم أن كل الشواهد تقطع بذلك، راح صاحبنا ينكر بإصرار، فقد كان يخاف أباه بقدر ما يحبه، وكان أبوه يفضل دائمًا أن يخشاه أبناؤه على أن يحبوه، ولذلك كان حريصًا على ألا يعلن عن تيقنه من أن ابنه يدخن، فقد كانت سرية التدخين في نظره أن ابنه ما يزال يخشاه رغم أنه موظف، ويناهز الثلاثة والعشرين من عمره!
**
لاحظ هذا على وجهه حمرة خفيفة تدّب في بشرته البيضاء كالحليب، لم يشك هو أن الأمر مجرد مصادفة، فقد كان بينهما من الصداقة والمحبة ما لا يسمح له بأن يظن أن حلمي دعاه عمدًا إلى قراءة المسرحية ليصل به بطريقة عفوية-في الظاهر- إلى حديث حواء، ولكنه-مع ذلك- لم ينج يومها من الخجل، فقد كان يشعر بأن حلمي قد صبر لدرجة مخجلة، وكان “نبيل” يشعر بثقل الدين على نفسه، كما لو كان صخرة، وكان يتمنى لو يمكنه أن يسدد دينه لتخلو صداقتهما من أي شبهة نفعية، ولذلك راح يداري خجله ببجاحة كانت في طبعه، فقال:
-حضرتك بتقرالي برنارد شو، ولا بتطالبن بالدين قبل ما يسقط بالتقادم؟!
وتورد وجه حلمي، وتوجس شرًا، وقال ضاحكًا، وكأنه يرجوه أن يمرر تلك المصادفة الملعونة بسلام، خاصة وأنه يعرف فيه سلاطة اللسان:
-بلاش سخافة، اسمع..
غير أن صاحبنا قال قبل أن يستأنف حلمي القراءة:
-أنا مليش دعوة يا عم، العهدة على برنارد شو..
سرّ”نبيل” يومها وتنفس بارتياح، كأنما أزيحت عن صدره صخرة..
**
إلى أين؟!
تساءل وهو يخرج من البيت إلى شارع عليش، تساءل في امتعاض، وهو واقف على عتبة البيت، يخرج من البيت إلى شارع عليش الضيق، المتفرع من شارع الربيع الجيزي، ووقف لحظة يفكر، إلى اليسار، أم إلى اليمين، أم يعود إلى شقته الكائنة بالدور الرابع.
تساءل في امتعاض، وهو واقف على عتبة البيت، كان عليه كل مساء، في مثل هذه الساعة…
تساءل في امتعاض حين لفظه البيت إلى الشارع، وكان عليه كل مساء، في مثل هذه الساعة تمامًا، الساعة الثامنة، أن يواجه هذا السؤال، وأن يبحث له عن جواب، إلى مقهى عبد الله؟! أم إلى نقابة الممثلين؟! أم إلى السينما؟! أم إلى شبرا؟!
ووقف لحظة يفكر، إلى مقهى عبد الله؟! أم إلى نقابة الممثلين؟! أم إلى السينما؟! أم إلى شبرا؟ أم يصعد لغرفته لينام؟!
إلى نقابة الممثلين، إن هذا يتطلب ثلاثة قروش للذهاب من الجيزة إلى العتبة، وبالعكس! ويتطلب ثمن الشاي، وقرشين ثمنًا للشاي، كم معك؟! لم يكن في حاجة لأن يتحقق من المبلغ، معروف، ثلاثة تعريفة، لم يكن ذلك لأن اليوم هو الخامس والعشرون من الشهرن فلا فرق بالنسبة إليه بين الخامس، والخامس والعشرين من الشهر، لم يكن هذا اليوم يوافق الخامس والعشرين من الشهر، ولكن لم يكن هذا هو السبب، فلا فرق بالنسبة إليه بين الخامس والخامس والعشرين، كان دائمًا مفلسًا، فما يكاد يقبض مرتبه حتى يسدد نصف ديونه، والخامس والعشرين، كان دائمَا مفلسًا، فما يكاد يقبض مرتبه حتى يسدد نصف ديونه، ويشتري بالباقي كتبًا لا يقرأها، ثم يعود فيستدين، وينتظر أول الشهر، ويسهر سهرتين، ويشتري بالباقي كتبًا لا يقرأها، ثم يعود ويستدين، وينتظر أول الشهر.
وكان حريصًا على أن يسدد للبقال المجاور للبيت ما يتراكم عليه كل شهر من ثمن السجائر التي يسحبها طوال الشهر، ومع أنه لم يكن يستطيع-ولو توفرت النية- أن يسدد كل ديونه، إلا أنه كان حريصًا على أن يسدد، أول ما يسدد ما عليه للبقال من ثمن السجائر التي يسحبها طوال الشهر، فالأصدقاء يستطيعون أن ينتظروا، وإن لم يستطيعوا فليضربوا رؤوسهم في الحائط، وليضربوا رؤوسهم في الحائط إن لم يستطيعوا، فالضرب في الميت حرام، أما البقال فلن يعطه، ولن يفتح له حسابًا إن لم يسدد له كل شئ، فلن ينتظر، وسيمنع عنه السجائر، وهو مدمن على التدخين، يدخن بمعدل سيجارة كل خمس دقائق، السيجارة في ذيل السيجارة، يستطيع ألا يأكل، وألا يشرب أيامًا، بل أسابيع، ولكنه لا يستطيع أن يكف ثانية، ثانية واحدة عن التدخين.
ليت كل الأصدقاء كحلمي، إنه يذكر دين حلمي، سبعة جنيهات منذ سبع سنوات، هذا غير الفكة، والتناغيش التي (لا تحسب) يعلم الشيطان، -فالله لا يعلم- متى يمكنه أن يسدد ما عليه لحلمي، ولكن لم يبد على حلمي يومًا نفاد الصبر، بل أخذها مرة واحدة في أزمة واحدة دفعة واحدة.
**
أو سيطعن من الخلف بسكين، كان يتوقع الموت في كل لحظة لسبب ما، وبلا سبب، وكان يراه-الموت- في كل شئ، كل شبر من الأرض قد يكون مقبرة، كل شئ في الشارع، في البيت قد ينهي حياته، ويصلح أداة تنهي حياته، وكان شديد الرقابة على ذاته، رغم الغيبوبة التي تتملكه، تلك الغيبوبة الغريبة الواعية، يغيب فيها شق من نفسه عن الوجود، بينما يبقى الشق الآخر عاكف على المراقبة، (ظل) يراقب تلك الغيبوبة، يحصي بوادرها، ويبحث عن بواعثها وجذورها، لا يدري متى تسربت إلى وعيه لأول مرة مشكلة الموت؟!
فقد ماتت أمه وهو في السابعة عشرة من عمره، منذ عشر سنوات(*كان عمر نجيب وقتها 27 عامًا) وكان حينذاك في السابعة عشرة من عمرة، منذ عشر سنوات، وكان حينذاك في السابعة عشرة من عمره، ولكنه يعرف أن تلك الفكرة اللعينة قد تسربت وأنه قد اصطدم بتلك المشكلة قبل ذلك بزمن طويل، متى؟! لا يدري! إنه واثق أن موت أمه لم يكن السبب، فقد كان قبل موتها بكثير صديقًا للخيام، وأبي العلاء وشبنهور!!
لم يكن موت أمه هو السبب، لقد ماتت منذ عشر سنوات فقط، وكان حينذاك في السابعة عشرة من عمره، وكان قبل ذلك بكثير صديقًا للخيام، وأبي العلاء، وشبنهور، متى اصطدم بالموت؟! لا يدري!! ولكنه يعيش كالمطارد!!
وانعطف مع الجدران، لشارع الربيع الجيزي، إلى اليمين، متجهًا، بحكم العادة..
وانعطفت الجدران إلى اليمين فانعطف معها تلقائيًا..
لم يختر قهوة عبد الله إلا مرغمًا، نزولًا على حكم جيوبه، فهي قريبه من منزله، لا أتوبيس، ولا حاجة به إلى أجرة أتوبيس، ثم إن له حسابًا مع الجرسون، يسدده أيضًا كل شهر أولًا بأول، سيشرب اثنين أو ثلاثة تعريفة للذهاب غدًا إلى المصلحة، كل شئ على ما يرام، ولكنهم هناك، وهو مجبر على أن يلتقي بهم بين ليلة وليلة، وأحيانًا كل ليلة، رغم ضغط الجلسة معهم على أصابه العارية، إنهم أشباح جوفاء، تافهة.
أشباح؟! وأنت؟! ألست شبحًا؟!
مخيفة، وحبيبة إلى نفسه أيضًا، وهو لا يدري على التحديد، هل يوالي على حضور سهرتهم ليلة بعد ليلة بدافع الخصائص المشتركة التي تجمعه بهم، أم لكي يستمد من انهيارهم، نوعًا من الإصرار على التماسك!
أشباح؟! ماذا تأخذ عليهم؟! جلوسهم في المقهى كل مساء؟! استغراقهم في لعب الطاولة والشاطرنج؟! زهدهم في كل شئ؟! إضرابهم منذ سنوات عن التفكير والقراءة؟! ضياعهم؟ قلقهم؟ مللهم؟ قرفهم؟ موتهم البطئ؟!
السابعة والعشرين..
وكان أبوه يفضل دائمًا أن يخشاه أبناؤه على أن يحبوه، واكتفى الأب بذلك، ولذلك ظل حريصًا على ألا يعلن عن يقينه من أن ابنه يدخن، وذلك حتى لا يظهر بمظهر المتسامح، أو بمظهر من يسكت مرغمًا على أمر لا يسره، وحتى لا يعتبر الابن هذا السكوت إذنًا ضمنيًا بالتدخين، يغريه بخطوة أكثر جرأة، وأحب الأب دائمًا تلك السرية التي يلتزمها ابنه عند التدخين، فمعنى ذلك أنه ما يزال يخشاه، رغم كونه موظفًا، ويناهز السابعة والعشرين..
وهو يفضل أن يخشاه أبناؤه على أن يحبوه، وكان صاحبنا يحب أباه، بقدر ما يخشاه، ولذلك ترك الأمر محلًا للشك، والتردد، والترجيح، مستهدفًا-فضلًا عن ذلك- أن يعطيه فرصة للعدول عن التدخين قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة اليقين..
**
واكتفى الأب بذلك، بل لعله سر بهذا الإنكار، فيما بينه وبين نفسه، وحدث ذات يوم أن توجه الأب إلى دكان البقال ليسدد حساب العائلة، وكان البقال من الغباء بحيث كتب حساب..
وأعطاه وطلب الدفتر لمراجعته، فراعه أن يرى حساب الابن في الصفحة المقابلة، مفردًا لابنه في الصفحة المقابلة،وراعه أكثر أن تتكون القائمة الطويلة من كلمة”علبة هليود”..
وكان البقال من الغباء بحيث سجل حساب السجائر في الصفحة المقابلة، وكان البقال من الغباء بحيث سجل حساب السجائر، وحساب العائلة في صفحتين متقابلتين، فراع الأب أن لابنه حساب منفرد، وراعه أكثر ألا يزيد هذا الحساب ..
وراعه أكثر ألا تتجاوز محتويات القائمة الطويلة “علبة أو علبتين هوليود” كان قائمة طويلة تتكون من “علبة هوليود” أو “علبتين هوليود” ..
فتملكه الغضب، وأسرع إلى البيت، فاستدعاه وسأله عما إذا كان يدخن؟!
ورغم أنه كاد ينفجر من الغضب! إلا أنه تمالك نفسه، عندما عاد إلى البيت، وسأله بطريقة تكاد تكون عفوية”إنت يا نبيل بتدخن؟!”، فراح نبيل ينكر بإصرار وبجاحة، واكتفى الأب بذلك، ولعله سر بهذا الإنكار فيما بينه وبين نفسه، وظل حريصًا على ألا يعلن عن يقينه من أن ابنه يدخن، وذلك حتى لا يظهر بمظهر المتسامح، أو من يسكت مرغمًا على أمر لا يسره، وحتى لا يعتبر نبيل هذا السكوت إذنًا ضمنيًا بالتدخين، قد يغريه بخطوة أكثر جرأة، وأحب الأب دائمًا تلك السرية التي يلتزمها ابنه عند التدخين، فمعنى ذلك أنه ما يزال يخشاه، رغم أنه موظف، ويناهز السابعة والعشرين، وترك الأمر محلًا للشك والتردد والترجيح مستهدفًا في نفس الوقت أن يعطي ابنه فرصة للعدول عن التدخين، قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة اليقين.
ولما سأله ذات يوم عما إذا كان يدخن، رغم أن كل الشواهد تقطع بذلك، راح صاحبنا ينكر بإصرار وبجاحة، فاكتفى الأب بذلك، وظل حريصًا على ألا يعلن عن يقينه، ترك الأمر محلًا للشك والتردد والترجيح، وظل حريصًا على ألا يعلن عن يقينه حتى لا يظهر بمظهر المتسامح..
وظل حريصًا على ألا يعلن عن يقينه، ليعطيه فرصة للعدول عن التدخين قبل أن يصل مرحلة اليقين، ومن ناحية آخرى كان الأب حريصًا على ألا يعلن عن يقينه، حتى لا يظهر بمظهر المتسامح، أو من يسكت مرغمًا على أمر لا يسره، وحتى لا يعتبر الابن هذا السكوت إذنًا ضمنيًا بالتدخين، قد يغريه بخطوة أكثر جرأة، بل لقد أحب تلك السرية التي يلتزمها ابنه عند التدخين، فمعناه-في نظره- أنه مايزال يخشاه، رغم أنه موظف، ويناهز السابعة والعشرين، وكان هو شديد الحرص، على أن يخشاه أبناؤه على أن يحبوه..
**
“انت يا ابني عليك عذر؟!”
وحدث ذات يوم أن توجه الأب إلى دكان البقال، ليسدد حساب العائلة، وطلب الدفتر لمراجعته، وكان البقال من الغباء بحيث سجل حساب الابن، وحساب العائلة في صفحتين متقابلتين، ووقعت عيناه على عبارة”حساب نبيل أفندي منصور” وتحتها قائمة طويلة تتكون من”علبة او علبتين هوليود”، فاحتقن وجهه غضبًا ودهشة وارتياعًا، ولم يتمالك نفسه، فسأل البقال غير مصدق عينيه:
-نبيل أفندي مين، مين نبيل أفندي ده؟!
-ابن حضرتك!!
فكتمها في نفسه، وعاد إلى البيت، واستدعى نبيل، وسأله بطريقة تكاد تكون عفوية..
وهو يردد بينه وبين نفسه “نبيل أفندي..” عال! “نبيل أفندي منصور” ما شاء الله! “نبيل أفندي هوليود..” يا حلاوة، ولكنه تمالك نفسه فيما بعد، وسأل نبيل بطريقة تكاد تكون عفوية، إنت يا نبيل بتدخن؟! فراح هذا ينكر بإصرار وبجاحة، فاكتفى الأب بذلك، ولم يصفعه بالحقيقة، وغضب أبوه بقدر ما سر، فمعنى ذلك أن نبيل مايزال يخشاه، وهو حريص على أن يخشاه أبناؤه أكثر من حرصه على أن يحبوه، رغم أنه موظف، ويناهز السابعة العشرين. وقبل أن يصل إلى مرحلة البعثة، بل لقد أحب تلك السرية التي يلتزمها ابنه عند التدخين، معناها-في نظره- أنه ما يزال يخشاه، رغم أنه موظف، ويناهز السابعة والعشرين!
فقد كان يفضل دائما أن يخشاه أبناؤه على أن يحبوه، أما هو فكان يحب أباه أكثر مما كان يخشاه، ولذلك كان خوفه من أن يمنع عنه البقال السجائر أشد من خوفه من أن يشكوه إلى أبيه، ومع يقينه من أباه يعلم بإدمانه على التدخين، إلا أنه كان حريصًا على ألا يعرض نفسه لموقف لن يخلو من إحراج، على كل حال، لم يكن يبقى من مرتبه بعد تسديد البقال-والجرسون- ما يفي بحقوق الأصدقاء، ليتهم جميعًا كحلمي، صديقه الأوحد، إنه مدين له بسبعة جنيهات منذ سبع سنوات، هذا غير الفكة التي لا تدخل في الحساب، ربع جنيه، نصف ريال، شلن، يعلم الله متى يمكنه أن يسدد ما في ذمته لحلمي، كي تخلو صداقتهما من أية شبهة نفعية، فلم يكن يؤلمه شئ كما لو كان يؤلمه أنه مدين لحلمي، وإنه عاجز عن عن تسديده، ما يهدد تلك الصداقة، وكان يرى في بقاء الدين في ذمته تهديدًا لصداقتهما هو الذي يعتبر حلمي عزاءه الوحيد في هذا العالم، ولكن لم يبد على حلمي يومًا شئ من نفاد الصبر، يا طول باله، بل لم يبد عليه مرة ما يوحي-ولو من طرف خفي- حتى أنه يتذكر ما له من نقود، بل هو دائب حتى الآن على الاستدانة من حلمي، رغم ما يجد في ذلك من خجل كلما التقيا، ولم يلمح على وجهه مرة بادرة ضيق أو ضجر، على كل حال، حلمي غني لا يضره السبعة جنيهات، بينما تكفي لكسر ظهره هو لأنها تعادل نصف مرتبة، وهو ينتوي-بحق- أن يسددها آجلًا بالطبع لا عاجلًا، وذلك عندما تتحسن الظروف التي يبدو أنها لن تتحسن أبدًا، ليكن، ليس ثمة ما يخجل، فحلمي يعرف أنه يحبه خالصًا من أي دافع نفعي، ويعرف أنه سيرد له نقوده يومًا، بل إن في عجزه عن السداد بعض مما يبعث على الراحة والزهو، أجل الزهو حلمي نفسه هو الذي فتح عينيه على هذا الجانب السار في الأمر..هل تعمد ذلك؟ أم كان الأمر مجرد مصادفة؟! لا يدري، كانا يقرآن “العودة إلى متيوشا” لبرنارد شو، حتى وصلا في خماسية “العودة إلى متيوشا” لمسرحية”في البدء”، وتكلمت حواء في حديثها “فمن أبنائها وأبناء أبنائها من لن يكون حفارًا أو لحادًا، وأدرجت حواء في حديثها أولئك الذين يقترضون ولا يسددون ديونهم، وسمعا حواء تتحدث عن العباقرة من أبنائها وأبناء أبنائها، ألم تقل إنهم يقترضون ولا يسددون، ولكن الإنسان يعطيهم ما يطلبون لأنهم يقولون أكاذيب جميلة في كلمات جميلة..” ألا يشبههم، إنه منهم ألست شاعرًا؟! لقد نظرا يومذاك إلى بعضهما البعض، وفي أعينهما، وعلى شفاهما ضحكة لم تنطلق وإن أفشتها الأعين، كان حلمي يعرف الحساسية، وربما فوجئ هو بتلك العبارة، وعرف موقعها من صاحبنا، وغشيت وجهه الأبيض حمرة خفيفة، ولكن هل دعاه حلمي إلى قراءة المسرحية عمدًا ليصل به إلى ما تقوله حواء؟ أم جاء ذلك مجرد مصادفة؟ إنه لا يدري على التحديد، ولكن اعترف بأنك سررت يومها، وتنفست بارتياح كأنما أزيحت عن صدرك صخرة!
ألست شاعرًا؟ ثم أليست فيك، فضلًا عن ذلك، الكثير من الملامح التي رسمتها حواء لتلك الفئة المصطفاة من أبنائها؟ إنك لا تحب أن تكون حفارًا، ولا تحب أن تحارب، وأنت ضعيف وجبان وغير مجدي، ثم أنت قذر الملابس، مبهدل الهندام، لا تكلف نفسك عناء قصّ شعرك المتراكم على قفاك، أو حلاقة ذقنك، متى قصصت شعرك؟ ألم يكن ذلك رغمًا عنك.
لقد جربت نفسك في كل شئ، وفشلت، الشعر؟ إن أحدًا لا يعترف بك، وأنت آخر من يُذكر اسمه حين يجري الحديث عن الشعراء، إن ذُكر على الإطلاق، النقد؟ شرحه! ثم هل تجد مكانًا تنشر فيه مقالاتك؟ بل ، أتستحق تفاهتك أن تنشر؟ التمثيل؟ أتؤمن حقًا بأنك تستطيع أن تكون ممثلًا ناجحًا؟! الإخراج؟ ألم تجرب نفسك في المسرح الشعبي؟!لقد طبع الجميع دواوينهم، وأنت تتسكع على الأبواب المغلقة!
لا يغرنّك ما كتبه البعض من تقريظ لبعض قصائدك.
**
لم يبد عليه مرة ما يوحي حتى بأنه يتذكر ماله من نقود في ذمة صاحبنا، بل كان يتوقع كلما التقيا أن يطلب منه، بل لقد كان يستدين منه كلما التقيا دون أن يلمح على وجهه بادرة من الضجر، “على كل حال حلمي غني، لا يضره السبعة جنيهات، أما هو فتكسر ظهره، لأنها بالضبط نصف مرتبه، ولسوف يسددها، عاجلًا أم آجلًا، حين تتحسن الظروف، من يدري، قد تهبط معجزة، وتتحسن الظروف؟ لكن يبدو أنها لن تتحسن أبدًا! لكن، ليس في الأمر ما يخجل، بل على العكس هناك ما يبهج، ما يدعو إلى زهو معزي، ما يغوي بل على العكس، هناك ما يغريه في عجزه، ليس الأمر ما يخجل، ففي عجزه عن السداد بعض ما يحث على الزهو، والراحة، والاطمئنان، حلمي نفسه هو الذي فتح عينيه لهذا الجانب السار،
**
خرج من منزله بشارع عليش الضيق المظلم، وكانت الساعة تقارب الثامنة..
إلى أين؟!
تساءل في امتعاض ويأس..ولم يطل به التفكير، ففي جيبه ثلاثة قروش لا غير، إلى قهوة الكمال..
**
يومها نظرة ذات معنى، وعلى شفاهما ضحكة لم تنفجر، وإن أخفتها الأعين! كان حلمي يعرف فيه شدة الحساسية، وربما فوجئ هو نفسه بتلك العبارة، وخمن موقعها من نفس صاحبه، فهو يذكر أن حمرة خفيفة علت وجهه، فقد علت وجه-حلمي- حمرة خفيفة، نمت عنها بشرته البيضاء كالحليب، ولكن هل دعاه حلمي عمدًا إلى قراءة تلك المسرحية، ليصل به إلى حديث حواء عن العباقرة الذين لا يسددون ديونهم، وهل يعتبر ذلك نوعًا من المطالبة الضمنية بالدين قبل أن يسقط بالتقادم؟!
أم كان ذلك مجرد مصادفة؟! إنه لا يدري حتى الآن، حلمي محامٍ، وفي هذا ما يثير الريب!! ولكن، اعترف بأنك سررت يومها غاية السرور، تنفست بارتياح كأنما أزيحت عن صدرك صخرة، وكأنما دفعت لحلمي ماله من دين! لست الوحيد الذي لا يسدد ديونه، بل يجب أن تتمسك بحقك في عدم السداد وفاءً لعبقريتك، ألست من تلك الصفوة المختارة التي تتحدث عنها حواء برنارد شو؟! ألست شاعرًا؟ ثم أليس فيك فضلًا عن ذلك الكثير من ملامح الصفوة التي حددتها حواء؟! ألست قذر الملبس، بلا هندام؟! ألم يدعوك أبوك وأمك وإخوتك منذ صغرك يطلقوا عليك منذ صغرك اسم أحد مجاذيب القرية؟ متى حلقت ذقنك؟ منذ أسبوع؟ وشعرك؟ منذ شهور؟ أنت أيضًا مثلهم-الصفوة- لا تكلف نفسك عناء قصّ شعرك المتراكم على قفاك؟! لم تذهب مرة إلى الحلاق بإرادتك، كان دائمًا يصطادك على ناصية شارع عليش، ويقسم عليك بالطلاق، فلا تملك إلا أن تنساق معه إلى الدكان، كما لو كنت تُساق إلى الذبح، لو لم تصفهم حواء أيضًا بالضعف والجبن واللاجدوى لتمت مسرتك!
لكن واثق أنت من أنك لست ضعيفًا؟ أوافق أنك لست جبانًا؟ أواثق من أنك مجدي؟! إن حلمي نفسه من القلائل الذين يؤمنون بك إيمانك بنفسك؟ إيمانك بنفسك؟! أأنت واثق حقًا من نفسك؟! هؤلاء القلائل ألا يخدعونك؟! ولكن ما مصلحتهم في الخداع؟! لتكن فاقد الثقة بالنفس، في هذا أيضًا ما يبعث على الراحة، والزهو، ألم يكن تشيخوف فاقد الثقة بنفسه؟! ولكن أين أنت من تشيخوف؟! ثم أكان حقًا يعاني فقدان الثقة بالنفس أم كان يلعب هذا الدور؟! إنك ترتاب حتى في نقاء تشيخوف!!
**
لم يقرر بعد إلى أين يذهب! فقد انشغل مؤقتًا بمشكلة أزلية، وكان قد وصل إلى رأس شارع عليش المفضي إلى شارع الربيع الجيزي، وكان عليه أن يتخطى دكان الحلاق، هل يجلس ابن الصرمة الآن أمام الصالون، أم تراه مشغولًا برأس أحد الزبائن؟
وقال بثقة الزبون الطيب المعاملة، النظيف الذمة!
-علبتين ونجز لو سمحت..
-كبيرة ولا صغيرة؟
قالها بثقة الزبون الطيب المعاملة، وأخذ العلبتين، وتنهد، لقد حلت مشكلة السجائر، وكان دائمًا يتنهد بارتياح كلما قبض على علبة السجائر، ناوله البقال علب السجائر، ووضع في جيبه علبتي السجائر، واطمأن على مؤنة الليلة، فلم يكن يرعبني شئ، كما يرعبني أن أبيت حرمانًا، كانت السيجارة معينه الأوحد على السهر في غرفته المظلمة، لا ينام، ولا يصحو، يدخن ويدخن حتى الصباح!
وأشعل سيجارة، ثم مضى متثاقلًا إلى المقهى مارًا ببائعي العنب والبطيخ والعجوة والتين الشوكي بعربات الباعة، وبالدكاكين دون أن يلتفت إلى شئ، كان (يغيب) دائمًا إلى الداخل، لا يرى شيئَا، وكان المنظر متكررًا بحيث، لا لأن المنظر يتكرر في رتابة أمام عينيه كل يوم بحيث لم يعد بحكم العادة ينجذب إلى شئ فحسب، بل لأنه كان يمشي دائمًا كالمسحوب إلى الداخل، مأخوذًا لا يرى شيئًا، وتدفعه الغريزة إلى السير فوق الأرصفة وتجنب النزول إلى الشارع، بل ومحاذاة جدران البيوت وأبواب الدكاكين، كالأعمى تجنبًا لمخاطر الطريق، فلم يكن ينتبه إلا على صوت بوق سيارة مفاجئ، يخرجه من غيبوبته، وينتصب شعره لحظة، ثم يمضي في سبيله ملتصقًا-أو يكاد- بالجدران!
لا يدري لماذا كان يتوقع دائمًا أن تصعد سيارة فجأة إلى الرصيف لتعصره بينها وبين الجدار، أو أن يسقط عليه سلك كهربائي فيصعقة، أو تنهار فوقه شرفة منزل، أو يسقط على رأسه إصيص أو قلة أو أي شئ، وكثيرًا ما فاجأ نفسه يشعر كما لو كان يتوقع من أحد سيصفعه على قفاه!
كان يستطيع أن يلف لفة طويلة ليصل في النهاية إلى مقهى عبد الله الذي قر رأيه-مكرهًا- الذهاب إليه، ولكن لم يكن هناك مفر من العبور أمام دكان الحلاق، فقد كان عليه أن يمر بدكان الحلاق ليصل إلى البقال، فما معه إلا سيجارتان فقط، وهو في حاجة إلى علبتين”ونجز” ينهي إحداهما في المقهى، ويأتي على الآخرى حين يعود إلى غرفته آخر الليل، ليدخن حتى الصباح! وخيل إليه أن بحرًا يفصله عن البقال، لماذا لم يكن دكان البقال قبل الصالون؟! بل لماذا توجد صالونات؟ لكن أكان هذا يغير من الأمر شيئًا؟ أجل كان يستطيع أن يأخذ علبتي الونجز ثم يلف لفة طويلة ليصل في النهاية إلى مقهى عبد الله دون أن يمر بدكان الحلاق!!
الأمر لله، خطا إلى اليمين متلصصًا، ثم وقف بحافة النور، واستجمع كل قواه، وأفلت، ثم أسرع دون أن يلتفت وراءه، ثم دلف دكان البقال!
**
إلى أين؟
تساءل في امتعاض ويأس حين لفظه البيت إلى الشارع المظلم الضيق، وكانت الساعة تقارب الثامنة، وكان عليه كل مساء في مثل هذا الموعد أن يواجه نفس السؤال، ووقف لحظة يفكر، وسرعان ما قر رأية على مقهي الكمال، فليس في جيبه أكثر من ثلاثة تعريفه، والمقهى في ميدان الجيزة غير بعيد من شارع عليش حيث يقع منزله، ولذلك لن يتكلف إليه مواصلات، فضلًا عن أنه سيشرب هناك كوبين أو ثلاثة من الشاي تضاف إلى الحساب الذي يواظب على دفعه كل شهر للجرسون وسيوفر الثلاثة تعريفة غدًا للذهاب إلى المصلحة!
لم يكن ذلك لأن اليوم يوافق الخامس والعشرين من الشهر، فلا فرق بالنسبة له بين الخامس منه والخامس والعشرين، فقد كان دائمًا مفلسًا، ما يكاد يقبض مرتبه حتى يسدد بعض ما عليه من ديون، ويقتنص سهرتين للتفاريح، يستعين بها على طول الشهر، ويشتري بالباقي كتبًا لا يقرأها، ثم يعود فيسدد، وينتظر أول الشهر!
كانت النقود تتبدد من يده بسرعة مذهلة، يعللها هو بضآلة مرتبه، ويعللها أبوه بأن كفه مخرومة من صغره، ولقد ضاق به أبوه، كما ضاق هو بنفسه، وبمن اخترع النقود التي تنفد كأن فيها عفريت، وأصبح التبذير مرضًا من أمراضه الكثيرة المزمنة الميؤس من علاجها، ذلك كان شأنه حين كان تلميذًا بمدرسة السنبلاوين الابتدائية بعيدًا عن أهله، أو في مدرسة زفتى الثانوية، فقد كان ينفق مصروفه في أيام، ويعيش على الطوى، أو على الطرشي والخبز الجاف، حتى يأتيه المدد من القرية، ولا يذكر أبوه مرة حتى بعد أن ألتحق بكلية الحقوق بالقاهرة، حتى بعد أن أصبح طالبًا بكلية الحقوق، أنه زاره فوجد لدية بقية من نقود، كان دائمًا يجده على الحديدة، أو شاحت الدقة، على حد تعبير أبيه، ولقد ضاق أبوه بتبذيره.
ومع أنه لم يكن يستطيع-رغم توفر النية- أن يسدد كل ديونه، إلا أنه كان شديد الحرص على أن يسدد للبقال المجاور للبيت ثمن ما يسحبه من سجائر طوال الشهر، فهو مدمن على التدخين، يتعاطاه بسعار، ويشعل السيجارة في ذيل السيجارة كأن أحدًا يجري وراءه، بل ويستطيع أن يصوم عن الأكل والشرب أيامًا، ولكنه لا يستطيع أن يكف ثانية عن التدخين، ولذلك لم يكن يخشى شيئًا كما كان يخشى أن يمنع عنه البقال السجائر فيما لو تأخر شهرًا عن السداد، ورغم أن حرمانه من السجائر يشكل في حد ذاته كارثة بالنسبة إليه، إلا أن الأمر-لا قدر الله- لن يقف عند هذا الحد، فسوف يهرع البقال إلى أبيه يطالبه بالدين، وتصبح الكارثة مضاعفة.
صحيح ان أباه يعلم بأنه يدخن، فقد كانت أصابعه مصفرة بشكل ملفت للنظر، كما لو كان يغمسها في صبغة اليود، وكانت أسنانه قاتمة تجمع بين اللونين الأصفر والأسود، في مزيج غريب مقزز، وزاد من بشاعتها اتساع المسافات بينها بشكل غير عادي، بحيث يبدو كما لو كان قد فقد نصف أسنانه، وكان هذا فضلًا عن مجلس أبيه بين الفنية والفنية كلما ألحّ عليه المزاج، وتسلله إلى إحدى الغرف أو إلى المراحيض، يخطف نفسين من سيجارة على عجل، مما لفت نظر الأب فقال ذات يوم”إنت يا بني عليك عذر؟!”، ولما سأله عمّا إذا كان يدخن، رغم أن كل الشواهد تقطع بذلك-راح صاحبنا ينكر بإصرار وبجاحة، فاكتفى الأب بذلك، وترك الأمر محلًا للشك والتردد والترجيح فلم يعلن عن يقينه. وذلك حتى لا يظهر بمظهر المتاسامح، أو بمظهر قد يغريه بخطوة أكثر جرأة، بالعلنية مثلًا، أو بتعاطي الخمور! مستهدفًا-من ناحية آخرى- أن يعطيه فرصة للعدول.
**
كان مقهى الكمال يشرف على جميع مفارق الميدان، فهو يقع على ناحية يمتد خلفها شارعان صغيران مزدحمان دائمًا بالباعة المتجولين، ويمتد على يمين الناحية، شارع يفضي إلى كوبري عباس، وعلى يسارها شارع يفضي إلى الهرم، أما فمن الأمام فيطل المقهى على شارعي الجامعة وحديقة الحيوان، وكانت المنازل المجاورة للمقهى من اليمين واليسار قديمة غير مرتفعة، ولا توجد على الميدان عمارات شاهقة تسدّ إليه منافذ الهواء أو تحجب عنه السماء، ولذلك كان أفضل مكان للجلوس فيه، وكان الرصيف معرشًا بسقف منحني من الخشب، يحجب عن الرواد شمس الصيف الحارقة، ولذلك-وخاصة في المساء- كان المقهى أفضل مكان للجلوس، لولا أنه ميدان غاصّ بالحركة، كثير الضوضاء، تمر به الترام والأتوبيس والترولبوس وكافة المواصلات المتجه من القاهرة إلى الجيزة أو العكس، هذا فضلًا عن الراديو الذي يزعق، ويخشخش بلا توقف.
**
(من قبل كان يتألم، الجديد الذي طرأ على تكوينه الذهني والنفسي، من قبل كان يتألم للموت، أما اليوم فيتألم ويشعر في ذات الوقت بالعار!) كتبها نجيب من أسفل لأعلى.
**
كانا يقرآن معًا مسرحية “في البدء” لبرنارد شو، ووصلا إلى حواء، وهي تتنبأ بالمستقبل، وتتحدث عن الصفوة المختارة من أبنائها العباقرة، ألم تقل أنهم يقترضون ولايسددون أبدًا، ولكن الإنسان يعطيهم ما يطلبونه، لأنهم يقولون أكاذيب من كلمات جميلة، يومها تبادلا نظرة ناطقة، وعلى شفاهما ضحكة، لم تنفجر، وإن فهما مغزاها، وكان حلمي يعرف في صاحبة شدة الحساسية، وربما فوجئ هو نفسه بحديث حواء، وضمن موقعه من نفس صاحبه، وكان صاحبنا شكاكًا بطبعه، ولو لم يكن الدائن هو حلمي، لظن أنه دعاه عمدًا إلى قراءة المسرحية، ليصل به بطريقه عفوية-وفي الظاهر- إلى حديث حواء عن العباقرة الذي لا يسددون ديونهم، ولكن كان بينهما المحبة، ما لا يسمح له بمثل هذا الظن، ولم يشك لحظة في أن الأمر مجرد مصادفة، وإن لم ينج يومها من خجل، فقد كان يعتقد بأن حلمي قد صبر عليه أكثر من اللازم، وكان يسعر بثقل الدين على ضميره، وكان يتمنى لو يمكنه أن يسدد دينه، فصداقتهما هي عزاؤه الوحيد في هذا العالم، وهو حريص على أن تخلو هذه الصداقة من أي شبهة منفعة، ولذلك كان
(وفي حديث حواء عن) أبنائها، ألم تقل إنهم يقترضون ولا يردون أبدًا، ولكن الإنسان يعطيهم ما يطلبونه، لأنهم يقولون أكاذيب جميلة في كلمات جميلة، يومها تبادلا نظرة ناطقة، وعلى شفتاهما ضحكة لم تنفجر، وإن أفشتها الأعين، كان حلمي يعرف فيه شدة الحساسية، وربما فوجئ هو نفسه بتلك العبارة، وضمن موقعها من نفس صاحبه، فقد لاحظ هذا على وجهه حمرة خفيفة، تدبّ في بشرته البيضاء كالحليب، لم يكن يدري على وجه التحديد، أكان ذلك مجرد مصادفة؟!
أم ان حلمي دعاه عمدًا إلى قراءة تلك المسرحية ليصل به بطريقة عفوية-في الظاهر- إلى حديث حواء عن العباقرة الذين لا يسددون ديونهم، خاطرة لمعت في رأسه دون أن تترك أثرًا، فقد كانت صداقتهما أقوى من أن تعطي لمثل هذه الأفكار شيئًا من الجدية:
-لحد هنا عال، انت بتقرا لي برنارد شو، ولا بتطالبني بالدين قبل ما يسقط بالتقادم؟!
وازداد وجه حلمي حلمي توردًا، وقال بحزم ليداري خجله!
-بلاش تفاهه، اسمع!
وواصل القراءة:
-أنا مليش دعوة، العهدة على برناردشو..!
لقد سر يومها غاية السرور، وتنفس بارتياح، كأنما أزيحت عن صدره صخرة، بل كما لو كان قد دفع لحلمي فعلًا ما عليه من دين!
لست الوحيد الذي لا يسدد ديونه، بل يجب أن تتمسك بحقك في عدم السداد، وفاءً لعبقريتك، والمسؤولية على برنارد شو، ألسنا من تلك الصفوة المختارة التي تتحدث عنها حواء، ألست شاعرًا وناقدًا وممثلًا ومخرجًا؟! ثم أليس فيك فضلًا عن ذلك الكثير من ملامح الصفوة التي رسمتها حواء؟! ملابسك القذرة المبهدلة، ألم يطلقوا عليك منذ صغرك اسم أحد مجاذيب القرية؟! متى حلقت ذقنك؟! منذ أسبوع؟! وشعرك منذ ستة شهور؟
أنت أيضًا-كالصفوة- لا تكلف نفسك عناء قص شعرك، هذا الذي يتراكم على قفاك! لم تذهب بإرادتك مرة إلى الحلاق! دائمًا يصطادك على الناصية، ويقسم عليك بالطلاق، فلا تملك إلا أن تنساق معه إلى الدكان، كما لو كنت تساق إلى الذبح!
ترى هل يجلس ابن الصرمة الآن أمام الصالون، أم تراه مشغولًا برأس أحد الزبائن، قد يقطع عليك الطريق، فتقضي ليلتك محني الرأس، تنصت إلى ضربات المقص الرتيبة، مائة ضربة في الهواء، وضربة واحدة في المليان، لو أن الملعون كان يضرب كل هذه الضربات في الصائب، لما استغرقت عملية الحلاقة أكثر من خمس دقائق، أو توقف عن الكلام!
وكان قد خرج من ظلمة شارع عليش إلى شارع الربيع الجيزي، وكانت أضواء المصابيح خافتة، بحيث لم تصلح إلا في تخفيف الظلمة، واسترق النظر-بالغريزة-إلى الصالون، كان الأسطى بالداخل، والضوء الخارج من الصالون يفرش مساحة كبيرة على الرصيف، لا مفر من عبورها، فقد كان عليه أن يصل إلى البقال، ليأخذ علبتين”وينجز” الأسطى منكب الآن على الشغل، ظهره إلى الباب، يا ترى أم وجهه؟! ألن يخرج فجأة لينفض الفوطة، أو ليرش الرصيف بالماء استجداءً
**
وتقدم إلى شارع عليش الفضي إلى شارع الربيع الجيزي، واختلس نظرة إلى الصالون، كانت الظلمة قد خيمت، وتقدم إلى ناحية شارع عليش الضيق المفضي إلى شارع الربيع الجيزي، كانت أضواء المصابيح..
إذا اصطادك، فستقضي الليلة محني الرأس، تنصت بضيق إلى ضربات المقص الرتيبة، مائة ضربة في الفارغ، وضربة واحدة في المليان، لو أن ابن الصرمة كان يضرب كل هذه الضربات في المليان لما استغرقت عملية الحلاقة أكثر من خمس دقائق، بل لو أنه كفّ عن الكلام لما كان الأمر بمثل هذه القسوة على أعصابك.
وكان قد وصل إلى أول شارع عليش الضيق، المفضي إلى شارع الربيع الجيزي، وكان قد خرج من ظلمة شارع عليش الضيقة، المفضي إلى شارع الربيع الجيزي، فكانت المصابيح من الخفوت بحيث لم تفلح إلا بتخفيف الظلمة، ونظر-بالغريزة- إلى الصالون، كان المعلم بالداخل، ولكن، كان عليه أن يعبر مساحة الضوء الخارجة من الصالون والمفروشة على الرصيف، تري أهو مُكبٌّ على الرأس التي بين يديه أظهره إلى الباب أم وجهه؟! يخرج فجأة لينفض الفوطة البيضاء من قصاصات شعر، أو ليرش الرصيف بالماء استجداءً لنسمة رطبة أو ليبصق؟! إن عليه أن يقفز في أقل من لمح البصر، ولكن هذا سيلفت نظره أكثر، وسيخرج ليستطلع الأمر، إن لم يفهم على التو، أم يعبرها ببطء؟! إذن ستكون الكارثة، سيراه، وسيعدو وراءه، وسيقسم بالطلاق! ليقسم! سأقسم أنا أيضًا بالزواج أني لن أحلق الليلة، وسأعده أن أحلق غدًا..غدًا، لكم قال له الأسطى”إنك تحاربنا في رزقنا، فلو كان في البلد منك.”، “أنت بتحاربنا في أرزاقنا، لو كان كل الزبائن زيك، كنا زمنا قفلنا وشفنا لنا شغلة تانية.”.
لا مفر من العبور، فهو لا يستطيع أن يذهب إلى إذا كان مصرًا على الذهاب إلى مقهى عبد الله في ميدان الجيزة، المكان الوحيد الذي يستطيع إن يذهب إليه الليلة، فهو يحتاج إلى ثلاثة قروش للذهاب(…) آخر الليل إلى البيت، وقرشين ثمنًا للشاي، ولا يستطيع أن يذهب إلى السينما، (…) فالأمر يحتاج إلى زجاجة زبيب على الأقل!
(الورقة مقطوعة بالمخطوطة).
**
(…) إيقاع الموسيقى، أو يلعبون بالسكاكين، وبالنار، أو يثبتون زجاجات الكوكاكولا في صدورهم بدبابيس، أو ينامون على المسامير، فلم يكن يعير اهتمامه لشئ من هذا، بل وكفّ منذ زمن طويل عن الانفعال بمثل هذه المناظر، والوقوف عندها كما اعتاد في أول عهده بالعاصمة منذ سنوات، وكان دائمًا يحس يحنين عارم إلى القرية التي يهبطها مرة كل عدّة سنوات، ثم لا يلبث أن يهرب منها إلى المدينة، فالريف الذي يحن إليه ليس هو الريف الذي يراه كلما سنحت له فرصة لزيارة القرية.
كان أنور يحرص دائمًا على أن يناديه أفراد الشلة بالأستاذ، وكان يتألم بعمق عندما يناديه أحدهم بأنور”حاف”، وقد عرف الجميع منه هذا الأمر، فاصطلحوا على إرضاء غروره، وكان هو-أنور- ينادي الجميع دون لقب الأستاذية، يصر على ذلك بوجه خاص بالنسبة لمن يحمل (الشهادات العليا).
ولكن أتقل أنت عنه تفاهة بإصرارك على تجاهله كما تجاهلك، من هو؟ من أنت؟ لاشئ، لا شئ على الإطلاق، أنتما معًا لا تساويان فردة حذاء قديمة!! فعلام كل هذا الغرور، قم إليه، قل له، أرجوك بحق زيوس أن تبصق على نفسك، أن تنتحر، أنت مثلي لا تصلح لشئ، أنت تافه، وأنا تافه، إننا أتفه من بصقة، ولذلك فمن الأوجب أن نجلس معًا، بماذا يستطيع أن يزهو صرصور على صرصور، إن أي نعل ليسحقهما معًا!
كان قد اعتاد أسراب المتسولين التي تمر عليه بالمقهى كل لحظة بدعواتها المنظومة، وعباراتها المسجوعة المنغمة، واستعراضها لأرجلها وأيديها المقطوعة، أو أعينها المفقودة، أو الأطفال الرضع العارين النائمين على الصدور، أو البهلوانات المهرجين الذين يعرضون ألعاب الجمباز، أو المهرجين الذين يرقصون على(…)
هنا تقف المخطوطة الأكبر، ثم جزء من دراسته عن ثلاثية نجيب محفوظ، ثم دراسة طويلة لنهاية المخطوطة المعنونه(بكراسة حساب بني والبالغ عدد صفحاتها 89 صفحة) ودراسة طويلة عن شاعر يُدعى “عبد الملك نوري”.، المحرر(محمد فرحات).
ثم مخطوطة آخرى من صفحتين تحت عنوان (كراسة حساب بني كبيرة، بها جزء من قصيدة بديوانه غير المنشور”إنه الإنسان”، المحرر(م.ف).
نبدأ بتحرير الجزء الأخير من المخطوطة والمعنونة (بكراسة حساب سوداء) ، المحرر(م.ف).
يعنون الأستاذ نجيب سرور هذا الجزء من المخطوطة بعنوان”بين القاهرة وموسكو”، وإن كان المتن لا يدل على هذا العنوان إلا في صفحته الأخيرة والتي يصف بها كيف كان وداع أسرته له حين ارتحاله لموسكو لبعثته من 1959. المحرر، (م.ف).
كانت الساعة تقارب منتصف الليل عندما وصل منصور أفندي عبد القادر إلى ناصية شارع عليش، وكان أول ما فعله أن رفع بصره إلى موقع نافذة نبيل أفندي من الدور الرابع، وتمتم بغيظ:
-حضرتك لسه مارجعتش!
لم يكن يتوقع أن يجد النافذة مضيئة، فلقد اعتاد نبيل أن يعود متأخرًا، بل وكثيرًا ما يعود مع شروق الشمس ليلتقي بنبيل خارجًا إلى العمل، يتبادلان تحية الصباح دون أن يوجه الأب إلى ابنه أدني ملاحظة! ولعله كان يغتاظ أكثر مما لو كان نبيل قد عاد الليلة مبكرًا على غير مألوفة، فقد كان مزاج منصور أفندي مقلوبًا لدرجة لا يطيق معها أن يرى ابنه أو حتى أن يشعر بأن سقفًا واحدًا يمتد فوقهما!
كان عائدًا للتو من جلسة صاخبة لمجلس إدارة الاتحاد العام للصيارف الذي انتخب هو-للمرة الثانية- وكيلًا له، ووقف في الجلسة أحد الصيارف الذين حصلوا حديثًا على ليسانس الحقوق بطريق الانتساب، وبدأ بستعرض أمام الجميع عضلاته القانونية بطريقة استفزت كبرياء منصور أفندي الذي كان دائمًا يحتقر حملة الشهادات، وخاصة العالية، لذلك لم يتمالك نفسه، فصرخ في الأستاذ المحامي:
-قانون، قانون، وانت ما تفهمش في القانون ببصلة!
فردّ الآخر وهو يخرج إحدى الجرائد من جيبه:
-أنا معايا ليسانس الحقوق.
وفتح الجريدة على عامود الاجتماعيات، وهو يستطرد:
-الظاهر سيادتك مابتقراش جرايد!
وهنا اغتاظ منصور أفندي، فقال بحدة:
-الليسانس ده تبله وتشرب ميته، التورة منكو بقت بقرش! أنا عندي ابن معاه الليسانس!!
قال الجملة الأخيرة، وهو يعلم أنه يكذب، ولكنه قالها دفاعًا عن كبريائه الجريح، كم حزّ في نفسه أن الظروف لم تتح له أن يحصل على شهادة عالية، فقد كان أبوه، الحاج عبد القادر، يعمل بناء في قرية إخطاب من قرى الدقهلية، وكان يملك قطعة أرض صغيرة اشتراها بادخار العمر، وأراد لابنه منصور أن يرث مهنته كبناء وأن يزرع قطعة الأرض، غير أن منصور هرب من القرية، والتحق بمدرسة بمدرسة المعلمين الأولية، واشتغل بعدها مدرسًا بالمدارس الإلزامية، ثم افتتحت الحكومة مدرسة للصيارف، فهجر المدرسة الإلزامية، ليلتحق بها، وعين منذ الحرب العالمية الثانية صرافًا بمصلحة الأموال المقررة في مدينة بورسعيد، ولكنه يوقن في أعماق نفسه بأنه كان قادرًا على أن يصبح من أنبغ المحامين على وجه الأرض، لو لم توقفه الظروف التعسة عند نهاية مدرسة الصيارف، فهو يتمتع بذكاء خارق، وبديهة حاضرة، وأفق متسع وشخصية نادرة مسيطرة تجبر الجميع على احترامها وحبها.
ثم هو ينظم الشعر ويحفظ اللزوميات عن ظهر قلب، ولكنها الدنيا “تدي الحلق للي بلا ودان” لذلك تملكه سخط، بل حقد، شديد على الأستاذ المحامي، ثم لم يلبث سخطه أن تركز على نبيل:
-يا خسارة تعبك يامنصور!
كثيرًا ما تساءل عن سر خيبة نبيل المفاجئة! إنه لم يقصر في حقه بشئ، بل لقد بذل فوق ما كان في وسعه، ليتيح له فرصة التعليم الذي حُرم هو منه. أدخله بمدرسة بورسعيد الإبتدائية، مع صفوت –الابن الأكبر- يوم كانت بالمصروفات، ويوم كان مرتبه لا يزيد على الأربعة جنيهات، ويوم كان وراءه أطفال يحتاجون لكل مليم من مرتبه، واقتطع من قوته الضروري، ليدفع لهما القسط الأول وثمن الكتب، ثم وجد نفسه عاجزًا عن دفع القسط الثاني، للاثنين معًا، فأخرج صفوت من المدرسة، نزولًا على رأي الأم، من أجل مواصلة تعليم نبيل، الذي كان يتمتع-على عكس أخيه- بهدوء ملائكي يجعله الأقدر على مواصلة الدراسة، بل وباع يومها من أجل نبيل سريرًا ودولابًا، واقترض نقودًا بالربا الفاحش، وقطع نبيل المرحلة الابتدائية دون تعثر، وكانت حالة منصور أفندي المالية قد تحسنت قليلًا فألحق بالثانوية، ثم بكلية الحقوق، وظل نبيل-كالعهد به- شغوفًا بالتعليم، ثم، ثم ماذا حدث؟!
-عين وصابت الولد!
إنه يفهم أن يترك الإنسان الكلية-أية كلية- في السنة الأولى أو الثانية، أو حتى الثالثة، أما أن يتركها في السنة النهائية، فهذا ما يبعث على الجنون، ولقد بدأ يعتقد أن خيبة نبيل في نهاية المرحلة الجامعية، انتقام من جانب الأقدار لصفوت. أن ضميره لم يسترح يومًا لتلك التضحية الاضطرارية، ومع أنه يبرر ذلك بهزال مرتبة حينذاك أو بشقاوة صفوت الذي كان يسرق من جيب أبيه نقودًا، أو مصوغات أمه، ويرتكب شتى الموبقات، فقد كان صفوت يسرق النقود من جيب أبيه، أو يسرق مصوغات أمه أو ما تصل إليه يده، ليسافر من القرية إلى المنصورة، حيث يقضي يومًا كأولاد البشوات، ينفق عن سعة، ويشتري كل ما تشتهيه نفسه، ويأكل في أحسن المطاعم، ويوزع البقشيش يمينًا ويسارًا، ثم يعود ليتلقى من أبيه ألوانًا من العقاب أقلها الكي، لا تنجح مع ذلك في ردعه عن السرقة التي كان يواصلها بإصرار جريًا وراء رغباته، ولم يكفّ في بورسعيد عن السرقة، ولذلك لم يتردد والده في التضحية به.
وأعاده إلى القرية ليفلح مع جده قطعة الأرض الصغيرة، فقضى بقية صباه في الفلاحة، وانتظر حتى أصبحت المدرسة الابتدائية بالمجان، فدخلها على كبر سنه، ثم عجز أبوه مرة ثانية عن إدخاله المرحلة الثانوية، التي كان نبيل في ختامها، وأدخله مدرسة الصناعات الميكانيكية لكونها بالمجان، وعُين بعدها مدرسًا بالمدارس الإعدادية بمرتب قدره خمسة عشر جنيهًا في كوم أمبو.
-يا خيبة أملك يا منصور!
تردد لحظة قبل أن يدق جرس الباب، وكاد يرجع على عقبيه ليذهب إلى أي مكان أو ليسير في شارع المدينة حتى الصباح، فلم يكن يريد في تلك اللحظة أن يرى أحدًا، ولذلك قفزت روحه إلى مناخيره، عندما فتح صفوت-بالذات- الباب.
لم يعدّ يشغل باله بخيبة صفوت، فقد رمى طوبته منذ زمن بعيد، بل لم يسبق أن علق عليه آمالًا، لكن في تلك اللحظة بالذات ارتفع منسوب الغيظ المكتوم في نفسه، فشعر برغبة في أن يصرخ، أو يشد شعره أو يضرب الباب بقدمه، أو يلعن أبا صفوت ونبيل، ولكن تمالك نفسه، وألقى من بين أسنانه تحية المساء خافتة صفراء، وعلى سبيل الواجب ليس إلا، وردّ صفوت التحية أكثر خفوتًا، وهو يسرع بالاختباء في غرفته الواقعة على يمين الداخل، وانحنى منصور أفندي قليلًا ليدخل من الباب فقد كانت قامته فارعة بشكل غير عادي، مما جعله يزهد في لبس الطربوش الذي يضيف إلى قامته ارتفاعًا هو في غنى عنه.
وفي خطوتين كان منصورأفندي قد قطع الصالة الواسعة التي تتوسطها ترابيزة سفرة كبيرة، ويقف بعدها بوفيه عريض مرتفع، وانحنى مرة ثانية، وهو يدلف إلى غرفته المواجهة للباب الخارجي، وكانت زوجته فاطمة قد استيقظت، على دقة الجرس، وأخذت ترتدي الروب:
-مساء الخير.
-مساء النور.
ولاحظت تجهمه، فركبها الرعب الذي يكبها دائمًا، كلما وجدته في هذه الحالة، وبدأ هو بخلع بدلته، وهو يقول بصوت خافت كأنه محمل بعاصفة:
-عندك حاجة تتاكل؟!
-عندي!
وأسرعت إلى المطبخ، لم يكن في حالة يستطيع معها أن يأكل رغم جوعه الشديد، ولكنه قالها لتذهب هي لإعداد العشاء، وينفرد هو بنفسه، لكم يود أن ينفجر، أن يخرج فائض البركان الذي يمور في أعماقه، وقديمًا كان يفرغ همه على رأس أم صفوت ونبيل كلما ركبه هم. أما بعد وفاتها فلم يعد يجد مصرفًا لما يعتمل في نفسه.
فهو لا يحب أن يظهر لزوجته-التي هي زوجة أب على كل حال- مدى خيبة أمله في أبنائه من زوجته السابقة، ولا يستطيع من ناحية آخرى في أن ينفجر في صفوت أو نبيل اللذين كبرا، وأصبح يخشى من أحدهما أن يبجح فيه، ثم هو يخشى أن يظنا أنه ضاق بهما أو يقحما بطريقة أو بآخرى مسألة كونه متزوجًا من غير أمهما، كما هي عادة الأبناء الأمر الذي يمرضه هو لدرجة الوسوسة على ألا يتطرق لحظة لخاطر أبنائه، والحق أنه استطاع أن ينسي صفوت ونبيل والثلاث بنات موت أمهم، رغم أنه تزوج مرتين، وماتت زوجته الأخيرة، بعد أن تركت له زوجته الأولى ثلاث بنات فضلًا عن صفوت ونبيل، وتركت له زوجته الثانية المتوفاة بنتين، وتزوج للمرة الثالثة فولدت له فاطمة، زوجته الثالثة، بنتين
(سبع بنات وولدين).
ولكن أبناءه لم يشعروا يومًا بما يشعر به الأباء عادة في ظل وجود زوجة الأب، وهو يرجع ذلك لا إلى أبنائه، ولا ناحية زوجاته، ولكن إلى رجولته هو، تلك الرجولة، التي تضبط النظام في البيت، وتلزم كلًا حدوده.
إنه يعتبر ما يحدث عادة بين زوجة الأب والأبناء من مشاحنات ومقالب ومكائد إنما يحدث نتيجة لضعف الرجل، وعجزه عن السيطرة على زوجته وأبنائه، وأن القيادة القوية الحكيمة قادرة على تحقيق الانسجام والتضامن في البيت، وكان زواجه الثاني والثالث برهانًا على صحة اعتقاده، وقد قال للاثنتين في أول يوم لهما في البيت، “أنا عارف إللي بيحصل بين الأولاد وبين مرات الأب، وعارف أولادي كويس، وما قدرش أغيرهم، لكن أقدر أغير مراتي، أوعي في يوم من الأيام تشكيلي منهم، فلان عمل، علان ما عملش، إذا كنت قادرة تعاشريهم يبقى يا دار ما دخلك شر، وإن شفت إنهم ما يتعاشروش خدي شنطتك على بيت أبوك، والله يسهلك وسيهل لنا، أنا اتجوزت لأن العيال عاوزه أم، مش عشان لأني عاوز مره!”.
لم يكن هو من النوع الذي يمكن أن يكون مطية لأمرأة، مما يسهل للمرأة أن تفسد ما بينه وبين أبنائه، وهو يعتقد أنه استطاع بذلك أن يحقق ما لم يحققه رجل آخر في العالم، ومع ذلك لم يكن الانسجام المتحقق في البيت نتيجة لصرامة منصور أفندي فحسب، بل كان أيضًا نتيجة لطيبة أولاده، ولاختياره الموفق في زيجته!!”.
كانت غرفة منصور أفندي تتكون من سرير خشبي عريض، يقوم أمامه دولاب ذي مرآة كبيرة، يقوم على يمينه تسريحة على يسارها جهاز راديو، وإلى اليمين خزانة حديدية صغيرة.
وارتدى منصور أفندي البيجامة، فبدا أطول مما كان ثم اضجع على السرير، يعبث بيده في شعره الأكرت الفاحم القصير، الذي دبّ إليه شيب خفيف من الجانبين، فلم يكن قد تجاوز التاسعة والأربعين، وكانت سمرته تنقلب في حالات الهم إلى زرقان رهيب، وعيناه تدادان ضيقًا، ومقلتاه تدوران يمينًا ويسارًا، وجبهته الضيقة تزداد انكماشًا، بينما يمضغ شفته السفلى، ولا يتركها حتى تدمى:
-سبع بنات! ماذا لو كانوا تسعة؟ ويموت صفوت ونبيل كما ماتت أمهما؟ ألم يكن ذلك أدعى لراحة البال؟
لقد استراحت أم صفوت، وتركتك للغم، واحد تزوج والثاني ترك الليسانس من أجل دبلوم معهد التمثيل، الناس يؤكدون أن السنة الرابعة أسهل سنة في كلية الحقوق، لأم يكن المضروب في بطنه نبيل قادرًا على أن ينتظر الليسانس لشهرين فقط؟!! ماذا أخذ من معهد التمثيل؟ أيهما أفضل ، محامي أم مشخصاتي؟!
ابنك مشخصاتي، يعني أرجوز، وبتقول للناس إنه محامي! حمار أخذ الليسانس وابنك عجز عن أخذه! كأن النقود التي صرفتها عليه طول العمر كانت حرامًا، لقد أعطاك الله النقود، والأرض، وخيبة الأبناء، لو أن أحدهما فلح لكان ذلك أبرك من الخمسة عشر فدانًا، دعنا من صفوت، فلم تعد تشغل بالك خيبته، لقد رميت طوبته، حتى من قبل أن يتزوج، ولم يسبق أن علقت عليه أملًا، خلينا في نبيل، فكم علقت عليه من آمال، ثم هو يخيب فجأة كالبنت التي تفقد بكارتها!
-الله يلعن الخلف واللي خلفوه!
أنت لست ضد التمثيل في حد ذاته، يوسف بك وهبي ابن باشا، ومع ذلك اشتغل ممثلًا، بل وحصل على الباكوية عن طريق التمثيل! التمثيل ليس عارًا، ولكن الحظ معلق على صدفة، قد تأت وقد لا تأتِ!
-ولكن لماذا لم يصبر شهرين فقط ليحصل على الليسانس، ويفعل بعد ذلك ما يشاء؟!
في مكتبته جميع أنواع الكتب، وليس من بينها كتاب واحد في القانون! أنت الذي علمته الشعر والأدب، أنت الذي وضعته في هذا الطريق، وها هو اليوم يكتب كلامًا فارغًا في مجلة لا يقرأها أحد، ويقول إنه شعر حديث، كيف يمكن أن يكون الشعر بلا قافية ولا وزن ولا نغم؟ ومع ذلك ليتفرغ للحقوق شهرين أو ثلاثة فقط، ثم يكتب بعدها أحجبة إن شاء! المحاماة مضمونة أما التمثيل والأدب فغير مضمونين، لماذا لم يتعلم من تجربتك أنت؟ هل كان في استطاعتك أن تشتري أرضًا، أو حتى أن تطعمهم خبزًا لو أنك تفرغت منذ شبابك للشعر؟! ثم هل تقاضى هو مليمًا واحدًا على ما كتب؟!
لقد هجر التمثيل لأن الفرصة لم تأت، فهل صرفت عليه دم قلبك ليصبح موظفًا في الرقابة يتقاضى خمسة عشر جنيهًا، لا تكفي حتى للدخان الذي يشربه؟! ألا يطلب منك نقود! كل شهر رغم أنه لا ينفق من مرتبه على المأكل والملبس، ولا يارك في البيت بمليم؟
والآخر الذي لا تكفيه هو وبنت الكلب وابن الحرام خمسة عشر جنيهًا، ويطلب منك المعونة كل شهر! لقد كنت مثله مدرسًا، وكان وراءك ستة أفواه، وكان مرتبك أربعة جنيهات، ومع ذلك لم تطلب من أبيك شيئًا، جيل بايظ مفسود ابن كلب!
لم يكن البيت في حاجة إلى مليم من مرتب نبيل وصفوت، ولم يكن منصور أفندي يريد لهما أن يدفعا في البيت شيئًا. إلا أنه كان يمتلئ قلقًا كلما تذكر أنه كان يعول أسرة كبيرة بأربعة جنيهات، بينما لا تكفي نبيل خمسة عشر جنيهًا صافية لجيبه الخاص، بينما يعجز صفوت بنفس المبلغ أن يعول زوجته وابنه، ورغم أن منصور أفندي كان أبعد ما يكون عن التمييز في الحب بين أبنائه سواء من زوجته الأولى أو الثانية أو الحالية، إذ كان يحبهم جميعًا بدرجة واحدة، وإن حرص على إخفاء هذا الحب بقناع من الصرامة اللازمة –في نظره- لضمان استقامة الأبناء، إلا أنه لك يكن يضيق بما يعطيه لنبيل كل شهر من نقود، بينما كان يضيق بما يعطيه لصفوت من حين لحين، وكان يختنق غيظًا كلما أحضر صفوت زوجته نوال وابنه فريد، لقضاء الإجازة الصيفية ببيت أبيه، فهو لم يغفر لصفوت حتى الآن، ولا يريد أن يغفر ذلك الزواج الذي تم رغم أنفه خروجًا على إرادته.
كانت نوال شقيقة زوجة منصور أفندي الثانية، وكانت تتردد على البيت، ولاحظ هو اهتمام صفوت بها فحذره، وحذر زوجته من أن تساعدهما على تنمية علاقتهما، وأكد أنه لن يقبل أن يتم زواج بينهما بحال من الأحوال، فالولد كان مازال طالبًا، وليس من المرغوب فيه أن يجمع منصور أفندي تحت سقف واحد بين شقيقتين في وقت واحد، وأن يكون هو عديلًا لابنه!
ولكن العلاقة نمت بين نوال وصفوت، وأثمرت العلاقة جنينًا، فأصر منصور أفندي على إجراء عملية إجهاض، بينما أصر صفوت على الزواج، وتزوج، واعتبر هو ذلك نتيجة تقصير بل تدبير من زوجته، فتزوج هو الآخر بفاطمة!
والحق أن زواج منصور أفندي كان ضرورة أكثر منه انتقامًا، فقد كانت شقيقة نوال مريضة بأكثر من مرض، مما جعلها عاجزة عن القيام بأعباء الحياة المنزلية والزوجية، وما من شك في أن زواجه كان سببًا في اشتداد المرض عليها فماتت بعد قليل تاركة له طفلتين، ومع أنه أذعن في النهاية، وسلم بالأمر الواقع، وبدأ يساعد صفوت بالنقود-أحيانًا- بعد أن عين بمدرسة كوم أمبو الابتدائية، ويسمح لثلاثتهم-على مضض- بأن يقضوا العطلة لديه.
إلا أن قلبه لم ينفتح أبدًا لنوال ولا لفريد-ابن الحرام- والتي كانت بطريق غير مباشر سببًا في موت شقيقتها أو على الأقل في التعجيل به.
الأمر الذي يشعر هو أيضًا إزاءه بالذنب خاصة، وإن أقارب المرحومة أكدوا في ليلة المأتم وعلى مسمع من أبنائه، بأنه قتلها بزواجه، كما أكد ذلك نبيل في لحظة من لحظات الغضب، كما لم ينفتح قلبه أبدًا لفريد”ابن الحرام” كما يصر منصور أفندي على تسميته، ولعل شعوره العميق بالذنب إزاء موت زوجته هو الذي يكمن وراء إفراطه في حب ناهد كبرى بنتيه منها والتي تشبه أمها تمام الشبه! إنه مازال يأمل في أن يطلق صفوت نوال، وكم حرضه على ذلك، وأبدى استعداده التام لدفع النفقة.
أحضرت فاطمة العشاء، خيارًا وجبنًا وطماطم، في أطباقه على صينية صغيرة وضعتها على مقعد خيزراني، قربته من حافة السرير، واعتدل هو، وبدأ يأكل بطريقة ميكانيكية، كأنه يؤدي واجبًا مفروضًا عليه دون أن يرفع بصره عن الأطباق أو يحس للأكل بطعم، وجلست هي على حافة السرير بالقرب منه، صامتة كالأرنب المذعور، لا تجرؤ على سؤاله عن سر تجهمه، فقد تعودت أن تتركه إلى أفكاره كلما وجدته في مثل هذه الحالة، وكان الأطفال قد ناموا فخيم على الشقة سكون ثقيل، ترن فيه الأصوات المنبعثة عن قضم الخيار أو كسر الخبز، أو عملية المضغ، ولا حظ هو ثقل الصمت خاصة وأن فاطمة تجلس إلى جواره مطرقة كأنها في مأتم، وأحب أن يعفي نفسه من ضرورة قول شئ فقال:
-افتحي الراديو!
حينئذٍ التقطتها المرأة فرصة، فقالت، وهي تبتسم، قاصدة أن تزف إليه خبرًا قد يكسر تجهمه:
والتقطت المرأة الفرصة، فقالت وهي تقصد إدخال شئ من المسرة إلى قلبه:
وأدارت المفتاح، وهي تقول قاصدة التخفيف عليه:
-النهارده اتذاع برنامج كان نبيل بيمثل فيه!
فتمتم الرجل بصوت مكتوم:
-مبروك!
واحمر وجهها بهذا الردّ الموجز، وهي تشعر بعجزها، فأطرقت تداري خجلها، وبعد ثوانٍ، جاء صوت صوت المذيع يقدم تسجيلًا لخطاب الرئيس:
-إقفلي الراديو!
حين دخل صفوت إلى غرفته المجاورة لغرفة أبيه كان على وجه زوجته نوال سؤال أدرك هو معناه للتو، فقال لها هامسًا وهو يتلعثم:
-شايل عبد القادر!
كانا يكشان في غرفتهما فور عودة الأب إلى المنزل، ويحرصان على ألا تنبعث من غرفتهما حركة أو صوت أو همسة تذكره بوجودهما معه في نفس الشقة، الأمر الذي يعرفان أنه يثير أعصابه، وكان يقبع إلى جوارهما على السرير أبنهما فريد الذي لم يتجاوز الثانية من عمره، والذي تعود أن يلتزم الصمت منذ أن تطأ البيت قدم الأب الكبير، كان يخشى جده بل ويكرهه، ويختفي عن ناظره كما يختفي أبوه وأمه، ولذلك كفّ عن الحركة، التصق بأمه وأبيه اللذين أرهفا آذانهما في توجس، وتناهت إليهما الأصوات المنبعثة من عملية الأكل، وأحسّا في حركة المضغ توترًا يعرفانه جيدًا لخبرتهما الطويلة بمثل هذه اللحظات، فلما تنفسا الصعداء حين جاءهما صوت الوالد يأمر فاطمة بفتح الراديو، وكان ذلك إيذانًا بأن في إمكانهما أن يتحدثا بصوت مرتفع قليلًا مما سيريحهما فترة من حبس الأنفاس بل ويتيح لهما إذا دعت الحاجة أن يكحا أو يعطسا! ثم لم يلبث أن خاب أملهما، وعادت أنفاسهما إلى الانحباس عندما سمعاه يأمر ثانية بإغلاق الراديو.
سيطر على صفوت طويلًا الشعور بالكراهية إزاء أمه وأبيه، فقد سمعها في ليلة من صباه البعيد يتجادلان حول ضرورة إخراج أحد الولدين من المدرسة، وسمع كيف نصحت أمه بإخراجه هو، وإبقاء نبيل، وفعلًا أعيد صفوت إلى جده في القرية ليشتغل فلاحًا في قطعة الأرض الصغيرة. فأمضى صباه في الحرث، والري، والزرع، والجز، وتنقية دودة القطن، وتربية الجاموسة، وفرض عليه أن ينتظر حتى تصبح المدرسة الابتدائية بالمجان، فيدخلها بالمجان على كبر سنه، ويعجز أبوه مرة ثانية-عن إدخاله المدرسة الثانوية التي كان نبيل قد أصبح في ختامها، فيدخل مدرسة الصناعات الميكانيكية لكونها بالمجان.
همست نوال في خوف:
-إنت ما عملتش حاجة؟!
وردّ صفوت بثقة:
-وها عمل إيه؟!
والحق أنه كفّ منذ زمن بعيد أن يفعل شيئًا يمكن أن يكون سببًا في انقلاب مزاج أبيه، بل لعله كفّ عن أن يفعل شيئًا على الإطلاق، فلقد انقلب في شبابه أكثر هدوءًا من ملاك، وأكثر زهدًا في الحياة من فقراء الهنود! لم يعد يستهويه شئ، وربما قضى العطلة الصيفية بطولها بين جدران البيت لا يخرج إلى الشارع إلا مرة، أو مرتين على الأكثر بعد إلحاح زوجته أو أخيه نبيل، ويقضي وقته كله في القراءة، ولكم سائل نفسه عن سر هذا التحول الغريب الذي حدث له، بعدما كان ينبض في صباه حيوية ونشاط وعفرتة، هو الذي فعل في صباه كل شئ، كان يسرق النقود من جيب أبيه، أو يسرق مصوغات أمه ويسافر من القرية إلى المنصورة حيث يقضي يومًا”كاولاد البشوات” يأكل في أحسن المطاعم ويشتري كل ما تشتهيه نفسه، ويوزع البقشيش يمينًا ويسارًا، ثم يعود ليلتقي من أبيه ألونًا من العقاب، كلها لم تفلح في ردعه عن السرقة التي كان يواصلها، بإصرار جريًا وراء رغباته، صحيح أنها كانت رغبات صبيانية، ولكن نجاحه في تحقيقها، رغم كل تحوطات أبيه وأمه كان دليلًا على الحيوية والنشاط والشقطارة، بل الذكاء الذي اعترف أبوه به مرارًا، وهو يذيقه أشد العذاب!
سرق نقودًا ذات مرة، واشترى ساعة يد، وحطمها أبوه أمام عينيه بيد الهون، ولكنه مالبث أن اشترى آخرى في الأسبوع التالي!
لا يذكر صفوت أن عقبه استطاعت أن تقف دون رغبة أراد تحقيقها، أين تلك الحيوية التي كانت تميزه في صباه؟!
لقد انقلب على أعتاب الثلاثين أكثر زهدًا في الحياة من فقراء الهنود، لم يعد يستهويه شئ، وربما قضى العطلة الصيفية بين جدران البيت، لا يخرج إلى الشارع إلا مرة أو مرتين على الأكثر بعد إلحاح زوجته أو أخيه نبيل.
إنه يلخص تاريخيه بكلمتين: التعلق والزهد، كان دائمًا يتعلق بالشئ، ويعاني الويلات في سبيل الحصول عليه، ثم يزهده فيتعلق بشئ آخر، ساعة يد، دراجة، آلة تصوير، ملابس كرة قدم، حتى نوال زوجته، تعلق بها لدرجة الجنون، ومن أجلها ابتلع أكثر من خمسين قرصًا من الأسبرين عندما أصر أبوه على عدم تزويجهما، ثم، ها هو يزهدها، كما زهد من قبلها أشياء وأشياء، إذن من أجل ماذا كان يود أن ينتحر؟!
لقد بدأ يخشى أن يتعلق بشئ لأنه واثقًا من الزهد فيه عمّا قريب، ولكنه بدأ من عامين التعلق بالقراءة، وخاصة قراءة الروايات والقصص والمسرحيات، وكل ما وجده في مكتبة نبيل، وتجنب الكتب الفلسفية والسياسية والاجتماعية والتاريخية، التي تزخر بها المكتبة، ولاحظ نبيل اهتمام صفوت بالروايات فبدأ يكثر من شرائها رغم كراهيته لها!
ثم بدأ صفوت يحاول كتابة القصة، وعرض إحداها على أخيه فأرسلها هذا إلى المجلة اللبنانية التي يكتب فيها، وكانت مفاجأة لصفوت أن يعتبرها أحد النقاد”قصة من أمهات القصص المصرية” وشجعه هذا على كتابة آخرى، وكتب عنها ناقد أنها “من أفشل القصص التي قرأها في حياته” واستطاع نبيل أن يخفف عليه الصدمة، وأن يدفعه إلى مواصلة الكتابة، يومها أفاق صفوت لنفسه، وحاول نبيل أن يخفف عليه الصدمة، ولكنه تلقاها بطريقة حادة، واكتفى بالقراءة!!
أنه يفهم أن يهتم نبيل بالأدب لأنه متعلم ومثقف، أما هو، فليس من حقه أن يحشر نفسه فيما لا تؤهله طبيعته وإمكانيته، لقد أخرجه أبوه من المدرسة صغيرًا، وأعاده إلى القرية ليشتغل مع جده في قطعة الأرض.
وأمضى حياة بين الحرث والزرع والري والجني وتربية الجاموسة، وانتظر حتى أصبحت المدرسة الابتدائية بالمجان، فدخلها على كبر سنه ثم عجز أبوه مرة آخرى عن أن يدفع له مصروفات الثانوية، التي كان نبيل في ختامها، فأدخله مدرسة الصناعات الميكانيكية لكونها بالمجان، وعين مدرسًا بالمدارس الإعدادية.
**
في عام 1969 ذهبّ صاحب الرباعيات إلى “أمين هويدي” رئيس قلم المخابرات المصرية، وحذّره من المؤامرة الماسونية العالمية لسرقة “الهرم” والسيطرة على ما فيه.
وباح بسر اللزوميات ورسالة الغفران والكثير من رموز القرآن والإنجيل والتوراة والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون، فأحيل صاحب الرباعيات إلى وزير البحث العلمي آنذاك، فالتقى به في المركز القومي للبحوث، ثم أحيل إلى مدير مرصد حلوان ومدير معهد الأرصاد، ثم اختطفوا صاحب الرباعيات بعد ذلك بأيام عند مدخل شبرا، وهو في طريقه إلى الإسكندرية هروبًا من القاهرة، بعد أن شم ريح الخيانة”حاميها حراميها”.
ومن قسم شبرا أخذوه مباشرة إلى مستشفى الأمراض المتوطنة ثم إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية حيث شنقوه، وحقنوه مرتين قبل توقف النبض، فضلًا عن أفانين التعذيب التي نشرت “آخر ساعة” عينات منها في الأسابيع الأخيرة، وعطشوه حتى العمى، ثم جرعوه”الجازولين”، ومكث بالعباسية ستة أشهر، ثم خرج منها حطامًا-بمعجزة- إلى المطاردة والتشريد والتجويع والتعرية والبطالة”رغم السبع صنايع”!
وفي مكتب النائب العام تحقيق مفصل بكل هذه الحقائق، مالبث أن أغلق فجأة وردم لأسباب لا تحتاج إلى فطنة! ومازال الشاعر “يعالج” حتى الآن من آثار جولة العباسية، الكبد، القلب، المرارة، المعدة، نشر العظام، ورم الساقين، والسكر، والانحدار التدريجي إلى العمى!. وذلك في مستشفى الدكتور النبوي المهندس للصحة النفسية بالأسكندرية، وإن كان في نفس الوقت”تحت التحفظ” والمراقبة القاسية.
هكذا كان مصير جميع من أدركوا سر الماسونية وسر الهرم من أبناء مصر خاصة وأبناء جميع شعوب العالم كافة في جميع العصور.
“فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن لن تحصوه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله.”-سورة المزمل-.
ولا يفوتك التقارب الاشتقاقي بين “هويدي” و”يهودي” كما لا يفوتك الدلالة للهرمين المتعاكسين فيما يسمى بنجمة داود، ولكن، “منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه”؟!