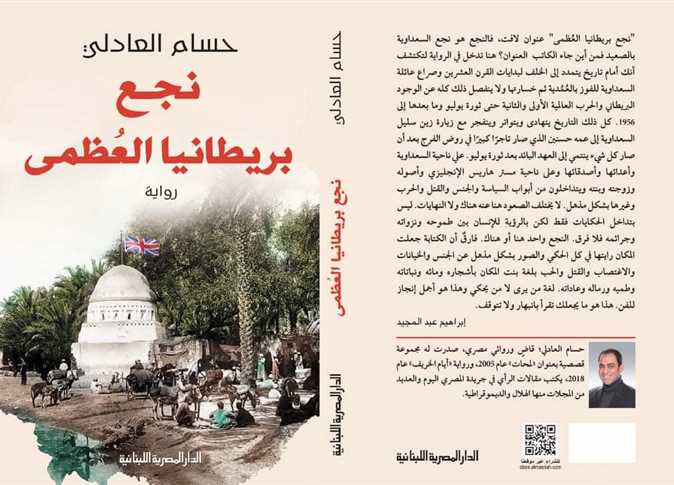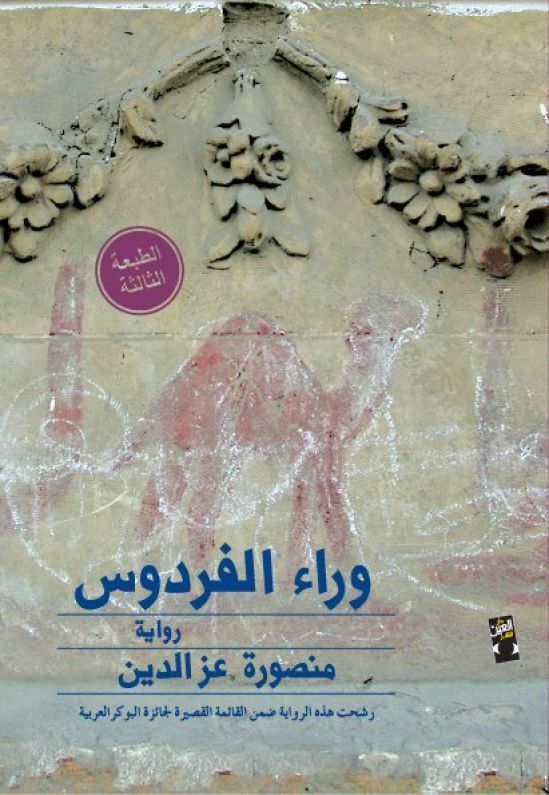ثيودورا وبخيت منديل هما محور السرد، وهما أبطال المأساة، عالمان لايلتقيان أبدا، ولكن الأقدار جمعت بينهما على خلفية معركة امتزج فيها الدين بالسياسة، أصبحنا أمام حكاية حب محكوم عليها بالمأساة فى زمن التعصب الدينى، ثيودورا التى ولدت فى الإسكندرية من أبوين يونانيين، كان يمكن ألا تكون راهبة، كان يمكن أن تعيش مثل بقية البنات اللاتى تطربهن عبارات الغزل فى الأسواق، وكان يمكن أن تغير قبلة ابنة تاجر الزيتون اليونانى حياتها، ولكن والد ثيودورا وهبها لله من أجل أن يحفظها، سنعرف فى النهاية أن شيئا لم يكن يغير أقدارها التى سارت إليها عندما ذهبت الى السودان ضمن بعثة لرعاية المسيحيين اليونانيين، أصبحت معلّمة فى الكنيسة، بينما عالم جديد يتشكل، ثورة ضد السلطة، ارتدت عباءة الدين، أصبحت من سبايا الحرب، تغيّرت حياتها الى الأبد، أما بخيت فله تاريخ غامض كطفل فى الجبال الغربية، جلبه النخاسون مبكرا ليكون عبدا صغيرا، وطوال حياته الشاقة امتهن حرفا كثيرة، وتقّلب فى سوق العبودية والأسر، عرف سيدا أوربيا وآخر تركيا وثالثا مصريا، شهد انتصارات الدراويش أتباع المهدى، وجد فيه خلاصا من ظلم وضياع، رأى غزو الدروايش للخرطوم، وخرج من سجنه الطويل بعد غزو مضاد أعاد الخرطوم الى السلطة، وأطاح بالمهدية، الطريقة التى رسمت بها الخطوط العامة لحياة ثيودورا وبخيت منحت الأقدار دور البطولة مثل التراجيديات الكبرى، وكأن هناك مصيرا مسبقا تساق إليه الشخوص، ولاتملك له دفعا، لا ثيودورا تريد التراجع، بل إنها تحب الخرطوم، وتقرر العيش فيها إثر مقتل والدها فى الإسكندرية، ولا بخيت يمكنه أن يغير شيئا من تلك العبودية التى تحاصره، يتغير عليه الأسياد، ويعمل فى كل المهن تقريبا، ينتهى حفارا للقبور، ولا يعرف من عالم البهجة سوى شراب المريسة، والليالى السريعة مع الغانيات فى البيوت السرية.
ولكن الحب إحساس عابر للأزمان وللأجناس، ولد بخيت من جديد عندما سمع صوت ثيودورا التى أصبحت جارية اشتراها تاجر سودانى ، أطلقوا عليها حواء، هى ستظل تسميه “أخى الأسود” بينما يراها هو الحياة نفسها وقد أقبلت عليه أخيرا، حتى نهاية الرواية ستظل ثيودورا مترددة فى مشاعرها ناحيته، تراه مختلفا لاينتمى الى مكانه وزمانه، شخصية شكسبيرية تاهت عن عالمها الأصلى، ولكنه ما زال رجلا أسود من المسلمين المتعصبين، ترتكب الشخصية التراجيدية خطأ يؤدى الى هلاكها، قد يكون الخطأ فى حياة ثيودورا أنها خاضت تجربة السفر الى بلد مضطرب، أو أنها اطمأنت لمن باعوها، فقاموا بتسليمها الى سيدها عندما أرادت الهرب، وقد يكون خطأ بخيت التراجيدى فى أنه انشغل عن ثيودورا / حواء بقراءة دفترها الذى كتبته، فى كل الأحوال لم يكن يستطيع إنقاذها، فقنع بأن ينتقم لها من الرجال الستة الذين كانوا سببا فى نهايتها، حتى طيفها الذى يطارده فى كل مكان رافضا العنف والقتل، لم يمنعه من الإنتقام، ظلت شخصية بخيت منشطرة بين الحياة والموت، الحب والإنتقام، وكأنها تترجم حياته القاسية، التى لم تكن فيها نسمة هواء إلا فى لحظات الوجد القليلة مع البيضاء القادمة من الإسكندرية.
تراجيديا ثيودورا وبخيت ليست معلقة فى الفراغ، ولكن فى خلفيتها تراجيديا أكبر وأعظم، الثورة المهدية كان عنوانها رفض الظلم والقهر والفقر، وكان رمزها شخصية قالت لأتباعها إنها ستقودهم الى النصر والى فتح العالم وغزو مصر والشاب وبلاد الأتراك بأمر مقدس، كان الدروايش يؤمنون يقدسية رسالتهم وقائدهم، يرتدون الجلابيب المرقعة، يؤمرون فيطيعون بلا مناقشة، كانوا يريدون أن تكون أم درمان أرضا طاهرة جديدة، ولكن الرواية ترصد بذكاء تحول هذا الحلم المثالى الى تعصب مقيت ضد الآخر، بل إن الدراويش كانوا يعتبرون الأتراك أيضا كفارا، الحلم اصبح كابوسا، واليقين المطلق فى نفوس البعض انتهى الى الشك الكامل، الحسن الجريفاوى هو أحد أهم شخصيات الرواية، وهو المعادل الفنى البارع لصعود وسقوط منطق المهدية، الشاب المتحمس الذى طلق زوجته ليتفرغ للجهاد مع الدروايش، والذى أصبح تاجرا بعد أن حاصره الشك، وبعد أن ولغ فى دم النساء والأطفال فى حروب المهدى المقدسة، يقول السارد العليم عن محنة الجريفاوى: “لكن ما بال رسالة الله تنشر بالموت؟ فى عهد التركية كان مؤمنا مظلوما، وحين شرح الله قلبه للمهدية صار ظالما شاكا، أين الحق؟”، ومثل بطل تراجيدى فى مسرحية يتساءل الجريفاوى: “إن كنا على الحق فكيف ظلمنا وقتلنا ثم هُزمنا؟ إن كنا على الباطل فكيف نكون أكثر عبادة وخشية لله من الترك والمصريين؟ أليسوا كفرة؟ ألسنا مؤمنين؟ ” ، الجريفاوى سيقبض على بخيت منديل الذى قتل سيد الجريفاوى انتقاما لما فعله هذا السيد بحواء ، ولكن الجريفاوى سيتردد طويلا فى قتل بخيت: ” لقد قتل وقتلنا، هو قتل لأجل حبه، ونحن قتلنا لأجل مهدى الله عليه السلام. على سيفه دم، وعلى سيفى دم” ، الشاب المتصوف الحسن الجريفاوى الذى خرج مجاهدا انتهى به الأمر قاتلا لطفلة تطارده فى الحلم، صار تاجرا يكنز المال، صار كارها للعودة الى أم درمان ” تلك البقعة التى ملئت بالإيمان ثم صارت خرابا به”، أصبح يتحدث عن “ركام اليقين الذى انهال علينا”، وقال شاكيا : “فرط الإيمان يكاد يودى بى الى الكفر”، ويفكر : “هل يكبّنا فى النار إلا أنّا أُمرنا فأطعنا”، ويقول عن بخيت: “خيّبه الله! لو عصى نجى”.
نحن إذن أمام دائرتين من المأساة الإنسانية: دائرة الحب المطلق الذى يؤدى الى الإنتقام، بخيت الذى سجن سبع سنوات بتهمة تناول المريسة ثم نسوه، سيتحول الى ملاك الموت الذى يقبض أرواح الذين كانوا سببا فى موت ثيودورا/ حواء ومعاناتها، ودائرة امتلاك الحقيقة المطلقة التى ستقود الى التعصب ومحو الآخر وادعاء القدسية مما سيؤدى الى سقوط المهدية والدروايش، لم يكن ممكنا أن تنجح قصة حب فى هذه الأجواء القاتمة، ولا حتى حب مريسيلة الصمت لبخيت المشغول بالقتل والموت، مريسيلة أيضا شخصية تراجيدية قادمة من عالم الفقر والجوع، فى قلبها فقط شعاع نور من حب مستحيل مع بخيت، ولكنها تكره انشغاله بتلك النصرانية البيضاء التى جاءت فأسرته حية وميتة، لا حيلة لبخيت فى مشاعره: ” هكذا هو الحب.. أن تصبح درويشا لمن تهوى ” .
فى الرواية بناء واع يخرج من الخاص الى العام، يعيد تأمل العواطف والأفكار البشرية، يقلّبها على وجوهها بسلاسة وعمق:الحب يدفع الى انتقام مخيف وقاس، ويقود فى نفس الوقت الى مشاعر أقرب الى الوجد الصوفى، بل إن الرواية تفتتحها كلمات محى الدين ابن عربى :” كل شوق يسكن باللقاء، لايعوّل عليه”، ويتمنى بخيت فى النهاية موتا سريعا ينقله الى من أحب فى عالم آخر، يحلم بلقاء يسكن بعده الشوق، أما الإيمان غير الواعى فقد انتهى بالحسن الجريفاوى الى الشك، تطرح الرواية أيضا سؤالها عن حدود الدين والدنيا، حدود التسليم الوجدانى والتفكير العقلانى، تضع”شوق الدرويش” الطبيعة البشرية الحائرة بين المثال والواقع على المحك، تكشف عن تضاريسها وتعقيداتها، ترسم شخوصا واقعية، ولكنها تعبر بأسلوب شاعرى يجعل للكلمات ألوانا، ويقيم بينما علاقات مدهشة:” ضحكتها لمعة مسروقة من خلف حوائط حزنها الحجرية”، “صحراء تسكن الروح/ أبدٌ من الرمل والحجر/ حكيمة رأت كل شئ، فماذا يدهشها؟”، “من أى بلاد تسكنها الملائكة أنت؟”، “فقط كونى بخير، تلك أجمل الهدايا”، “يشتعل رغبة. يتشظى حنقا. يعض شوقه. يطلب النوم. فتصهل الأحلام الموجعة فى روحه. يشتاقها شوق الدرويش للجنة” . ورغم تفتيت السرد الى لوحات متناثرة، فإنه يحتفظ بتماسكه، ويؤدى دوره فى التشويق بحيث لن تفهم سر المأساة وحدودها إلا مع الصفحات الأخيرة، قد يرى البعض أن الشكل الكلاسيكى فى السرد ربما يناسب أكثر تراجيديا تاريخية متقنة، ولكنى أعتقد أن هذا التفتيت السردى قد جعل القارئ شريكا فى التأمل واستكمال الصورة والتفاعل مع جوانبها، كما منح الأحداث تلوينا مستمرا بين خليط من العواطف، ويتسق ذلك تماما مع مغزى الرواية عن ذلك الأنسان الأكثر تعقيدا مما نظن، والقادر دوما على الصعود الى السماء أو الهبوط الى الوحل، يمكننا القول إن “شوق الدرويش” بهذا المعنى الواسع ترجمة شاعرية لتناقضات البشر سواء فى حال سطوة الأقدار، أو عندما يختارون بملء الإرادة.
هنا رواية كبيرة حقا بحجم أسئلتها، بدرجة نجاحها الفنى، وبهذه المستويات البارعة فى قراءة التاريخ، إنها رواية عن عصرنا بقدر ما هى رواية عن زمن قديم، يسمو الإنسان بالقلب وبالعقل وبالروح، ويسقط بالإنتقام وبغياب العقل والتسامح، يتحرر بالحب حتى إذا كان عبدا، ويستعبده الإنتقام حتى لو كان حرا، نمتلك عاطفة تجعلنا نستدعى الجنة الى الأرض، ونمتلك غرائز وشهوات وضلالا يجعل من حياتنا حجيما مستعرا، حتى مع سطوة القدر، لابد أن نصمد بشجاعة، تقول رواية “شوق الدرويش” على لسان بخيت : “ليس العالم إلا من نحبهم، إن فارقناهم فارقنا العالم”، وتقول على لسان ثيودورا:” الإنسان كائن وحيد. مهما أحاط به ضجيج البشر.لايمشى معه درب وجعه سواه”، وتختتم الرواية كلمات ابن عربى:” .. والعشق داء فى القلوب دفين”، وليست التراجيديا فى جوهرها الإ تجسيدا لوجع إنسانى لكائن وحيد مشى وراء أشواق قلبه كالدروايش، فحصد الخيبة، ذلك أن بين المثال والواقع هوة لم نستطع أن نردمها أبدا.