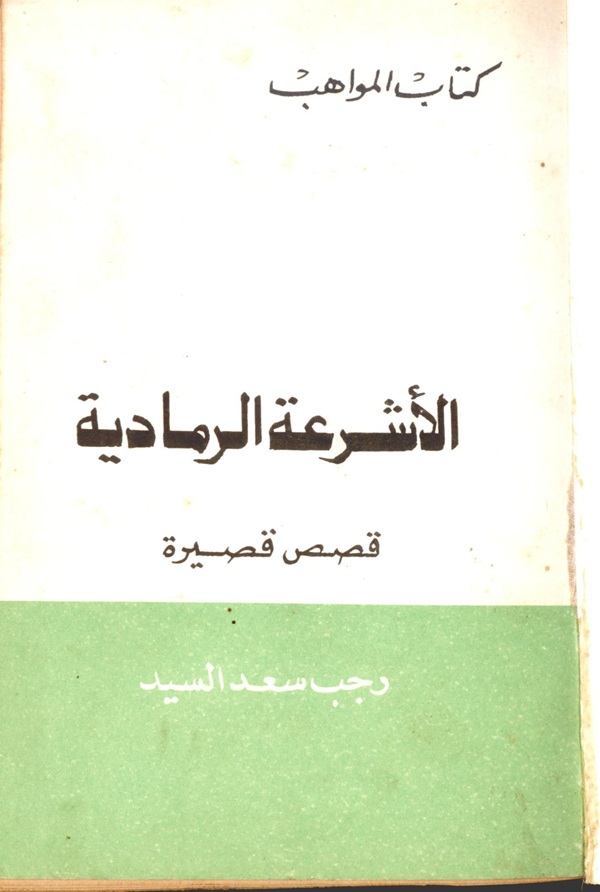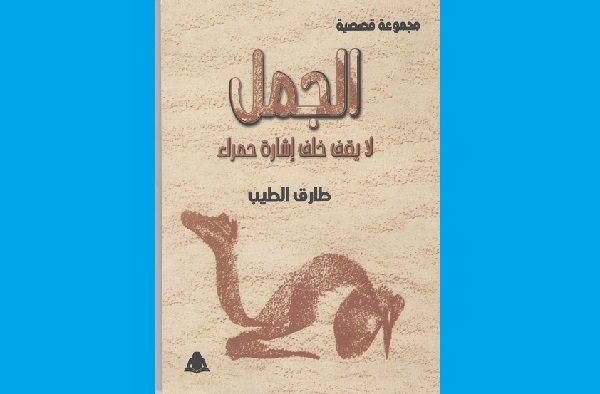أسامة كمال أبو زيد
رياض الصالح الحسين واحد من تلك الأرواح النادرة التي لا يكتمل ميلادها إلا بعد الموت، شاعرٌ ازداد حضوراً كلما غاب، حتى بدا أن موته لم يكن إلا باباً آخر للحياة، مرّ على غيابه أكثر من أربعة عقود وما يزال اسمه يتوهج كأنه كتب اليوم، يتداوله العاشقون على منصاتٍ عابرة وأوراقٍ باقية، بينما تواصل قصائده بثّ نبضها كأنها تعاند غبار الزمن. ولد في درعا عام 1952 لأسرة بسيطة، جسده معطوب منذ طفولته، عانى المرض وفقد السمع والنطق في جراحة قاسية تركته كائناً يعيش نصف العالم بالصمت ونصفه الآخر بالخيال، لكنه كان يرى أبعد بكثير من الأصحاء، إذ صنع من العطب نافذةً واسعة على الحرية. ترك الدراسة مبكراً، عمل عاملاً في مصانع الغزل ثم موظفاً في حلب ودمشق، لكن قصيدته هي التي صاغت سيرته الحقيقية. كتب أولاً التفعيلة ثم انصرف عنها نهائياً إلى قصيدة النثر منتصف السبعينيات، كأنه وجد فيها صوته الأعمق، صوت الصمت وهو يتكلم، وصوت الألم وهو يغني. عانى الاعتقال والتعذيب حين شارك في إصدار “الكراس الأدبي”، وتعلّم أن الحرية ليست فكرةً للترف، بل قدراً يدفع المرء ثمنه من جسده وروحه، وكان آخر ما خطّ يده كلمة “الثورة”، وكأنها وصيته. في قلبه عاشت النساء، بين حب عابر وصداقة عميقة وعشقٍ جارح لفتاة عراقية تدعى هيفاء أحمد حلم معها بكوخ وزواج وأطفال، لكن الفقدان طارده حتى في الحب، فانقطع خيطه الأخير بالحياة قبل أن تكتمل الحكاية، لينطفئ في نوفمبر 1982 في دمشق، ميتاً عارياً إلا من سروال داخلي، ويُدفن في مارع كأنه لم يكن، إلا أن قصيدته بقيت، وها نحن نعيش بها.
أربع مجموعات فقط تركها: خراب الدورة الدموية، أساطير يومية، بسيط كالماء.. واضح كطلقة مسدس، وأخيراً وعل في الغابة الذي عُثر عليه في درج مكتبه بعد الموت، ومعها ترك العالم العربي قصيدة نثر أكثر شجاعة وأصدق عاطفة. في عناوينه وإهداءاته سرٌ يكشف جوهره: يهدي عمله الأول “إلى الدنيا والناس”، يفتتح الثاني بصرخة زوربا “كل ما يجري غير عادل”، يقتطف في الثالث مراثي المصري القديم الذي فقد إخوته وأصدقاءه، ثم يترك في الرابع جملة رافائيل ألبرتي “أنت في وحدتك بلد مزدحم”، كأنه يكتب سيرته كلها من خلال الآخرين. هو شاعرٌ ينتمي للإنسانية قبل أي شيء، يكره السياط لكنه يقرّ بخبز البلاد وزيتونها، ويمزج الحب بالحرية، والحياة بالموت، كأنهما وجهان لعملة واحدة.
قصيدته لم تكن هروباً من السياسة ولا انغماساً في المباشرة، بل كانت شديدة التوازن بين الجمال والفعل، بين الحلم والمقاومة. في “هيروشيما” يسخر من الطغاة ويدعوهم لاحتفال بالموت الذي صنعوه، وفي “نيكاراغوا” يحيل المأساة السورية إلى بلد آخر في العالم الثالث ليفضح الاستبداد بلا تصريح، وفي قصائد الحب يكتب عن العطش، عن الولد الذي يدور بدراجته في فناء قبره سعيداً منتشياً، عن سوريا التي هي مدفأة في كانون وعظمة بين أسنان كلب ومشرط في يد جراح في آن واحد، ويعدها هو وأبناؤها الطيبون بأن يقودوها إلى الينابيع مهما طال الخراب.
لم يكن رياض ابناً لفراغ، بل جاء في سياق عريق من شعراء قصيدة النثر من أدونيس وأنسي الحاج والماغوط إلى سعدي يوسف وسركون بولص ووديع سعادة ومنذر مصري، غير أن فرادته أنه جعل من قصيدته جسداً مريضاً يكتب صحته بالحلم، ومن حياته القصيرة حياةً ممتدة في وجدان الآخرين. تجاهلته بلاده طويلاً، لم يُطبع له كتاب واحد في حياته، لكن أصدقاءه حفظوا نصوصه ونشروها، حتى أصدرت “منشورات المتوسط” في إيطاليا عام 2016 أعماله الكاملة في مجلد أنيق مصحوباً بمقدمة منذر مصري “سيرة موت ناقص”، كأن الشاعر نفسه لم يكتمل إلا بهذا الجمع بعد عقود من رحيله.
رياض الصالح الحسين هو ذاك الوعل الوحيد في الغابة، الذى يظل في مواجهة الوحوش عارياً إلا من القصيدة. عاش تسعاً وعشرين سنة فقط، لكنه ترك من الشعر ما يكفي ليظل حياً بيننا، قصائده تشبه ماءً جارياً في صحراء، مرةً بسيطة وواضحة كالماء، ومرةً جارحة كطلقة مسدس، لكنها في كل حال وعدٌ بالحرية، عهدٌ بالحب، وإيمانٌ بأن الشعر، وحده الشعر، قادر أن يكتب الحياة في قلب الموت.