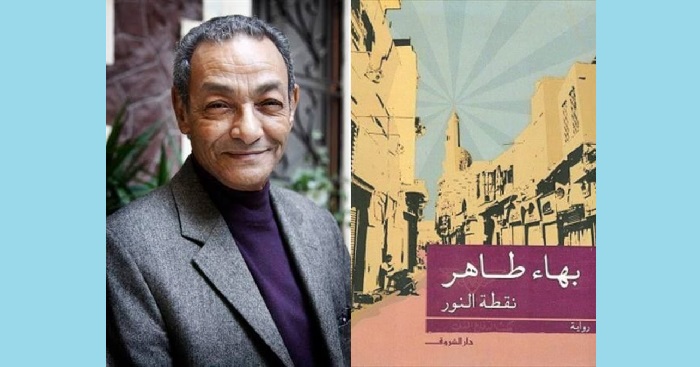د. عزة مازن
في شهر أكتوبر عام (2019) احتفلت الأوساط الأدبية العالمية بمرور مائة عام على ميلاد الكاتبة الإنجليزية “دوريس ليسينج” (1919 -2013). وكانت ليسنج حصلت على جائزة نوبل في الآداب عام 2007، في الثامنة والثمانين من عمرها، قبل وفاتها بستة أعوام. وصفتها الأكاديمية السويدية آنذاك بأنها “راوية ملحمية للتجربة النسائية، تسبر أغوار حضارة منقسمة على نفسها، منهجها في ذلك الشك وقوة البصيرة والحماسة”.
انطلقت ليسينج نحو الشهرة بروايتها الأولى “العشب يغني” (1950)، تبعتها رواية “المذكرة الذهبية” (1962)، والتي رأت فيها الأكاديمية السويدية “عملاً رائداً ينتمي إلى مجموعة الأعمال التي شكلت رؤية القرن العشرين للعلاقة بين الرجل والمرأة”. وفي عام 2008 وضعتها جريدة التايمز الإنجليزية في المركز الخامس ضمن أعظم خمسين كاتبًا إنجليزيًا منذ عام 1945.
ولدت “ليسينج” عام 1919 في إيران لأبوين إنجليزين، ولكنها انتقلت للعيش في إنجلترا منذ عام 1949. وقبيل وفاتها عام 2013، عن أربعة وتسعين عامًا، كانت “ليسينج” قد نشرت أكثر من خمسين عملًا إبداعيًا، بين رواية ومجموعات قصصية. تناولت في أعمالها قضايا الصراع السياسي والإجتماعي، كما تعرضت لتجارب شبه ذاتية في جنوب أفريقيا، وكانت لها روايات ذات أبعاد نفسية مثيرة وأخرى تندرج تحت الخيال العلمي. اعتبر كثير من النقاد روايتها “المذكرة الذهبية” رواية نسوية كلاسيكية، إلا أن “ليسينج” رفضت هذا التصنيف، ورأت أن هؤلاء النقاد أغفلوا الثيمة الأساسية في الرواية، وتتمحور حول دور الإضطراب العقلي في علاج المرء وتحرره من الأوهام. لم ترض “ليسينج” عن تصنيفها ككاتبة نسوية، ورأت في الخطاب النسوي إعلانًا للصراع مع الرجل، دون إدراك لحقيقة العلاقة المتشابكة بين المرأة والرجل.
استخدمت “ليسينج” أدب الخيال العلمي، لتناول قضايا إجتماعية وإنسانية. وقد تجسد شغفها بالعلم والإضطرابات الإجتماعية في عملها الضخم “كانوبس في أرجوس”، وهي سلسلة من خمسة كتب نشرتها بين عامي 1979 و1983، وفيها تتخذ من أدب الخيال العلمي الذي يدور في الفضاء وسيلة لدراسة الأنظمة الإجتماعية المختلفة. وفي عام 1988 تأتي روايتها “الطفل الخامس”، والتي أتبعتها بجزء ثان بعنوان “بن والعالم” (2000 ). يتناول الجزء الأول حياة الزوجين “ديفيد” و”هاريت”، في إطار زمني يمتد من نهاية الستينيات وحتى منتصف السبعينيات. وفي الجزء الثاني، يتواصل السرد ويمتد الفضاء الزمني حتى منتصف التسعينيات. ففي تحد لمنظومة إجتماعية متعارفة في تلك الفترة، يقرر “ديفيد” و”هاريت”، بعد لقائهما في حفل إجتماعي، أن يعيشا حلمهما الخاص ويحققا سعادة زوجية في منزل فسيح، وينجبا عدداً كبيراً من الأطفال، في عودة لما كان سائدًا في العصر الفيكتوري، قبل إنتشار المفاهيم الحديثة التي تدعو إلى التحكم في النسل ومشاركة المرأة في بناء المجتمع الخارجي. وبالفعل تتحقق لهما السعادة التي ينشدانها، مع إنجاب أربعة من الأبناء، ومشاركة الأهل والأصدقاء، الذين يجتمعون في بيتهما الفسيح في أعياد الكريسماس والمناسبات الإجتماعية الأخرى. ولكن ما يلبث القدر أن يضن عليهما بتلك السعادة، فتبدأ المعاناة مع بداية حمل “هاريت” في طفلهما الخامس، والذي شعرت به عملاقاً يهاجمها من الداخل، ليولد طفلاً غريب الأطوار قوي البنية يميل ميلاً كبيراً نحو العنف، وكأنه “فرانكينشتين”، الإنسان الوحش، في رواية الكاتبة الإنجليزية “ماري شيلي”، التي تحمل نفس الإسم (1818). ينبذه إخوته ويتجنبه أبوه وتحاول “هاريت” وحدها أن تهذب من سلوك الطفل وشراسته، فيجانبها النجاح في كثير من الأحيان. ومن ثم ينتابها شعور جارف بالذنب، وكأنها مجرم اقترف جريمة في حق سعادة تلك الأسرة. وعلى مضض، تتقبل الأم فكرة وضعه في مصحة لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية، إلا أنها حينما ترى ما يعانيه طفلها هناك من عذاب وإنتهاك لأدميته تفر عائدة به إلى المنزل، لتواجه مرة أخرى ما يعانيه سائر أفراد الأسرة بسبب ذلك الطفل. وتعود الأم لتواجه حيرتها بين طفل لا يعي ما يفعل ولا يقصده إنما يحمل في داخله حباً بلا حدود ورغبة ملحة في التواصل مع الآخرين، وبين زوجها وأطفالها الآخرين الذين يعانون من شراسة الطفل غير المقصودة ولا يبذلون جهدًا في محاولة فهمه واحتوائه.
في الجزء الثاني “بن والعالم” يطالعنا السرد وقد بلغ “بن” الثامنة عشرة، فتشجعه الأم على الإستقلال بعيداً عن الأسرة، في محاولة للتخلص منه؛ وفي قسوة بالغة تنتقل الأسرة من منزلها الذي تعيش فيه، حتى لا يجد الفتى عنوانًا يعود إليه. يلتقي “بن” بأنماط شتى من الناس، فيستغله الكثيرون، ولا يجد الحب والمأوى إلا مع الفقراء والمهمشين، ومنهم سيدة عجوز تحتويه وتأويه في منزلها ليشاركها معاشها الضيئل. وفي إنسانية بالغة يفتقدها كثير من الأسوياء، يشعر “بن” بحب وامتنان للعجوز، فيخرج معتمدًا على قوته الجسدية في العمل كعامل للبناء، ليأتي إليها بما تشتهي من طعام. ويبقى الحال هكذا حتى يعود إليها يوماً ليجدها وقد فارقت الحياة، فيخرج مرة أخرى لمواجهة العالم بكل شروره. يستغله البعض في تهريب المخدرات، فيغير ملامحه ويخرجه بجواز سفر مزور إلى فرنسا؛ ويبدأ الفتى شوطاً من الترحال ينتهي به إلى يد مجموعة من العلماء تحاول أن تخضعه لتجاربها. وتنتهي الرواية بموت “بن”، وعودته إلى كائنات تنتمي إلى حقبة تاريخية سابقة، هي جنسه الأصلي.
في تكثيف درامي بالغ وأسلوب لغوي موجز مشبع بأرق الأحاسيس وصور شعرية آخاذة، تمزج “ليسينج” بين متعة الخيال العلمي، وما يبعثه من إثارة وتشويق، وبين نقد إجتماعي لاذع ينهال بسياطه على مجتمع الحضارة الحديثة، الذي تحكمه الرأسمالية والبرجماتية، فلا يعرف أفراده شيئاً من رحمة أو تعاطف، مجتمع لايعرف سبيلاً للتعامل مع من يختلفون عنه ويخرجون على نوامسيه، سواء كانوا من الأطفال المعوقين ذهنياً أو الكبار من الفقراء والمهمشين، مهما كانت درجة قرابتهم. وفي ثنايا العمل تسلط الكاتبة ضوءاً ساطعاً على حقيقة أن من بين هؤلاء المختلفين والمهمشين مَن يحمل قدرة على التعاطف والرحمة لا يعرفها غيرهم، ممن وقعوا فريسة لمادية الحضارة الحديثة وأطماعها. وبينما تنتهي رواية “ماري شيلي” بثورة ” فرانكينشتين” على صانعه، ومن ثم خلاصه من القهر والذل، لا تري “ليسينج” خلاصاً لبن سوى بالموت، في إشارة واضحة إلى مدى قسوة الحضارة الحديثة على مثل هؤلاء البشر.
بإبداعاتها المتميزة استطاعت الكاتبة الإنجليزية “دوريس ليسينج” أن تضع بصمتها الواضحة على أدب القرن العشرين، وتٌشكل ملامحه، وأن تكون واحدة من أساطين الأدب العالمي في ذلك الزمان.