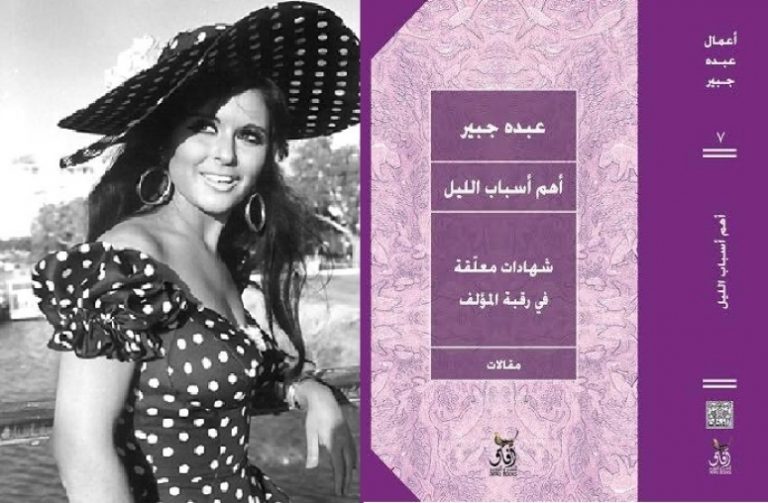ولنفترض أننا عشنا قرابة الساعتين في عالم آخر غير الذي نعيشه مصدقين إياه، متوحدين مع الممثلين الذين يقدمون مثل هذا العالم حتى لكأن الفيلم هو الواقع بينما الواقع الحقيقي قد تحول إلى ما يشبه الخيال أو الماضي المنبت الصلة بالحاضر، ألا يكون هذا دليلا على قدرة المخرج في إدارة فريق عمله من ممثلين وسيناريست وموسيقي ومونتير وغيرهم؛ مما يعني أنه قد حقق قدرا غير هين من النجاح؟
إذن فلنفترض افتراض أخير، ماذا لو حدث معنا ما سبق افتراضه ثم لم تلبث تلك الجملة القاسية في لفظها، الخاوية في معناها- هوّه أصلا فيلم مالوش قصة.. إيه يعني واحدة اتجوزت خمسة؟!- أقول ماذا لو اصطدمت تلك الجملة- الخائبة- العاصفة بآذاننا حتى تكاد أن تفجر طبلتيها، ومن ثم تخرجنا من حالة التوحد التي مازلنا نعيش طيفها الجميل إلى عالم آخر أكثر قسوة وصدمة وفجاجة من العالم الذي رأيناه على الشاشة- ولكن بشكل شاعري-، ألا يعني ذلك وجود أزمة تلقي سينمائي خطيرة لابد من تأملها ومن ثم معرفة السبب في نموها وإلى أين من الممكن أن تصل؟
علّ تلك الأزمة- إشكالية التلقي السينمائي- قد استطاعت أن تفرض نفسها منذ فترة ليست بالقريبة على الواقع السينمائي المصري، لكننا لم ننتبه لخطورتها إلا في الآونة الأخيرة حينما حاول بعض المخرجين الجادين انجاز العديد من التجارب السينمائية الجادة، ومن ثم لم يستطع الجمهور التكيف معها أو التأثر بها؛ فمنيت مثل تلك التجارب بالفشل الذريع نتيجة عدم قدرة الجمهور- الهدف الأول في صناعة السينما- على استساغتها.
وبالتالي رأينا العديد من الأفلام مثل “عرق البلح” للراحل “رضوان الكاشف 1999 ، “أرض الخوف” للمخرج “داود عبد السيد” 2000 ، “رشة جريئة” للمخرج “سعيد حامد”2001 ، “جنينة الأسماك” للمخرج “يسري نصر الله2008 ، “باب الشمس” للمخرج “يسري نصر الله 2005 ، “الدرجة الثالثة” للمخرج “شريف عرفة”1988 ، “سمك لبن تمر هندي” للمخرج “رأفت الميهي”1988 ، وغيرها الكثير من الأفلام تلاقي قدرا لا بأس به من الفشل الجماهيري نتيجة إعراض الجمهور- العاجز عن استساغتها- وبالتالي رُفعت سريعا من دور العرض ولم تأخذ فرصتها في إثبات جمالياتها السينمائية.
بل إن الأمر يذكرني بعبارة أخرى أكثر قسوة أطلقها أحد المشاهدين منذ سنوات-عام 2000- حينما عرض فيلم “أرض الخوف” للمخرج “داود عبد السيد” تقول (أحمد زكي خدعنا وقدم لنا فيلم فالصو)، كما سمعتها مرة أخرى- عام 2000- عند عرض فيلم “جنة الشياطين” للمخرج “أسامه فوزي” فهتف أحدهم (ضاعت فلوسنا ع الفاضي، عايزين فلوسنا)!
علّ مثل هذه الأقوال الاستنكارية المعترضة حينما تطلق من قبل الجمهور على أحد الأفلام الهامة لابد أن تثير داخلنا عاصفة من القلق ومن ثم الاهتمام والتفكير، وبالتالي التفرغ التام لمحاولة تأمل الأسباب التي أدت إلى ذلك، وإلى أين من الممكن أن ينتهي بها المطاف؛ لأنها دليل ومؤشر شديد الخطورة على موت التجارب السينمائية الجادة، وكل ما هو فني في مقابل فيضان من التجارب “اللاسينمائية” التجارية المفرغة المضمون والقيمة، ومن هنا لابد أن نتساءل أيضا (لم تستمر هذه التجارب اللاسينمائية المتهافتة فنيا، في حين تموت أمامها الكثير من التجارب الجادة؟).
ربما كانت مثل هذه التساؤلات وغيرها الكثير هي شغلي الشاغل- التي أخرجتني من حالة الانسجام الفيلمية التي أعيشها- حينما صدمت مثل هذه العبارة أذني؛ كي أصل إلى حالة أخرى- مغايرة- من القلق الدائم نتيجة العجز عن التلقي السينمائي الذي بات عليه جل جمهور السينما الآن- إن لم يكن جميعه-.
مما لا شك فيه أن السينما هي الانعكاس الطبيعي لحركة المجتمع حولنا؛ وبالتالي تصبح هي المرآه التي يرى فيها المجتمع صورته- سواء كانت شائهة أو مثلى- إلا أن التحولات الاجتماعية الخطيرة الحادثة في أواخر القرن الماضي، من الانفتاح على ثقافات أخرى مغايرة دون القدرة على هضمها وتمثلها جيدا، واجتياح الاسلام السعودي- الوهابي- بشكله السلفي القاسي- الملائم لبيئته الصحراوية-، والانهيارات السياسية والاقتصادية المتتالية التي جعلت المواطن المصري على وجه الخصوص يعيش في حالة دائمة من القنوط واللامبالاه، والسخرية واللامعنى، وصولا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، كل هذه الظروف وغيرها قد أدت إلى وجود مشاهد غير قادر على الاهتمام بتثقيف نفسه أو حتى الاهتمام بالتفكير فيما يدور حوله؛ ومن هنا أضحت حالة اللامبالاه هي المسيطرة على الجميع، وأصبح النموذج الذي يتم الاحتذاء به من قبل الكثيرين من الشباب- جمهور السينما الحقيقي والفعلي- هو نموذج الفهلوي القادر على فعل أي شيء بلا هدف أو منطق نتيجة التكريس لمثل هذا النموذج من خلال العديد من صنّاع السينما؛ ومن ثم رأينا “اللمبي” للمخرج- مع تحفظنا على كلمة مخرج- “وائل إحسان”2002 ، “عبود على الحدود” للمخرج “شريف عرفة”1999 ، “صعيدي في الجامعة الأمريكية” للمخرج “سعيد حامد”1998 ، “عليا الطرب بالـ3” للمخرج- مع الاعتذار لهذا الوصف- “أحمد البدري” 2007 ، وغيرها الكثير من النماذج التي يسيطر عليها نظام الاسكتشات في الكتابة ولعبة القص واللصق التي تُمارس بلا أي معنى، وبالتالي رأينا العديد من الشخصيات التي يسيطر عليها البله المنغولي ومشاكل النطق والجهل وكأنها هي الحل المنطقي والسحري ومن ثم النموذج الذي لابد أن يحتذي به الشباب؛ ونتيجة لأن بعض صنّاع السينما- من المتكسبين والتجار- انساقوا خلف هذه النماذج التي ابتدعها بعض كتّاب السيناريو- مثل “أحمد عبد الله وشركاه-، والتي أقبل عليها شريحة عريضة من شباب جمهور السينما؛ فلقد باتت القاعدة المنطقية هي أن الجمهور لا يرغب إلا في الضحك على ما يراه من هراءات، وبالتالي فتقديم سينما جادة يرى فيها آلامه ومشاكله وأحلامه وآماله لابد ستصيبه بالإكتئاب ومن ثم الاعراض عن مثل هذه السينما.
ولكن لماذا تقبّل جمهور السينما تجربة مثل “المومياء” للمخرج “شادي عبد السلام”1969 فيما سبق في حين أنه غير قادر على استساغة أفلاما أخرى أكثر بساطة منه اليوم مثل “أرض الخوف” على سبيل المثال؟
ربما كان السبب في ذلك المحاولات المستمرة من قبل بعض الدخلاء على صناعة السينما من منتجين وكتّاب سيناريو- بالصدفة- ومخرجين وغيرهم منذ فترة طويلة- ثمانينيات القرن الماضي- تلك المحاولات الهادفة إلى خلق جيل مُهرمن/مُخلق من رواد السينما الذي لا يستسيغ سوى ما هو فاسد ويتلاءم مع أذواقهم-صنّاع السينما- التي نشأت على فكرة التجارة وغيرها من المهن التي كان يمتهنها هؤلاء قبل الدخول إلى عالم صناعة السينما، ومن ثم رأينا التاجر الذي تحول إلى منتج سينمائي قد أتى ومعه آلياته الخاصة بالتجارة وليس السوق السينمائي المصري وصناعته، ومثله في ذلك الجزار والحداد وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى التي أفسدت تلك الصناعة ومن ثم فرضت آلياتها على الجمهور الذي استجاب لها مع طول فترة الالحاح المتواصل عليه مما أدى إلى إفساد ذوقه، وهنا كانت النتيجة المنطقية أن الجمهور( أدمن هذا البرسيم الذي يُقدم له)- على حد قول “رأفت الميهي”- وبالتالي لفظ كل ما هو جاد وجيد؛ وصار من الصعب إعادة تشكيله سينمائيا وفنيا مرة أخرى إلا بالعديد من التجارب السينمائية الجادة التي هي في حاجة للكثير من الوقت والجهد كي تؤتي ثمارها المرجوة.
ولكن هل ساهم نقاد السينما في صناعة هذا الذوق الفني الفاسد أم أنهم وقفوا موقف المتفرج؟
أظن أن مثل هذا التساؤل كان لابد أن يطرح نفسه على كل من يتأمل هذا الأمر؛ لأنه إذا كان النقد السينمائي ذي وظيفة ما- وبالتالي يخرج من دائرة الرفاهية- فلابد أن يوجه مثل هذا الجمهور ويساعده في تشكيل ذوقه السينمائي، بل وينتشله من مستنقع “اللمبي” وغيره إلى الفن الحقيقي الذي يساعده في تشكيل ثقافته أو على الأقل الاستمتاع بسينما جيدة وحقيقية.
نقول أن نقاد السينما- على فرضية تواجدهم- كان لهم نصيب غير قليل في انهيار الذوق السينمائي المصري ومن ثم فلقد اشتركوا مع صنّاع السينما الذين تحدثنا عنهم آنفا في جريمة تشكيل هذا الذوق الهابط، إما بالوقوف على الحياد- موقف المتفرج- خشية أن يلومهم لائم، أو نتيجة للمجاملات والصداقات الخاصة، أو خوفا على مصالحهم مع بعض صنّاع السينما، وصولا إلى الآفة الكبرى وهي التجرؤ ومن ثم عدم القدرة على فهم ماهية النقد السينمائي الذي بات مفهومه- عند الكثيرين من الصحفيين وغيرهم من أدعياء النقد- هو تلخيص محتوى الفيلم السينمائي وعرض قصته؛ وبالتالي ينام هذا الناقد قرير العين لأنه كتب نقدا/تلخيصا لم يسبقه اليه ناقد، وهنا لابد أن تكون النتيجة المنطقية لدى المتلقي- قارئا كان أو مشاهدا- الإعراض عن هذه الكتابة التي لن تعني له شيئا، في حين أن النقد الذي يعرض الفيلم محللا إياه من حيث جمالياته وآليات صناعته وأدواته وعناصره الفنية من مونتاج وتصوير وإخراج وسيناريو وغيره- كقصة الفيلم إذا كانت ملتبسة- وما إلى ذلك، نقول أن هذا النقد لابد سيتيح للمتلقي القدرة على إثراء ثقافته السينمائية والقدرة على فهم الفيلم وبالتالي استساغة الكثير من التجارب السينمائية الجادة والمختلفة.
ومن هذا المنطلق كان من الطبيعي سماع من يقول مثل هذه العبارة؛ لعدم قدرته على التواصل مع العالم الفيلمي الذي قدمه لنا المخرج “مجدي أحمد علي” بالتعاون مع السيناريست “هناء عطية” في أولى تجاربها للكتابة السينمائية، ذلك العالم الذي اقترب بشكل شفيف- أقرب إلى الشاعرية المُحبة المتصوفة- من عالم الفقراء والبسطاء؛ فقدم لنا تلك الخلطة السحرية- خلطة فوزية- التي أعطتنا الحل لمقاومة الحياة ومن ثم نتمكن من القدرة على التعايش مع أسوأ ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بنا بحثا عن سعادة- أية سعادة- كي نستطيع الاستمرار قدما في الحياة بدلا من الوقوع في براثن القنوط والاعراض عنها، إما بالحياة في عالم آخر متخيل، أو بالثورة عليها ورفض كل ما يحيط بنا متبنين العنف كأسلوب للحياة للرد على قسوتها.
ومن هنا رأينا “فوزية”( إلهام شاهين) يقدمها لنا المخرج “مجدي أحمد علي” في مشاهد ما قبل التيترات avant titre باعتبارها امرأة مزواجة، تطلب الطلاق من “عبد العزيز”( لطفي لبيب)- زوجها الأول- نظرا لعودته يوميا سكرانا، غير قادر على تحمل المسئولية، ليلي هذا المشهد مباشرة مشهدا آخر يشب فيه حريق في بيت “فوزية” ويقوم رجل المطافئ “خلف”( حجاج عبد العظيم) بانقاذها هي وولدها؛ ومن ثم تطلب منه الزواج كي يليه مشهد طلب الطلاق منه مباشرة، ثم مشهد ثالث تقابل فيه “طلبه”( مجدي فكري) بائع السمك الذي يُسرّ اليها بوحدته وانقطاعه عن أهله وعدم وجود أحد له في الدنيا؛ فتطلب منه الزواج كي يليه مشهد طلب الطلاق كالعادة، ثم مشهد “سيد”(عزت أبو عوف) السباك الذي يحاول إصلاح ما تلف لديها من (حنفيات) وإسراره لها بشيء من حياته ومدى عشقه للسينما حتى أنه يحمل معه دوما صورة شخصية (لرشدي أباظة) موقعة بخط يده منذ عهد بعيد وبالتالي نراها تتزوجه كي يليه مشهد طلب الطلاق نظرا لأنه (نص نص)- إشارة إلى قدرته الجنسية- كل هذه الزيجات يقدمها لنا المخرج “مجدي أحمد علي” في مشاهد سريعة جدا ومختصرة- بعيدا عن الرطرطة والمط- يساعده في ذلك مونتاج المونتير “أحمد داوود” لنعرف من خلالها كون “فوزية” امرأة مزواجة ولكن دون تقديم سبب واضح أو مقنع لهذا التنوع في الزيجات، ثم لا تلبث تيترات الفيلم في النزول كي يصدرها المخرج بتلك الأبيات الدالة من قصيدة (الغريق) للشاعر “فؤاد قاعود”:
العشق زين بس الهموم سباقة
والشوف حديد بس الغيوم خناقة
والانتظار للوعد نار حراقة
ولعل تصدير المخرج “مجدي أحمد علي” تيتراته بمثل هذه الأبيات لهو خير دليل على احتوائها قدر غير هين من مضمون وفلسفة فيلمه وكأنه يقول لنا( تلك هي مفاتيح شفرة هذا العالم الفيلمي) الذي نرى فيه “فوزية”( إلهام شاهين) تلك المرأة الفقيرة التي تعيش على الكفاف في إحدى القرى الصغيرة التي امتدت لها يد العمران العشوائي أسفل الطريق الدائري على مشارف القاهرة، ولذلك لم يكن غريبا حينما رأينا الكاميرا تستعرض منذ بداية الفيلم البيوت البسيطة المبنية بالطوب الأحمر، المتجاورة وكأنها تتساند على بعضها البعض- تماما مثل سكانها البسطاء- وكم أبدع “مجدي أحمد علي” متعاونا مع مدير التصوير “نانسي عبد الفتاح” في لقطاته الشاملة full shot التي استعرضت من خلال الكاميرا تلك البيوت غير المنتظمة، شديدة العشوائية وسط الأراضي الزراعية الخضراء، كي تدخل بنا العديد من الحواري الضيقة مصورة لنا حياة الكثيرين من البسطاء، ثم لا تلبث أن تنتقل بنا إلى النسوة اللاتي يغسلن ثيابهن وأدوات مطابخهن في مياه النيل بشكل فيه من الواقعية والبساطة مالا يقل عن الواقع كثيرا، نقول أن إبداع “مجدي أحمد علي” في هذه اللقطات الانسيابية قد تمثل في مروره على هذه البيوت بشكل فيه من الحميمية والشاعرية والحب مالا يقل كثيرا عن كاميرا المخرج الراحل “عاطف الطيب” الذي كان من أكثر مخرجينا تعاطفا ومشاركة وجدانية مع هؤلاء البسطاء، وبالتالي جعلنا نتعاطف معهم ونشعر بالحب تجاههم أكثر من محاولة تجاهلهم أو الاستياء من أسلوب حياتهم؛ ولذلك أعاد إلى ذاكرتنا السينمائية سينما بديعة تحمل هموم الآخرين مثل تلك التي قدمها لنا “عاطف الطيب” ببساطة افتقدناها منذ رحيله.
وهنا نعرف أن “فوزية”(إلهام شاهين) تعيل أولادها الأربعة- من الزيجات الأربعة السابقة- من المال القليل الذي تتكسبه من صنع المربى وبيعها لأهل قريتها من البسطاء؛ بل ونعرف أنها باتت على علاقة صداقة أقرب إلى الأخوة مع أزواجها السابقين الذين يأتون لزيارتها والاهتمام بها وبأولادهم كل أسبوع لتكون جلسة بها من المشاعر الفياضة والصداقة والأخوة الكثير؛ ولذلك نراها تُعد لكل منهم ما يحبه من أنواع الطعام كل أسبوع.
ولكن هل ثمة من يذكر قول المخرج الراحل “رضوان الكاشف” الذي كان يحرص دائما على ترديده- نحن نقدم سينما لها قلب-؟ تلك السينما التي كانت تضع نصب أعينها الانسان في جوهره الحقيقي؟
لعلها هي تماما تلك السينما التي نلاحظها دوما عند المخرج “مجدي أحمد علي” الذي يصر على تقديم موضوعه الأثير لديه منذ بدايته في فيلم “يا دنيا يا غرامي” 1996 ، والاهتمام بالمشاعر الجميلة ومن ثم القدرة على الحياة وسط الفقر المدقع وقسوة الحياة وظروفها وضغوطها؛ ولهذا نرى أن جميع شخصيات الفيلم لم تخرج عن مأزق الحاجة إلى الأنيس أو الحنان والاهتمام من قبل الآخرين؛ ولعل هذا أيضا هو الدافع الرئيس والأساسي الذي من أجله تزوجت “فوزية”(إلهام شاهين) زيجاتها الخمس؛ فهي ليست كما قد يبدو للمتفرج امرأة قادرة على اتخاذ القرار وبالتالي فهي مالكة لارادتها الحرة ولذلك فهي التي تختار أزواجها بملئ إرادتها؛ لأننا إذا ما توصلنا إلى هذا الفهم نكون غير قادرين على فهم المحتوى الفيلمي نتيجة قصور في التلقي أو لفشل المخرج في إيصال رسالته لنا، بل هي في حقيقة الأمر امرأة هشة أمام شعورها بالوحدة وعدم وجود من يهتم بها ويدفق عليها مشاعره، ولعل الدليل على ذلك أننا نراها حينما يعطيها “حوده”( فتحي عبد الوهاب)- السائق الذي أوصلها إلى المقابر كي تدفن زوجها السابق “سيد”(عزت أبو عوف)- نقول أنه حينما يعطيها باقة من الورد تميل عليه طالبة منه الزواج غير مصدقة أنه قد اهتم بها إلى هذه الدرجة.
إذن فهي إمرأة تقع متهدجة لأية لفتة اهتمام أو حنان؛ وبالتالي نراها في مشهد آخر تدلل على ذلك حينما تخبر جارتها “وداد”(نجوى فؤاد) أنها قد تيتمت مبكرا وكيف أن أمها قاسية عليها ولا تسأل عنها أو تزورها بالاضافة إلى كونها بخيلة مما عمق داخلها الشعور بالوحدة والحاجة إلى الآخر الذي يحنو عليها ويهتم بها.
ومن هنا يتضح لنا أنها امرأة تحاول البحث عن السعادة مع أي انسان يحاول أن يبدي لها شيئا من الاهتمام، ولذلك أيضا حينما جاءت صديقتها “نوسة”(غادة عبد الرازق) لتقول لها (أنا جيت لك يا اختي عشان أواسيكي..سيبي هولي) طالبة منها أن تشاركها في “حودة”(فتحي عبد الوهاب)- زوج فوزية- بالزواج منه معها، نراها- فوزية- تنتفض لتقول لها( إلا حودة.. دا ساعات أصحى من النوم فيقوم ويقول لي عايزة ميه يا فوزية؟) لعل مثل هذه الاسقاطات خير دليل على كونها تبحث عمن يهتم بها ويؤانسها كي يكسبها بعضا من السعادة المفتقدة.
بل نلاحظ أن جميع الشخصيات تفتقد لمثل هذا الشعور بالأمان والحب وبالتالي فهي تعيش دائما في حالة خوف قلق، ولذلك نرى “وداد”(نجوى فؤاد) الراقصة السابقة التي اعتزلت الرقص لكبر عمرها تبيع كل ما تمتلكه كي تشتري لنفسها مدفنا( طربة) ومن ثم تهتم بترتيبه وتجميله، وحينما تندهش “فوزية” مما فعلته تقول لها (دي النومة المريحة) كما نراها تشتري تليفونا محمولا كي تحادث به/تستأنس “بإمام” البقال، والمفتقد هو الآخر للشعور بالأنسة؛ ولذلك نراه حينما يعلم بموت “وداد”(نجوى فؤاد) يطلب هاتفها لا لشئ إلا لكي يستأنس بسماع دقات هاتفها، كذلك نرى “وداد”(نجوى فؤاد) حينما راحت في سبات طويل وحاولت “فوزية”(إلهام شاهين) ايقاظها بوضع يدها على صدرها نرى “وداد” تفتح عينيها لتمسك بيد “فوزية” المنسحبة من على صدرها قائلة لها( سيبي إيدك، كان نفسي من زمان حد يطبطب لي على الحتة دي).
مثل هذه الرغبة في الشعور بالأمان والهروب من الفقر والبؤس المحيط بهم نراها كذلك عند والدة “فوزية”- عايدة عبد العزيز- التي تبرر لابنتها أنها غير قاسية أو بخيلة لكنها تبحث عن رجل كي يكون لها سندا وإذا لم يكن هناك رجلا فالمال هو السند ولذلك تقول( الدهب في ايديا أمان زي الراجل بالظبط)، هذا البؤس في الافتقار للمشاعر الجميلة نراه أيضا عند “نوسة”(غادة عبد الرازق) الراغبة في رجل، أي رجل، المهم أن تتزوجه، ليس لمجرد أنها تخشى العنوسة، وليس لمجرد رغبتها الجنسية الملتهبة؛ ولكن لأنها راغبة في الشعور بالدفء والاحتواء والأمان؛ فنراها تقول “لفوزية” حينما تتزوج( عرفت ان فيه حاجات أهم من البوس).
ولعلنا نلاحظ مثل هذا الشعور القاتل لدى “حودة”(فتحي عبد الوهاب) الشاعر دوما بالوحدة لأن شقيقته “ليلى”(هالة صدقي)منفصلة بدورها عن العالم غير شاعرة أو مهتمة به؛ وبالتالي فليس له من أنيس سوى “فوزية”(إلهام شاهين) التي تزوجها كي تصبح هي محور حياته.
ولذلك لاحظنا أن جميع هذه الشخصيات تتوصل إلى الخلطة السحرية التي توصلت إليها “فوزية”، ألا وهي الاهتمام ببعضهم البعض لمحاولة إكساب كل منهم السعادة للآخر، ولعلهم جميعا بلا “فوزية” ما استطاعوا التوصل إلى هذه الوصفة أو الخلطة السحرية في الحياة؛ حيث نراها دائمة الاهتمام بالآخرين، قادرة على تحمل همومهم جميعا من أجل إكساب السعادة لهم ولها أيضا؛ فهي تهتم بأزواجها السابقين ومشاكلهم، كما نراها دائمة الاهتمام “بوداد” جارتها الراقصة السابقة، كذلك “نوسة” صديقتها الراغبة في الزواج ومن ثم انتقلت إليهم تلك العدوى السحرية في القدرة على الحياة وسط الموت الدائم الذي يهاجمهم وسط هذا الفقر المادي، والفقر في المشاعر.
هذا الموت الذي يصر اصرارا عمديا على مهاجمتهم وسرقة أية سعادة قد يستطيعوا اقتناصها- وكأنه قد تكاتف مع المجتمع المحيط بهم وسياسات الدولة وظروفهم الصعبة لقهرهم- فيهاجم “سيد”(عزت أبو عوف) في ليلة زفافه على “نوسة”(غادة عبد الرازق) ومن ثم يصاب بطلق ناري ليقع قتيلا.
ولكم أبدع المخرج “مجدي أحمد علي” في نقل هذا المشهد بعدما جعلنا نعيش صخب ليلة زفافه وضجيج أصوات مكبرات الصوت والطلقات النارية مع مشاهد تدخين الحشيش واحتساء البيرة ثم فجأة يصيبه الطلق الناري ليسود المشهد صمت مطبق قاس جتى أني شعرت بطنين الصمت يطبق على سمعي، كما نرى الموت المصرّ على مهاجمتهم مرة أخرى في ليلة زفاف “نوسة”(غادة عبد الرازق) الثانية حينما ينتحي الأطفال ومنهم (علي) الابن الأكبر “لفوزية” والأقرب إلى قلبها- ربما لأنه معاق في قدمه- أقول ينتحي الأطفال أحد الأركان كي يشربوا البيرة في غيبة من أهلهم وهنا يحاول الأطفال تحفيز “علي” على شرب البيرة بأنه إذا شرب الزجاجة كاملة فسوف يدفعونه بكرسيه المتحرك، ولأنه يشعر بالرغبة في الطيران يفعل ما يطلبونه منه ومن ثم يبدأون في دفعه بسرعة كبيرة وقوة كي ترتفع القدرة الابداعية لدى “مجدي أحمد علي” أيما إبداع في تصوير هذا المشهد حينما نرى الطفل- علي- بينما الأطفال يتدافعونه بقوة لنشاهده من خلال الكاميرا يرى نفسه وكأنه طائرا خفيفا في الفضاء تصاحبه ألوان الطيف وكأنه يسمو فوق الجميع؛ فيرى من خلال طيرانه العرس والأراضي الزراعية والبيوت والجميع، كل ذلك من خلال تقنية العرض البطئ slow motion مع انتقال الكاميرا تارة على مشهد طيرانه وتارة أخرى على مشهد أمه و”جودة” اللذين يرقصان على خشبة المسرح كي تأتي إحدى السيارات صادمة إياه لتعيدنا مرة أخرى إلي أرض الواقع البائس بعيدا عن المشهد الحلمي، وليكون الموت هو سيد الموقف دائما.
ولذلك رأينا (إلهام شاهين) في موقف معبر صادق تخرج بمحاذاة الطريق الدائري مخاطبة الله( الواد متصاب… سيبهولي.. تاخده منّي ليه؟ ليه؟ .. إيه حكمتك؟.. إيه حكمتك؟!).
نقول أن كل هذا الفقر الذي أدى إلى معيشتهم على الكفاف وسط البيوت العشوائية المبنية بالطوب الأحمر والمسقوفة بالأخشاب- نتيجة لأنهم على علم تام بأن الحكومة قد تطردهم وتهدم لهم بيوتهم في أية لحظة- بالاضافة إلى عدم قدرتهم على التمتع بخصوصية ما؛ وبالتالي لا نرى أي مرحاض أو “حمام” خاص في بيت أي منهم- بل يوجد مرحاض واحد عمومي لجميع أهالي القرية-، متضافرا مع الموت الذي يترصدهم دائما، بالاضافة إلى يد الحكومة الطولى التي تحاول النيل منهم وتشريدهم بدلا من الاهتمام بحل مشاكلهم وتحسين أوضاعهم، وليس أدل على ذلك من المشهد الذي رأينا فيه رجال الشرطة يهدمون المرحاض الذي يحاولون بناؤه كي يكون خاصا بالنساء وحينما يحاول الأهالي الاعتراض يخبرهم رجل الشرطة بصفاقة أن هذه أرض دولة ولا يمكن لأحد البناء عليها حتى وإن لم يكن هناك مراحيض تماما.
نقول أنه بالرغم من كل هذه الظروف القاسية التي يحيونها إلا أنهم دائما وأبدا ما يحاولون التكيف معها باقتناص السعادة من حولهم بإسعاد بعضهم البعض.
ولعلنا نلاحظ قدرة المخرج “مجدي أحمد علي” في جميع أفلامه التي قدمها لنا على الحيدة التامة والموضوعية في تقديم ما يريد الحديث عنه، فهو لا يقف إلى جانب ما في مقابل الجانب الآخر؛ ولذلك لم نره يدين الحكومة والظروف الاقتصادية التي أدت إلى تلك الحياة القاسية لهذه العينة من البشر، كما انه في ذات الوقت لم يقف إلى جانب هؤلاء البسطاء محاولا الاعلاء من شأنهم والدفاع عنهم بشكل ضجيجي مفتعل؛ فالفيلم ليس فيه تناميا في الحدث بقدر عرض مقطع من الحياة لهؤلاء البسطاء وتأملها عن قرب بشاعرية وشفافية، إلا أنه بالرغم من التزامه الحيادية لم يفوته قول كلمته بذكاء غير هين في لقطاته الشاملة full shot التي عرض فيها البيوت والحواري والبسطاء المهزومين كي تمر الكاميرا على صور الرئيس “مبارك” المعلقة في الشوارع وكأنه الدليل والسبب في كل ما يحدث لهؤلاء البسطاء من هوان وفقر وبؤس، إلا أنه في مروره على هذا المشهد أكثر من مرة بدا لنا الأمر وكأنه مصادفة غير مقصودة.
على أية حال نجح المخرج “مجدي أحمد علي” في تقديم مقطع طويل من حياة هؤلاء البسطاء الذين تحول حلم أحدهم- فوزية- وتمركز حول امتلاك” حمّام” خاص بها تشعر فيه بالخصوصية وبانسانيتها، هذا الحلم الذي تكاتف أزواجها السابقين متعاونين مع “حودة”(فتحي عبد الوهاب) في تحقيقه لها في نهاية الأمر، ساعده في هذا النجاح الأداء الصادق والعفوي لكل من (غادة عبد الرازق)، (فتحي عبد الوهاب) اللذين يحرزا فيلما بعد آخر الكثير من التوهج والنضج الفني فيجعلانا متعايشين معهما حتى أننا نفتقدهما في المشاهد التي لا يتواجدا فيها.
إلا أننا لا يمكن نسيان الرافد الأهم لهذا النجاح وهو الموسيقى الشجية التي قدمها “راجح داود” والتي تشعر معها أنها ذات ارتباط وثيق بالمكان location وبالتالي إذا ما حاولنا فصلها فصلا تعسفيا عن المكان تفقد مباشرة قدرتها على التأثير وكأنها سقطت في الفراغ، كذلك المونتاج الهادئ للمونتير” أحمد داوود”، والتصوير الذي كان هو البطل الحقيقي للفيلم حتى أن الكاميرا أشعرتنا وكأننا ننتمي جميعا لهذا المكان ولا يمكننا الانفصال عنه من خلال عدسة “نانسي عبد الفتاح”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناقد وروائي مصري