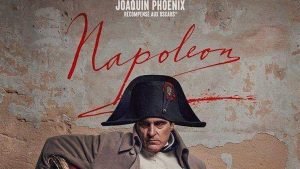ما الذي تغير أو استجد ليلقى الفيلم بعد انحسار نوعه السينمائي كل هذا التقدير النقدي والرضى الجماهيري (إن المتفرجين بين كبار عايشوا هذا النوع السينمائي يثيرهم أن يستعيدوه، وصغار يثيرهم أن يكتشفوه).. لكن الجدير بالتساؤل ما الذي دفع صناعه إلى انجازه دون خوف في ظل سيادة مهولة لأنواع سينمائية أخرى مبهرة؟.
إن تجميع عناصر هذه المسألة يعيدنا حسب رأيي إلى واقع قريتنا الكونية، التي تعيش حقبة دامية وصفتها الكثير من التحاليل والتقارير بالحرب العالمية الثالثة حتى وإن لم تكن معلنة. لنتذكر وسط كل هذا أحد فيديوهات داعش المربكة قبل سنتين في زحفها على ليبيا وكيف جمعت كل ما عثرت عليه من آلات موسيقية بإحدى غزواتها وقامت بحرقها. في تجسيد “حي” لإحدى فتاويهم بتحريم “المعازف”.. إن داعش التي أفشت الرعب، وبثت الفوضى، أثارت أيضا الأسئلة: من تكون؟ وما الإسلام؟ وما تعني أفكارها؟.. إن الغرب “البعيد” هو أكثر احساس بروح القرية منا وتاليا أكثر احساس بخطر ما يحدث حوله-عندنا..
لعله من المؤسف أن يجد انسان الألفية الثالثة نفسه يشك ببديهيات ويقينيات، يجد نفسه يخضع الموسيقى بعد تاريخ طويل مجيد للسؤال عن فائدتها وعن جواز تعاطيها.. وربما هذا ما قاد إلى ضرورة اعادة اكتشافها.. ولا سبيل لاكتشافها سينمائيا إلا بالكوميديا الموسيقية.
هو نوع ازدهر خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي أي بعد الحرب العالمية الأولى وحقق أيقوناته التي لا تنسى في الخمسينيات والستينيات أي بعد الحرب العالمية الثانية،، ألا يبدو والحال كذلك نوعا فنيا جماليا خطابه الأول والأوحد الحب والسلام؟. يبدأ لا لا لاند بمشهد متصل “سيكينس شووت” عبارة عن ازدحام مروري تقف فيه السيارات متراصة في انتظار الانفراج، هي لحظة حرجة من المفترض ألا تورث إلا التشنج والانفعالات السلبية، لكن ما إن تتعالى الموسيقى من أحد الراديوهات حتى يخرج الناس من مركباتهم تباعا منخرطين في الغناء والرقص في استعراض متناغم مليء بالبهجة والألوان.
صحيح أن فوز “لا لا لاند” ليس الفاتحة بعد انقضاء عصر الأفلام الموسيقية، إذ شهدنا 2003 فوز “شيكاغو” الذي بتتويجه كسر حصار الصمت الموسيقي الذي امتد لعقود شهدت نجاحات لم تكن مميزة. وتلاه 2012 فوز فيلم “ذي ارتيست”. غير أن الفيلمين ليسا نموذجيين، أي لا يذكران المشاهد بهذه النوعية في شكلها الكامل وفي زمنها التليد المجيد. شيكاغو يميل إلى الموضوع الفنتازي المركب. بينما دي أرتيست يبرز فيه توظيف الشكل حيث انجز كفيلم صامت وبالأبيض والأسود.
عودة الكوميديا الموسيقية اليوم في شكلها المتعارف عليه هو حتما حدث في الصناعة السينماتوغرافية. هو تعبير لا ريب عن حاجتنا إلى إبهار غير تكنولوجي ولا عجائبي ولا فكري. وإنما إبهار البسيط اليومي كالعلاقات الانسانية، الألوان، الغناء والرقص، أي ما لا يمكن أن يجسده إلا هذا النوع من الأقلام. كأن لا لا لاند المتوج بعد خمسين سنة على تتويج أيقونة “صوت الموسيقى” بخمس أوسكارات والتحفة “حكاية الحي الغربي” بعشر أوسكارات، هو رد فعل فني انتصارا للفن ضد محرّميه، وضربة موجهة ضد تنظيم الدولة.
على أن هذا الأمر أوسع من كونه متعلقا بالسينما وأبعد مما يكون مرتبطا بتوجه مؤسسة، بل هو أمر يعني الإنسان، إنسان هذا العصر، إنسان الحياة، لذلك تحركت آلة الثقافة هنا وهناك لتحمي نفسها وتحمي الإنسان والحياة. لنتذكر مفاجأة أكاديمية نوبل 2016 في واحدة من أزعج دوراتها، حين أثارت لغطا واسعا بتتويجها بوب ديلان المغني المعروف الذي اشتهر عقد 60 و70 بأغانيه الانسانية. الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عن معنى الأدب ومدى علاقته بالموسيقى. عن الواصل والفاصل بين الأدب والغناء.. على أنه سخطنا أم رضينا على هذه النتيجة يمكن القول أن الغناء يحمل ضمنيا روح أدبية تختزلها القصائد الشعرية التي ينبني عليها فيما بعد اللحن والأداء.. وديلان قبل أن يكون موسيقيا هو كاتب أغاني. بل هو بشهادة الكثيرين منهم الأدباء شاعر متميز وعميق. وفد لمس النقاد في المغني روح أدبية عالية لما أصدر قبل أكثر من عشر سنوات كتابه “يوميات”.
قد تكون نوبل انحرفت قليلا عن خطها الأدبي الصارم لكنها بتكريمها لأدب تحت أدبي عملت على تكريم الموسيقى باعتبارها جزء من الأدب سيما في حالات تفوقها العميق الذي يحرك حاسة القراءة كما حاسة السمع. لا ريب أن الأمر بلغ حدا خطيرا إلى درجة جعل فنونا أخرى تتجند للدفاع عن الموسيقى، يذكر العارفون حينما كانت الموسيقى لا تجد لها مدافعا إلا الموسيقى نفسها: إذ سجل لنا التاريخ قصة أغنية “لنهز القصبة” التي ذاعت وحققت رواجا وشهرة منذ عام 1982. لما غناها الفريق الغنائي البريطاني “ذي كلاش” كرد فعل على تحريم النظام الإيراني للمعازف، عقب نجاح الثورة الإسلامية في إيران 1979. فكانت نارية في معانيها التي استخدمت كلمات عربية منها كلمة “القصبة” الجزائرية التي تعني المدينة العربية القديمة. ناهيك عن كونها صورت في كليب مستفز تظهر فيه الفرقة تعزف وتغني وترقص عند حقل بترولي.
إن الموسيقى في ذاتها هي لغة وكتابة.. لغة مثل كل اللغات. وتملك مثلها طاقة إبداعية لابد أن تجسدها. هي من جهة فن الموسيقى ومن جهة ثانية علم الموسيقى.
إن فيديو تحطيم وحرق الآلات الموسيقية لا يختلف في شيء ولا يقل فداحة عن الفيديو الذي يصور ذبح الناس. هذا الكلام لا علاقة له بالمجاز والبلاغة،، إنما يعكس تاريخ من البحوث والتنظيرات التي وضعت هذا الفن تحت المجهر والتحليل، آخرها ولعل من أهمها ما طرحه كتاب “غريزة الموسيقى” صدر قبل سنوات قليلة لفيليب يال أميركي متخصص في الكتابات العلمية. كأنه رد آخر علمي تنظيري على مسألة تحريم الموسيقى، يبني فرضيته على كون الموسيقى هي غريزة في الإنسان لا تختلف عن غريزة اللغة وتكتمل ماهيتها عنده عبر التجربة والثقافة،،، ألا يبدو كل هذا حرب العالم ضد داعش، حرب ثقافية خفية.. حرب تنتظم ضمن الممارسة الثقافية السائرة، وغير معلنة لكن موجهة لتحافظ على ما تبقى من الإنسان.
…………………………………………
كاتب وناقد جزائري