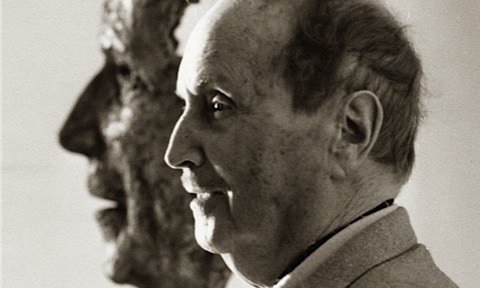موسوعة بريد السماء الافتراضي
كتابة وحوار: أسعد الجبوري
كان يمشي ثقيلاً على خط الاستواء، وعلى كتفه صقرٌ يتلو أناشيد الحزن الحمراء. لم ينظر إلى الهاوية التي كانت قدماه تعبرانها، لكنه سرعان ما توقف عن الحركة وهو يرفع عن كتفه الطير ويحرّرهُ في الفضاء.
بعد ذلك قام الشاعر الفارسي بيجن جلالي بسحب خط الاستواء خلفه كالحبل، ومن ثم رسم لوحة صغيرة على الأفق تضم طاولةً وكرسيين وساعةً ضخمةً مُعلّقة على جدار البعد الخامس، وهي تفيض نوراً.
وبمجرّد اكتمال المشهد، دخلنا اللوحةَ على متن عربة مجنحةٍ لإجراء هذا الحوار.
تصافحنا وتعاطينا معه المشروبات وبعض الأحاديث عن أدوات الفضاء، ثم سألناه:
س: هل كنتَ نجماً؟
ج- لا. ولكنني طمحتُ أن أكون ذات يوم من الأيام كويكباً يدورُ في مدار اللغة.
س: ما المسافة الفيزيائية ما بين اللغة وبين النجوم؟
ج- مسافة الضوء.
س: هل أدركت يوماً بأن الضوء يتحرك في جسد اللغة؟
ج- روحياً نعم.
س: وماذا عن أجساد الكلمات يا جلالي؟
ج- كل كلمة تتبرّع بخلاياها للسوريالية ستبقى حتماً نجمةً لا تذبل في المدار.
س: ما علاقة الشعر بالفيزياء؟
ج- لا تتمدّد صورُ الكلمات إلا داخل فضاءات تجمع ما بين مناعة اللغة ضد الموت وما بين تورد خدودها على سرير الشّهوات.
س: هل كنت صورةً في برواز الشعر؟
ج- لا. أنا ذاك الدم الذي لم يتوقف عن السّيلان في اللوحة.
س: عن أية لوحة تتحدث يا جلالي؟!!
ج- أنا أتحدث عن الوجود الذي لا ينام في لوحة الغيب ولا يفسخ علاقته بالعدم.
س: كأنك دخلت الموت مبكراً، أي قبل أن تنتهي إكلينيكياً!!
ج- الشعراء معصومون عن الموت. هكذا كانت جملتي التي أردتُ تثبيتها أو حفرها على شاهدة قبري.
س: متى متَّ أنت؟
ج- أنا أُدخلتُ قسراً إلى القبر، ولم يمسسني الترابُ بعد.
س: لِمَ لمْ يمسسك بعد؟
ج- ربما لأنني صاحب فلزّات شعرية أقوى من تلك النائمة في الطين.
س: متى تنهض تلك الفلزّات في الجسد الشعري؟
ج- هي لا تنهض، هي تتسلّل إلى اللُحوم البَضّة وتدخنُ حشيشة الملاك في غرف القواميس.
س: هل كنت ميّالاً إلى رؤية الشعر يركضُ في الشوارع؟
ج- ذلك شيء رائع تماماً، ولكن ليس قبل أن يحطم الشعرُ الخطوط الحمراء في الروح.
س: عن أية خطوط حمر تتحدثُ يا جلالي؟
ج- ما أقصده من تلك الخطوط هو الفاصلة ما بين مذاهب اللغة وبين مذاهب ديانات تحاول حجب الشموس عن الروح الشعرية لصالح مشايخ الكلاسيكيات وصحارى الأسلاف ممن يخشون هدم معتقداتهم الرملية وعدم طاعة القبور المنتشرة في المعاجم وسير مشايخ التفسير والتبرير وتحرير العقول من جراثيم الحداثة!
س: وماذا عن أبراج الشّهوات التي اختفت عن قلب جلالي وقصائده؟!!
ج- يبقى الحب مشرحةً لجسد العاشق، ولم يكن عندي رغبة بقبول المشارط لتلعب في لحمي أو أي غرفة أخرى من جسمي.
س: هل تعتقد بأن أسهم النساء تعثرت بالوصول إلى قلبك مثلاً؟
ج- ربما، وربما لأن قلبي كان بلا مداخل وأبواب. كان من الجدران الكونكريتية المُسلّحة.
س: خزنة حديد تقصد؟!
ج- وهو كذلك. أنا شعرت بأن تدريّع مضخة العواطف بالحديد خوفاً عليه من الاختراقات السريعة أفضى بي إلى ذلك الوضع المسدود.
س: كيف يستطيع الشعرُ أن يُعَبّر بمعزل عن الحبّ يا جلالي؟!
ج- بالتفاوض مع الخيال.
س: هل نساء الخيال أعظم فداحةً بالغرام من نسوة الواقع؟
ج- أجل. فأنت تقدر على تشكيل المرأة التي تريدها خيالياً لردم صور ما يقابلها من نساءات في الواقع، وبحرية وشمولية فنية أعظم.
س: ألا تظننّ بأن رائحة الشعر الخالية من النساء عطرٌ بلا معنى؟
ج- ليست المسألة متعلّقة بالرائحة النسوية وحسب، لأن الشعر يحمل الرائحة اللغوية الفائضة من جسد الشاعر حكماً.
س: كيف يتشكّل العطرُ في اللغة؟
ج- يتشكل من الفردوس النائم بدويلة الشاعر العميقة ذاتياً.
س: ألا تنتزعُ النصوصُ المُركَّبة شيئاً من الشعراء هديةً للقارئ؟
ج- ذلك أمرٌ حتمي، فالقراءُ بالأساس هم أكَلَةُ لحوم النصوص.
س: وما المواد التي يستطيبون تذوّقها في النصوص؟
ج- كل ما في رادارات الكلمات من جنس ومعارف وحشيش ونار وخمر.
س: كأنك تشير إلى أن التفاعل ما بين الشاعر وبين القارئ يشي بلعبة قمار؟
ج- أليس برأيك ذلك بالشيء الجميل؟
س: ربما، فالجنس هو الظل الشره وراء أبواب اللغات كما أعتقد. ألا تشاركني يا جلالي هذا الرأي؟
ج- نعم. فالجنس في اللغة هو من يُعيد للنصوص إنسانيتها ولا يُفرطُ بالتناغم الحيوي للشّهوات أمام عبودية اللاهوت الذي طالما يدّعي محاربة اللّذة، فيما هو أسيرُ الخطيئة نفسها.
س: متى تصبح الشهوة في الشعر فلسفةً بنظر جلالي؟
ج- تصبح فلسفةً حين يصير الشعرُ سفينةً بمجرى الدم الجسدي.
س: كسفينة نوح مثلاً؟!
ج- ليس بتلك الشاكلة أبداً. فسفينة سيدنا نوح كانت سفينة إنقاذ حيوانات، فيما الشعر فيلم رومانسي شبيه بباخرة تيتانيك التي التهبتْ على سطحها نيران ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت وهما يصارعان الغرق بالحب قبيل الموت البحري.
س: كيف تنظر لغرقى اللغات يا جلالي؟
ج- هم من الكائنات النادرة، ولا تستريح بأحضانهم الحروف، وما أشبههم بالماء حين يحب روحاً وينتحب مختنقاً بأسباب غرقها.
س: ما الجماليات التي وجدتها بالفيزياء التي درستها في جامعة طهران؟
ج- أنا وجدت في الفيزياء جماليات التناغم ما بين سرعة الضوء وبين أصوات الأنفُس المحمولين بصناديقها.
س: هل الأنفُس صناديق من كارتون أم حديد؟
ج- كلّ نفس تعيد تشكيل نفسها على مدار اليوم الواحد. تتجدّد وتتفاعل وتكتب ما يروق لها في المفكرة الحمراء.
س: وما هي المفكرة الحمراء يا جلالي؟
ج- مفكرة التأملات بخلود الشعر الذي يعبرُ تلال الآلام ويعزّي الشاعر بعزلته الكبرى بين النجوم المتآخية.
س: ومن هو القادر على تعزية القلق المتوحش في الباطن الشعري؟
ج- حين يبلغ الشعرُ مرحلةَ ما بعد حطام الغرام، تظهر علامات الجحيم على وجه الشاعر.
س: هل تؤمن بالنار الشعرية؟
ج- أجل، كما هو إيماني بفراديس النصوص. كل حرف نظريةٌ تبحث عن فاعل روحي ليس على الورق وحسب، إنما في مجرى الدم البشري الذي يقوم بتغذية الشعر كي ينتقل بفلاسفته من اللغة إلى مكوك الموسيقى المُطهِّرة لشوائب الأجساد في القصائد.
س: كأنك تجعل الشعر منصةً للأسئلة؟
ج- تماماً. فكلّ سؤال اجتراح وإلهام ورصد وبحث وكشف لكل غامض ومعتم وسرّي وسام.
س: ما الذي يُسمّم القصائد برأيك يا جلالي؟
ج- الملابس الثقيلة.
س: تقصد أن التعرّي من الثياب فضيلةٌ شعرية؟
ج- لا أقصد الفضائل الدينية بالضبط، إنما الشيء الجوهري هو مرحلة الزجاج الشعري، أي الوصول إلى تلك الشفافية التي يرى فيها القارئ جميع أعضاء جسم شاعرة القصيدة أو شاعرها.
س: يبدو أن فرسان الشعر الفرنسي قد توغلوا بعيداً في أعماق جلالي. ما ردّك؟
ج- ولمَ لا. أنا جسد شعري دون أقفال أو حيطان لمنع رامبو أو مالارميه أو فاليري أو بودلير أو فرلين أو هوغو من الدخول. هؤلاء فرسان اللغة الحارّة، وليس عيباً أن تحترق بما لديهم من نيران لشحن الذات بالشعر.
س: ألا تظن بأنك شحنتَ رأسك بكائنات الشعر حتى حدوث السكتة الدماغية التي أودت بك إلى الموت عام 1999؟
ج- أجل. فالشعر عادةً ما يستدرج الموت ليكوّن معه منظومة خاصة تعمل على فتح باب الدنيا الأخير نحو العالم الآخر.
س: وماذا رأيت في العالم الآخر يا جلالي؟
ج- رأيتُ كيف ترعى القصائدُ في البراري وعلى الجبال وبين أفخاذ النساء. قصائدٌ تملؤها الثمالةُ والغرامُ وغبار النجوم.
س: وهل ندمت على عدم زواجك يوم كنت حيّاً على الأرض؟
ج- بالتأكيد لا. فقد كنت أدخر طاقاتي للتزاوج مع نسوة العدم، حيث النساءات هنا أشدّ تكافلاً مع الشهوات الطيّارة التي لا تدوم علاقاتها سوى لحظات.
س: أنت نشرت “الأيّام” 1962، “قلبنا والعالم” 1965، “لون المياه” 1971، “الماء والشمس” 1983، “لعبة النور”، “يوميات” 1994، يوم كنت على قيد الحياة، وصدرت لك مجموعات بعد ذلك مثل “قصائد التراب قصائد الشمس”، “عن الشعر”، “خريطة الكون”، “قصيدة الصمت”. ماذا أردت من شعرك أن يكون؟
ج- أرادني الشعرُ أن أكون مصباحاً يُشرّدُ خيوط نوره في كلّ اتجاه من أجل أن أستعيد تلك المخلوقات التي كانت تسكن في خلايا جسدي.
س: وما نوع تلك المخلوقات يا جلالي؟
ج- لم أكنْ أعرف عنها الشيء الكثير. رأيتُ بعضها وخفتُ، فيما تحدثت مع نماذج أخرى منها لأدرك حجم الخديعة التي نحن فيها على الأرض قبل أن نتحدّ بالتراب ونكتب ما بين جدران اللُحوم التي كنا نرتديها ثياباً متألمة.
س: هل كنت صديقاً للموت؟
ج- بالتأكيد نعم. كنا نتفاعل في خلية فيزيقية مُحدّبة، لا أحد منا يستطيع الإمساك بالآخر. كان الموت عندي وجوداً لغوياً ليلياً يُمهّدُ للأنفُس حوارات متعاقبة لا تنتهي حتى تحت أكوان التراب.
س: ما أحلام الموتى؟
ج- رؤية التاريخ البشري بقرةً متوفاة تُجرها شاحنةٌ بحبلٍ من مسد.
………………
* الحوار من الكتاب العاشر “موسوعة بريد السماء الافتراضي”