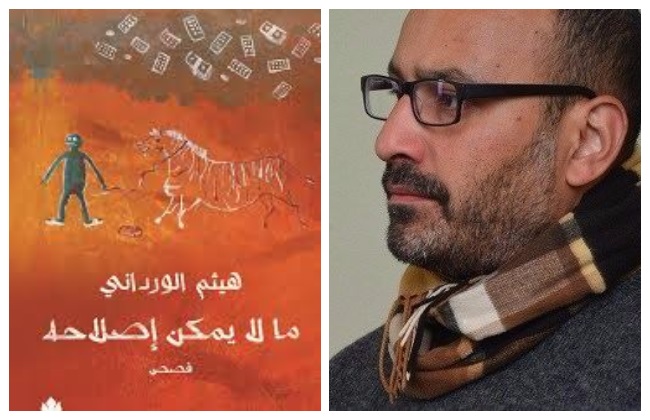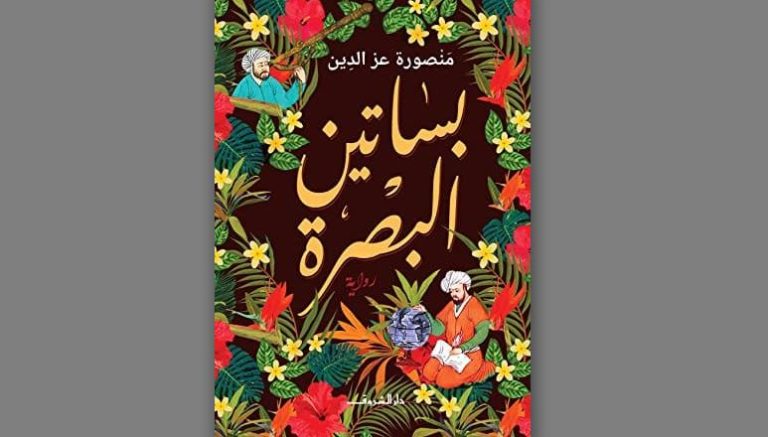محمد عبد النبي
بعضُ كتب السيرة يزعم نَقله الأمين لأحداث الواقع، مرتديًا قِناع المؤرخ ومُشْهرًا سيفَ الحقيقة، غيرَ أنَّ أصدق كتب السير الذاتية والمذكرات وأشدها إخلاصًا لما يُسمَّى الواقع يخضع، طوعًا أو كُرهًا، لشروط الكتابة والانتقاء وترتيب المشاهد والفصول، كما يخضع بالقدر نفسه لوِجهة النَظر وعين الرائي ومسافته مِن كل حَدث وموضعه منه. لذلك كله فليست السيرة غير رواية مِن نوعٍ ما، وإن قلَّ اعتمادها على الخيال حتَّى ندر أو انعدم، السيرة رواية لا نملك إلَّا أن نصدق ما وردَ فيها ولو لم تكن إلَّا تأويلًا لحُلم الحياة.
تحت تصنيف السيرة، يندرج كتاب رندا شعث جبل الرمل، (دار الكرمة-2020)، ومع ذلك فهو ليس السيرة التقليدية، تلك التي تحاول أن تجمع الخيوط في جديلة متماسكة، أو تتبَّع كَرَّ السنين والمراحل والحقب بترتيبها الزمني الطبيعي، أو تتأمَّل حصاد العُمر وثمار الرِحلة، وكل الصَيغ الموحية بقصة ذات بداية ونهاية، بغلافين كبيرين يمسكان تجربة حياة ويأسرانها في قالب. هُنا تتشظّى تجربة العُمر لتتوزَّع على لمحات ومَشاهد متناثرة، متواثبة بين الأماكن والأزمنة والأشخاص، كأنها قِطع “بازل” مختلطة، بلا نية ولا رغبة في تجميعها وتنسيقها وجَرّها قَسرًا مِن الفوضى إلى النظام، شيء أقرب ما يكون إلى ألبوم صور فوتوغرافية بلا ترتيب، صور شخصية وعائلية وإنسانية، لا يجمعها إلَّا العين التي وراء العَدسة. لا عَجب أن يشعر قارئ جبل الرمل بأنه أمام حالة فوتوغرافية إن كانت كاتبته مصوّرة فوتوغرافية بالأساس، ولها خبرة مديدة في التصوير الصحفي والفني. رندا شعث، المصرية الفلسطينية، ليست بالاسم الغريب على عالَم الصحافة والإعلام المرئي، وقد عملت كمصورة في صحيفتيّ الأهرام ويكلي والشروق وبعض الوكالات الأخرى إلى جانب معارضها ومشاريعها الفنية وورشها التعليمية وكتب ثلاثة منها “وطني على مرمى حجر” الموجّه للفتيان عام 1988، ومن السهل الإطلاع على أعمالها ومساهماتها الفنية بمجرد البحث على الإنترنت، غير أنَّ ما يصعب وجوده على الشَبكة، في هذه الحالة وعلى وجه العموم، هو ما وراء الصورة وما بين سطور النبذة الذاتية المختصرة عن هذا الفنان أو ذاك، الوجه المختفي تقريبًا وراء الكاميرا، قصة العَين التي رأت بجانب قصة ما تراه، فكلاهما يصنع الآخَر بدرجةٍ ما. وهُنا يبرز كتاب جبل الرمل كسيرة موازية لحكاية صاحبة الصورة، الذي خرج في شَكل حلقات متواشجة.
لا عَجب أن يشعر قارئ جبل الرمل بأنه أمام حالة فوتوغرافية إن كانت كاتبته مصوّرة فوتوغرافية بالأساس، ولها خبرة مديدة في التصوير الصحفي والفني. رندا شعث، المصرية الفلسطينية، ليست بالاسم الغريب على عالَم الصحافة والإعلام المرئي، وقد عملت كمصورة في صحيفتيّ الأهرام ويكلي والشروق وبعض الوكالات الأخرى إلى جانب معارضها ومشاريعها الفنية وورشها التعليمية وكتب ثلاثة منها “وطني على مرمى حجر” الموجّه للفتيان عام 1988، ومن السهل الإطلاع على أعمالها ومساهماتها الفنية بمجرد البحث على الإنترنت، غير أنَّ ما يصعب وجوده على الشَبكة، في هذه الحالة وعلى وجه العموم، هو ما وراء الصورة وما بين سطور النبذة الذاتية المختصرة عن هذا الفنان أو ذاك، الوجه المختفي تقريبًا وراء الكاميرا، قصة العَين التي رأت بجانب قصة ما تراه، فكلاهما يصنع الآخَر بدرجةٍ ما. وهُنا يبرز كتاب جبل الرمل كسيرة موازية لحكاية صاحبة الصورة، الذي خرج في شَكل حلقات متواشجة.
مِن الصحيح أنَّ ثمَّة ترتيب زمني يضمها، من الطفولة حتَّى سنوات قليلة ماضية، ولكن يبدو كما لو أنَّ التجاور المكاني هو الغالب على التتابع الزمني، جَسد الصورة وحضورها تأكيدًا على البقاء والمثول، ولو ذكرى مستعادة. وهناك ما يربط كل تلك النقط المنثورة أكثر مِن مجرد عين الرائي، تربطها حَركة في الزمن عبر تاريخ وحكايات الأجداد من الناحيتين، وتَربطها أيضًا حَركة في المكان تشكّل خارطة للحكاية مِثل شجرة وارفة تمتد فروعها بين القدس وبيروت وغزة والقاهرة والإسكندرية وفيلادلفيا والجزائر وصولًا إلى قرية صغيرة في سويسرا حيث قضت الكاتبة بضعة أشهر في إقامة فنية.
على الرغم مِن تلك الامتدادات الجغرافية، ثمة نقطة مركزية هي قلب الشبكة المرسومة بنسيج الحكايات، تلك النقطة هي مُبتَدأ الحكاية وأصل الشجرة، بيت الجدة، أم الأم، فاطمة التي أُهدي إليها الكتاب، في الإسكندرية، منطقة المندرة، وجبل الرمل الذي كان أطفال العائلة في زمنٍ ما يلعبون فيه باحثين عن كَنزٍ يفترضون أنه مدفون فيه: “بحثنا عن الكنز في الرمال الممتدة مِن البحر حتَّى أعلى الجبل حيث بنى جدي بيتًا للعائلة” – “كنزٌ ما ضاعَ مني هناك”، “لم نجد قَط الكنز الذي كنا نبحث عنه”، “أعي الآن كنز المحبة. نحيا بها.”
عنوان الكتاب، وصورة غلافه، وإهداؤه للجدة، والانطلاق من لحظة وداع النَخلة عيشة قبل بيع بيت المندرة، ثم الختام بحالة التفكيك لهذا البيت والتخلّي عنه، ولو رغمًا عن مالكيه؛ هذا كله يوحي بمركز باقٍ ومفقود معًا، تمتدّ منه أشعّة الحكايات لتسافر عبر البلاد والمواقف ووسط خيوط العلاقات والأشخاص والمَهام، لكنها تعود إليه دومًا. بقي بيت المندرة، بطقوسه في إجازات الصيف أو في شهور رمضان والأعياد، وبطلاته مِن الإناث، ومغامرات الطفولة والصبا، مرسى ومرفأ راسخ في الوَعي والذاكرة الحسية عبر مشاهد وحلقات الكتاب المتواشجة.

كما نلحظُ انحيازًا واضحًا إلى النسخة الأنثوية مِن الحكايات العائلية، أو على الأقل إلى إناث العائلة مِن الجهتين، عائلة الأم المصرية، وعائلة الأب الفلسطينية. ودائمًا ما بدا الرجال في الكتاب بعيدين مستغرقين في مشاريع ذات جلالٍ وشأن، يلعبون دورًا لتغيير الواقع، بل ربما يصنعون التاريخ نفسه، وقد تقاطعَت طرق الكاتبة بطرقهم أكثر من مرة، لا سيما في مساعدتها لأبيها نبيل شعث، في لحظات حاسمة من تاريخ القضية الفلسطينية. وعلى الرغم مِن ذلك الثقل، هيمنت البطلات الإناث على الكتاب، بداية مِن الجدة فاطمة التي يبدأ بها الكتاب وينتهي معها وبحواراتها المستعادة مع الكاتبة، مرورًا بالأم والخالات والعمَّات وبناتهنّ والصديقات والزميلات. حكايات بطولاتهنّ تبدو أحيانًا كأنها مِرآة، ترى فيها الكاتبة نفسها من غير أن تصرّح أو تعترف بهذا، نشعر بالأعباء التي يحملنها ويمضين بها، في صمت وكبرياء.
لا يعني هذا أنَّ الكتاب اقتصر على سرد اللحظات الأسرية الحميمة، وتجمّعات الإجازات والأعياد، ولذائذ المطبخ ومعجزاته، وإن اشتمل على هذا كله، فقد فرضَ البُعد السياسي نفسه بطبيعة الحال على النص، بل ظلَّ هذا البُعد يفرض نفسه على المساحة الشخصية والاجتماعية للكاتبة في كل لحظة تقريبًا، وليس أَدلّ على ذلك مِن تلك اللحظة الثمينة والموجعة، للمراهقة ذات الجدائل التي جرَّبت ذات مرَّة، في بدايات الحرب الأهلية في بيروت، أن تراقص ستارة شرفتها على أنغام أغنية لأم كلثوم، فرأت فجأة في رقصها شابًا على السطح المقابِل يتابعها، فركضت لتخبر أمها التي ارتعبت وأجرت اتصالًا وخلال دقائق انتشرت قواتٌ مسلحة في البيت، وأخذوا يسألونها عن السطح الذي ظهر منه الشاب لأنه قد يكون قنّاصًا. قالت باقتضاب إنها لم تقترب من الستارة منذ ذلك اليوم، وسرعان ما رحلوا عن بيروت وانتُزعَت من ذكريات طفولتها هناك بلا تحذير أو وداع، بحفنة تذكارات بين يديها لكنها قادرة على استعادة حياة بكاملها، شأنها شأن فصول هذا الكتاب.
فلسطين ساطعة كالشمس ترسل نورها على أبعد أركان حكايات الكتاب، حضورها ليس فقط كقضية سياسية مركزية في الزمن العربي الحديث والراهن، بل كحكاية وأرض وناس، كحُلم بالعودة يتواصل مِن جيل إلى جيل، وذاكرة موروثة منذ لحظة زواج جدي الكاتبة لأبيها وسفرهما بقطار الشرق السريع عبر المدن الفلسطينية والعربية وصولًا للإسكندرية. هذه الحكاية القديمة التي تحرص هي على أن تحكيها لأبناء أخويها، لكيلا تضيع وتتبدد: “حكيتُ كما حَكتْ لي جدتي”، بعد أن دار الزمان دورته وأصبحت هي نفسها الصوت الآتي من داخل البيت مناديًا على الأطفال اللاهين لتناول العشاء، وقد كانت قبل سنوات قليلة أو صفحات قليلة واحدة من هؤلا الأطفال.

ربما تكون رحلات الكاتبة إلى فلسطين بحاجة إلى كتابة مستقلة، أكثر توسعًا، شأنها شأن بعض خيوطٍ أخرى في الكتاب، لأن السِمة الغالبة عليه كانت عَدم الاستغراق بل المرور سريعًا واختطاف ما يعبّر بعمق وتكثيف عن مساحة زمنية واسعة أو تجربة إنسانية عميقة، كما أنَّ بعض التجارب المهنية بحاجةٍ إلى مزيد مِن البحث والتقصي مثل تجربتيّ الشروق والأهرام ويكلي، ومِن قبلهما تجربة دار الفتى العربي بكل سياقها الثري سياسيًا وإنسانيًا.
تكتب رندا شعث في موضعٍ ما مِن الكتاب: “كتابتي وصوري، بل حياتي كلها، كانت لها علاقة وثيقة بمحاولتي أن أكون داخل المكان تمامًا. أظن أنها عقدة الإنسان المهدَّد بالطرد: مِن البلد، مِن المكان، ومِن قلوب الناس…”، وفي ذكرى أسبق كثيرًا، كانت تتدرَّب على الباليه المائي وهي طفلة في مدرستها في بيروت، وكثيرًا ما كان يتأخَّر والدها في الذهاب بها لموعد التدريب لظروف عمله، تقول: “وكان ذلك مؤلمًا، ولكن الأصعب مِن ذلك كان غيابي من كُتيب برنامج الحفل السنوي. دائمًا الصفحة التي تحمل صورة فريقي تُذيَّل بالعبارة نفسها: [رندا شعث غير موجودة بالصورة].). هل على المصور الفوتوغرافي أن يكون موجودًا في الصورة؟ الإجابة السهلة هي لا، لكنَّي أظن أنَّ الأصح أنه يكون موجودًا في كل صورة له، بطريقةٍ أو بأخرى. وعلى ذلك فإن رندا شعث، عبر صفحات هذا الكتاب، ومهما ابتعدت أحيانًا عن ذاتها وحكاياتها الشخصية الحميمة فقد كانت موجودة في الصورة، بقدر ما كانت داخل المكان تمامًا.