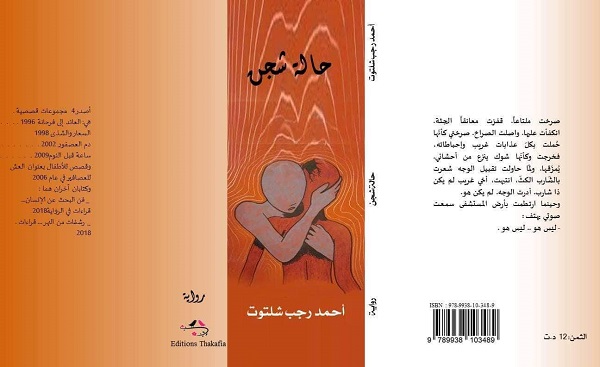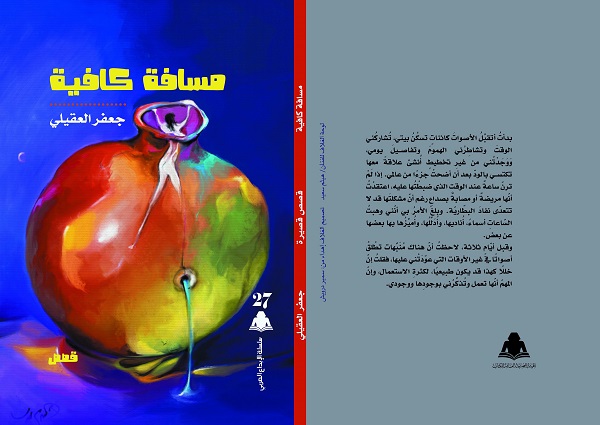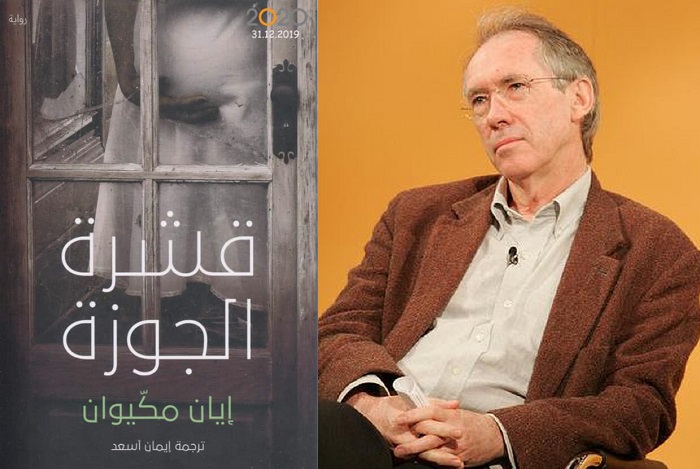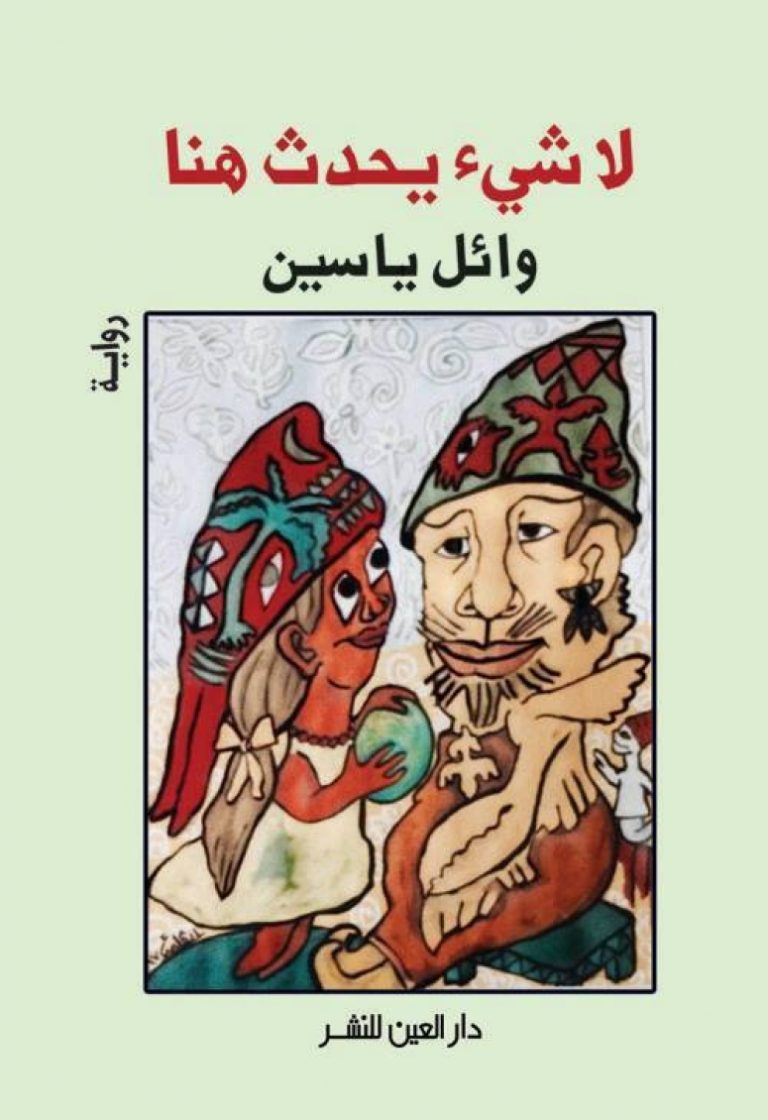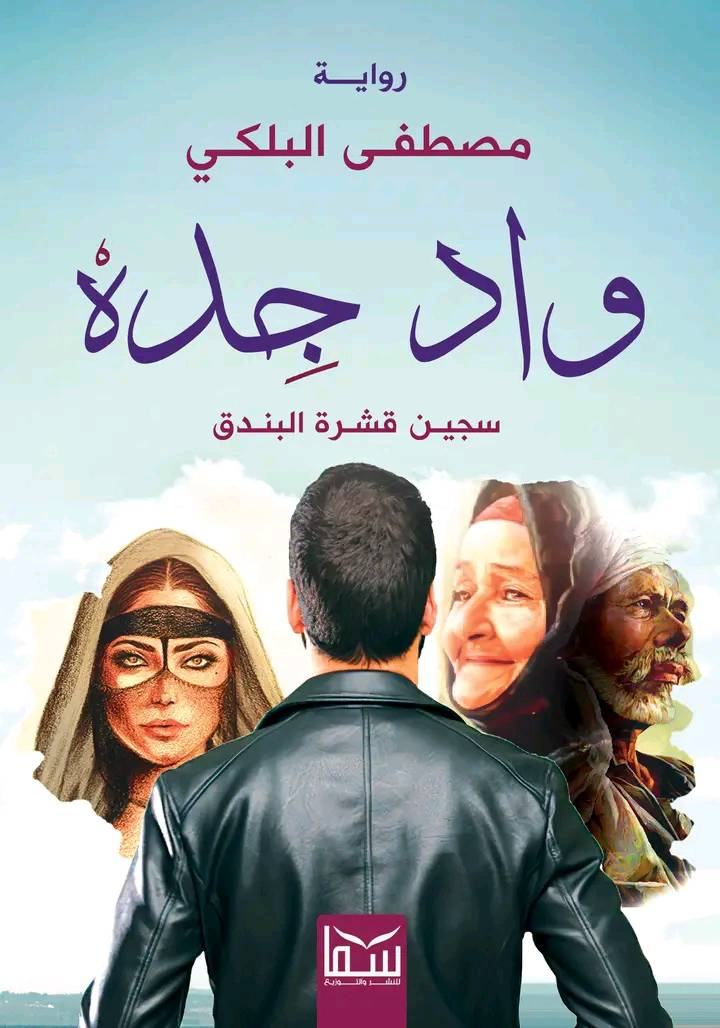بولص آدم
فكرة نهاية العالم تشكّل هاجساً إنسانياً متكرراً منذ البدايات الأولى للوعي، وقد حضرت في الأساطير القديمة والرؤى الدينية والتجارب التاريخية الكبرى بوصفها سؤالاً عن المصير والمعنى أكثر من كونها مجرد حدث كارثي. في المخيلة الإبداعية تحولت النهاية إلى مرآة للإنسان نفسه، تتخذ أشكالاً متعددة بين الخراب المفاجئ والانطفاء البطيء والصمت الذي يتسلل إلى الحياة اليومية، فتغدو نهاية العالم رمزاً لانهيار القيم أو تبدد المعنى أو شعور الكائن بالعزلة أمام الزمن. لهذا ظل الأدب يعود إلى هذه الفكرة باستمرار، لأن الحديث عن نهاية العالم هو في جوهره حديث عن هشاشة الوجود وعن اللحظة التي يُعاد فيها طرح السؤال القديم: ماذا يبقى حين يتداعى كل شيء؟
ومن هذا الأفق الوجودي والرمزي تحديداً تنبثق قصيدة ميلوش “أغنية عن نهاية العالم”، التي تقارب النهاية لا بوصفها مشهداً مدوّياً، بل كحقيقة تتخفّى في التفاصيل العادية للحياة.
يمثّل تشيسلاف ميلوش واحداً من الأصوات الشعرية الأكثر حساسية وعمقاً في القرن العشرين، شاعراً تشكّلت تجربته على تماس مباشر مع أكثر لحظات التاريخ الأوروبي قسوة واضطراباً. وُلد عام 1911، وخلال حياته الطويلة التي انتهت عام 2004، شهد الاحتلال النازي لبولندا، ثم صعود النظام الشيوعي، فالمنفى القسري الذي قاده إلى فرنسا ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث استقر أستاذاً في جامعة كاليفورنيا – بيركلي. هذه السيرة الممزقة بين الجغرافيا والأنظمة واللغات تحوّلت إلى مادة داخلية صاغت نظرته إلى الإنسان والتاريخ والمعنى. في شعر ميلوش، يتجاور التأمل الفلسفي مع الحس الأخلاقي، وتظهر اللغة كأداة نجاة بقدر ما هي أداة مساءلة، وهو ما يفسّر نيله جائزة نوبل في الأدب عام 1980، بوصفه شاعراً أعاد للقصيدة دورها الشاهد في زمن التدمير.
كُتبت قصيدة «أغنية عن نهاية العالم» عام 1945، في لحظة بدا فيها العالم وقد بلغ ذروة الانهيار. كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت رسمياً، غير أن آثارها الأخلاقية والإنسانية بلغت أوج حضورها، من معسكرات الإبادة إلى المدن المدمّرة، ومن القنبلة الذرية إلى الشعور الجمعي بأن الحضارة نفسها قد انكسرت. نُشرت القصيدة ضمن ديوان «الخلاص»، وهو عنوان يكشف منذ البداية عن توتر دلالي بين النجاة والفقدان، وبين الاستمرار والانقطاع. في هذا السياق، بدت الكتابة الشعرية محاولة لإعادة تثبيت الإنسان في عالم فقد قدرته على الفهم وفق المفاهيم القديمة.
رؤية النهاية في تفاصيل الحياة اليومية
تأتي القصيدة بوصفها رؤية شعرية لنهاية العالم، رؤية تعيد تعريف هذا المفهوم من داخله. النهاية هنا تظهر عبر مشاهد من الحياة اليومية، حيث تتحرك الكائنات ضمن إيقاعها الطبيعي، ويواصل البشر أعمالهم الصغيرة، وتبقى الطبيعة وفية لدورتها. النحلة تحلّق فوق زهرة الكبوسين، الصياد يصلح شبكته، الدلافين تقفز في البحر، العصافير تتشبث بالميزاب، الأفعى تستمتع بجلدها الذهبي، النساء يمشين تحت المظلات، السكير يغفو على حافة العشب، بائع الخضراوات ينادي في السوق، القارب ذو الشراع الأصفر يقترب من الجزيرة، وصوت الكمان يعلّق نغمة بشرية في الهواء، بينما ينفتح الليل المرصع بالنجوم. هذه الصور تؤدي وظيفة تأسيسية في بناء المعنى، إذ ترسم أفقاً تأويلياً متكاملاً. العالم، في لحظة نهايته، يواصل كينونته كما لو أن التفاصيل تملك استقلالها الخاص، وكأن الحياة تحتفظ بإيقاعها بعيداً عن التوقعات الكبرى. من هنا، تتحقق في القصيدة عملية تفكيك هادئة للسرديات الشاملة، عبر تجاهلها شعرياً، وإعادة توطين المعنى في المشهد القريب، المحسوس، والهش.
وظيفة العنوان والبنية الشعرية
تُسمّى القصيدة «أغنية»، وهو اختيار يحمل دلالة جوهرية. فالأغنية تقترن بالخفة والإيقاع والتداول الشفهي، وتبتعد عن نبرة التحذير والإنذار. هذا الاختيار يخلق توتراً داخلياً مع موضوع النهاية، ويمنح النص قدرة على احتواء الفجيعة دون تصعيدها، وتحويل النهاية إلى تجربة وجودية صامتة. البنية الشعرية نفسها تدعم هذا الاتجاه، فهي قصيدة بيضاء ذات قوافٍ غير مستقرة، مقاطعها متفاوتة الطول، وإيقاعها يتقدّم على نحو يشبه جريان الحياة، من دون ذروة درامية واضحة.
تلعب الأدوات الأسلوبية دوراً مركزياً في تشكيل هذا المناخ. الألقاب الكثيفة التي تصف الطبيعة والأشياء تخلق إحساساً بالسلام والتوازن، وتحوّل المشهد إلى لوحة تقترب من المخيال الأركادي (أي التصور الشعري لعالم بسيط متناغم، تعيش فيه الطبيعة والإنسان في انسجام بدائي هادئ). الاستعارات، مثل امتداد صوت الكمان في الهواء وانفتاح الليل المرصع بالنجوم، توحّد بين الجمال الإنساني والجمال الكوني، وتضع الإنسان داخل النسيج العام للوجود. أما التكرارات الأنافورية، ولا سيما تلك التي تستدعي الشمس والقمر والنحلة والأطفال، فترسّخ فكرة الاستمرارية، وتبني مقابلة ضمنية مع المخيال الإسخاتولوجي، أي تصورات النهاية الكبرى المرتبطة بيوم القيامة والتحولات الكونية القصوى، من خلال طمأنينة وجودية متواصلة.
في قلب هذا المشهد، تظهر شخصية الرجل العجوز ذو الشعر الرمادي، وهو يربط شجيرة الطماطم ويتحدث عن نهاية العالم. تؤدي هذه الشخصية وظيفة رمزية دقيقة، إذ تمثل معرفة متأتية من الخبرة، وحكمة تشكّلت عبر الزمن. موقعه ليس موقع نبوءة، وإنما موقع العمل اليومي، وصوته لا يرتفع بوصفه إعلاناً، بل يأتي كشهادة عابرة. هنا تتجسد فكرة أن المعرفة الأخلاقية تنبع من الانتباه لما يحدث أمام اليد والعين، لا من الخطابات المتعالية.

جورج تراكل و”Grodek”: مأساة الفرد أمام آلة الحرب
كتب الشاعر النمساوي جورج تراكل قصيدته الشهيرة “Grodek” عام 1914، بعد أن شهد القتال في الحرب العالمية الأولى مباشرة. تعكس القصيدة الصدمة النفسية للمقاتل أمام الموت الجماعي والدمار المروع، حيث يسقط الجنود بلا حول ولا قوة، وتمتزج الطبيعة بالمأساة لتصبح انعكاساً للخراب الداخلي والخارجي على حد سواء.
استخدم تراكل الرمزية المكثفة والصور الطبيعية لتجسيد الموت والعزلة، مع لغة موسيقية حالمة تعكس شعوره بالغربة والاغتراب أمام آلة الحرب الحديثة. فالليل يحيط بالمحاربين المحتضرين، وظل الأخت يمرّ في البستان الصامت لتحية الأرواح، والسحاب الأحمر الذي يسكنه “إله ساخط” يرمز إلى القسوة الكونية، فيما يصف الدم المراق بالبرودة القمرية الفقد والفناء. وختام القصيدة بذكر “الأحفاد غير المولودين” يرمز إلى خسارة المستقبل والجيل القادم، وهو ألم عميق يتجاوز الموت الفردي ليصل إلى المستوى الأخلاقي والكوني.
جورج تراكل و«Grodek»: مأساة الفرد أمام آلة الحرب
كتب الشاعر النمساوي جورج تراكل قصيدته الشهيرة «Grodek» عام 1914، في لحظة تاريخية كانت أوروبا فيها تنزلق إلى واحدة من أكثر الحروب دموية ووحشية في تاريخها. جاءت القصيدة بعد أن شهد تراكل القتال في الحرب العالمية الأولى مباشرة، وعاش بوصفه مسعفاً عسكرياً تجربة مواجهة الموت الجماعي عن قرب، وسط عجز الإنسان أمام سيل الجرحى والانهيار الأخلاقي الذي تفرضه الحرب. لذلك تبدو «Grodek» أكثر من مجرد قصيدة عن معركة بعينها، إنها وثيقة شعرية للصدمة، ورؤية أبوكاليبتية لنهاية عصر كامل، حيث يسقط الجنود بلا حول ولا قوة، ويتحوّل الإنسان إلى ضحية داخل آلة حرب حديثة تبتلع الأفراد وتحوّلهم إلى أرقام في مشهد مروّع من الفناء.
استخدم تراكل لغة رمزية مكثفة وصوراً طبيعية مشبعة بالعتمة ليجسّد الموت والعزلة والانكسار. فالطبيعة في القصيدة ليست ملاذاً بريئاً، بل تتحول إلى خلفية صامتة أو شاهد متواطئ على الخراب: الليل يطوّق المحاربين المحتضرين، والغابات الخريفية تبدو خاوية من المعنى، والدم المسفوح يكتسب برودة قمرية توحي بالفقد والعدم. وفي أحد أكثر مشاهد القصيدة تأثيراً، يمرّ ظل الأخت عبر البستان الصامت لتحية الأرواح، في تلميح إلى عالم داخلي حميم يختلط فيه الحنين بالموت، وكأن الحياة الشخصية نفسها تُسحق تحت ثقل المذبحة. أما السحاب الأحمر الذي يسكنه «إله ساخط» فيرمز إلى قسوة كونية تتجاوز حدود السياسة والتاريخ، لتجعل الحرب وكأنها لعنة شاملة على الوجود. ويأتي ختام القصيدة بذكر «الأحفاد غير المولودين» بوصفه صرخة ضد المستقبل المهدور، وألماً أخلاقياً يتجاوز موت الفرد إلى موت الجيل القادم قبل أن يرى النور.
مقارنة تراكل وميلوش: الحرب الأولى مقابل الثانية
في هذا السياق، تتقاطع تجربة تراكل مع تجربة الشاعر البولندي تشيسواف ميلوش بعد الحرب العالمية الثانية، رغم اختلاف النبرة والبعد التاريخي. تراكل يكتب من قلب الحرب الأولى بوصفها صدمة فردية مباشرة، حيث الموت حاضر أمام العين والطبيعة شاهدة على الانهيار، وحيث العالم يبدو وكأنه يسير نحو تسوّس أسود لا مخرج منه. قصيدته تصرخ من الداخل، وتغرق في الكآبة والرؤية الانطفائية التي تجعل النهاية حتمية.
أما ميلوش، الذي يكتب بعد الحرب الثانية، فيقدّم منظوراً أكثر اتساعاً وتأملاً، حيث لا تأتي نهاية العالم في صورة انفجار صاخب أو خراب فوري، بل تظهر في مفارقة هادئة: الحياة اليومية تستمر، النحل يطير، الدلافين تقفز، النساء يمشين تحت المظلات، فيما يراقب رجل عجوز النهاية بهدوء أشبه بالحكمة المرّة. هنا تتحول النهاية إلى سؤال أخلاقي وفلسفي عن معنى الحضارة بعد الخراب، وعن قدرة الإنسان على إدراك الكارثة حتى وهو يعيش تفاصيله العادية.
يمكن القول إن تراكل يصوّر مأساة الحرب على مستوى الفرد المسحوق داخل آلة القتل، بينما يحوّل ميلوش الخراب إلى تجربة وجودية أوسع، حيث تصبح التفاصيل الصغيرة منصة للتأمل في الإنسانية والمصير. ومع ذلك، يشترك الشاعران في جوهر عميق: الطبيعة واللحظة اليومية ليستا مجرد خلفية، بل أداة شعرية لإعادة بناء المعنى وسط الانهيار. هكذا يتحول الشعر لدى كليهما إلى شهادة على ما يكاد يتعذر التعبير عنه، وإلى محاولة للقبض على الإنسان والتاريخ والحياة في أكثر لحظات النهاية ظلمةً وقسوة.
نص قصيدة ميلوش الكاملة:
أغنية عن نهاية العالم
تشيسلاف ميلوش
في يوم نهاية العالم
تحلق نحلة فوق زهرة الكبوسين،
ويُصلح صياد شبكة لامعة.
تقفز الدلافين المبتهجة في البحر،
وتتشبث العصافير الصغيرة بالميزاب،
وتتمتع الأفعى بجلد ذهبي، كما ينبغي.
في يوم نهاية العالم
تسير النساء في الحقول تحت المظلات،
يغفو سكير على حافة العشب،
وينادي بائعو الخضراوات في الشارع،
ويقترب قارب ذو شراع أصفر من الجزيرة،
ويتردد صوت الكمان في الهواء،
ويُفتح الليل المرصع بالنجوم.
ومن انتظر البرق والرعد،
يخيب أمله.
ومن انتظر العلامات وأبواق رئيس الملائكة،
لا يُصدق أنه يحدث بالفعل.
ما دامت الشمس والقمر ساطعين،
ما دامت النحلة الطنانة تزور الوردة،
ما دامت ولادة أطفال ورديين،
لا أحد يصدق أن هذا قد حدث بالفعل.
فقط رجل عجوز ذو شعر رمادي كان ليكون نبيًا،
لكنه ليس نبيًا، لأنه لديه أمور أخرى ليفعلها،
يقول وهو يربط الطماطم:
لن تكون هناك نهاية أخرى للعالم،
لن تكون هناك نهاية أخرى للعالم.
الشعر كشهادة وإعادة بناء للمعنى
تُذكر قصيدة ميلوش اليوم ضمن أبرز نصوص القرن العشرين الشعرية التي تناولت فكرة النهاية، من زاوية جمالية وفلسفية فريدة. وهي تؤكد أن الشعر أداة شهادة، ووسيلة لإعادة بناء المعنى من داخل استمرارية الحياة اليومية، مهما بلغ الخراب حدّه. ومثل تراكل، الذي صور مأساة الفرد في قلب الحرب الأولى، يظل ميلوش شاهدًا على النهاية الكبرى، لكنه يقدّمها بصوت هادئ وامتنان للحياة اليومية، مما يمنح القارئ فرصة لتأمل هشاشتنا الإنسانية، وربط المعنى بالحياة نفسها.
هكذا، يتحول الشعر إلى جسر بين التاريخ والفلسفة والأخلاق، ومنصة لمواجهة الكوارث الإنسانية عبر الصور اليومية، من دون الانغماس في الصدمة المباشرة، مع الحفاظ على القدرة على التأمل الأخلاقي والجمالي.