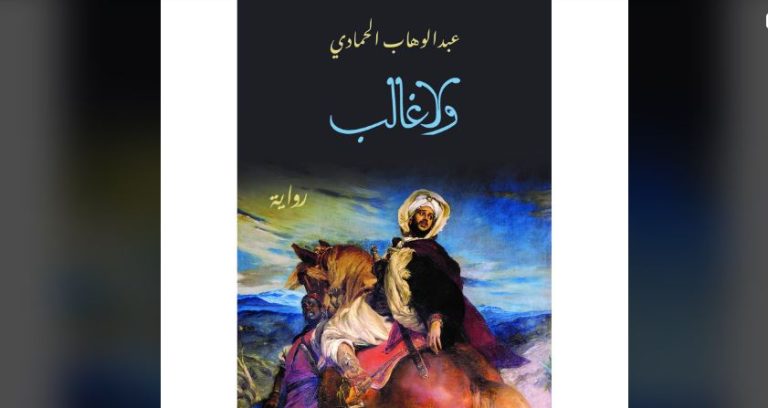تبدأ الرواية بحدث غير عادى وشاذ فى جنازة الشيخ محمود والد عبد الناصر، حيث يتقدم بطلنا الذى يبدو مهمل الثياب، أشعث الشعر، فى اتجاه جاره الإمام أثناء دفن الجثمان، يضربه بعنف، وينهال عليه بالسباب :”يلعن دين والديك، يا منافق، يا ندل، يا ساقط ، أخرج من غادى يا ……”، يفترض أن هذا الحادث سيبرر أن يقوم السارد (وهو صديق عُمْر الطليانى) بحكى قصة بطلنا من الألف الى الياء، ثم سيعود فى الصفحات الأخيرة لتفسير تصرف الطليانى ( أطلقوا عليه هذا الاسم لملامحه الأجنبية التى تشبه أبطال المسلسلات الإيطالية) ضد الإمام الشيخ علاّلة. ستظن، وبعض الظن إثم، أن رحلة الطليانى السياسية والإجتماعية، لها علاقة بحادث الضرب، ثم ستكتشف أن الأمر يتعلق بحادث إنتهاك جنسى ارتكبه علاّلة تجاه لطليانى فى طفولته، مجرد حادث فرعى لا يبرر كل هذا السرد الذى يبحث بالتحديد فى مأساة المثقف وسقوطه. الأعجب أن حالة عبد الناصر الطليانى فى صفحات الرواية الأولى، كانت توحى بنهايته أو اقترابه من اليأس أو الموت، يتضح ذلك من حوار الطليانى مع شقيقه الأكبر صلاح الدين، ثم نكتشف أن كل هذه الثرثرة، والحديث اليائس عن الفشل، انتهى ببداية جديدة للطليانى، فإثر وفاة الأب، التحق الطليانى عام 1989 بوكالة للأنباء، وقضى فى مكتبها بتونس أكثر من سنة وبضعة أشهر، ثم سافر الى أماكن أخرى مثل قبرص والسودان والصومال ولبنان والعراق، ثم عاد الى تونس سنة 1994ليفتح شركة “عيون” للإتصال والإشهار والإعلان، لن يحكى السارد بالطبع عن تفاصيل ذلك، فربما تطلب الأمر رواية جديدة، ما يعنينا هنا أن حادث ضرب الشيخ علاّلة بدا كحيلة ساذجة لا يمكنها أن تغلق قوسا أو تفسر شيئا، مجرد وسيلة لكى تستمر فى القراءة، لا هى ذروة إنهيار، ولا هى بداية نهاية، ولا هى تنذر بانتحار، ولا هى تعبير عن موقف عام، ولكنها ثمرة معاناة نفسية قديمة من انتهاك جنسى، أو ربما هو انتقام لزوجة الشيخ علاّلة، التى اختبر معها عبد الناصر فى فترة شبابه المبكر ملذات الجسد!
لكن الإضطراب الأكثر وضوحا يمتد بالأساس الى متن الرواية، أعنى بذلك الطريقة التى رسمت بها شخصية عبد الناصر وحبيبته وزوجته زينة، فمن بداية قوية لشخصيتين تمتلكان ثقافة وقوة ووعيا وقدرة على النضال، ننتقل تدريجيا الى شخصيات تاه منها الطريق سواء فى دهاليز السلطة فيما يتعلق بعبد الناصر، أو فى دهاليز حب الذات وخدمة طموحها العلمى كما هو الحال مع زينة، لن تستطيع أن تبتلع هذا القفزة دون تمهيد، ولن تصدق أن عبد الناصر وزينة اللذين تبادلا القبلات تحت هراوات رجال البوليس، يكشفان تدريجيا عن ميل عميق للتراجع والتنازل مع أول اختبار، بل ستولد علاقة ممتدة بين عبد الناصر ورجل الأمن الذى ينتمى الى نفس منطقته، رجل ألأمن سيساعد فى الإفراج عنه، وسيمنحه فرصة العمل فى الجريدة الحكومية وثيقة الصلة بالحزب الحاكم، وسيساعد فى حصول زينة على ما يجيز حصولها على وظيفة مدرّسة للفلسفة رغم نشاطها السياسى السابق، عبد الناصر الذى كان يتعمد الرسوب فى كلية الحقوق حتى لا يترك ساحة الجامعة للمتأسلمين، سيتحول تقريبا الى شخص آخر بعد التخرج، وزينة التى تمتلك تحليلا رائعا تضع من خلاله المتأسلمين والشيوعيين فى سلة واحدة من حيث الصرامة الأيدلوجية البائسة، هى نفسها التى لا تستطيع أن تحلل موقفها من عبد الناصر، يتأخر كثيرا قرارها بالإنفصال عنه، وتسير علاقتهما بين مد وجذر، بل إن تعاملها مع حلم الحصول على الدكتوراة يفتقد النضج، إنها تبدو مثل طالبة تضع حياتها بأكملها فى مقابل هذه الدرجة العلمية، وهو أمر لا يليق بمنظّرة سياسية وفلسفية بارعة، سينتهى الأمر بخيانة عبد الناصر لزينة مع صديقتها، وستسافر هى للدارسة فى فرنسا بعد أن ارتبطت برجل فرنسى أكبر منها سنا.
كل رواية، وكل عمل فنى، يصنع قانونه وحيثياته، وليس فى رواية “الطليانى” إلا تقلبات غير مستساغة، ومحاولات غير ناحجة لرسم الشخصيات، تتسلل إليك وسط هذه الضبابية الفنية الناتجة حتما عن نقص الأدوات معالم وجهة نظر سياسة تجعل اليسار فى خندق الحكومة ونظامى بورقيبة وبن على فى مواجهة الخطر الأكبر للمتأسلمين، الذين بدأوا فى الإنتشار والتغلغل منذ الثمانينات من القرن العشرين، عقدوا مؤتمراتهم، واقتحموا الجامعات، وحصل بعضهم على رعاية الحزب الحاكم، يعلو صوت السياسة مع استغراق مفتعل فى صوت الجنس وخبرات الطفولة المؤلمة، زينة مثلا انتهكت فى طفولتها جنسيا من شخص لم تتبين معالمه، قد يكون والدها أو شقيقها، لم تستطع أن تعيش حياة جنسية سوية بعدها، ثم اكتشفنا أن عبد الناصر، الذى يبدو مثل كازنوفا يسارى، تعرض أيضا للإنتهاك فى طفولته من الشيخ علاّلة، صديقة زينة تبدو أيضا كنموذج غريب ومفتعل، لاتعرف بالضبط هل هى تحب عبد الناصر أم تريد جسده؟ ولن تفهم أبدا علاقتها الملتبسة مع زينة التى تشاركها فى رجل لديه مشكلة انتهاك جنسى فى طفولته.
تفتقد الرواية تلك البؤرة التى تجمع شتاتها، أتصور أن شكرى المبخوت نفسه قد أحس بذلك، فحاول على لسان السارد العالم بكل شىء أن يفسر التيه الذى تداخل فيه العام والخاص بدون تفسير أو سياق، يقول السارد:” ولو رويتُ ما سمعته لتطلّب منى تديونه ونقله بأقصى قدر من الأمانة والتماسك مئات الصفحات التى لا أقدر على تحريرها لطولها ولا أريد أن أفعل ذلك لأنها استطرادات قد تضيع عنى خيط الحكاية التى أدت بعبد الناصر الى فضيحة المقبرة، فالواقع أن الكثير منها لا يضيف لنا شيئا عن حياة عبد الناصر ودوافعه فى ضرب الإمام الشيخ علاّلة يوم دفن سى محمود، ولكن الكثير منها قد يدل على ما عاناه عبد الناصر وهو ممزق بين استسلامه لتلك الإجواء البائسة فى الوسط الثقافى والإعلامى التونسى، ووعيه الحاد بأنها لا تثرى فيه حسا ولا تطور معنى، إنه السأم الذى يتغذى من السأم والقرف الذى يتولد من القرف، وعلى حد معرفتى بعبد الناصر وشغفه بالتجديد والتغيير والتبدل وبحثه عما يثرى أحاسيسه ومعارفه وحساسيته ونظرته الى الحياة، فإن كل تلك الأجواء دخلها اضرارا لا اختيارا” . فى هذه الفقرة السابقة ما يكشف مأزق الرواية الفنى بوضوح، لقد شعر كاتبها بثرثرتها واستطرادها، وعدم ارتباط ذلك بحدثها الإفتتاحى، فساق تبريرا بأن كل ذلك يكشف عن معاناة بطله بين استسلامه ووعيه، الذى أورثه مللا وقرفا انفجر فى وجه الشيخ علّالة، وكان أولى أن ينفجر فى شخص عبد الناصر نفسه، نسى كاتب الرواية أن عرض الفكرة بشكل مباشر يثبت عجز أدواته عن توصيلها، ونسى أن حديثة سيفرز سؤالا هاما عن سبب وجود هذا الشخص الواعى الحساس والمناضل المستعد لدفع الثمن فى أوساط الإعلام التونسى الخاملة ؟ كيف تحولت الشخصية القيادية المستقلة الى شخصية مستسلمة ومؤيدة وتابعة؟ كيف تكون شخصية متمردة مثله مضطرة ومجبرة ؟ لا إجابة.
تحتمل أزمات المثقفين وصعودهم وسقوطهم تناولا فنيا وأدبيا مفتوحا، لدينا رصيد لا بأس به فى هذا المعنى فى ورايات كتاب كبار مثل نجيب محفوظ وفتحى غانم وغيرهم، لا يصح بعد كل هذه السنوات أن تكون لدينا صياغة غائمة وركيكة مثل “الطليانى” حول نفس الموضوع، ليست الرواية هى تلك الصفحات الطويلة المكتوبة والمليئة بالتفاصيل والأحداث ، ولكن الرواية هى المعنى والمغزى من وراء كل ذلك، فإذا اضطرب المعنى، وتاهت مبررات الشخصيات، واستند البناء على حادث هزيل، فإننا سنكون ساعتها أمام معضلة اسمها “الفشل الفنى”.