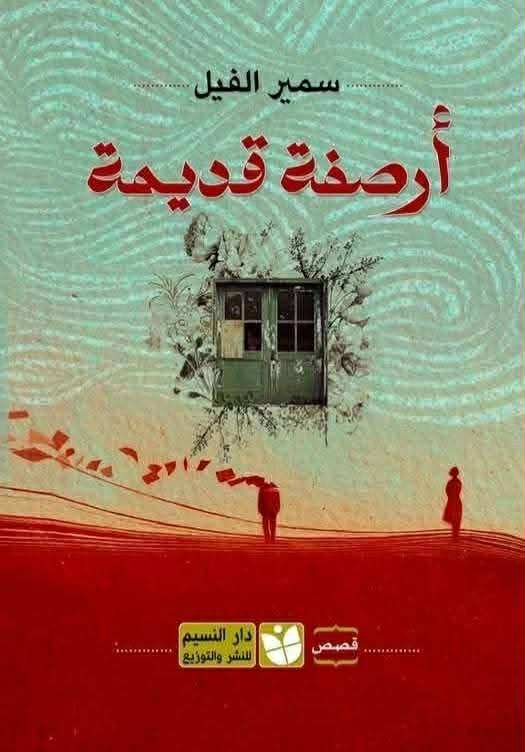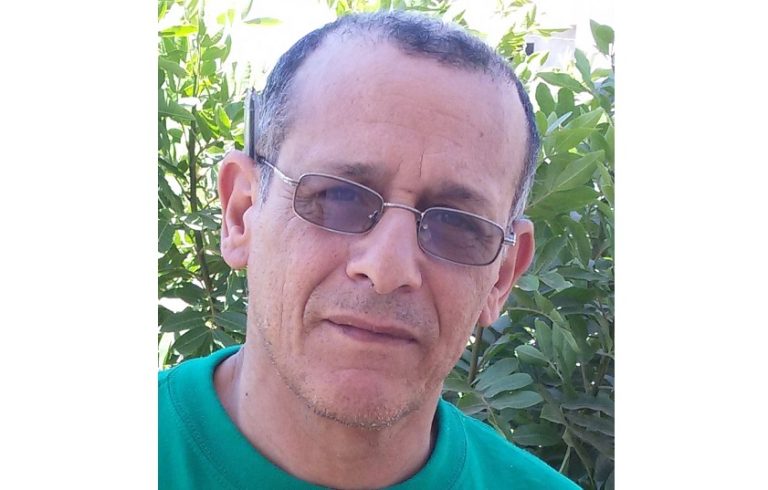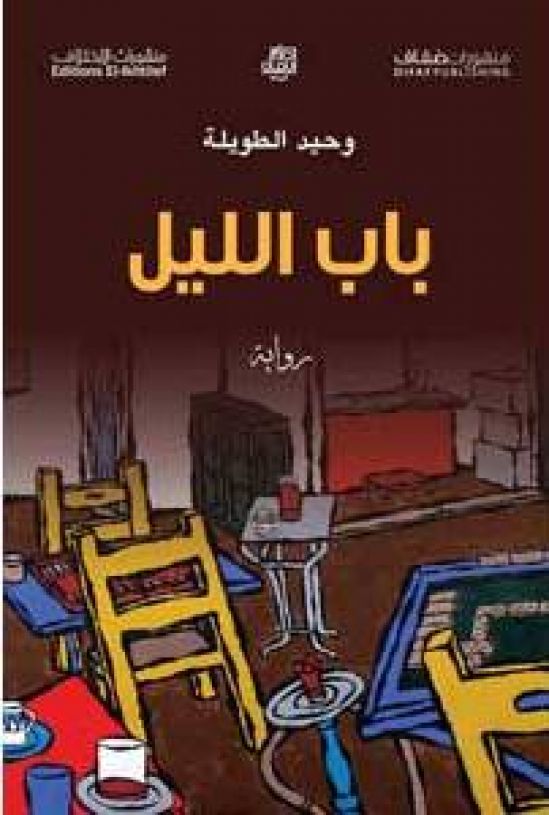محمود سلطان
عاد مع عائلته إلى قريته، ابن عشر سنوات، مُنذ ذلك الحين، وهو يرى عمه “علي” شيخًا للبلد. تقدم به العمر، تخرج في الجامعة، سافر وعاد وتزوج وأنجب، ولا يزال عمه “على” شيخًا للبلد، حتى العمدة الذي استقبلهم، واستضافهم في دواره الواسع، منذ ثلاثين عامًا، بقى على عرش العمودية، لم يتغير فيه شيء، إلا الدوار: استبدل الطين والقش وعروق الخشب، بالطوب الأحمر والأسمنت والخرسانة، والمندرة بالأنتريه والنملية بالنيش والطبلية بطاولة السفرة.
اعتاد على رُؤية العمدة بلحمه وشحمه، وعمه “علي” شيخًا للبلد، حتى ظن أنهما سيبقيان إلى أن يتوفى بعد عُمر طويل، ويشيعانه إلى المقابر، ثم يصطفان مع أهله لتلقي العزاء فيه.
لم يشغل نفسه يومًا بالسؤال، لِمَ ظلت أكوام قش الأرز وحدها لا شريك لها، في الجرن الكبير باقية متغطرسة وعصية على استبدالها بأخرى من عيدان شجر الذرة اليابس، وسيقان القطن الجاف، أو حتى بأكوام السباخ وروث البهائم أو جيف الكلاب النافقة؟!
هكذا كان حاله!، فما الذي يجعله، يهمز بكعب رجله بطن حماره الأبله ولم يُفكر يومًا أن يسرج متنه ليعتليه؟!
لا تقع عينه إلا على المستنقع، وبرك المياه الراكدة، التحق بوظيفة في مطلع شبابه، ولم يُفصله عن الخروج إلى المعاش إلا أيام قليلة، ورئيسه الذي استقبله مُستهلا أول أيام العمل، لا يزال هو “الرئيس” يستقبل الجدد ويُودع المُحالين للتقاعد. حتى الباشا المأمور، لا يزال سيد المركز، لم يتغير فيه إلا النجوم التي تلمع على الأكتاف، من نجمة وحيدة إلى نسر ونجمتين. رئيس الجامعة التي درس فيها، استقبله طالبًا، ولا يزال ـ بعد تخرجه ـ يرفل في نعيم الكرسي ويستمتع بدفء السلطة،
الإلف والتعود يورث التبلد وسماكة الجلد وعطب ميكنة العقل.
خاصم الرغبة في السؤال، وفقد شهية الركض وراء التفسير، حتى يوم أن أمر ضابط الدورية، بربط يدي شيخ الخفر بحبل خشن وقاس، وعقده في ذيل فرسه، وسحبه على وجهه في شوارع القرية، ينزف دمًا ويقسو على جسده النحيل بكرباجه الميري، ثم يركله بحذائه الثقيل، ويُلقي به وسط ميدان، يكسوه الحصى الجارح، ويكتظ بالعابرين ومحال البقالة، ثم يستدعي “متولي” الحلاق، ويأمره بحلق نصف شاربه المعقوف، ويترك نصفه الآخر، وحمله على “أتَان” عجفاء، ظهره لرأسها، ورأسه لدبرها، وطافوا به طرق وحواري القرية.
حتى هذه لم تغمد في جلده، رأس وغزة إحساس بالغضب، وقد ألف سماع أصوات الاستغاثة كل ليلة تأتيه من دوار العمدة، وأنّات تشبه استعطاف مواء القطط، يرهف لها سمعه وكأنه يطرب بأم كلثوم “عودت عيني على رؤياك”.
عرف فيما بعد أن جريمته، كان “طمعه” في مشيخة البلد خلفًا لعمه “علي”!، باغته الضابط النوبتجي، وقت القيلولة مُتوقعًا غيابه عن غرفة السلاحليك، وتصيده في لحظة “خطأ” بات عُرفًا لا عقوبة عليه.
ومثل الحمار الذي لم يفهم “نكتة” القرد إلا بعد عام مضى، تذكر أن عمه “على” صاهر الباشا “والي” الأختام، منذ سنوات طويلة، وأن جناب العمدة الأخ غير الشقيق للبيه مأمور المركز، وأن أستاذه رئيس الجامعة، مُتزوج من شقيقة زعيم الأغلبية “الأبدي” بالبرلمان، ورئيسه في العمل، ابن رجل أعمال مدلل يجيد رضاعة المن والسلوى من أثداء الحكومات المتعاقبة.
دلف إلى غرفة مكتبه بالبيت، يشعر بالملل وكأن قبضتين غليظتين تعصران قفصه الصدري، ألقى بجسده الكسول على كرس جلدي، وقعت عينه على عدد من الصحف البريطانية مُلقاة بإهمال على طاولته: الصنداي تايمز، ديلي ميرور، ديلي تلغراف، ذا تايمز، التقط مثل البصرة أو “كش الولد” في لعبة الكوتشينة، “ذي إيكونوميست” يقلبها بسأم، لفت نظره مانشيتا لتقرير كبير بعنوان: هل يمكن إصلاح المؤسسات ذات النظام العائلي؟!. قرأ التقرير بنهم، ثم نهض متجهم الوجه، أشعل سيجارة، ثم استقبل صورة للرئيس مبارك، علقها والده ـ أمين عام الحزب الوطني ـ على جدار غرفة الضيوف، تأملها طويلاً، ثم ركل باب الدار بعنف: شاهد محطة مترو رمسيس وقد تغير اسمها، ولكن ظلت البرك راكدة، والنهر يغالب صلف المستنقعات المتوقحة، وعمه “على ” المستذئب” شيخًا للبلد.