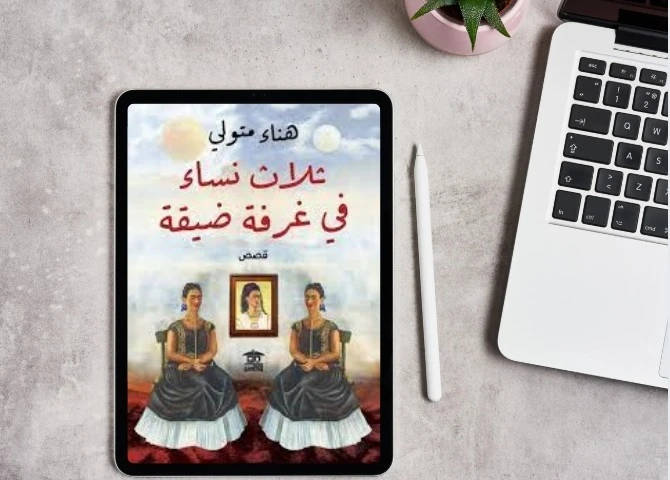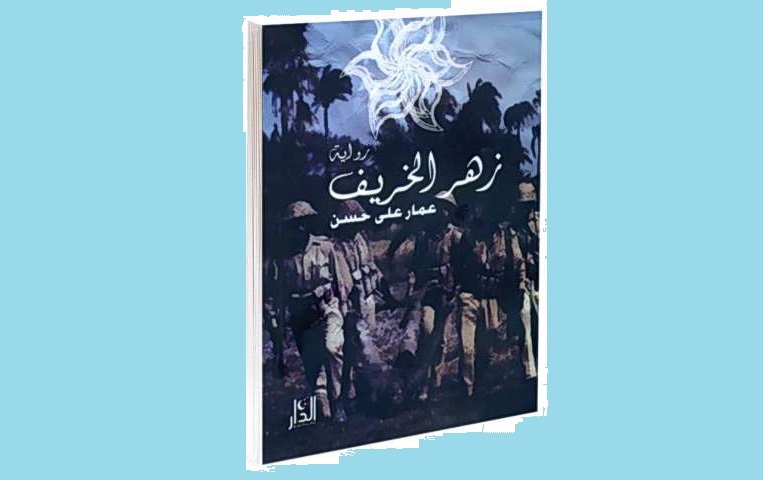إيهاب خليفة
لمحمود خير الله تجربة شعرية ذات خصوصية، حظيت بقبول واسع، وخطوة بخطوة احتلت نصوص خيرالله – أحد شعراء قصيدة النثر الحقيقيين – صدارة المشهد الإبداعي، نظراً لثرائها الجمالي، ولما تختزنه في ثناياها من طاقات إنسانية و فلسفية و رمزية وجمالية، مجاوزة لما هو مجانيّ، الشعر لدى خيرالله لا يتخلى عن جوهره الجمالي، كما أن له دوراً تثويرياً مبهراً، فخيرالله كما ينجز تجربة شعرية متفردة، يحلم أيضاً بتغيير العالم، لصالح المهمشين والمنسيين ويجعلنا – كقراء – نؤمن بأن ثمة أملاً ما وراء أوتار المأساة هذه التي تعزف تراجيديا الوجود.
أصدر الشاعر محمود خيرالله من قبل” فانتازيا الرجولة” 1998م و”لعنة سقطت من النافذة“2001،و “ ظل شجرة في المقابر“2005، و” كل ما صنع الحداد“2010م، ومقالي اليوم قراءة في ديوانه الأحدث “الأيام حين تعبر خائفة” الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب 2018.
” الأيام حين تعبر خائفة ” عنوان دالٌ فيه يشي محمود خير الله بوهن خيوط نسيج الزمن، وبصلابتها في الوقت نفسه، ثمة عبور للوقت محاط بخوف كثير، خوف يتسرب في نسيج الوقت، وفي نسيج المكان ويفيض على كل الكائنات، ويستعمر الأرواح، ومع هذا الخوف تحدث أشياء كثيرة أكثر رعباً، فالأيام التي تحدد هي المصائر تنتظر مصيرها هنا، فميراث الخوف الكبير يجعلها ساكنة رغم حركتها، حتى الحب لا يملك التحقق فوق يابسة مدججة بالهواجس، يقول الشاعر في مفتتح الديوان :
كقبلة وداع مزقتها صافرة قطار/كحافلة سقطت في النهر عنوة/ فتبللت جيوب الموت/ فجأة/ كالذنوب والخطايا/ كَسِنّ معدنية تلمع،/ فوق شفاه قاتل/ كشمعة/ كطلقة في الميدان/ مصوبة منذ أعوام/ لكنها لم تصل/ – بعد- إلى سويداء القلب/ كطريق فرشناه معاً/ بالأسى والحنين/ كسمكتين وحيدتين/ في “حوض” ضائع/ أحبك ../كندبة”.
يشي هذا المفتتح الدال بأن الحب كقيمة كبرى في حياتنا يحيا حياة معذبة، لا يملك اكتمالاً، وهو أي الحب سيبدو كجريمة يسعى الوجود إلى إقصائها؛ لأنه ببساطة قرين الحري ووقودها، فالوجود لن يسمح مثلاً باكتمال قبلة واحدة حتى لو كانت للوداع، لن يسمح حتى باختراق الرصاصة للمعاني التي تجول في القلب، سيجعل الرصاصة معلقة أبداً، مصوبة أبداً، لتظل المصائر هنا في متاهة تشبه متاهة سيزيف، وإذا أشعلت شمعة واحدة لتضيء الطريق لأحد ما، فإن الرصاصة قد تكون الرد الجاهز أمام ما تقترحه الشمعة من ضوء.
بتجاوز المفتتح، نجد النص الأول “عاريا يتغطى بنافذة” أحد النصوص المركزية في الديوان، وفيه تحاول الذات تعرف أبعاد وجودها ووجودنا، خلف الشرفة تصبح العينان أهم الحواس لالتقاط ما يترى من أحداث خارج الغرفة، هنا الذات تقصي عالم التفاصيل المحدود، ولا تعترف بقدر ما تحاول أن تمتلك معرفة، وتطرح قصيدة “عارياً يتغطى بنافذة” دلالات عدة تتكاثر من دال “الشرفة”، فبينما نجد ذاتاً واحدة، نجد في المقابل شرفات كثيرة، وإذا كان ميلاد الإنسان يمر عبر رحم الأم، في طقس الولادة، فإن ميلاد الشاعر لا يكون إلا عبر نافذة؛ لتتحقق له ولادته المعرفية والجمالية، يقول خيرالله:
احصل على النافذة أولا،/وأنا أضمن لك/ أن القمر سيأتي صاغرا معها/ والنجوم/ والشجر سوف يأتي،/ وإذا جاءك هؤلاء جميعا،/مرة،/صدقني /سيأتي النهر مهم دائمًا
/ من تلقاء نفسه.
خلف النافذة، حيث يمارس محمود خيرالله هذا الطقس الاستثنائي الذي يمزج بين نقيضين : عزلة الذات من جهة وانفتاحها على العالم من جهة أخرى، إنها ذات تتأبى على التلاشي – رغم إقصائها- كما أنها ليست خيطاً في نسيج العالم المخادع، تصبح الشرفات في ديوان “الأيام حين تعبر خائفة” الوتر المشدود بين عالمين: عالم الداخل وعالم الخارج، الحلم والحقيقة، ما نتمنى وما هو كائن، الروح المكتنزة بأسئلتها وجسد العالم المتيبس، يقول خيرالله:
أنا لا أملك من حطام الدنيا /سوى عينين ونافذة/أرى بهما العالم /الذي يدور في رأسي
لا بيت لي/ لا أصدقاء/أهلي كلهم هجروني،/لم يبق معي- دائما-/ وإلى النهاية/ سوى الشرفات،
في ” عاريا يتغطى بنافذة” تتجلى شاعرية محمود خيرالله في رصده المدهش لشرفة تتلبس البشر، وكأنما هي سجينة الحوائط، تتعذب؛ إذ رغم مكاشفتها للرؤى، تبقى منعدمة الفعل، مما يجعلها تقرر الانسحاب من العالم، وقد تكون شرفة خير الله الثورة الموءودة، التي نظرنا من خلالها إلى الحلم، قبيل انهدامها/ وأدها، يقول:
بعض الشرفات تودع حياتها التليدة في البناية/ وتهوي على الأرض/ مرة واحدة،
كأنها قررت / فجأة أن تنتحر.
بعض الشرفات تفعل ذلك/ لأنها تلعن قصص الحب/ التي انمحت من جدراها،/ تلعن الندوب الثقيلة،/ التي تحفرها الأيدي /على خشب النوافذ…./ بعض النوافذ تسقط كالثورات الزائفة،/ وتتكوم كالروث/ في جانب الميدان.
عند محمود خيرالله نزعة أصيلة تتبدى في نسيج شعره، كبصمة من عالم شعري يرتكز أساساً على المغايرة والتجاوز، هذه النزعة هي الإبقاء على المسميات مع تغيير تصوراتنا تجاه المسمى، بتبيان جوهره الرؤيوي من وجهة نظر الشاعر، فكل ما في الكون من نجوم وأقمار وأمطار و شواطئ، كل ذلك مرده إلى الإنسان، بحيث كان جزءاً منه، مثلاً القمر عند الشاعر هو جوعنا المضيء ألماً، والرذاذ عرق أجيال عاشت في خنادق العبودية، وأمواج البحر دموع كل الأمهات الثكلى اللائى التي حولت الحرب حياتهن إلى حياة أشباح: وتمثل ذلك المنحى قصيدتا “حيث لا تنتهي الحرب أبداً” و”ليتني شجرة“، فيهما يؤكد الشاعر أننا أبناء ميراث طويل من التهميش والتجاهل، وأنه يتم استنزافنا عبر مئات السنين، يقول الشاعر في القصيدة الأولى:
انتبهوا../هذا الرغيف الأبيض الفاخر،/الذي يظهر كل ليلة،/في السماء،/ويبدو نحيلاً- أحياناً -/كعود قصب،/ومستديراً /-أحياناً-/كقرط في أذن الغيم،/ليس قمراً/صدقوني
إنه آخر ما تبقى من دموع أجدادنا،/ الذين ماتوا في سالف الأزمان،/ببطون خاوية.
الشاعر ببصيرته يستقرئ الواقع المرير، ولا يقترح حلولاً واهية، لتمنحنا خلاصاً كاذباً، بل لا يجد تقريباً أي مساحة لأمل مُحتمل، وعلى هذا يعلن عن أمنيته الأخيرة أن يضحِّي بنفسه من أجل إعلاء شأن المهمشين، إذ يُصبح أمله هو أن يطعم الفقراء جسده حين يصير شجرة بعد موته، وإن تيبَّس سيصبح أمله أن تطأ أحذية الفقراء فوق رأسه، حين يصير جسراً، يمرون به في مشاويرهم، هنا نجد الشاعر يعلم أن الموت يتربص به ويتربص أيضاً بأمانيه، إلا أنه – رغم ذلك- يؤكد على عطائه اللانهائي، يقول:
ليتني / بعد أن أموت/ وتصير العظام ترابا/ أن أتحول – ذات مرة-/ إلى شجرة،
ينام الناس تحتها،/ يبتسمون ويأكلون كلما شاءوا،/ وحين تجف الحياة في بدني،
وتصير القامة يابسة،/ تماماً،/ من كثرة الحنين إلى الثمار،/ أصير جسراً ميتاً بين ضفتين،/ لا يمكنني أن أصحو،/ إلا كلما مرت/ أحذية الفقراء على رأسي”.
لكن في المقابل قد نجد الذات الشاعرة تستشعر خوفا من القادم وتمسي مدججة بميراث هائل من الهواجس، التي تترصد الشاعر، أبرزها هاجس الشيخوخة الذي يتهيبه وهاجس التقاعد حين يحرمه بسبب الكبر من الكتابة، يقول:
لن تجد القدرة على الصراخ،/في هذه الآهات الضعيفة والمتقطعة،/ التي تقول رأيها على الملأ،/ في هذا الرجل العجوز/ الذي ينام كل ليلة في الشرفة حزينا،/بعدما طردته الدولة من العمل،/ بحجة أنها تخلصت/ -مؤخرا- من الحاجة إلى الصحف”.
وتفصح قصيدة ” الأربعون” عن ذلك الهاجس بجلاء، فيقول فيها الشاعر:
المجد للطريقة التي/ نتسلل بها/ حين نبلغ الأربعين،/ خارجين من البيوت الدافئة/ دون أن يلحظنا أحد،/ المجد للأشباح التي نرتديها/ ونحن ذاهبون إلى الخديعة/ وحين نعود/ نخلعها على الأبواب بسرعة/ لنشم بعمق/ هواء البيت!”.
وفي قصيدة “وجه أبي” يرصد الشاعر محمود خيرالله جزءاً من سيرة أبيه الذي غيبه الموت بأشنع الوسائل، لكنه – أي الأب – شديد الحضور في حياته لا يزال، حتى لقد أعاره وجهه من الأبدية في سن الأربعين، وكأنما نبوة ما تلبست الشاعر بدأت تكشف له أسرار كل شيء؛ لقد اكتشف مثلاً أنه نقيض أبيه من الداخل، رغم تشابههما الظاهري، فقلب الأب مليء بالإيمان بينما الابن يطارد الفراشات في حديقة البيت، رغم أن هذا الابن نفسه كان يدرأ ذبول الحديقة بالأمل، قبل أن يعانق اللاجدوى، تحمل هذه القصيدة عذابات الشاعر في فقد أحد ركائز حياته، يقول:
البار هو اللحظات الأخيرة،/ يا أبي،/ حين تنفق آخر ما في جيبك،/ على آخر ما في رأسك/ وحين يغلق عامل كسولٌ الباب/ بضربة واحدة./ البار،/ هو الجنة التي يلوذ بها،/ من كان زاهدا فيها،/ من يحاول العودة إلى البيت،/ وهو لا يستطيع أن يعود إلى نفسه.
لعل قصيدة ” لا شيء يدوم” في ديوان ” الأيام حين تعبر خائفة” تمثل ذروة الفعل الشعري ، وهي – على ما يبدو لي – وجه العملة الآخر لقصيدة الشاعر” عاريا يتغطى بنافذة”، يُكمل هنا محمود خير الله فجيعته الكونية، يسد الشاعر بهذه القصيدة على القارئ كل الدروب، فلا يمكنه أن يفلت منها إلا موجعاً ومحملاً بزخم من التعاسات الشفيفة، في القصيدة ينتقي الشاعر معلماً مغايراً يستقي منه جوهر الوجود، وما هو مدهش أن محمود خيرالله قد اختار الشرفة التي ليست سوى فراغ داخل جدار؛ يعكس هذا الفراغ امتلاء الذات بالرؤى، لذا تأتي الشرفة لتعلم الشاعر كل شيء عن الحياة، فبينما هو غير منغمس في فعل ما كما قد يتراءى، إلا أننا نجده عبر الوقوف خلف الشرفات يستجلي كل أبعاد الوجود، دون أن يقترف جرائمه أو تدنسه دسائسه، يقول الشاعر:
علمتني الشرفات التي وقفت خلفها،
كثيراً وأنا صغير،
أن لا شيء يدوم،
حتى وأنت مختبئ
وراء شرفة بالية،
الأصوات تأتيك عارية من ملامحها،
والحزن يهز ذيله للعابرين،
لكن
لا شيء يدوم.
العالم مؤلم فعلاً من وراء النافذة:
العاهرة تهش حزنها وهي تمشي،
والمنتحرون يسيل لحمهم دون إرادة منهم،
أقف وحيداً في الشرفة،
ربما،
لأن لديَّ ما أنظر إليه،
أنا مولود في شرفة يتيمة، وحين كبرت
صرت أفتح قلبي – بصعوبة-
كنافذة تكافح كي لا يغطيها التراب،
عرفت شرفاتٍ تآكلت حين مات أصحابُها
ونوافذ تعرَّت جدرانها
قبل أن تتعرى النساء فيها”.