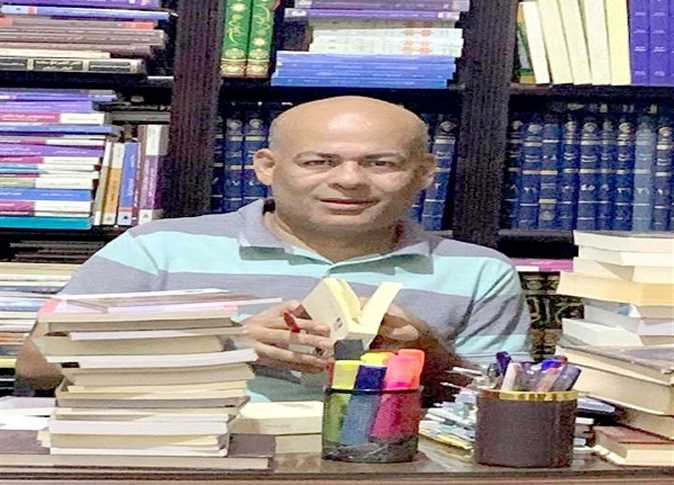إبراهيم فرغلي
وصلتُ إلى منتصف الجسر. توقفت. لا أذكر السبب الذي جعلني أصعد إلى الجسر. ولا أذكر حتى كيف تمكنت من الوصول إلى هنا. الرصيف الضيق الذي لا يزيد عرضه عن مساحة قدمين متجاورتين لا يسمح للمرء أن يمشي بشكل جيد، ولو نزلت قدم بطريق الخطأ من على الرصيف لنهشتها سيارة مارقة على الفور.
صحيح أن السيارات مكدسة وتقريبا لا تتحرك. لكن القاعدة معروفة: «انزل بقدمك من الرصيف، وسوف ننهشها فورا».
رأيت البناية السوداء الجميلة أمامي، فانتبهت من شرودي. فلماذا صعدت الجسر وقد كان المفترض أن أعبر إليها من أسفل الجسر؟، قدّرت أن حالة أمي التي عدت لتوي منaزيارتها في المستشفى هي السبب. لا أكاد أصدق أنها الآن ترقد هكذا، بلا صوت، ولا قدرة على الحركة، ولا قدرة ربما حتى على إدراك وجودي بجوارها أو غيابي الآن عنها.
علا فجأة صوت غريب. صخب بشري مشوّش وغامض. لكنه في مجموعه لا يسبب إلا التوتر. ربما لأنه يشير إلى غضب ما. ثمة جماعة غاضبة كان صوت هديرها البشري يعلو تدريجيا.
المؤكد أنه ليس بإمكاني القفز من هنا للوصول إلى البيت. وليت أمواج النهر كانت هي البديل لطوفان السيارات المتدفق الآن أسفل هذا الجسر اللعين، لكن ألقيت بنفسي من دون الكثير من التفكير. ويبدو أيضا أنه لم يعد بإمكاني العودة من حيث جئت، إذ يبدو أن صوت الهدير آت من نفس الجهة التي قدمت منها صعودا إلى الجسر. تأملت بنايتنا التي تنحشر بين عدّة بنايات شبيهة، لا تكاد تميز أيا منها عن الأخرى بسبب السواد العالق بجدرانها جميعا.
هالني مشهد السواد. أأسكن هنا؟ أهذا هو البيت الجميل كما يرد إلى خاطري دائما؟ ابتسمت للخاطرة، كيف يمكن لبيتٍ كنت أتصوره دائمًا جميلا، أن يرفل في سواد الغبار والقذارة والإهمال على هذا النحو البائس؟ تذكرت وقفاتي مع شلّة أصدقائي من الجيران، ونحن نضحك ونسخر أحيانا مما كنا نصفه بقذارات البشر.
لطالما تمنيت، في سنوات المراهقة، أن أسكن بعد زواجي، في بيت جميل، مثل بيتنا. تلك الشقة الواسعة المستقرة في الطابق الخامس من البرج الشاهق المطل على الشارع الشهير الفسيح، والتي سكنها أبي قبل ثلاثين عاما، ليتزوج فيها، ولكي أولد فيها، وأعيش أجمل سنوات طفولتي، ومراهقتي.
المدهش، في مشيئة الأقدار أن يتحقق حلمي لأتزوج في البيت، نفس البيت الجميل، بل وبسبب المفارقات، أصبحت اليوم أعيش مطلقا في نفس البيت، أيضا بسبب المفارقات التي.. آه. على أية حال.
ها أنذا أقف مصدوما من أنني لأكثر من ثلاثين عاما لم يتح لي أن أنتبه أن بنايتنا التي نسكن فيها سوداء على هذا النحو المخزي. غبار وعوادم السيارات المتراكمة على مدى عقود وضعت بصمتها الأبدية على بيتنا الجميل، الذي يفترض أن جدران بنائه كانت مطلية باللون الأبيض يوما ما.
تذكرت أنني كنت مستغرقا في التفكير في أمي، وربما لهذا فاتني العبور إلى الشارع الآخر الذي يقود إلى البيت، بدلا من الصعود الخطر إلى هذا الجسر.
الذاكرة اللعوب، خاتلتني، فيما كنت أمد يدي بفتفوتة خبز صغيرة، لتتمكن الشفتان المرتعشتان من التقاطهما، بينما أتأمل العينين العسليتين الجميلتين الشاردتين بعيدا، إلى حيث لا يعرف أحد. ألحظ حركة الفم، الذي هجرته الأسنان، كأنها تطحن قطعة لحم سميكة لا مجرد مزقة من فُتات العجين.
كنت أتأمل، بألم وذعر، الذراع المنهكة من أثر السنين، والمرض، والمزرقّة من فعل شكشكات اختبارات الممرضات الفاشلة في البحث عن وريد شاحب وهارب في متاهات الجسد. تأملت الكف الحانية بأصابعها الأليفة التي كانت تُلقمني قطعا صغيرة من نسيج القصب، حتى تتمكن شفتاي الصغيرتان من تذوق عصارة السُكّر.
ما زالت الكف الحانية، تزهو بجمالٍ شاحبٍ قديم رغم الكدمات التي سببتها الإبر حتى أدمتها.
باغتتني الذاكرة بصورة ارتحلت لذهني قادمة من زمن بعيد، حيث كنت طفلا، بجسدٍ هزيل، ممدّدا على الأريكة في البيت الجميل، أضع رأسي قريبا من حضنها، مظللا بغيمة الحنان والجمال والأمان، تربطني بها أينما حلّت بجواري أو قريبا مني. حيث أشاهد حلقة من حلقات الكرتون التي أعشق.
ثنيت جزعي لكي أواجهها. أحدّق في عسل العينين الجميلتين المحبتين بلا حدود، فتبدو كأنها لا تراني. كأنها تشيح بهما عني. ألا تعرفني؟. أنادي عليها برفق: «ماما»، فلا تحرك بؤبؤي عينيها إلا بمقدار ملليمترات، لتوجههما إلىّ بنظرة زائغة. كأنها تخبرني أنها تعرف بوجودي، لكن شرودهما الجلي يمزق قلبي، فلا أجد في نفسي قوة إلا لكي أفتت فتفوتة أخرى من شريحة الخبز الصغيرة المطوية على قطعة من جبنٍ أبيض، ماسخ، أكاد أشك أنها تعرف لها مذاقا.
تعود ذاكرتي للبيت الجميل، بينما أقف أمامها بجسدي وأسئلتي ومخاوفي وقلقي وألمي. ترتحل الذاكرة إلى حيث كنت أنتظر الليل لكي أنصت للحكايات، بالصوت الذي أعشق، ويبهجني ويثير خيالي بعيدا إلى حيث تدور وقائع الحكايات، بعيدا في الغابات، وعلى الجبال، وحيث كل المخلوقات التي تبتكرها أمي أو تجترها من التراث، تفيض بالمكر والحيلة، وتقدم لانتصار الخير على الشر. حتى أغفو.
أما أنا فلا أمتلك ترف الحكي، علني أرد لها بعضا من فيض المحبة التي مثيل لها، فهي لا تكاد تسمعني، وإذا قربت من الأذنين شفتي أسأل عما ترغب، فلا أجد منها إلا هزّة رأس طفيفة لكي أفهم أن إجابة السؤال إما لا، أو نعم. لا أملك حتى أن أنذر لها نذرا مما نذرته لي وظلت توفيه حتى أقعدها المرض وأذهلها عن العالم وعني.
فيم تفكرين يا أمي؟ أسأل؟ محاولا تخيل كل ما يمكن أن يطوف في خيالها من أفكار، ولكني أخفق تماما في توقع أي شئ.
فيم تفكر الآن هذه السيدة التي كانت طاقتها وحيويتها مصدر الدهشة، وهي الآن بهذا الجسد العليل، الذي لم تعد عضلاته قادرة على تقبل أوامر الحركة من المخ الشارد بفعل جلطة صغيرة مرت وهربت تاركة الوعي في شروده المدهش المعذب هذا؟
اقترب صوت الهدير، وبدأت حركة السيارات بجواري تأخذ طابعا متوترا. كان بعض قائدي السيارات قد استشعروا خطر الأصوات الهادرة التي لم يكن واضحا من تستهدفه بهتافها، أو أين ستوجه غضبها.
أما أنا فقد أسقط في يدي. فأين سأذهب الآن؟ لم يكن هناك مفر من مواصلة السير في عكس الاتجاه الذي جئت منه، بلا هدف ولا مقصد إلا الهرب من الجموع الغاضبة.
ركضت هاربا، لكن الأمر لم يكن سهلا. فقد كان عليّ أن أتجنب بائعات المناديل اللائي سبقنني إلى هنا، وبائع السميط الذي وضع قفصا ممتلأ بدوائر العجين الناضج جعل مروري مستحيلا إلا إذا نزلت من على الرصيف.
بدأت أشعر بالتوتر. لأن الهدير الآن قد أصبح أقوى صخبا. ولمحت بعض السيارات المتراصة في موقف الزحام المتواصل، وقد صارت خاوية، وبدا أن سائقوها تركوها في أماكنها وفروا هاربين.
لكني قدّرت أن هذه السيارات المتعطلة ستكون بعض أسباب قدرتي على الهروب من هذه الحشود الغاضبة. وهكذا وجدت لنفسي مساحات فارغة رحت أمرق منها، من بين السيارات لأبدو كثعبان يركض على ساقين.
وفجأة واجهتني فتاة، كانت تركض باتجاهي وتستغيث. فتاة طويلة، رشيقة، ترتدي جينز أزرق ممزق من موضع الركبتين، وترتدي جاكيت أسود يظهر منه تي شيرت أسود. وتحاول أن تزيح خصلات من شعرها الطويل الناعم وهي تركض باتجاهي.
ومن بعيد، تجلى لي مشهد حشد آخر يبدو أن الفتاة كانت قد هربت منه هي الأخرى.
توقفت أمامي لاهثة وأمسكت بيدي بشكل انفعالي:
– أرجوك إنقذني.
– ماذا حدث؟
– هؤلاء الهمج.
-ماذا بهم؟
– لا أعرف، لكني أرجوك أن تحميني منهم. فأنت تقود مسيرة كبيرة على ما يبدو.
– أنا؟ أقود مسيرة؟
– أرجوك ليس هذا وقت التواضع، ها هي الحشود التي تقودها، بإمكانهم أن يحموني. أليس كذلك. فقط أخبرهم أنني واحدة منكم.
للحظة شعرت بأنني مشلول تماما. كنت أتلفت أمامي وخلفي، لأرى المسيرة التي أصبحتُ، بقدرة قادر، قائدا لها، وللحشود القادمة من الجهة الأخرى، والموسومين بالهمجية من هذه الجميلة.
كانت جبهتها العريضة مبتلة بالعرق، وعيناها العسليتان تلتمعان ربما بفعل التوتر والخوف، وشفتاها لا تتوقفان عن الارتعاش، وكان لصوتها بحة غريبة.
قلت لها:
– لست قائدا لأحد. أنا كنت أهرب منهم أساسا.
– أرجوك. أرجوك. هذا ليس وقتا للمزاح.
كانت الحشود قد أصبحت الآن، بسبب التعطل الذي تسببت فيه هذه الفتاة، تكاد تطبق علينا من الجانبين. لكنني لاحظت فجأة أن ما يهدر به كلا الطرفين تقريبا متشابه.
وحينما أصبح الحشدان على بعد خطوات قليلة جدا منا، وجدت الفتاة ترتمي في حضني كأنها تستغيث بأب. وكاد قلبي أن يتمزق من شدة الألم والحيرة, بين ضرورة وقوفي الآن أمام هذه الحشود جميعا، إن لم يكن لأجل حماية نفسي فلأجلها هي على الأقل.
احتضنتها، وهمست لها مطمئنا أنها ستكون بخير وأن كل شئ سيكون على ما يرام.
أمسكت بيدها، وتوجهت صوب الرصيف المطل على الجهة التي يقع فيها بيتنا الجميل، وأنا أشد يدها. توقفت عند الحاجز المعدني الذي يحد هذه الضفة من الجسر. صعدت عليه، ومددت لها يدي. تأملتني بحذر وخوف لدقائق. أدارت وجهها باتجاه الحشود مرة إلى اليمين وأخرى لليسار. ثم أمسكت بيدي ووقفت إلى جواري.
شعرت بخوف شديد حين اكتشفت أنني غير قادر على حفظ توازني. ولم أكن متأكدا من الخطوة التالية. تذكرت في لحظة، أنني حين سألت أمي بسبب تشككي: “ماما، إنتي عارفاني”؟ وكنت وضعت فمي قرب أذنها، وجبينها يلامس جبيني، وجاءني من صدرها كلمة عتاب قالتها بحركة الشفاه وبلا صوت، :”طبعا”. شعرت بكف الفتاة في يدي ساخنا وبضا، ولكنه أليف أيضا ألفة غريبة. وتذكرت أن صوت أمي حين ودعتها قد تجلى لي رغم إعيائها الشديد :”مع السلامة”.
أغمضنا عينينا، بعد أن ألقيت نظرة أخيرة على أمواج السيارات العابرة أسفل الجسر، ثم خطفت ببصري لمحة أخيرة إلى بيتنا الأسود الجميل. وكنت على يقين تام أنني وهذه الفتاة لا نعرف أبدا أين سيكون مصيرنا في اللحظات التالية.
…………..
*عن “الأهرام”