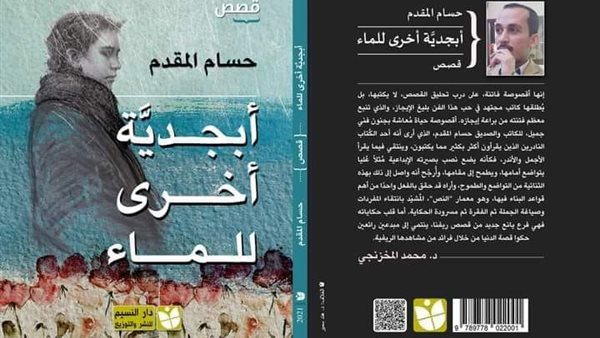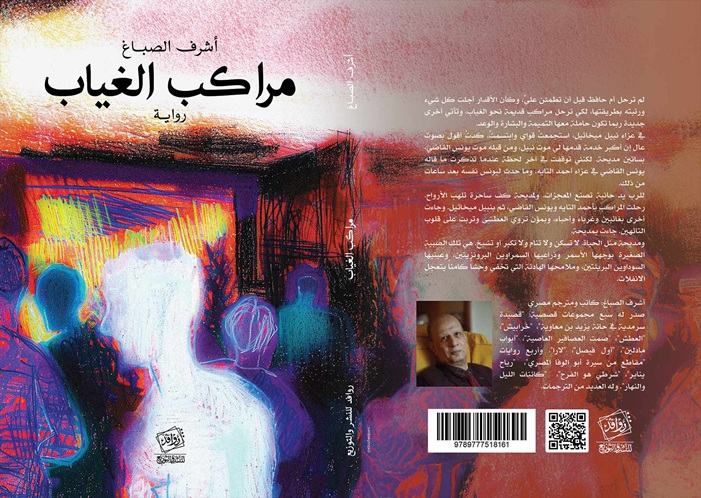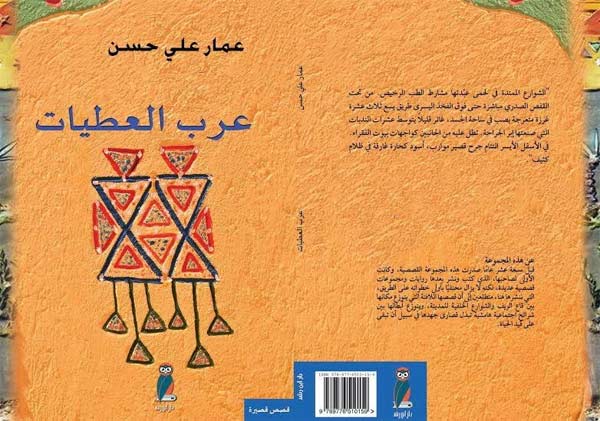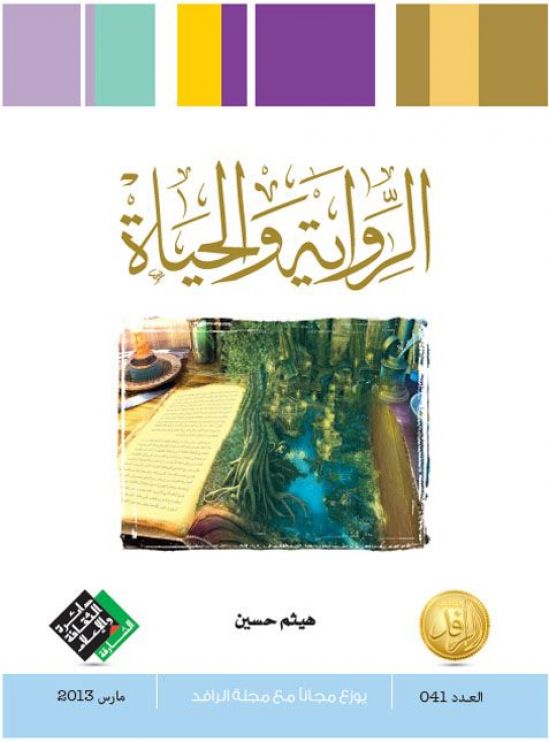محمد أبوالدهب
في مجموعته القصصية (أبجدية أخرى للماء) الصادرة عن دار النسيم يقدم القاص حسام المقدم خمسة وثلاثين نصا قصصيا قصيرا، تقدم بدورها للقارئ بعضا مما قد يتوقعه إن كان تعرّف سابقا على كتابة هذا القاص المتمرس (كثافة وحصافة الحساسية باللغة/ دقة الوقوف على لحظة وكيفية أداء الضربة القصصية/ الوعي المنطوي على إعجاب بعلامات التراث القصصي دون الانجراف في هوة التقليد والاجترار) وتوقُّعات القارئ هي عينها المهيِّئة لتلقِّي الشطر الآخر من الوجبة: المباغتة والإدهاش والتحفيز على الاعتقاد بأن المسألة ليست بسيطة كما تظهر فيعيد قراءة أسطر بعينها من قصة هنا أو قصة هناك، ربما ليُشبع تعاطيه مع هذه “الجاذبية العاطفية” التي تقدمها بعض النصوص، أو ليفهم الإشارات ويفك الرموز التي لا تبخل بها نصوص أخرى، وأخيرا ليتحرَّى مكمن السِّر في كل هذا التألم والتفجُّع الذي تشتعل بهما فئة ثالثة من قصص المجموعة ولو على مستوى فضاءاتها الدلالية رغم كَونها مكتوبة بطرافة وخفة روح ودم!
“واصِل، لاتهتم وسِر في قراءتك. لا تنظر نحو أحدهم وامشِ بعينيك في السطور. مهما يكن، لن يحدث شيء خطير إذا تجرأ واحد منهم. لا تعبأ واعبُر الصفحة الأولى. خذ نفسا عميقا من بطن الكتاب، وتمتع برائحة التونة الصابحة!…” إنها ليست وَصفة يغرينا بها القاص لنقرأ كتابه بثبات وصرامة دون التفات إلى جرأة وألاعيب الآخرين، الذين هم على الأغلب مضادُّون للقراءة/ للثقافة.. الأسطر الأولى من أولى قصص المجموعة (وصايا)، حيث إعادة تنظيم عالم بطلنا المثقف الذي ربما يعاني من عزلة عدم الفهم وانقطاع الوسائط التي يحسبها هو مناسبة للتواصل، مع إدراكنا أنه لا يعاني أبدا من عزلة عدم الاختلاط بدليل أننا حين نراجع وصاياه (العشر) نجد منها الوصية بعدم الالتفات لرنات الموبايل ليتفادى ثرثرة الأصدقاء في المكرور، ومنها عدم الدخول إلى النِّت بزعم الانفتاح على العالم لقناعته أخيرا بأن النت ليس أكثر من بيت للصور والأصنام، ومنها ألا يبدأ كلاما مع أحد في سيارات الأجرة حتى لا يكلمه أحد، فلا أبلغَ من الصمت تعبيرا عن مساحة القطيعة.. إذن لا بد أنه كان يفعل هذا كله، وربما بإسراف.. كان اجتماعيا أكثر من اللازم، لكنه انتهى إلى أن العزلة يجب أن تكون متكاملة الأركان في مناظرته المستجدَّة والمتحدية لعالمه، بالذات إذا ضممنا إليها عددا آخر من الوصايا التي تعبر عن مواقف اجتماعية وفنية وقيمية ناقدة للمتغيرات التي يموج بها الواقع من حوله، والمثير للسخرية أن نصَّ وصيته الأخيرة يدَّعي التفاؤل: “لا تتشاءم.. أنت لا تزال على قيد الحياة”!.. ولما كانت معظم الوصايا السابقة تزفر تشاؤما، رغم طابعها العملي، لأنها لا ترمي إلى التقييم والتقويم ومواصلة التماس الأعذار بقدر ما تدعو إلى البتر والانسحاب والنكوص فإن السخرية مستهدفة، ويدلل على ذلك أن موقفه عموما اتسمَ بالتأرجح والتذبذب، فإنه إذ يأمر بفعل وينهى عن آخر، لا يتحكَّم -أو على الأقل لا يتنبأ- بصيرورة الأمور: “فالقصة توشك أن تضع نهايتها بنفسها، أغلق كتابك ونَمْ.. نَم كما لم تنم من قبل”. وما بين السطر الأول المحرِّض على تجاهل الآخَر والمضيِّ في القراءة، والسطر الأخير الموسوس بإغلاق الكتاب والذهاب إلى نوم عميق، حمولة ثقيلة من اتهام الذات.
يستطيع حسام المقدم أن يصنع قصة غنية بالمواصفات الشكلية والمضمونية التي يمكن أن تهجس بها رؤى فنان عارف. من البسيط والمبتذل، سواء عنده ما يتعلق بانبثاقات الواقع أم باعتمالات الذهن، ينير لحظة قصصية قلما تسقط من ذاكرة قارئها، فعديم الإدهاش خارج السرد يصبح هو المدهش حين تستضيفه توليفته المميزة: (اللغة الوجيزة القوّالة، الحِس الحيادي والمتورط معا، تغليف الواقع بغلالة رقيقة من الخيال، تطويع مخزون الذاكرة البصرية ونحْته، اليقين القاهر بسطوة الزمن وجبروته المنتقل من قصة إلى قصة ولا يكاد يُستشعَر كما لو أنه عفو الخاطر). ينال هذا الكلام العديد من قصص المجموعة، منها: (المرتبة المحدبة.. مروان التاريخي.. أشكالي الهندسية.. تمارين أولية لموسم قادم.. تاريخ سري.. الصاخبون.. أماكن.. عشق آباد.. سيرة العيون والصخب…….).. غير أني سأتوقف قليلا مع قصة (رؤيا الحبل)، التي تبدأ بارتداد نوستالجي إلى مرحلة أواخر الطفولة وبدايات الصبا، حيث ألعاب العيال الكثيرة، “كذا وعشرين لعبة” كما تقول القصة.. نتلقى وصفا مدققا لتفاصيل خطوات إحدى تلك الألعاب: جمع أغطية المشروبات الغازية، ولَضْمها في الخيط، وتشكيلها واستخدامها في أهواء وأغراض عفوية عشوائية، ثم سرعان ما تختفي وتظهر لعبة أخرى كأنه انتقال سلمي قدَري للمراحل وغير مأسوف عليه، حتى أن العيال لا يتساءلون: “لماذا لا تبقى اللعبة بنفس حضورها وغليانها في الرؤوس؟ كيف ننساها كأنها لم تكن وندخل في أخرى؟”. واحدٌ فقط مَن كان يسأل، ويشغله السؤال عن مغزى الترك والتجاوز والنسيان، غير أنه ينتقل معهم إلى اللعبة الحاضرة. ومن انتقال إلى آخر حتى الوصول إلى اللعبة الخطيرة، مقصد القصة: حبل مفتول، توتة يطلعون عليها ويختبئون بين أوراقها، ثم يتربصون بالعابر ويسوون مقلبهم، مستلهمين مشهد الإعدام في فيلم (عمر المختار)، وتتطور اللعبة معهم فيقيدون اليدين ويرصون قوالب طوب تحت القدمين على أن ينجدوا اللاعب في الوقت المناسب، فتصير أقرب إلى طقوس شنق حقيقية. ويجرّب أحدهم، ويحكي لهم عن الأشياء الغريبة التي استبصرها ووجوه الموتى التي رآها قبل أن يعيدوه، ويتناوبون التجربة: “وفي كل مرة، بعد أن ينزل المشنوق دائخا غائما، يحكي ما أحسه ورآه، في لحظات هي الحافة ذاتها، هي الشعرة الفاصلة الرهيفة”. هنا تحديدا أسأل: هل كنتُ مضطرا لتلخيص القصة هذا التلخيص المُخل وإنها موجودة بالمجموعة لمَن يقرأ متنها؟ هنا تحديدا: نعم، لأنها اللحظة التي يتسلل فيها السارد لتحويل وعي المتلقِّي من استقبال حالة نوستالجيا –طبيعية وعادية ومستهلكة للحقيقة- رامية إلى أيام الطفولة الجميلة واللعب الخالي من المسؤولية تجاه العالم، إلى مواجهةٍ ميتافيزيقية مفاجئة مخيفة مع الموت، بالأدق مع العودة إلى الحياة بعد الاقتراب الشديد من الموت، بل وسرد ما صار من رؤى وأضغاث وانبعاث وجوه الموتى في النفق الذي لم يتم عبوره بالكامل، للحدّ الذي يحيل بعضنا قسرًا إلى كتاب (الحياة ما بعد الموات) لريمون موري، وبعضنا إلى الكتب الأكثر انتشارا والأقل علمية عن قصص العائدين إلى الحياة، والبعض الثالث إلى الاحتماء بمصدّات دينية وعقائدية، وننسى تماما ولو مؤقتا مغامراتنا وألعابنا في الصِّغَر، ولا تنكسر حالة تحويل الوعي بتوهُّم عودة القصة إلى مسارها المنتظر، لأن السارد يعرف ماذا يفعل، فالآباء والأجداد، رغم خطورة اللعبة على حيوات أبنائهم وأحفادهم، وكاد أحد الأولاد أن يموت شنقا بالفعل، لم يتصرَّفوا أكثر من: “نهروا العيال بلا حسم، إلى أن أخذوا الأمر باعتياد وتعنيف مبتسم لهؤلاء العفاريت الصغار”، كأنهم يسلِّمون بأنه لا حسم مطلقا عندما يتعلق الأمر بالموت، ليس إلا الاعتياد والتعنيف المبتسم الخانع. والولد الذي كان يسأل ويتحسَّر على نسيان لعبة مقابل ظهور أخرى، صار “يحلم بلعبة جديدة تزيل أثر هذه العدوى الرهيبة”، كأنه كان يقدر على حمل أمانة سؤال النسيان غير أنه يأبى حمل أمانة سؤال الموت ويشفق منه.. عاد إلى ألعابه القديمة وخاصم أقرانه، وجاء بلعبة جديدة، لعبوها معه، لكنه بقي على غيظه منهم لأن بعضهم لم ينس التوتة والحبال.. لم ينس مشاكسةَ الموت!
يتكرر مخطط تحويل وعي القارئ في عدد من قصص المجموعة، بتأثيرات متفاوتة وتوقيتات مختلفة، فقد يجري تفعيله بجملة واحدة وليس عبرَ حدث متولد عن الحدث الأصلي -كما عُرض لنا مثلا في قصة (رؤيا الحبل)- وقد تكون هذه الجملة في وسط القصة أو متأخرة قليلا أو في ختامها، مع احتمالية ألا يَقبل وعي كل قارئ هذا التحويل، أو أن يتباين مساره من قارئ إلى آخر، فالنص كما يقول المناطقة متماثل في الأعيان مختلف في الأذهان. أمثلة: (وانحنت تنظر يمينا وشمالا ثم دخلت/ قصة عيون).. (أحد الأعمام انتهى من طرقعة آخر أصبع في يديه/ قصة ركن يصلح لوصف المشهد).. (طقت شرارات كهربائية نتيجة تلامس الحروف الحمراء للافتة مع سلوك عصب العين/ قصة تمارين أولية لموسم قادم).. (في المقابل، أثق أنهما لن تسألاني السؤال الموازي: وانت يا بابا، مش هتلبس؟/ قصة مشهد الساعة الأولى).. (استدار عائدا ليأخذ الأوراق الملمومة ومضى مسرعا/ قصة “أغنية الكوب الحزينة”، مضافا إليها جملة النهاية: يمكن لأي واحد بنظرة خاطفة أن يرى صينية عليها كوبان فارغان، إلا من بقايا بُن غامق).
تضم مجموعة حسام المقدم قصتين من أجمل قصصها: (أبجدية أخرى للماء) التي حمل الكتاب عنوانها، وقصة (خمس وأربعون نجمة بطول ذراع). تبدو القصتان، على تفرُّق طقسيهما وتباعد مفردات عالميهما، كما لو أن العلة المحرِّكة لكتابتهما قريبة الشبَه، وكما لو أن الدافعية العاطفية والانفعالية لتخليقهما بادية التماثل، ولا غرابة في ذلك من حيث المبدأ، فكاتبهما واحد ومهما اختلفت أنماط تعاطيه مع ذاته أو تعاطي ذاته مع الكتابة وإنْ غلب نمطٌ على نمط فإنه يظل واحدًا، لكن خاطر التشابه، خصوصا أنه ليس تشابه الاستسهال والاستهلاك، يدفع القارئ إلى الموازنة بين القصتين: سقوط التليفون المفاجئ في النهر في القصة الأولى يقابله انقطاع الكهرباء المفاجئ في الثانية.. يستنهض سقوطُ التليفون الراوي للهَمِّ بالقفز في الماء، الذي لن يحدث بالقطع، لكن التحسر على ضياع الأرقام المسجلَّة يستدعي وجوه أصحابها التي لا يتذكر ملامح بعضها غير أن الاستدعاء لا يتوقف حتى وإنْ نما بشكلٍ انتقائي حسب مذهب القصة، فيما انقطاع الكهرباء يستتبع استعمال الكشَّاف الذي ينقش نوره خمسا وأربعين نقطة على الحائط تستحيل خمسة وأربعين وجها في هواجس الراوي، يعرف بعضها ولا يعرف أغلبيتها. نقرأ من قصة (أبجدية أخرى للماء): “أغمض عيني بشدة، وعلى الفور أفتحهما باتساع، بعد فزعة الخاطر الصاعق: صحيح توجد أسماء وأجساد لا أتذكر ملامحهم، لكن هناك أهلي وأبي وأخوتي وأعز الناس”.. ومن قصة (خمس وأربعون نجمة بطول ذراع) نقرأ: “تكبر الخمس وأربعون نقطة بشكل مزغلل، تتجسد على حائط الصالة اللامع بخمسة وأربعين وجها. أعرف بعضهم، والأغلبية لا أعرفهم”. استحضار الوجوه في الأولى بدا كطقس تطهُّر وطلب الغفران خاصة مع هيمنة الحسرة على ما لا يمكن استرداده من الزمن الضائع رغم إمكانية شراء تليفون جديد بديلا عن المفقود، فيما استحضارها في الثانية تجلَّى كطقس انعزال وداعي إجباري مع هيمنة رعب اقتحام الظلام رغم هدهدة المشاعر التي قد تغذِّيها رؤية النجوم الساطعة على الجدار (وحسام المقدم مغرم بمسألة استحضار الوجوه هذه في مجموعته بوجه عام، على المشنقة بين الموت والحياة وعلى صفحة ماء النهر وعلى حائط الصالة وعلى خريطة العالم وفي الشقوق الطولية للجدران الرطبة وغيرها) ويلعب التخييل دوره، وهو ما يبرع فيه المقدم، مع تدوير التجسد والتفاعل لبعض الوجوه في البنية الحكائية للقصتين، لنعايش رويدا تخييلا داخل التخييل في قصة (أبجدية أخرى للماء) مع قفز صديق الراوي إلى الماء واستخراج زجاجات الخمر الآتية من بلد جنوبي يتشارك النهر ذاته بعد التخلص منها تطبيقا للشريعة.. وتخييلا داخل التخييل في قصة (خمس وأربعون نجمة بطول ذراع) مع اكتشاف أن ما كُتب بالقلم على الورقة قبل عودة الكهرباء كان بلغةٍ غير معروفة ولا وجود لها. إنها أنشطة قرائية متنوعة يقدمها نَص حسام المقدم لقارئه رغم قصره: استشراف ما وراء الدلالات، الاستنامة والتسليم للطرافة والخيال، النزوع إلى البحث الذي تستثيره الوجازة اللغوية واستيهامات المجاز، الحرية في التلقي رجوعًا للحالة الفكرية والمزاجية، وحتى الانبراء لصنع نص مقابل أو متقاطع.
ذكَّرتني قصة (شرفات بحجم الكف) بفيلم (النافذة الخلفية) الذي أخرجه مخرج الشكوك ألفريد هتشكوك عام 1954، أصيب بطل الفيلم بكسر في ساقه فاضطر إلى ملازمة شقته التي تطل نافذتها الخلفية على الشقق المجاورة، فراحَ يتسلى بمشاهدة جيرانه أو قل بالتلصص عليهم قتلا للملل إلى أن رأى ما ظنَّه جريمة قتل. وقصتنا تراقب خمس شرفات متجاورة (خمسة مقاطع سردية مستقلة، أو خمس قصص قصيرة، ولكل منها عنوان مستقل)، والعين الراصدة -رغم أن السرد خارجي وأمثولة الراوي العليم تحلُّ المعضلات!- تتلصص من شرفة سادسة على الجانب الآخر من الشارع الواسع، وليس هذا اجتهادًا، إنما عنوان القصة يفضُّ الإشكال، وإلا ما كان لكفِّ اليد أن تحجب شرفة لتنتقل إلى أخرى. ومثل الفيلم تمدنا القصة بمثيرات التشويق والتشكك، لكن الحكاية هنا ليست تفتيشًا وراء قاتل، إنها عن أسرار لحظات القلق الإنساني والاستنفار الأبدي وراء رغبات في الاتصال بين الذات والآخر، الذي ينجح حينا ويخفق أحيانا. وهذه اللحظات قد تُرصد مع بداية القصة كما في (يمامتان وعصفورة)، أو في وسطها (ولد صغير ينادي العابرين)، أو مع نهايتها كما في باقي المقاطع. وهذا الشكل الذي لا غضاضة أن أسمِّيه (ملف سردي) جرَّبه حسام المقدم إضافة إلى قصة (شرفات بحجم الكف) في (أشكالي الهندسية) و(الحالم) و(سبعة نصوص لحكيم غير محترف) و(الضاحك)، يكون عنوانها هو مبرر الجمع بينها على نحو أساسي ثم يتبين الرابط الخفي بينها سواء كان على مستوى البنية أو المدلول أو كليهما، وأحيانا لا نجد هذا الرابط –اللهم إلا ما تُوهم به فردانية الذات الساردة- كما في (سبعة نصوص لحكيم غير محترف) التي قد لا نقع على فارق ملموس إذا نشرت تحت عنوان (قصص قصيرة جدا).
قصص (أبجدية أخرى للماء) تمتعك قراءتها، لأنها لا تدعك تقرؤها بسلام! ولا أجمل من أن نختم بجزء مما كتبه عنها أحد كبار القصة القصيرة القاص محمد المخزنجي، في كلمته الملحقة بالكتاب: “… حسام المقدم، الذي أرى أنه أحد الكُتاب النادرين الذين يقرؤون أكثر بكثير مما يكتبون، وينتقي فيما يقرأ الأجمل والأندر، فكأنه يضع نصب بصيرته الإبداعية مُثلا عليا يتواضع أمامها، ويطمح إلى مقامها، وأرجح أنه واصل إلى ذلك بهذه الثنائية من التواضع والطموح، وأراه قد حقق بالفعل واحدا من أهم قواعد البناء فيها، وهو معمار النَّص….”.