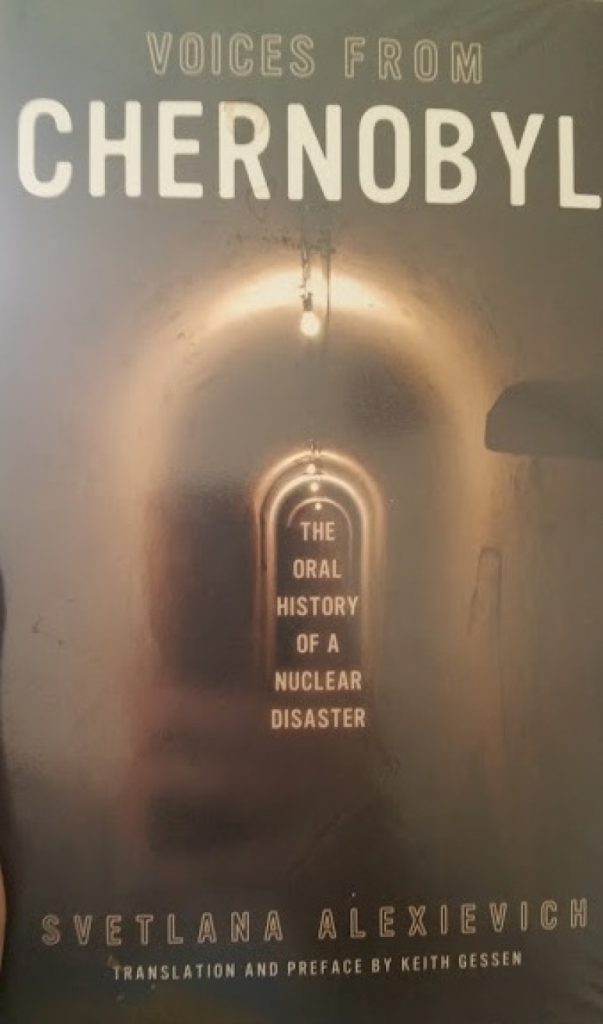في التاسع والعشرين من ابريل سنة 1986، سجلت الآلات مستويات عالية من الإشعاع في بولندا وألمانيا والنمسا ورومانيا. وفي الثلاثين من ابريل، في سويسرا وشمالي إيطاليا، وفي الأول من مايو والثاني منه، في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وبريطانيا العظمى، وشمالي اليونان. وفي الثالث من مايو، في إسرائيل، والكويت وتركيا …. ارتحلت الجزيئات الغازية مع الرياح في شتى أرجاء الكوكب: فسُجِّلت في اليابان في الثاني من مايو، وفي الخامس منه في الهند، وفي الخامس والسادس في الولايات المتحدة وكندا.
“توابع حادثة نوبل في بيلاروسيا”.. كلية ساخرو الدولية للإشعاع، مينسك، 1992
***
لايودميلا إجناتينكو.. زوجة الإطفائي الفقيد فاسيلي إجناتينكو
كنا حديثي الزواج. لا نزال نسير في الشوارع متشابكي الأيدي، حتى لو كنا في الطريق إلى المتجر لا أكثر. أقول له “أحبك”، ولكنني لم أكن أعرف وقتها إلى أي مدى كنت أحبه. لم تكن لديّ فكرة…. كنا نعيش في عنبر بمحطة الإطفاء التي نعمل فيها. وكنت دائما على دراية بما يجري، بمكانه، وبما يفعله.
وذات ليلة سمعت ضوضاء. نظرت من الشباك. رآني. “أغلقي الشباك وعودي إلى النوم. هناك حريق في المفاعل. سأرجع بسرعة”.
لم أر الانفجار نفسه. فقط ألسنة اللهب. كل شيء كان مشعًّا. السماء كلها. لهب طويل. ودخان. والحرارة كانت فظيعة. ولم يرجع.
ذهبوا على الحال التي كانوا عليها، في قمصانهم. لم يخبرهم أحد. تلقوا اتصالا بأن هناك حريقا، لا أكثر.
السابعة صباحا. في السابعة قيل لي إنه في المستشفى. جريت إلى هناك، ولكن الشرطة كانت قد طوَّقت المستشفى ولم تعد تسمح لأحد بالعبور مهما يكن. ليس سوى عربات الإسعاف. صاح رجال الشرطة “عربات الإسعاف مشعة، ابقوا بعيدا!”. بدأت أبحث عن صديقة، طبيبة تعمل في المستشفى. جذبت معطفها الأبيض حينما خرجت من عربة إسعاف. “أدخليني”. “لا أستطيع. حالته سيئة. كلهم كذلك”. تشبَّثت فيها. “أراه فقط!” قالت “حاضر. تعالي معي. خمس عشرة دقيقة فقط، أو عشرون”.
رأيته. كان متورما تماما، منتفخا. لا تكاد تميز الواحدة عينيه.
قالت صديقتي “هو بحاجة إلى لبن. إلى الكثير من اللبن. ينبغي أن يشرب كل واحد فيهم ثلاثة لترات من اللبن”.
“لكنه لا يحب اللبن”.
“سيشربه الآن”.
كثير من أطباء المستشفى وممرضاته، لا سيما كبار السن، سيمرضون هم أنفسهم ويموتون. ولكننا لم نكن نعرف ذلك وقتها.
في العاشرة، مات المصوِّر شيشينوك. وكان الأول.
قلت لزوجي “فاسينكا، ماذا أفعل؟”. “اذهبي من هنا. اذهبي. أنت تحملين طفلنا بداخلك”. كنت حبلى. لكن كيف كان لي أن أتركه. كان يقول لي “اذهبي! ارحلي من هنا. أنقذي الجنين”. “لا بد أن أحضر لك اللبن أولا، ثم نقرر ما نفعل”. جاءت صديقتي تانيا كيبينوك وهي تجري، وكان زوجها في الغرفة نفسها. كان والدها معها، وقد جاء بسيارة. ركبناها وانطلقنا إلى أقرب قرية. اشترينا مجموعة من زجاجات اللبن ذات الثلاثة لترات، ربما ست زجاجات، لتكفي الجميع. ولكنهم راحوا يتقيأون اللبن بعنف.
مضوا يفقدون الوعي، فعُلِّقت لهم المحاليل. وظلّ الأطباء يقولون إن الغاز أصابهم بالتسمم، لسبب أو لآخر. لم ينطق أحد كلمة عن الإشعاع.
لم أستطع دخول المستشفى في ذلك المساء. كان هناك بحر من الناس. وقفت تحت شباكه. أطلّ وصاح بشيء. كانت لحظة يأس مطبق. سمعه شخص من الواقفين في الزحام ـ كانوا سينقلونهم إلى موسكو في الليل. تجمّعت الزوجات كلهن معا. قررنا أن نذهب معهم. “فلنذهب مع أزواجنا! ليس لكم الحق”. لكمناهم وخمشنا وجوههم. الجنود، طوال الوقت كان هناك جنود، وكانوا يدفعوننا إلى الوراء. ثم خرج الطبيب وقال إنهم سينقلونهم بالطائرة إلى موسكو، وإن علينا أن نحضر لهم ثيابا. فالثياب التي كانوا يرتدونها وهم في المحطة احترقت. كانت الحافلات قد توقفت عن الحركة فمضينا نجري في المدينة. ورجعنا جاريات والأكياس في أيدينا، لكن الطائرة كانت قد أقلعت. خدعونا. لكي لا نبقى هناك صارخات باكيات.
في وقت لاحق من ذلك اليوم بدأت أتقيأ. كنت حبلى في الشهر السادس، ولكن كان لا بد أن أذهب إلى موسكو.
في موسكو سألنا أول شرطي رأيناه، أين وضعوا رجال المطافئ من تشيرنوبل؟ وقال لنا، وتلك كانت مفاجأة، فقد كان الجميع يدفعوننا في فزع إلى التفكير بأن الأمر فائق السرية. “المستشفى رقم 6. في محطة شوكينسكايا”.
كان مستشفى خاصا، للإشعاع، ولا يمكن الدخول بغير تصريح. منحت بعض النقود للمرأة الواقفة بالباب، فقالت “اذهبي مباشرة”. ثم كان عليّ أن أسأل شخصا آخر، بل أتوسل إليه. وأخيرا في مكتب كبيرة أطباء الإشعاع، أنجيلينا فاسيلينيفا جاسكوفا. سألتني على الفور “هل لديك أبناء؟”
ما الذي كان يمكن أن أقوله؟ كنت أرى بوضوح أنني بحاجة إلى إخفاء حملي. ما كانوا ليسمحوا لي برؤيته. من حظي أنني نحيلة، وأن حملي لا يظهر عليّ.
أقول “نعم”.
“كم عددهم؟”
أفكر، ينبغي أن أقول لها اثنين. لو واحد فقط، لن تسمح لي بالدخول.
“ولد وبنت”
“لست بحاجة إذن إلى إنجاب المزيد. ليكن، اسمعي: جهازه العصبي المركزي منهار تماما، جمجمته منهارة تماما”.
أفكر، ليكن، سيكون مهزوزا بعض الشيء.
“واسمعي: إذا بدأت في البكاء، سأطردك فورا. ولا أحضان ولا قبلات. بل ولا تقتربي منه. وعندك ساعة زمن”.
ولكنني كنت أعرف بالفعل أنني لن أتركه. ولو رحلت، فسيكون معه. وأقسمت لنفسي على ذلك!
أدخل. جالسون على الأسرَّة، يلعبون الورق ضاحكين. صاحوا “فاسيا”. يتلفت حوله: “أوه، حسن، انتهينا الآن! عثرت عليّ حتى في هذا المكان”. يبدو في منتهى الظرف، يرتدي بجامة من مقاس 48، ومقاسه 52. الكمَّان قصيران، والبنطلون قصير. لكن وجهه أكثر تورما. كانوا قد أعطوهم بعض السوائل.
أقول “إلى أين أنت ذاهب؟” يريد أن يحتضنني. لا تسمح له الطبيبة. تقول “اجلس، اجلس، لا أحضان هنا”.
تحوَّلنا بطريقة ما إلى نكتة. ثم جاء الجميع، من بقية الغرف أيضا، كل الذين جاءوا من مدينة بريبايات، كانوا ثمانية وعشرين على الطائرة.
أردت أن أنفرد به، ولو لدقيقة. شعر الرجال بذلك، فوجد كلٌّ منهم عذرا ما، وخرجوا جميعا إلى الصالة. احتضنته وقبّلته. ابتعد عني.
“لا تجلسي بالقرب مني. اجلسي على مقعد”.
قلت وأنا أشيح بيدي “دعك من هذه السخافة”.
في اليوم التالي حينما حضرت، كانوا نائمين فرادى، كل في غرفة. ممنوعون من الخروج إلى الصالة، من الكلام مع بعضهم البعض. كانوا ينقرون على الجدران بأصابعهم. بوم بم، بوم بم. أوضح الأطباء أن رد الفعل على الإشعاع يختلف من جسد إلى آخر، وأن ما يحتمله شخص، لا يحتمله غيره. كانوا يقيسون الإشعاع حتى في الجدران المحيطة بهم. عن اليمين، واليسار، بل والأرضية من تحتهم. نقلوا جميع المرضى من الطابقين الأعلى والأدنى. لم يبق من أحد في المكان.
بدأ يتغير ـ كنت في كل يوم أقابل شخصا جديدا تماما. بدأت الاحتراقات تظهر على السطح. في فمه، وفي لسانه، وفي خدّيه ـ في البداية كانت هناك لسعات صغيرة، ثم بدأت تكبر. بدأت تظهر في طبقات ـ مثل نسيج أبيض … لون وجهه … جسمه … أزرق … أحمر …. رمادي في بني. ومع ذلك هو هو زوجي! مستحيل أن أصفه. مستحيل أن تستوعب الكتابة. مستحيل حتى تجاوز الأمر كله. الشيء الوحيد الذي أنقذني هو أن كل شيء كان يحدث بسرعة خاطفة، لم يكن هناك أي وقت للتفكير، لم يكن هناك من وقت للبكاء.
أربعة عشر يوما. في أربعة عشر يوما يموت الشخص.
كان اليوم التاسع. وكان يقول لي دائما “أنت لا تعرفين كم هي جميلة موسكو هذه! بالذات في يوم النصر [التاسع من مايو V-Day]، عندما يطلقون الألعاب النارية. أريدك أن تري هذا”.
كنت جالسة بجواره في الغرفة، فتح عينيه.
“نحن بالليل أم بالنهار؟”
“الساعة التاسعة ليلا”.
“افتحي الشباك. سيطلقون الألعاب النارية”.
فتحت الشباك. كنا في الطابق الثامن، والمدينة كلها تحتنا. وكانت هناك باقة من الألعاب النارية تتفجر في الهواء.
قلت “انظر إلى هذا”.
“قلت لك سأريك موسكو. وقلت لك إنني دائما سوف أهديك زهورا في الإجازات…”
نظرت إليه، كان يتناول ثلاث قرنفلات من تحت المخدّة. كان قد أعطى الممرضة نقودا فاشترتها له.
جريت إليه وقبّلته.
“حبيبي! حبيبي الوحيد!”
بدأ يغمغم “ماذا قال لك الأطباء؟ لا أحضان. لا قبل”.
استاء للغاية لأنني رفضت أن أتركه ولو لثانية. كان ينادي طول الوقت “لوسيا، أين أنت؟ لوسينكا”. كان ينادي وينادي. في الغرف الأخرى، التي كان فيها شبابنا، كان الجنود هم الذين يقومون بالرعاية بعد أن رفض التمرجية العمل، مطالبين بثياب واقية من الأشعة. الجنود هم الذين كانوا يحملون الأواني الصحية. ويمسحون الأرضيات، ويغيّرون الملاءات. هم الذين كانوا يفعلون كل شيء. من أين جاؤوا بأولئك الجنود؟ لم نسأل. لكن هو، هو، كل يوم كنت أسمع: مات. مات. تيشورا مات. تيتينوك مات. مات.
كان يتبرَّز ما بين خمس وعشرين مرة وثلاثين في اليوم الواحد. بدم ومخاط. بدأت بشرته تتشقق في الذراعين والساقين. صارت تملؤه الدمامل. وحينما كان يتقلب برأسه، كنت أرى كتلة شعر على المخدة. حاولت أن أمزح: “هكذا أحسن، لن تحتاج إلى مشط”. وسرعان ما حلقوا لهم شعرهم كله. أنا التي حلقت له بنفسي. كنت أريد أن أفعل من أجله كل شيء بنفسي. ولو كان بوسعي جسديا، لكنت بقيت معه أربعا وعشرين ساعة في اليوم. ما كنت لأضيِّع ثانية.
[صمت طويل]
هناك شذرة من حوار. أتذكرها. يقول أحدهم: “لا بد أن تفهمي: هذا لم يعد زوجك الذي تعرفين، ليس شخصا محبوبا، بل مادة مشعة ذات قدرة تسميمية قوية. أنت لست انتحارية. أدركي نفسك”. وكنت كمن فقدت عقلها: “لكنني أحبه. أحبه”. هو نائم. وأنا أهمس “أنا أحبك” وأمشي في فناء المستشفى “أحبك”. أحمل أوعيته الصحية، “أحبك”.
وذات ليلة، كان الهدوء يعمُّ كل شيء. كنا بمفردنا. نظر إلي بغاية التمهل، وقال فجأة:
“أريد أن أرى طفلنا بشدة. كيف حاله؟”
“بماذا سنسميه؟”
“ستقررين هذا بنفسك”
“ولماذا أنا، ونحن اثنان؟”
“في هذه الحالة، إذا كان ولدا، فليكن اسمه فاسيا، أما لو كانت بنتا، فلنسمِّها نتاشا”.
كنت أشبه بعمياء. لم أشعر حتى بالخفقان أسفل قلبي. برغم أنني كنت في الشهر السادس. كنت أشعر أن حبيبي الصغير بداخلي، وأنه محروس هناك.
وبعدها ـ آخر شيء. أتذكره صورا بارقة، متشظية كلها. كنت جالسة على مقعد صغير بجواره طول الليل. في الثامنة قلت: “فاسينكا، سأخرج لأتمشى قليلا”. فتح عينيه وأغمضهما، سامحا لي بالذهاب. سرت فقط حتى الفندق، فصعدت إلى غرفتي، استلقيت على الأرض، لم أكن أستطيع أن أتمدّد على السرير، كان كل شيء يؤلمني بشدة، عندما بدأت عاملة خدمة الغرف تطرق الباب. “هيا! اجري إليه! إنه ينادي عليك كالمجنون”.
سارعت أتصل بالممرضة. “كيف حاله؟” “مات منذ خمس عشرة دقيقة”. “ماذا؟ لقد كنت هنا طول الليل. لم أغب غير ثلاث ساعات”. نزلت أجري. كان لا يزال في الغرفة لم ينقلوه منها بعد. لم أتركه بعدها مطلقا. رافقته حتى المقابر. برغم أن ما أتذكره ليس المقبرة، بل كيس من البلاستيك. ذلك الكيس.
قالوا لي في المشرحة، “هل تحبين أن تري ما سنلبسه؟” قلت نعم. ألبسوه زيه الرسمي، بقبعة الخدمة. لم يستطيعوا أن يلبسوه الحذاء وقد تورّمت قدماه. وكان عليهم أن يقطعوا الزي الرسمي أيضا، لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوه فيه. لم يكن هناك جسد كامل أصلا ليلبسوه. في اليومين الأخيرين له في المستشفى، كانت أجزاء من رئتيه وكبده تخرج من فمه. كان يبتلع أجزاء من أعضائه الداخلية. كنت ألف يدي بضمادة وأدخلها في فمه لأزيل كل تلك القطع. مستحيل الكلام عن هذا. مستحيلة الكتابة عنه. حتى تجاوزه مستحيل. لم يعثروا على حذاء واحد يناسب قدميه. دفنوه حافي القدمين.
جاء الجميع ـ والداه، ووالداي. اشتروا مناديل سوداء من موسكو. قابلتنا لجنة الطوارئ. وكرروا نفس الكلام للجميع، مستحيل أن نعطيكم جثامين أزواجكن وأبنائكم، فهي مشعة للغاية وسيجري دفنها في مقبرة موسكو في يوم معيّن. في توابيت من الزنك المختوم، وأسفل بلاطات من الأسمنت. وعليكم أن توقعوا هذه الوثيقة.
ومن أرادوا ساخطين الرجوع بالأكفان إلى مدنهم، كان يقال لهم إن الموتى الآن، كما تعرفون، أبطال، وإنهم ما عادوا يخصّون عائلاتهم. كانوا أبطال الدولة. كانوا يخصون الدولة.
وسارعوا بشراء تذاكر طيران تعيدنا إلى مدينتنا. في اليوم التالي مباشرة. وفي البيت رحت في النوم. ما كدت أدخل البيت حتى وقعت على سريري. نمت ثلاثة أيام. جاءت عربة إسعاف ولكن الطبيب قال “لا. ستصحو. ليس هذا غير نوم رهيب”.
كنت في الثالثة والعشرين. وبعد شهرين رجعت إلى موسكو. وانطلقت من محطة القطار مباشرة إلى المقابر. إليه. وفي المقابر بدأ يأتيني المخاض. ما كدت أبدأ الكلام إليه حتى حدث ذلك ـ واستدعوا عربة الإسعاف. قبل أسبوعين من الموعد المنتظر.
أتوا بها إليّ ـ فتاة. قلت “نتاشينكا. أبوك سمَّاك نتاشينكا”. بدت صحتها بخير. ذراعان، ساقان. ولكنها مصابة بتليف الكبد. أظهر كبدها ثمانية وعشرين من وحدات قياس الأشعة. وعيب خلقي في القلب. بعد أربع ساعات قالوا لي إنها ماتت. ومرة أخرى: “لن نعطيك إياها”. “ماذا تقصدون بأنكم لن تعطوني إياها؟ أنا التي أعطيتها لكم”.
[تسكت لوقت طويل]
في كييف أعطوني شقة. كانت عمارة كبيرة وضعوا فيها كل الناس من المحطة الذرية. شقة ضخمة، بغرفتين، كالتي طالما حلمت بها أنا وفاسيا.
[تقف، تتجه إلى الشباك]
يوجد الكثير منا هنا. شارع بأكمله. واسمه: تشيرنوبلسكايا. هؤلاء الناس كانوا يعملون في المحطة طوال أعمارهم. ولا يزال الكثيرون منهم يذهبون إلى هناك بين الحين والآخر، وهكذا يعملون هناك الآن، لم يعد أحد يعيش هناك. عندهم أمراض سيئة، كلهم مرضى، ولكنهم لم يتركوا وظائفهم، يخافون حتى من فكرة إغلاق المفاعل. وأي عمل لمثلهم إلا في المفاعل؟ وغالبا ما يموتون. في دقيقة. فجأة يقعون، يكون الواحد منهم ماشيا، فيقع، ويروح في النوم. كان ذاهبا بباقة ورد إلى ممرضته فتوقف قلبه. يموتون، ولكن لا أحد يسألنا. لا أحد يسأل عما مررنا به. عما رأيناه. لا أحد يريد أن يسمع شيئا عن الموت. عما ترتعد منه فرائصهم.
ولكنني كنت أحكي لك عن الحب. عن حبي …
*
كورس الذين عادوا
أوه، لا أريد حتى أن أتذكر ذلك. كان مريعا. طاردونا، الجنود طاردونا. الآلة العسكرية الهائلة دارت. آلة كل المناطق. رجل كبير السن ـ كان بالفعل مطروحا على الأرض. يحتضر. إلى أين هو ذاهب؟ صاح “فقط سأقف، وأسير إلى المقابر. سأفعلها بنفسي”.
*
كنا راحلين ـ أخذت بعض التراب من مقبرة أمي، وضعته في كيس صغير. جثوت على ركبتيّ: “سامحيني أني راحل عنك”. ذهبت إلى هناك بالليل ولم أكن خائفا. كان الناس يكتبون أسماءهم على المنازل. وعلى الخشب. وعلى الأسيجة. وعلى الأسفلت.
*
الليالي بالغة الطول في الشتاء. نجلس، أحيانا، ونحصي: من ماتوا؟
*
رقد رجلي في السرير شهرين. لم يقل أي شيء، لم يجبني بشيء. كان مجنونا. كنت أتجوّل في الفناء، وأرجع: “كيف حالك يا رجل يا عجوز؟”. عندما يحتضر شخص ما، لا يكون بوسعك البكاء. ستقاطعين احتضاره، سيكون عليه أن يواصل النضال. لم أبك. طلبت شيئا واحدا فقط: “سلِّم على ابتننا وعلى أمي العزيزة”. كنت أدعو أن نذهب معا. هناك من الآلهة من يفعلون ذلك، لكن الإله أبى أن أموت. أنا حية …
*
مسحت البيت، وغسلت الموقد. ينبغي أن تتركي بعض الخبز والملح على المائدة، وطبقا صغيرا وثلاث ملاعق. ملاعق بعدد أرواح البيت. فنرجع مرة أخرى.
*
كانت للدجاجات أعراف سودا، لا حمراء، بسبب الإشعاع. ولم يكن بوسعك صنع الجبن. عشنا شهرا بغير الجبن أو الجبن الريفي. كان اللبن لا يتخثر، بل يتحول إلى مسحوق. مسحوق أبيض. بسبب الإشعاع.
*
أصاب الإشعاع حديقتي. الحديقة كلها ابيضَّت، بقدر ما يمكن أن يكون عليه البياض، كما لو كان يكسوها شيء ما. قطع من شيء ما. ظننت أن أحدهم قد يكون أتى بها من الغابة.
*
لم نكن نرغب في الرحيل. كان الرجال جميعا مخمورين، مضوا يرمون أنفسهم أسفل السيارات. ومضى كبار قادة الحزب يمرون بالبيوت متوسلين إلى الناس أن يرحلوا. والأوامر: “لا تأخذوا معكم أغراضكم”.
*
لن يخدعنا أحد بعد هذا، لن ننتقل إلى أي مكان. لا متاجر، لا مستشفى. لا كهرباء. نجلس على مقربة من مصباح كيروسين في نور القمر. ويروق لنا هذا! فنحن في الوطن.
*
كانت الشرطة تصيح. يجيئون في سيارات، ونهرب إلى الغابة. كما لو كان يطاردنا الألمان. وفي إحدى المرات جاء معهم وكيل النيابة، ظل ينفخ ويغمغم، كانوا يوشكون أن يطبقوا علينا المادة العاشرة. قلت “فليمنحوني سنة في السجن. سأقضيها وأرجع إلى هنا”. هم وظيفتهم الصياح. ونحن وظيفتنا الهدوء. عندي وسام. أفضل حصّاد في مزارع الكولخوزات. ويأتي هذا ليخيفني بالمادة العاشرة.
*
قال صحفي إننا لم نرجع فقط إلى الوطن، لقد رجعنا مائة عام. نستعين بمطرقة في الحصاد، وبمنجل على القص. نضرب القمح مباشرة على الأسفلت.
*
أطفأنا المذياع. لا نعرف الأخبار، لكن الحياة وديعة. لا نغضب. يأتي الناس، يحكون لنا القصص ـ هناك حرب في كل مكان. وما إلى ذلك، الاشتراكية انتهت ونحن نعيش الآن في ظل الرأسمالية. والقيصر عائد. هل هذا صحيح؟
*
الجميع عائدون، راجعون إلى الحصاد. هذا هو الأمر. كلُّ يريد أن يسترد نصيبه. الشرطة معها قوائم بالمسموح لهم بالرجوع، ولكن الأولاد فيما دون الثمانية عشر عاما لا يمكنهم الرجوع. سيرجع الناس وسيكونون في غاية الفرحة بالوقوف بجوار بيوتهم. في فنائهم على مقربة من شجرة التفاح. في البداية سوف يبكون في المقابر، ثم يذهبون من بعد إلى أفنيتهم. وهنالك أيضا يبكون، ويدعون. يتركون شموعا. يضعونها على أسيجتهم. أو على الأسيجة الصغيرة في المقابر. بل إنهم في بعض الأحيان سوف يتركون إكليلا على بيت. منشفة بيضاء على بوابة. عجوز تقرأ صحيفة: “أيها الأخوة والأخوات، تحلّوا بالصبر”.
*
يصطحب الناس بيضا، ولفائف، وأي شيء آخر، إلى المقابر. الجميع جلوس إلى أسرهم. ينادون عليهم “أختي، أنا جئت لأراك. تعالي نتناول الغداء”. أو “أمي، أمي العزيزة. أبي، أبي العزيز”. ينادون الأرواح أن تنزل عليهم من السماء. الذين مات لهم ناس في هذا العام يبكون، ومن مات ناسهم قبل ذلك لا يبكون. يتكلمون، يتذكرون. الجميع يدعون. ومن لا يعرفون كيف يدعون، هم أيضا يدعون”.
*
لدينا هنا كل شيء ـ قبور. قبور في كل مكان. الشاحنات الغبية تعمل، والبلدوزرات. البيوت تتداعى. حفارو القبور يكدحون. دفنوا المدرسة، والمقرَّات، والحمامات. هو هو نفس العالم، لكن الناس تغيروا. شيء واحد لا أعرفه: هل للناس أرواح؟ من أي نوع؟ وكيف يتلاءمون كلهم مع العالم التالي؟ جدي مات لمدة يومين. كنت أختبئ وراء الموقد وأنتظر: كيف تخرج من جسمه وتطير؟ ذهبت أحلب البقرة، ورجعت فناديت عليه، لكنه كان مطروحا هناك مفتوح العينين. كانت روحه قد طارت. أم لم يكن شيء قد حدث؟ وكيف إذن سوف نلتقي من جديد؟
ـــــــــــــــــــــــــ
جزء من نص نشر في باريس رفيو عدد 172 شتاء 2004 مترجما من الروسية إلى الإنجليزية بقلم كيث جيسين.
ـــــــــــــــــــــــ
نقلا عن مدونة: قراءات أحمد شافعى