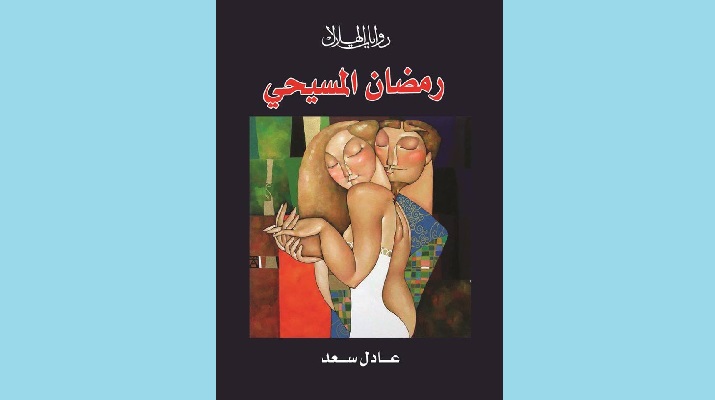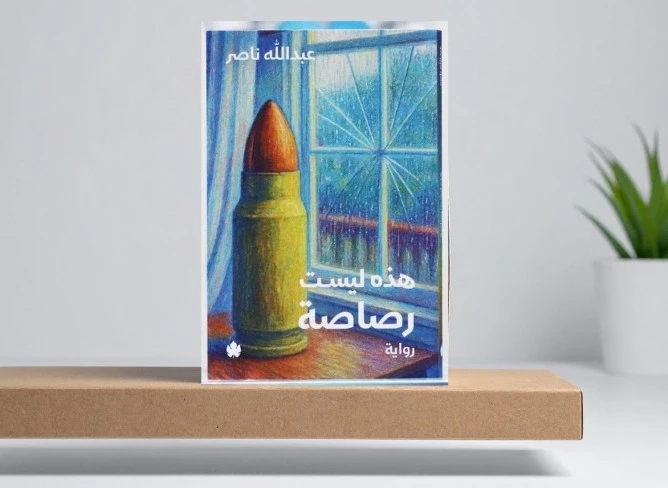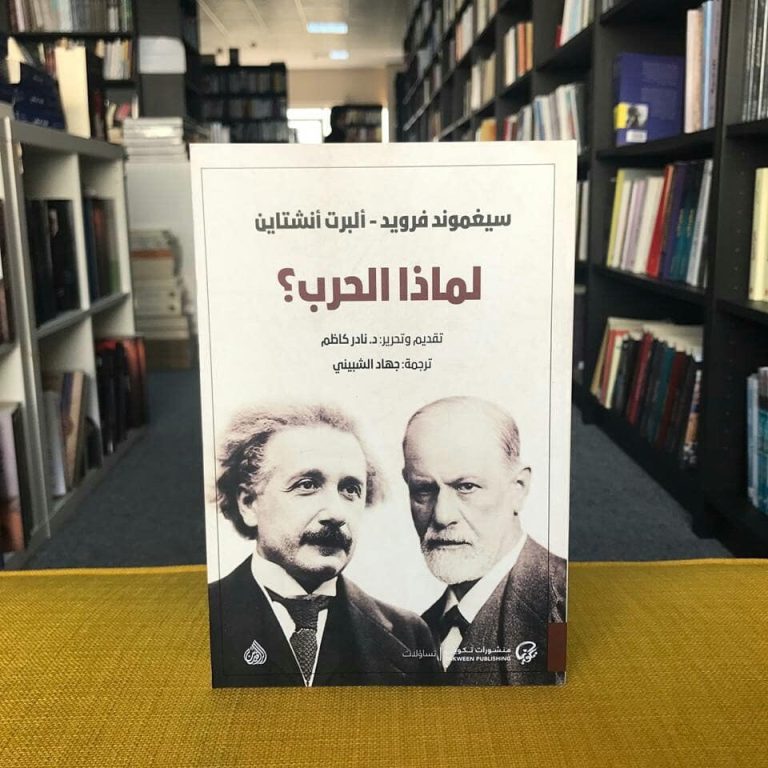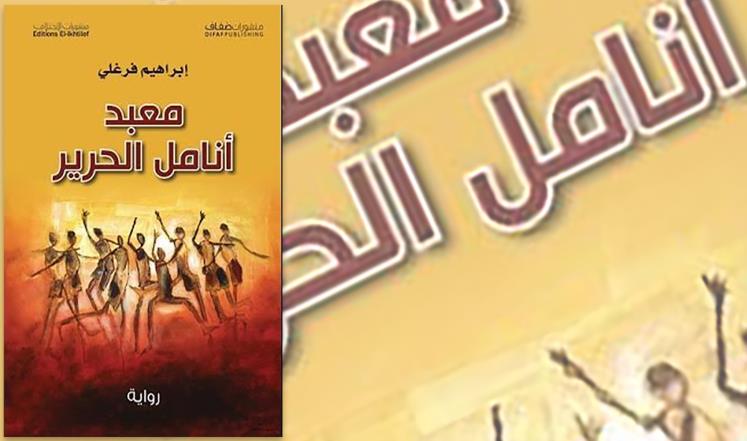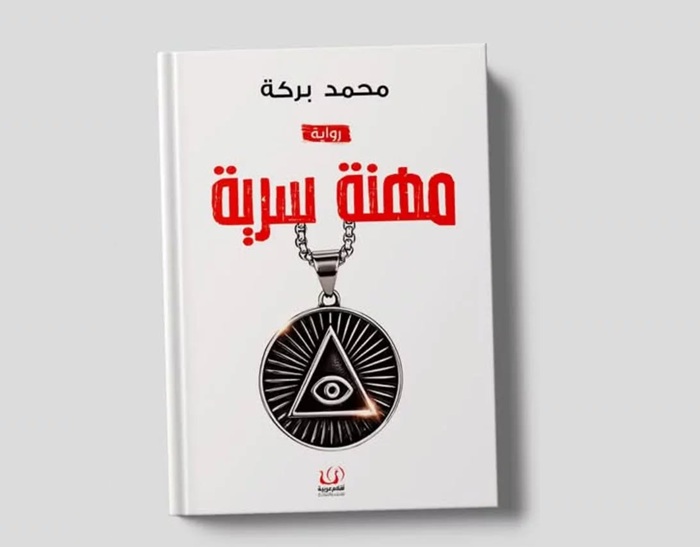شوقى عبد الحميد يحيى
بعد بعد رحلة ممتدة بين أشكال الإبداع المتنوعة، وعديد الإصدارات، يرسم “السيد نجم”- فى مجموعته الأحدث “دوائر من حرير”[1]، دائرتان كبيرتان تضمان فى داخلهما مجموعة من الوحدات السردية، التى تتناول جانبا من حياة الإنسان بطول وجوده على الأرض. تشمل مراحل الحياة، أو التجارب الكبرى فيها، مقسمة إلى وحدات سردية، تُشكل فى مجموعها رؤية للمرحلة.
تناولت الدائرة الأولى منها “أحوال”، والتى تشمل “الحال” التى عاشها الكاتب، أو شاهدها، بما يمكن إعتباره تناول الحياة (من الخارج). خاصة تلك التى عايشها الكاتب فى المراحل العمرية، أو بمعنى أدق، مراحل فترة العمل، أو حتى تلك التى تتعلق بالطفولة، وأحلامها، حين كان –الطفل- يرى كثيرا دون أن يدرك ما وراء ما يشاهده. إلا أن ذلك لا يعنى أنها تسجيل لتلك (الحالات)، ولكنه يعرضها مصبوغة برؤية ذاتية، تعنى أنه مشاهد مدرك لكنهها، وأبعادها. كما مارس فيها التجريب القصصى، الذى يدمج بين الواقع المعيش، ورؤية السارد “العليم”، الذى يستخرج بواطن الأشياء. مثلما نجد فى أولى هذه الوحدة “ورطة ضمير المخاطب” بما تتطلبه من يقظة، وحرص.
بينما مثلت الدائرة الثانية، ذلك الشعور الذى ينتاب المرء عندما يشعر بأنه وصل محطة يمكن معها أن يتأمل ما فات. فجاءت تسميتها “فى رحاب الغربة والانزواء”. والتى تعتنى بتلك المشاعر الداخلية، أو حديث الذات للذات، حينما تُطبق الوحدة، والبرودة على أعماق ذلك المنتظر للنهاية، أو خبرة إنسان بلغ من العمر ما يُمَكنُه من التأمل والتدبر. تشكلت –أيضا- من مجموعة من الوحدات (القصصية) تمثل كل وحدة منها قصة قصيرة، غير أنه يجمعها وحدة واحدة، وكأننا أمام متوالية قصصية.
فبعد كثير الكتابة عن تجربة الحرب ، والمقاومة، ينتقل السيد نجم إلى روح أدب المقاومة، فالحرب والمقاومة، يصهران الإنسان فى الصراع بينهما، ذلك الذى له ظروفه الاجتماعية، والاقتصادية والنفسية، والتى يجمعها وحدة واحدة، هى الظروف السياسية. تلك التى ينظر إليها السيد نجم فى أولى قصص المجموعة، وأولى قصص الدائرة الأولى ” أحوال” وهى قصة “ورطة ضمير المخاطب”، والتى يمكن أن نسميها “باب الدخول” –الخول إلى المجموعة، والدخول إلى الحياة- كما سنوضحه فيما بعد-، من خلال التجربة الشخصية، التى عاشت وتعايشت مع أحداث الوطن، فى الحرب وفى السلم، حين وجد التناقض بينها، وكأنهما جزيرتان منعزلتان، فتخيل نفسه يمارس الشئ الذى يحبه، كتابة القصة، أى أننا أمام قصة داخل القصة، عاشهما السارد فى ذات الوقت. حيث يبحث عن الطريقة التى بها يستطيع قول ما يريد، متلاشيا تلك الموانع، أو الخطوط الحمراء-وفق ما تقول القصة- ويلقى باللائمة على (الحكومة) فى الكثير مما يعانيه الإنسان فى هذا البلد، مثل {فالذى لا يعرفه البعض أننى لم أتزوج حتى تارخه لقصر ذات اليد، بينما أسعار الشقق فى حاجة إلى يد طويلة}. وكأنه يرمى بالإشارة العابرة، وكأنه سائر فى الطريق ودون أن يلفت النظر قذف طوبة تجاه زجاج سيارة فكسرها، بينما هو يسير وكأنه لم يفعل شيئا، حيث يرمى إلى الاتهام للحكومة المتقاعسة عن مواجهة الخارجين عن القانون –أصحاب اليد الطويلة، متخفيا فى تلك الحيلة التى صنعها، كتابة القصة، ليهرب من ذلك المصير الذى يواجهه، كل من يقول للغولة (عينك حمرا). فنقرأ {بالقصة لن يتهمنى أحدهم بأننى من قوى المعارضة المشاغبين، عندما أُجَمِلْ فى مساكن الإيواء التى يقطنها سكان ضواحى القاهرة والمدن الكبرى، فأجعل من السرقات بالإكراه التى زادت ….}. {أمْيَزُ ما تتميز به القصة أنها تحمينى من سطوة جهات خفية، تعلم أننى من هؤلاء المتابعين الفاهمين ولكننى من الخبثاء، فلا أفصح عما أريد، ولم أعبر الخطوط الحمراء….}. ثم ينتقل تدريجيا إلى ميدان الحرب، وكأنها العبور من الجبهة الداخلية إلى الجبهة الخارجية فنقرأ {فيما سبق كنت أستخدم –غالبا- ضمير المتكلم، حتى ظن النقاد قبل الأصدقاء أننى أكتب عما حدث لى شخصيا، أقسم أننى لم أر جنديا إسرائيليا واحدا طوال فترة الخمس سنوات التى قضيتها فى السويس أثناء المعارك وما قبلها.. لا يصدقنى أحد … يبدو أن الناس تريد الباطل.. سوف أستخدم ضمير المخاطب، لا أريد أن يخلقوا صورة كاذبة عنى} ثم يلقى ضوءا على تجربة الحرب {تجربة الحرب فى القصة التى أريدها، لا تصرخ فرحا، بل تندم على سوء الفهم والغباوة التى يمكن أن تمتلك جماعة أو حتى دولة بأكملها، كما تعنى الموت فى مقابل الحياة، إلا إذا كان ضروريا ولابد من الموت، بديلا عن العيش فى هوان أو مذلة سرقة الأرض والشرف} . ثم يكشف عن تلك الحالات التى مات فيها الجندى، كى يعيش أؤلئك الذين على الجبهة الداخلية، مثل الدفعة الصعيدى “عواد” الذى ألقى بنفسه أمام فوهة المزغل أثناء اقتحام خط بارليف أثناء معارك 73. والجندى “سلامة” الذى رآه السارد فى ميدان التحرير وهو يعرج و(قد نِلتُ الوظائف العليا فى الدولة، بينما لم ينجح أحدهم من نزع الرصاصات من قدمه. وعودة السارد لكتابة القصة التى درج على فتح التليفزيون أثناء كتابتها، وقد اعتاد غلق الصوت حتى لا يُشوش عليه أفكاره {يكفينى جدا أن أراها ترقص.. ولم أر راقصة.. رأيت بركة دماء، وبيت يتهدم، وطفل معلق بشجرة، يبكى على جذعها وهو يتابع البلدوزر يذبح لوحة الشطرنج وكرته الكاوتش وكراسته.. .. هل ما رأيت هى العراق أم رفح فلسطين أم “جنين” سوريا؟ .. نسيت موضوع كتابة القصة.. لعنت قصتى وكل قصص العالم والقاصين، وكل الضمائر}. حيث تتسع الرؤيا لضمار الحروب فى كل البلاد العربية. وليتحول استخدام (الضمائر) فى الكتابة غير ذى أهمية أمام فاقدى الضمائر، وأمام مآسى الحرب التى لم يشعر بها الراقصون والراقصات على شاشات التليفزيون.
ثم ينتقل الكاتب بعد قصته الأولى، التى يلقى باللوم فيها على الحياة والحرب، إلى تأمل مسيرة الإنسان على الأرض، فيصنع متتالية قصصة، تتناول مسيرته فيها، وعليها.
فيبدأها بعالم الطفولة فى ستة نصوص، يبدأها بالبدايات الأولى.. الطفولة.
يتأمل حال الطفل فى الدائرة الأولى “فى رحاب الولد”، فيجده جسد لا ينطق، وذراعان عاجزان(لمخمور). يتبول على نفسه كل صباح، ولا يخاف إلا من لذة يفقدها. ويتأمل الأم تمسك بيده – فى وحدة أخرى-، لا يشغله غير اللعب، والأم تنظر –بعد عبور الجسر- أنه كان طويلا وكأنه عبور الحياة ذاتها.. وتختفى الأم ، ويختفى لعب الطفل الذى لم يعد يلعب، ولم تلهه نشوة عبور الجسر الذى تحول إلى عبور رحلة الحياة. ثم يتناول أحلام الطفولة- فى وحدة أخرى- متمثلة فى حلم بناء هرم من الرمال، غير أن أمواج البحر تهدده، كلما حاول الحفاظ عليه، فبكى من العجز، وعندما حكى للأم .. كادت تبكى، ولم يعرف سر بكائها إلا عندما أصبح له أحفاد، يبنون أهراما من رمال شاطئ البحر. وكأنها كادت تبكى على أحلام الطفولة التى تتبخر –دوما- أمام تيارات الزمن. وفى وحدة أخرى، يشب الطفل عن الطوق، يبحت عن الحب، فيجده بعيدا، فقد تسرب كل شىء. ليصبح {أنا وهى وطن للجراح}. لتتم رحلة الحياة المليئة بضياع الحلم، ولا يترسب فى النهاية غير الجراح، الملازمة لذلك الطفل بعد الكبَر.
وفى متوالية جديدة تدور “فى رحاب الجد”. نقرأ “صورة للجد، الذى فرض صورته بالعسكرية على كل أفراد العائلة{كل ما حرص عليه جدى، أن يعتنوا بصورته وهو المقاتل القديم}. غير أن الأهل بدأوا يتململون من الصورة، فيقرر الجد جمع الصور من أفراد العائلة، ويكتفى بصورة وحيدة فى حجرة نومه. التى بدأ ينعزل فيها، إلى أن تضاءل، جسدا، حتى أصبح فى حجم الفأر، ثم فى حجم النملة، غير أن صوته المجلجل، لم يزل كما هو، فيطلب من أفراد العائلة أن يضعوه فى برواز الصورة. لتفصح رؤية القصة عن التلاشى الجسدى، إلا أن ذكرى ما كَانَهُ الرجل، فى الماضى، وكأنها حياة الإنسان، يتلاشى فيه الجسد الحاضر بين الآخرين، ثم لا يتبقى منه غير الذكرى. فهى إذن لوحات تصويرية، لمراحل عمر الإنسان، بين الولد، والجد، والحيوان، والحرب، والسرح، والفضاء الرقمى. أى أنها شلمت الراحل التى يكون فيها الإنسان .. فاعلا.
وقد لانبتعد كثيرا عن تلك الأجواء التى سرت فى عروق المجموعة، فسنجد أن الهم الإنسانى، وما يعانيه الإنسان عبر مراحل حياته. فإذا انتقلنا إلى آخر قصص المجموعة التى عنونها الكاتب ب”نص أخير”، والتى يقف بها على ما يمكن أن نسميه “باب الخروج”، والذى لا يعنى به النص الأخير فى المجموعة، وإنما هو “النص الأخير” فى رحلة الحياة التى تؤرق الكاتب والتى طالت، وحملت الكثير من الذكريات. غير أن -الكاتب- أتبع ذاك العنوان، بعنوان آخر “ماذا يقول الطالع؟” والذى يستدرج به القارئ، لارتباطه بالحدث المباشر فى القصة، وربما ليشتت انتباهه –على وزن: شفت العصفورة؟-، فيدخل فى مفترق طرق، مثلما أدخله فى إحتفالات الناس من حوله، برأس السنة، وإحتفالاتها، وبين العاشر من أغسطس، التى وجد نفسه-السارد- يعيش فيها، حيث تحدث المفارقة، التى يكشف عنها –أيضا- ذلك الموقف من الزوجة، حين يقول السارد {أنا من محاربى أكتوبر 73، يدى تلك أسرت طيارا منهم، وأحد أفراد الاستطلاع، وهى نفسها التى قبرت الدفعة “عبده المقص” أمهر رماة الجيش الثالث. فتزوجت أخته حتى لا أنسى صديقى، لكنها صرخت فى وجهى ذات ليلة ليلاء وأنا بين أخضانها وأخبرتنى بأنها تكره “عبده” مثلما تكرهنى بالضبط}. حيث نجد المفارقة بين النظرة لما حدث فى أكتوبر 73، وبين موقف الزوجة، المعاكس لها. فضلا عن المفارقة بين الماضى والحاضر، فالزوج-السارد- يعيش على بطولات الأمس، بينما هو فى الحاضر، عاجز عن إشباع الزوجة، بدون بطولات. مؤكدا ذلك حين يُصرح {لا أدرى أين ذهبت بهجة تلك الأشياء.. هانت بهجة الحلوى وقد نال منى السكرى ….}. حيث بدأت علامات الكِبَر عليه، حد النسيان، أو التداخل بين التواريخ.
وهى المفارقة التى تحملها النهاية، حيث يحتفل السارد – ظاهريا- بوم العاشر من أغسطس- عيد ميلاده- بينما ذهب إلى الكازينو فى يوم 1 يناير- راس السنة-. وهو ما يدعو لإمعان النظر فى وجود {النادل النوبى العجوز، الذى يلقبه الرواد بالروح الطاهرة} حيث يشير ذلك الوصف إلى حقيقة ذلك النادل، والتى تُخرجه من وظيفته –الظاهرية- إلى الوجود الرمزى له، والذى يكشف عنه {يعرفنى باسمى ولا أعرف اسمه….لعله الآن ممن يرتدون القفطان اللامع والعمامة البيضاء مع المنشفة الصغيرة المدلاة من قماط عريض، وعلى الرغم من سنين عمره فلا تجده إلا فى حركة ما}- حيث تشير تلك الملاحظة إلى التشابه- فى العمر- مع السارد.{أكثر ما جذبنى إليه صمته ونظراته الناطقة، أفصح ذات مرة وأخبرنى بسر تعلقه بى.. قال: {لأنك تبكى وحدك .. وكل الناس تغنى} حيث يتبين مدى إلتصاقه بالسارد، ومعرفة مالم يعرفه عن نفسه. ثم نعرف أن النادل صموت، وتأتى إشاراته بالنظر، فضلا عن علمه ببواطن ودواخل السارد. ثم يقول السارد{أخبرته بسر تعلقى به وبالمكان: لأننى أرى فيك ما يفعله الزمان فينا}. حيث تكشف الجملةعن تلك التغيرات التى حدثت فى الحياة، والتى من بينها، وجود ذلك النادل/ الضمير، فى زمنه، بينما لا يوجد (شبيهه) فى الحاضر.
ثم تتكشف حقيقة النادل، حينما يسمع السارد صوته للمرة الأولى، يهاجمه {شوف نفسك، ألم تنظر إلى المرآة قبل أن تحضر إلى هنا؟.. شاب شعرك، ترهل جلد رقبتك، ترهلت جفونك، كبر كرشك ولو نقص وزنك.. هل تريد المزيد؟}. لتكشف الفقرة عن الخطأ الذى وقع فيه السارد، بتداخل الأزمنة. وبعدها مباشرة يأتى حديث السارد{.. وإن ضَبْطُ النادل العجوز الأسمر بأسنانه اللامعة البيضاء وحده هناك يرمقنى. الملعون العجوز الشائخ المجنون أضاع منى متعة أن أبقى وحدى}. فالنادل إذن، موجود وغير موجود، موجود داخل السارد نفسه، وغير موجود خارجه.. إنه ضميره الذى جاء يؤنبه ويحاسبه، كيف تحتفل بيوم رأس السنة، وأنت العجوز الشائخ، الذى فعل بك الزمان أفعاله؟ خاصة أن تأتى واقعة الزوجة بعدها، وكأنها البرهان على صدق ما يقوله النادل/ الضمير. ويؤكد –أيضا- ذلك الامتزاج بين النادل والضمير، أن السارد {للمرة الأولى منذ أن عرفت أرض الكازينو لمرة واحدة كل سنة، أشير للنادل المخادع العجوز وكأننى سمعت لأول مرة صوت أم كلثوم تغنى من شريط بالعمارة المجاورة {لن يطيل النوم عمرا، ولن ينقصه طول السهر} والتى ربما تعمد الكاتب أن يوردها بهذه الصيغة، ربما ليؤكد على كبر السن، الذى هو محور القصة، وإلا ليس من المقبول أن يُخطئ كاتب محترف قول رباعيات الخيام، التى غنتها أم كلثوم{فلا أطال النوم عمرا، ولا قصر فى الأعمار طول السهر}. مثلما أخطأ – السارد- فى زيارته السنوية لأرض الكازينو، يوم رأس السنة (1 يناير)، وقد ظنه (10 أغسطس)، يوم ميلاده، ذلك اليوم الذى تعود فيه أن يزور الكازينو، وهو سر تلك الغضبة التى غضبها النادل، الذى ظنه أتى إحتفالا براس السنة، وهو ما لم يعتده منه، من قبل.
وقريبا من ذات اللعبة -الإبداعية- تأتى قصة “طقس شديد البرودة”، فى الدائرة الثانية، حيث ينشطر السارد إلى أثنين، أحدهما السارد، المتعامل مع الناس، بوجوده الطبيعى، والآخر مستتر، كان موجودا فى فترة الصبا والشباب، ذلك هو صديقه الذى مات، فى الحجرة العلوية- وأتصور أن اختيار الكاتب لأن تكون الحجرة “علوية” وليست العكس، ربما لتشير إلى منزلة تلك الفترة عنده، وربما لرفضه أن تموت تلك الحجرة وذكرياتها، التى لازالت حية فى ذهن السارد – حجرة الشباب، التى أتت إليه فيها بائعة الفجل. ذلك الصديق الذى كانت له جولات، ومغامرات. لكنه الآن مات، ويسألونه أن يصعد لتكفينه. غير أنه، لا يكترث، وعندما يصعد، يعود ليخبرهم بأنه ما مات، وكأنه تشبث به، أو بتلك الفترة التى كانها. ويسوق الكاتب بعض المفاتيح، التى تساعد القارئ للدخول إلى عالمه المُتَخَيل، مثل {كان من الممكن أن أبقى هكذا، أبحلق فى سقف الغرفة مستمتعا بصمتى وبرائحة فنجان القهوة المصنوع من البن المحوج، لولا أنهم اقتحمونى عنوة، بحجة أن صاحبى، قاطن الحجرة العلوية، على سطح العمارة ..يحتضر}.. وليقنعوه بضرورة الصعود إليه، حاولوا إثارة الشفقة{أفاضوا فى وصف لحظات احتضاره : صاحبك وحيدا يحدق فى سقف الغرفة، شفتاه ترتعشان بما يشى باسمك} حيث يتم التوحد بينهما، فذات الجِلسة الواحدة بينهما. ثم تأتى النهاية، والتى تلعب دور”لحظة التنوير” التى كانت تأتى فى النهاية، ليكشف الكاتب، عن ذلك الانقسام، لا إلى شخصين، وإنما إلى مرحلتين زمنيتين، السارد حين كان فى الصبا والشباب، ذلك هو الذى مات. بالتعبير عن تلك البرودة الشديدة التى يشعرها السارد، فى شهر أغسطس، شديد الحرارة { اسرعت إلى البطانية الصوفية.. تلحفت بها، لعل القشعريرة المجنونة فى أوصالى.. تهدأ. الذى أدهشنى فيما بعد .. أن تأكدت أننا فى شهر أغسطس الحار جدا..}. وليربط الكاتب بين بداية القصة، ونهايتها، ليحصر الفعل الذى شمل عمرا بأكمله. فإذا كانت هذه هى نهايتها، فقد كانت البداية، حيث كان شهر توت- وهو الشهر القبطى- يأتى ما بين( 11 سبتمبر و 10 أكتوبر)، وهو شهر فيضان النيل، الذى كان يُغرق الأراضى. فكان {سكان قريتى.. لا يستبشرون خيرا فى أيام “توت”}. وكأن السارد يرمى إلى القول بأنه بعد أن فارق الصبا والشباب، (لم يعد يستبشر خيرا) فى الحياة التى يصبو إليها، أو التى كانها.
وفى الدائرة الثانية –أيضا- “فى رحاب الغربة والانزواء”، حيث تشمل الدائرة بداخلها قشعريرة برد الوحدة، واسترجاع ما كان، وما هو كائن، أى إلتصاق السارد بجوانيته، بصورة أكبر.
فكانت الوحدة الأولى “لا تخرج إلى الحارة”. لنتعرف على كيف كانت الأم تحجر عليه الخروج إلى الحارة، رغم ضيق البيت، أو الحجرة التى يسكنها مع أبيه وأمه، اللذين كان يتنصت على ما يفعلانه فى الليل، وهو لا يعرف ماذا يفعلان{يرقدان على جنوبهما تارة.. وأخالهما جسدا متوحدا تارة أخرى. الجسد المتموج مع صوت خَبْرتُه ولم أفهمه}. غير أنه رغم الحَجْرِ كانت له جولاته الصبيانية.
وإذا كان –الكاتب- قد تناول مسألة المظاهرات مدفوعة الأجر فى “غدا مظاهرة”، مؤكدا انشغاله بالهم العام، دون أن يتوقف عند الهم الشخصى، فإن الأمور تتأكد فى الوحدة السردية (القصة) المعنونة “باب الروح” ذلك العنوان الناطق بالبحث عن الحرية، حيث اختنق السارد من روائح الحجز، لمجرد أنه ذهب للقسم بحثا عن حقه فى الحماية، رسم لنا ذلك الموقف (الهزلى) الساخر، عندما أصبح دون حماية، فقد سرق (مجهول)مفتاح الخزينة، ومفتاح الباب، فاصبح مكشوف الظهر، بينما هو يريد أن يكتب (قصيدة). ففضلا عن تلك السخرية التى قابل بها (المسؤول) بالقسم، كونه شاعرا {يا فندم .. سرقونى .. حتى لم ..أعد .. أكتب القصيدة.. أنا شاعر.. ضاحكا هذه المرة: وأين الربابة والمزمار يا شاعر}. فإنها كاشفة عن تهميش ذلك الجانب الإنسانى، الثقافة، أو الإبداع، فى مواجهة الرؤية القمعية، التى لا تبحث إلا عن الجرائم المدموغة بالأدلة.وكأننا أمام إدانة للمجتمع الذى يسخر من الثقافة، ويهتم فقط، بالأشياء المادية. وكأن الكاتب نظر حوله، وتأمل ما يجرى، فاخرجه فى قصة، تحتوى السخرية، وتحتوى الرؤية الشاعرية.
وفى قصة “مواجهة” .. لايزال الكاتب يراوده هاجس الكِبَرُ والموت. فنرى الصراع بين “يوسف” والموت، ذلك الذى اختطف منه كل أهله، وظنه نسيه هو. ذلك الذى عاش حتى بلغ الخمسين، فى الوقت الذى {أفراد عائلته أصابهم الداء، ولسبب لم يعرفه، الموت مبكرا.. إنه الوحيد الذى بلغ ما بلغه من العمر فى غفلة من ملاك الموت}، ثم يقرأ “يوسف” الطالع، تخير برجا عشوائيا ليقول له الطالع{لاتنفعل اليوم، قد تتعرض لمشاكل لا تتوقعها}. ليصيبه الهياج، ويعلن العصيان على كل شئ. فقد توقع أن يحدث اليوم ما لم يكن يتوقعه، ليواجه ملك الموت، ذلك المجهول غير المرئى {اسمى يوسف عرفه، ملابسى من ريش الطير، أقيم فى حى “بين السرايات” أما أنت الذى أكرهك وأمقتك، لأنك أخذت أهلى وناسى منى.. لخمسين سنة ظننت أننى أهرب منك، ولا أبحث عن ملامحك وأسرارك لخمسين سنة تركتنى.. تسعى لأن تتركنى من غير سند… لماذا الآن تبين لى}. فبعد طواف-الكاتب- لاسترجاع حياة يوسف، منذ الطفولة، واستهزاء زملاء العمل منه، وشهادة رؤسائه بدقة عمله، فلابد فى النهاية أن يواجه الموت، وجها لوجه.
ولم تكن البداية- فى قصة “مواجهة”- محض عملية تشويق، أو جاءت عفوا، وإنما كانت فعل تقديم لما سيحدث، حيث {كلهم أمروه بعدم استخدام مدخل الفندق الخاص بالنزلاء، ولا يتواجد بأماكن النزلاء، حتى لا يرونه أو تقع عيونهم عليه عفوا}. ورغم هذه التحذيرات إلا ان شيئا خارقا، وتغير ناموس الكون، فأتى بما لم يأت به من قبل، ففى البداية، كنا قد قرأنا{ضبط نفسه على الزجاج الفميه لبوابة الفندق}. وقد وفق الكاتب فى اختيار(الفندق) ليواجه فيه ذلك المصير. حيث الفندق هو موقع إناس عديدين، مختلفى الجنس ومختلفى البيئة، فيه القادم وفيه المغادر، فيه القائم، وفيه النائم، إنها دنيا، تتسع لعديد البشر. فكيف واجه ملك الموت –بصورته المنعكسة على باب (الفندق) {وكأنه متلبسا بإثم لم يرتكبه.. كما المشلول على قدميه، ملتوى الجذع، مائل الرقبة محدقا نحو مسخ منسوخ منه فى التو واللحظة} حيث كان إختيا الكلمات والتعبيرات موفقا لحد كبير، فقد أتى –السارد- للحياة ، ليس برغبته، وعاش الحياة، ليس برغبته، وها هويواجه الموت، ليس برغبته، فكلها آثام، لم يكن له ذنب فيها.
كما تتجسد –روح الفكاهة- فى قصة “غدا مظاهرة”، التى تجعل القارئ يبتسم، متذكرا (شر البلية ما يُضحك). حيث نعيش مع روح الطفولة التى أجاد الكاتب فى تصويرها، وإنعكاس أكل (الكوفتة)، الإسبوعى، وتحديدا يوم الخميس على الفعلة التى تجمع بين الزوجين، فى تلك الليلة، إلى أن يأتى خميس، دون أن تنفرج أسارير الأب، فى ذلك اليوم، ولا أحضر الكوفتة المعتادة، وحين تسأله الزوجة، يخبرها بأن (غدا مظاهرة). وقد نجح الكاتب فى عدم ذكر أسباب المظاهرة، أو فى أى عصر، لينفتح المجال أمام عقود ممتدة، درج المسئولين فيها على منح الخارج فى المظاهرة، وجبة كوفتة” وعشرين جنيها، ولتصبح مصدر رزق، لأمثال هؤلاء الفقراء. ولتتحول القصة بأكملها إلى نوع من الفكاهة المريرة. وتشتد مرراة السخرية عندما يصرخ الأب فى ابنه{اهتف يا بن الكلب، اعمل بأكلك}. فى الوقت الذى لم يكن الطفل – ولا الكبير- يعلم مما يدور حوله {صعد أحدهم وألقى حطبة كما التى أراها وأسمعها فى تليفزيون المقهى، لم أفهمها أيضا، لكن وبحق لا أدرى لماذا فرحت عندما قال{ميعاد العودة بعد العشاء والدعاء بالنصر والثبات} لم أفهم.. النصر على من؟ وما معنى الثبات هذا؟}. ولتتجسد (ملهاة) الساسة، وجوع الفقراء.
وفى أخر قصص تلك الحلقة، تأتى قصة “الجنرال يشرب القهوة” حيث يستمر الكاتب فى التعبير عن فترة المعاش، وانتظار الموت. حيث يخرج الجنرال بعد ثلاثين عاما، من “الشغل” المتواصل، لايجد وقتا ليراقب لعب الأطفال، أو يستمع لثرثرات زوجته، الذين يبحث عنهم اليوم، فى أول يوم “معاش” له.. فلايجدهم..كما يستمر وجود الطقس، بتأثيراته النفسية، فكان خروج الجنرال فى (عز) شهر طوبة. كما تأمل كل شئ يحيط به، ليجده باهتا، قد فعل الزمن فيه أفاعيله.
التقنية القصصية
وضع الكاتب فى البداية قصة “ورطة ضمير المخاطب” والتى تناول فيها .. بداية .. كتابة القصة، بما يوحى أنها بداية لإنشاء حياة. كما تناول فيها الإشارة إلى 73. ثم ختم المجموعة بقصة “نص أخير” ليتناول فيها فترة المعاش، او ما بعد العمل، وكأنها النهاية، كما تم فيها –أيضا- ذكر 73. وهو ما يمكن أن نرى فيه أنه وضع المجموعة بين دفتى البداية والنهاية، وكأن المجموعة –فى مجموعها- تمثل ضفتى الحياة. كما يمكن إعتبار 73 وذكرها فى الحالين، أنها بداية للحياة الحقيقية –بالنسبة لمن خاض تجربتها- وهى أيضا النهاية – النهاية الفعلية لمن فارق الحياة فيها- والنهاية المعنوية لمن عاش وشاهدها تتلاشى أمام ما يحدث، وما اشار إليه، فى قصتى البداية والنهاية.
استخدم الكاتب أكثر من وسيلة ليحافظ على تقنية القصة القصيرة، شديدة التكثيف، والتى تبدو- كما قال يوسف إدريس – كالطلقة. ومن بين هذه الوسائل، استخدام صيغة شاعر الربابة، الذى يبدأ بعملية التشويق، ثم يطلب من (السميعة) ان يذهبوا معه إلى أصل الحكاية، مثلما فى قصة “طقس شديدة البرودة”{سكان قريتى لا يستبشرون خيرا فى أيام شهر(توت)، وهو ما تأكدت منه اليوم لى..}، حيث يبدو الكاتب كأنه الراوى الشعبى، يخاطب (السميعة) عن إحدى السير الشعبية، حيث يبدأ بالذروة، ثم يدعو الجميع للرجوع معه إلى بداية (الحكاية).
وفى قصة “مواجهة”، يشخص الكاتب الحالة ثم {رفع ناظريه عن الأرض.. وكان ما كان}. وكأنه يبدأ العودة إلى اصل (الحكاية) فقد كانت هذه .. فقط.. عملية تشويق.
كما ولَدَ الحكايات من الشرق والغرب، فى إطار اللحظة، فى مثب قصة “ورطة ضمير المُخَاطب” التى بدأت بمحاولة كتابة القصة، ثم طاف على الماضى ليستحضر الأصدقاء قبل النقاد، وحصرهم له فى الكتابة عن (المقاومة)، ثم المرور على تجربة 73، وتجارب من كانوا معه فيها، ثم فى النهاية، يلعن القصة والقاصين، حيث لم تغادر القصة مرحلة كتابتها.
كما حرص الكاتب على استخدان الكلمات، ذات الإشعاع الدلالى، ليوحى للقارئ بما يدور خلف السطور، وهى إحدى الوسائل التى تمنح السرد شعريته/إبداعيته.
كما كانت روح الفكاهة والسخرية، حاضرة بصورة واضحة، حيث لجأ إليها السيد نجم، كى نتقبل جهامة موضوعات، الحرب والموت والإصابات الباترة. فمثلا نجد فى قصة “ورطة ضمير المتكام”، بعد أن يلقى بحجر ليصيب به الحكومة والمجتمع، عندما يكشف عن قِصَرْ اليد التى تعيقه – رغم كبر السن- عن اقتناء شقة الزوجية، نجده يكمل، بتلك الروح {حتى عبرت سنى الزواج، ولم أعد أصلح إلا لتربية العصافير فى الشرفة}.وفى قصة “نص أخير”أو “ماذا يقول الطالع” نجد السخرية المريرة الكاشفة عن فقدان السارد القدرة على الفعل، مع زوجته، والتى انتفخت جفونها المتورمة، من شدة الحاجة{ لم أنتبه إلى جفونها المتورمة ولا احتقان كرتى عينيها ولا الصُفرة التى اعتلت بشرتها، إلا بعد أن أضاءت المصباح. أزحتُ حديثها إلى جانب المزاح. عادت وأقسمت أنها دفنت أخيها منذ زمن. فلما اعتبرتها نكتة جديدة، اندفعت نحو رقبتى وتعلقت بها حتى شعرت بانطباق السماء على الأرض، فطلقتها غير نادم.. كيف تتهمنى بأننى أعيش مع صديقى فى صحوى وأقص لها عنه، وفى منامى فأحلم به وأردد اسمه؟}.
شاعرية القص
من المعروف أن أحد أهم عناصر الشعرية، هو المجاز، غير أن السيد نجم يستخدم المجاز هنا –فى السرد-. فمثلا حين يقول فى قصة “ورطة ضمير المتكلم” {فالذى لا يعرفه البعض أننى لم أتزوج حتى تارخه لقصر ذات اليد، بينما أسعار الشقق فى حاجة إلى يد طويلة} تلك العبارة المكنوزة ، والدالة، والحاملة للكثير من روح الفكاهة، أو السخرية. فنجد أنها تنتهى ب{ بينما أسعار الشقق فى حاجة إلى يد طويلة}، فهى لا تهدف إلى المفارقة –التى هى أيضا أحد عناصر الشعرية- فقط للمقابلة بين اليد القصيرة واليد الطويلة، وإنما يأتى طول اليد هنا إشارة إلى طوائف كثيرة من المجتمع، تستبيح السرقة، والرشوة، والسلطة، والمكانة الاجتماعية، هى التى تقدر على تأجير، أو شراء الشقة، التى لا يقدر عليها ذلك المستقيم فى الحياة، أو أصحاب المهمات البدنية، والتى يمكن أن نقول عنها أنها حطب النار التى يُشعلها الكبار، أمثال الجندى، الذى نتعرف عليه فى نهاية القصة.
كما تأتى الشاعرية فى قصة “فى رحاب الولد”، مرة فى تصويره لأهرام الرمال التى تُمحيها أمواج البحر، ليوحى بتيار الحياة الجارف. ومرة ثانية، فى كف الأب الممسكة بيد الطفل، وكأنه الذبابة المحبوسة فى الفاترينة، وعندما يفك يده من يد الأب ويتصور أن الذبابة طارت فى الهواء حرة، إكتشف أنها لم تزل محبوسة، وكأنه يرى أن التخلص من سيطرة الأب تبدأ عندما يكبر قليلا، يكتشف أن جينات الأب تتجذر فى أعماقه، وكأنه الفاترينة المحبوس فيها، لا الذبابة. ومرة يتجسد فى شكل البهيمة، التى تبتغيها الأم، وتتصوره طفلا لا يعرف المعنى الخفى، عندما تتخلص من معاملته كطفل، وتسأل الجارة عن بهيمة غير تلك التى ماتت، فيتحول هو –فى أحلامه، إلى تلك البهيمة، ولتتحول الأم إلى إمرأة تشعر بالجوع تجاه الرجل، فيمر به الزمن، ليصح هو الآخر “بهيمة
وفى قصة “نص أخير” تعتبر المفارقة فى التواريخ، والمفارقة فى وضع كل من السارد وزوجته، والتى تكشف عن واقعة ثورة الزوجة على السارد، بينما هو بين أحضانها، عن عملية الانزياح التى مارسها الكاتب، بإحلال غضب الزوجة من تكرار ذكره لأخيها، وبطولات الماضى، محل التصريح بالفشل فى إشباع الزوجة.
كما تمثل عملية إخراج الضمير من التخييل إلى التجسيد، فى إحللال النادل محل الضمير، لهو أيضا من مظاهر الشعرية.
وفى قصة “مواجهة” لعب الكاتب على فكرة التقديم والاسترجاع، التى تحرك ذهن القارئ، وتجلعه يبحث، أين البداية واين النهاية، حيث لم تكن البداية إلا كالحركة الأولى من سيمفونية “القدر” لبيتهوفن، قوية وسريعة، وكأنها تهيئ القارى إلى حدث جلل سيقع. وهل بعد الموت من حادث جلل يثير المشاعر، ويُحْضِرُ الشاعرية؟.
كما تنضح الشاعرية فى قصة “طقس شديد البرودة” حيث تم إزاحة فترة الصبا والشباب، وتجسيدها فى شخص –صديق السارد-. وإن ساق الكاتب المفاتيح التى تؤدى للدخول إلى الشخصية، والوصول إلى رؤية القصة.
وفى قصة “باب الروح” التى يفتح العنوان فيها آفاق الرؤية الأبعد من مجرد السخرية، والفكاهة، التى أزاح بها ما هو مخبأ فى باطنها، من رؤية الحاضر، وما به من عورات تنال من جوهر الإنسان.
كما تأتى الشعرية فى قصة “الجنرال يشرب القهوة” فى المفارقة، بين البداية والنهاية، حيث يساعد العنوان فى تصور أن الجنرال، لا زال يعيش فى فترة “الشغل” ولكن باستحضار قصة “باب الروح” وتدبر افعال الشرطة، سيتوقع الصرامة والحزم فى فعل الجنرال، وفى كل المواقف، لتأتى النهاية بعكس تلك الرؤية، حيث يمتنع –الجنرال- عن توجيه الرصاص للمتظاهرين- الذين لم تذكهم القصة- ولكنا نعلم أنه فعل ذلك/ ما عَرَّضَهُ للاحالة{نفر الشباب الثائر ووقفوا فى وجهه يصيحون، عجز عن توجيه هراوات جنوده نحو رؤوسهم العارية ووجوههم المحتقنة، فلما استدعته القيادة العليا، صاحوا فى وجهه.. وكان الاختيار قاسيا، الإحالة إلى المعاش أو توجيه تهمة موثقة بالتقصير}. وإن لم ترفع التهمة عن الشرطة، إلا أنها ترى أن من بينهم، من يحمل مشاعر (الإنسان). كما أنها تدفع القارئ لاستحضار ما حدث بالميدان فى 25 يناير، وكان السيد نجم أحد شهوده، وتسجيله فى عمله “أشياء عادية بالميدان”.
أزعم أننى أحد متابعى إبداعات السيد نجم، المتنوعة، وهو الأمر الذى يمكننى من القول بارتياح، أنه وصل فى مجموعته هذه “دوائر من حرير” إلى قمة النضج الإبداعى، حيث توافرت المتعة القرائية، من خلال عمليات التشويق، والإثارة، والمقابلة، فضلا عن الإشباع النفسى، من خلال خلق المناخ الذى يمكن أن يعيشه القارئ فى حياته المعتادة، خاصة أولئك الذين بلغوا سن المعاش. والمتعة الفكرية، حيث يدعوه فى الكثير من القصص-إن لم يكن فى كلها- للبحث عما وراء السطور والكلمات. فجاءت المجموعة فى شكلها الشاعرى، لتعلن عن إضافة جديدة لفن السرد، عامة، وللقصة القصيرة، خاصة.
8 / 1/ 2023
………
[1] — السيد نجم – دوائر من حرير-الهيئة المصرية العامة للكتاب- ط1 2022.