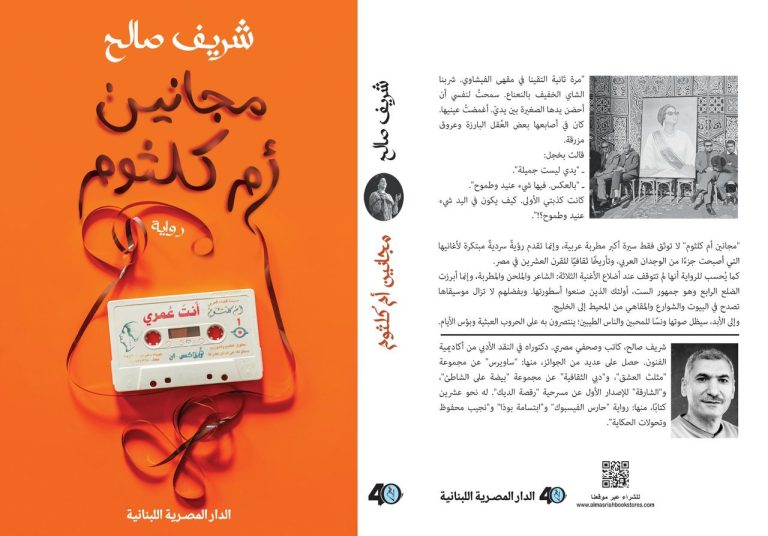وما بين الواقعية والأسطورة يُولَدُ عملٌ إبداعي مهم، يخطو خطوة جديدة فوق أرضٍ بِكر، إذ ينقلنا وحيد الطويلة نقلاتٍ متلاحقة ما بين عالم الريفِ والحضر، ويستدعي حكاياتٍ تتناقلها الأجيال ورموزاً لا تُنسى ويقدم لنا معاني أكثر عمقاً لمفاهيم العائلة، الصراع، النفوذ، الغرام، والرغبة، وكرامة الإنسان
وعبر صفحات الرواية التي تبلغ 265 صفحة، ندركُ أن اللغة مقصٌ وإبرة، تُفصِلُنا على مقاسها، وتمنحنا ثوبَ الرواية كي نغطي به أسرارنا وعوراتنا
تبدأ الرواية الصادرة عن “الدار” للنشر بمنتصف الحكاية أو قرب النهاية بقليل، إذ يرقد البطل “محروس” في المستشفى في حالة خطرة بعد تعرضه لإصابة تكاد تكون مميتة
“النعشُ على باب المستشفى، والملائكةُ أيضاً، وإن تجولوا بسرعةٍ في ردهاتِها القذرة حين يشعرون بالملل، في انتظارِ ساعتِه، وإن بدَدوا سأمهم أحياناً بقبض روح أو اثنتين
رآهم الفناجيلي ابن أخيه، العين في العين، وهم يبصّون من ثقوب الأبواب، وإن تخفَوا في ملابسَ بيضاء كالأطباء وأحياناً الممرضات
وهو كما هو، رابضٌ في نفس السرير، بين الحياة والموت، خيطٌ يشده وخيطٌ يرخيه، ممدد دون ضعف أو أنة، لا آهة ولا توجّع، وجهه محتفظٌ بآلام عراكه الأخير” (ص7)
هكذا يضعنا صاحبُ الرواية منذ اللحظةِ الأولى وجهاً لوجه أمام الموت
لكن للموتِ المراوغ تاريخاً لا يُختصر وهوية لا تُمحى
والموتُ هنا يصارعُ أقوى الرجال: محروس
سيد القرية الذي واجه القاتل المأجور عبد المقصود في معركة شرسة، فقد فيها محروس ذراعه وكاد أن يفقد روحه، لكنه احتفظ بما هو أهم: كرامته
نحن أمام بطلٍ شعبي، حياته حربٌ لا سلام فيها، كأنه منذورٌ للحروب والكفاح، والجسد ليس سوى ساحة قصل
وفي الرواية الصادرة عن “الدار للنشر والتوزيع” عام 2008، نستعيد ذاكرتنا عن ريفٍ غاب عن الروائيين منذ أن أحياه مصطفى نصر في “الهماميل” وعبد الحكيم قاسم في “أيام الإنسان السبعة” وخليل حسن خليل في “الوسية” وقبلهم توفيق الحكيم في “يوميات نائب في الأرياف“
وها هو وحيد الطويلة يتقدم بالرواية عن ريف مصر خطوة أخرى إلى الأمام
“.. قوم يا محروس
ابنته إنصاف تربض عند قدميه اللتين تعبران حافة السرير، تلعب بين أصابعه، تفلّي جسده قطعة قطعة، تدغدغه، تنادي عليه بصوتٍ معبأ حتى آخره بالحنان، يغشاه أسىً خفيف حيناً، وجرعةٍ وافية من ثقة أحياناً أخرى.
قوم يا محروس، قوم…،
قلتلك قوم، نبحت قلبي
وهو كما هو، عيناه معلقتان بالسقف، كأنما يقرأ شريط حياته، يحركهما جانباً حتى نهايته، ثم يعود من الأول، كأنما يفرز الأحلام والحسرات ويقف منتصباً بينهما، وحين يفرغ من السطر الأخير، يغمضهما عميقاً ويسلم قدميه في دعةٍ لإنصاف” (ص 8)
الكل خائفٌ يترقبُ مصيرَ كبيرِ البلدة الذي أصيبَ إصابة خطيرة أثناء عراكه مع القاتل المأجور. أهل القرية تركوا أعمالهم، وتساءلوا كغريقٍ يتعلق بعودِ قش عن حالة الرجل الذي يصارع الموت في المستشفى
“والشيخ عثمان يفرك سمرته التي أفلتت من سواد غطيس لأبيه وجده، يقذف تنهيدةً من قلب جوفه ويقول:
– عيّان؟، والله ما عيان إلا اللي عنده عيان” (ص 10)
الريف في الرواية غيمةٌ عملاقة يرضع من ثديها الجميع..ولذا لم يكن مستغرباً أن تكون ملامح محروس مستوحاةً من طمي تلك الأرض الولود
“كلُ من يراه تلبسه الدهشة، جسدٌ عرمرم يملأ السرير، يملأ مركزه، يكاد يهبط من حافتيه لولا صلابته، أنفه الكبير الكبير، كأنف جمل شارخ، بلونٍ وردي ولمعةٍ ظاهرة، لمعة تسرق من الكبر وهنه، ومن المرض وحشته
وطاقتا الأنف، النائمتان على جنب، صاحيتان على الشارب المنتعظ تحت أنفه الكبير، الذي لا تجرؤ ملفحة أن تخبئه تحتها. والأذنان، كل فردة نصف مطرحة قديمة، متربة بالشعر، طولية، كأنها سماعة الميكروفون الذي ينصب في سرداقات العزاء والأفراح لتسمع القرية من أولها لآخرها، ويسمع القابعون في الغيطان بالمرة
وسمرةٌ حنون بحمرةٍ متقدة تجمع كل هذا تحتها وتطويه” (ص 10-11)
قلبُ الأحداث هو حياة محروس التي تكون على المحك في المستشفى، أما الآخرون فهم يدورون حول تلك الساقية طائعين مختارين
“شهورٌ تمر، ومحروس كأنما اختار المستشفى مقراً أخيراً، بيتاً ومقبرة، لا يزيدُ ولا ينقص، المحاليل معلقة، الخيوط مفتوحة بين جسده والحياة، واصلة بين جسده والموت، والقريةُ تركت حالها ومالها ونفرت إليه
شهورٌ، يدعون له، كبير البلد، حبيبها وحاميها، والكبير لا يُهان حتى ولو من موت.. نشف الزرع، والبهائم على وشك الهلاك
تعطلت مصالحُ الخلق، والدعواتُ تُرفَعُ في الصلوات وخُطبِ الجمعة، والدعوات التي كانت تصله بالشفاء، صارت تُكال له بالراحة والرحمة” (ص 12-13)
والروايةُ حافلة بمشاهد تحبسُ الأنفاس، ومن ذلك مشهد الابنة إنصاف وهي تحاولُ انتشالَ أبيها الذي يُحتضر من براثن الموت:
“الموتُ يشدُك أو على الأقل ينوي لك، معركتُه الآن معك، يقفُ الآن على الباب، أو يبصُ من خلف عمود السرير، وأنت تفيق ساعة وتغيب ساعتين
وهو كما هو، اختفى السرير تحته، عضلات وجهه تنقبضُ بقوة وبسرعة، تركب بعضها، تتعارك، وفمه مضغوط في فمه، كأن فكاً سيتعتع الآخر أو يفتك به، أو أسناناً مغتاظة ستغرز في الجهة الأخرى وتنفذ
وجهه يتقلبُ بعنف ويهتز، ينتشُ رجله التي انزلقت من الحافة، الحافة التي يطلُ عليها كل ثانية، ذراعُه مرفوعة لأعلى، متشنجة، وقبضةُ يده مزمومة، وجبهته تكومت يكاد يعصرها، يعصرها، يقاومُ جاذبية الهوة القاتلة متكئاً على جرمه الكبير
ذراعه تترجرجُ، تتطوحُ في الهواء، وجسده ينتفض، وهي …هي تشدُ ياقة جلبابه بعنف، وتلهثُ، تدفعه بعيداً عن الحافة، تغرز رجليها في الأرض، تنطره بقوة، تشده بعزم الجن لتستعيده، تجذبه لتستعيدَه، … تستعيدُه
يرمشُ بعينيه، تمشطُ صدره وعنقه حتى يرتخي، يبدأ في الرجوع، وتهدأ الأرجوحة، يسترخي.. مسحة من راحة تعبره، عاد من الحافة سالماً كأنه لن يعود إليها ثانية” (ص 22-23)
الريفُ حاضرٌ بقوة، بكل عاداته وتقاليده، وصوره وملامحه التي تأخذنا إلى عالمٍ لا يعرفه إلا أهله
“لا تلمس البَيضَ يا ناصر، لا تلمسه يا ولدي، سيفسد، الدجاجةُ تنفرث من بَيضٍ به رائحةٌ غير رائحتها، لا تنامُ عليه من بعد، تعافه، وأحياناً تنقره بقسوة، بعد أن كان على شفا الفقس
النسوة يلمسنه بطرف أصابعهن مرة واحدة قبل أن يضعنه في عش أو قنّ، يقلّبنه في عينِ الشمس ليتأكدنَ أن البيضة ملآنة، وأن ماءَ الديك يسبح فيها” (ص 127)
حتى في الزواج والطلاق، الحب والبغض، الشوق والقتل، يطبعُ المكان قُبلته التي لا تُنسى على الناس والأرض
“البطة التي تزوجها دياب العُكّش قطة مغمضة، في السر، غصباً، وفاءً لدين أمها الذي ناءت به، وما من باب رزق لترده
فتحت له رجليها.. ونامت، وتركته وحده يشتعل ويشتغل
وحين ذاقت لذة العشق، وطرف عينها منديل يس العاشق، الصياد العايق، الذي رمت نفسها في شبكته قبل أن يرميها، خيَرت زوجها بين الطلاق أو الفضيحة، رفض، قتله العاشق، ودفنه في غرفتها تحت سريرها، لا من شاف ولا من دري، وناما معاً فوقه، وماء المحبرة الذي فاض وسال روى قبره ليلتها وباقي الليالي
ولأن التبات والنبات لا يُعمِرُ طويلاً فوق الدم، ولا يزهرُ فوق مجراه، أخذته حبةُ طماطم مسمومة وجابت أجله في لمعة عين” (ص 177)
ومن رحمِ المجتمع الريفي تُولَدُ الأسطورة وتنمو حتى ينبتَ لها جناحان من الحقيقة
“يحكون أن أحدهم في الغيط قد قتل ثعباناً أزرق، وقطع ذيل وَلِيفتِه، التي تحورت وتحولت لطائر بجناحين، أغارت على الناس والخوازن، وكادت تفسد ليل الوادي، اصطادها محروس، شواها وأكلها، ومن يومها وشعره ازداد كثافة في كل أنحاء جسمه، ازداد كثافة وسواداً” (ص 17)
الصراعُ على “العهد” و”البشارة” و”السر” للفوز بالوادي والميراث، هو أحد محاور هذا العمل، إذ يقفز النزاع بين أطرافه المختلفة إلى سطح الأحداث، في محاولةٍ من كل طرف للفوز بالوادي الضيق، كأن بالأمر إسقاطاً على حاضرٍ نعيشه وواقع نعاصر أحداثه
“وبصوتٍ قاطع: السر أمانة، أمانة.. ما يتورثش، ما حدش يديه لابنه، السر لو فلت حيروح عزبة إسرائيل” (ص 121)
وعندما يُوزَعُ الميراث، يكونُ الوادي من نصيب العناني
“الشرُ ينطُ من عينيه، أمسكه من ياقة قفطانه، بيديه الاثنتين، يكاد يفطسُ بينهما
الوادي ليك يا عناني، وادي جلانطه، أمانة في رقبتك، منك وليك، حقك وسرك، وأوعى تغضب ولا ترجع” (ص 38-39)
الطمعُ مغناطيس، يشفط البعيد، يحيلُ النحاس حديداً، ويجذبُ السمك بقوةٍ إلى الشباك
والطمعُ يفتكُ بالعناني
“يقطعُ الوادي في الصباح والمساء كسحليةٍ دائخة، بروح مخنوقة وصوت مسروق، لا يرفع عينه من الأرض، يمد ساقاً خلف ساق بتؤدة وانتظام ، كأنه يقيسه.. في الصباح يعدُ الخطوات من أوله لآخره، ثم يقلب الآية مساءً، يعد الخطوات من آخره لأوله
ومن آن لآخر، يصفق بكفيه، ينفخ:
.. كان فيها إيه لو مد لي العهد على عزبة إسرائيل كمان؟ صبرت، صبرت، وآخر المتمة أكون شيخ على شوية الغجر دول؟، ومن غير سر” (ص 40)
تلحُ علينا إسقاطاتٌ جديدة، حين نعرفُ حكايةَ العزبةِ المجاورة
“ينعتونها بعزبة إسرائيل، القرية المجاورة لأعلى، التي ترميهم بالطوب عند كل معركة بينهما، إلى أن يصعدوا وتتدخل النبابيت، وهي تصفعهم وتسميهم غجر جلانطه” (ص 43)
وأبو الليل ينصحُ العناني كي يحدَ من أطماعِه ونهمِه للحصول على ميراثٍ أكبر
“الطمعُ مقتلة يا عناني، وأنت طماع، احمد ربنا، يا راجل لو أداه لي كنت شفيت، باقولك ايه، تاخدش النص وتديني النص” (ص 45)
ترن في أذني العناني مقولةُ صاحبِ العهد “إن غابت الريح ثلاثاً، عليك أن تسلم السر”، وبعد أن تغيب الريح لمدة يومين نقرأ حاله: “لونه مخطوف، أصفر يابس، مثل حبة ليمون لم يشترها أحد، وبقيت وحيدة، متغضنة، تتفرج على اقتراب نهايتها” (ص 211)
شخصيةٌ أخرى تدعو إلى التأملِ في الرواية هي فرج، شيخ الكُتاب، الذي يقدم لنا تفسيراً جديداً وفريداً للأعراق والأجناس في تاريخ البشرية:
“يمشي بخيلاء، ليعوض انحناءة جده، يدكّ الأرض ليستعيد عزة نفس أبيه، يعلّم أولاد الوادي، ويسبهم بآبائهم أحياناً
بالعمامة والقفطان دائماً، لا يخلعهما إلا عند النوم، يرفع ذيله من حين لآخر ليبين جوربه، يلبسه صيفاً وشتاءً وبالمرة يخفي ساقيه
يمدُ يده في سيالةِ فقطانه، يشخشخ بالنقود، ثم يدبها في ظهره، يدفعُ صدره بالكبرياء.. ويحكي حكايته:
سيدنا حام كان يمشي في السوق إلى جانب سيدنا سام، كلٌ متأبطاً مصحفه، يدعوان الناس أن يعبدوا الله الواحد الأحد الذي لا يفرق بين عباده إلا بالتقوى، وأن يكونوا طيبين، كلُ في حق الآخر، إلى أن فاجأهما المطر تحت سماء مكشوفة
سيدنا حام خبأ المصحف في قفطانه يا ولاد الهرمة
السما انفتحت، وسيدنا حام جرى بالمشوار
يخرج يده، يعدل وضع قفطانه، يضبط عمامته بيد، رافعاً المصحف بالأخرى
وسيدكم سام رفع المصحف بكلتي يديه فوق رأسه، ليمنع المطر عنه، المطر الذي هطل بغزارة، فأسال حبر المصحف على رأسه، ومن يومها اسودّ وجهه وجسمه
يده في الأعلى، ينزلها، متأبطاً المصحف بقوة، كأنه يكفر عن خطيئة جده
ومن يومها يا ولاد الفرطعوس فيه ناس بيض، وناس سمر” (ص 64-65)
وفرج كان عاشقاً وعشيقاً في السر لعزيزة العمشة
تمشي وحدها.. تظنه على يمينها، ونفس الابتسامة المختفية على وجهه عند عودتهما من واجبهما في العزاء، يمدُ يده فجأة، يشبكها بيدها، يضغط .. يسحبها إلى داخل غيط القمح، يفترشان القش، في وسطه تماماً، لا أحد، الطيور جاءت من كل فجّ، تحوم فوقهما، تغني، تنفرطُ بعيداً وتغني، وعرقهما سقى الأرض والنوى
في كل عام، في نفس الميعاد، تطلع وسط غيط القمح نوارة فول، أرضها مبللة حتى ولو زرعت قطناً” ( ص 238)
شخصياتُ الرواية منحوتة بإزميل فن الوصف، ولا عجب إذاً أن يستمتع القارىء بمتابعة مواقف وتصرفات محروس، وعزت العايق، والفناجيلي، وأبو الليل، وإنصاف، والشيخ العناني، وفرج، وأبو العشم، وعزيزة العمشة
وعائلة محروس تختصرُ الكون وهمومَ البشر
“عزت يبيع الوهم، يعشق النساء والحمير، غارق حتى شوشته، حتى صدق الحكاية وأصبح يبيعه لنفسه
الفناجيلي يتأرجح بين كفنه ونبوّته، يطارد الموت والوهم في الجبّانات والوجوه الباردة
ونَشْأَتْ ابن غزلان هجّ من الوادي بعد أن تهامس الناس من خلفه، على صوت أمه الذي يطلع في الشارع كلما نامت مع زوجها أبو العشم والد عزّت” (ص 132)
ونشأت هذا عانى من عشق أمه لرجلها الجديد، إذ كان جسدها يهتز بالانفجاراتِ من البداية وحتى النهاية، حتى لا يخفى على أحدٍ صراخها
“إلى أن وقعت الواقعة.. تقدم أحدهم منه، والباقون ينتظرون دورهم: صوت أمك طالع في الشارع وواصل للسما، واحنا عندنا بنات وخايفين عليهم
عيناه في الأرض وبواقي كرامته، يبحث عن شق مناسب ليبتلعه، بعدما ابتلع شق أمه كرامته” (ص 208)
أما عزت، فحكايته حكاية
“ريفو، واحد من أسمائه، اسمه الأول عزت العايق، أبو سنة دهب لولي، حيلة أبيه بعد زواجين وعشر نساء في السر، أخذه أبوه للبندر وهو صغير، ركب له غطاءً من الفضة لأسنانه ، لعب به في الموالد وعند الغوازي، من يومها عشق المدينة، جرت في دمه وظلت حلماً يعشش في خياله حتى استوى عوده، يسأل بصدر مفتوح:
هي إيه الكلية اللي بتطلع رئيس جمهورية” (ص 75)
للغرامِ نصيبُه الوافر في هذه الرواية، وخصوصاً عند عزت الذي يسترقُ النظرَ إلى ابنةِ الشيخ العناني وهي “تنشرُ الغسيل، تلعبُ مع الحمام، يرقبُها مختبئاً خلف الأجولة، الخميرة تصعدُ برأسه، المراقبة تطول، رأسه تصعدُ والشمس تلطشه
ترفعُ ذراعيها لأعلى، يتسربُ الضوء تحت إبطيها ومن تحتهما، طاقة نور” (ص 70)
لكن عزت الذي تَصورَ في لحظةٍ أنه طبيبٌ يداوي المرضى بالأدوية والحقن، كان مُغرَماً بالنساء والمؤخرات، حتى إنه كان يدفعُ لامرأتِه كي تمنحه نفسها كما يريد
ولا يمكن أن نغفلَ شخصية أبو الليل، الذي أصابه الجذام فغرقَ في بحر الظلام، بعيداً عن الأعين المشفقة أو المستهزئة
“هو السيد، حامي حمى الليل، الذي تهفو نفسه لعشيقة، نجمة أو امرأة، فإن أنفت أو عفّت، يفتش عن طريدة
يتحسسُ أصابعه مرة، فيقرر أن يقضَ مضاجع من يعايرونه، ويتحسسها أخرى.. فيسرق ليل من يأنفونه
أوجعته عِلتُه كثيراً، عيونُ الناس أوجعته أكثر، وضحكاتهم خلف ظهره” (ص 115)
لكنه يبقى طائراً حراً متفائلاً بعودةِ النجوم إلى سماءٍ تحلم بالضياء
كل ليلةٍ يخرج، يفردُ عباءةَ الليل، يشمُها، يمرح في طياتها حتى تنفرد تماماً، وتشبع من امتداداتها
يحكي له حكايات النهار الأخير،.. التي وقعت في غيبته، وحين يشم رائحة النهار الجديد خلفه، يشده من ذيله، يطويه تحت إبطه ويعود، يعود من حارة أخرى، حتى لا يراه محروس، يسمع صوته ، ويشّتم رائحته من آخر الدنيا” (ص 40)
ولأن الأوجاعَ تصنعُ الفلسفة، فإن شخصية أبو الليل تتأملُ الحياة من منظورٍ مختلف
“الليل يجعلُ الناسَ كلهم ذوي عاهات، وأنتَ وحدك المعافى، حتى السرقة تبدو لك دائماً ابنة حلم” (ص 117)
ولعل وحيد الطويلة أرادَ أن يجعلَ روايته دائرةً مغلقة، تكونُ فيها النهاية موصولةً بخيط البداية
لنتأمل معاً تلك النهايةَ العجيبة التي تقلبُ الموازين
“ومحروس انتفض، قطعَ الخيوط، رمى المحاليل، انتفضَ في اتجاه دورة المياه، خرطوم ماء كأنه خرطومُ حنفية الحريق، قوياً حتى خرجت الصراصيرُ من مكامنها، طويلاً عفياً حتى خرجت الفئران من مخابئها، والطبيبُ المذهول يرقبُ الموقف، ويبحث بعينيه عن النعش
عادوا بسرعةٍ، جميعاً، دون اتفاق أيضاً، الطبيب يصرخ، الفئران تتجه إليه، في غير اتجاه يصرخ ويهرب، والعناني في ذيله
والباب يترجرجُ، كان الموت يدق حوافره عليه، كأنه أغلق دون الملائكة
فتحته إنصاف، وهم في كعبها،
تسمّروا،
كان قد عاد من قبل، وضع كمامة الأوكسجين فقط على فمه، وراح في نوم عميق
لم يتحركوا، ولا شالتهم أقدامهم، يبصون في اتجاه واحد، كأعمدة زرعت مكانها
النعشُ ليس على باب المستشفى
والملائكة تفرقت” (ص 260-261)
وحين ندركُ أنها حكايات النهار الأخير، نصبحُ متورطين في تلك الحكاياتِ التي لا نتمنى أن تنتهي لفرطِ صدقها وحميميتها، ولقدرةِ الكاتب على نقلِ القارىء إلى عوالمَ لم تنل حقها في الروايةِ العربية المعاصرة
حتى وإن تفرقت الملائكة، ستظلُ عيون القراء معلقةً بباب المستشفى..حيث يرقد محروس