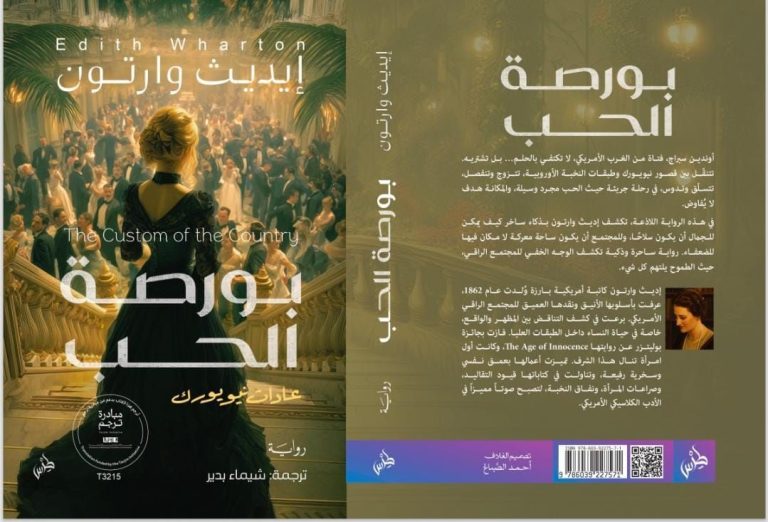قصة: لوسيانا برودان
ترجمة: نجلاء الجعيدي
(…
ومازلت أجرؤ على حب صوت الضوء
فى لحظة ميتة
ولون الزمن على حائط مهجور..
لم يعد يعنيني شيء
داخل عيني..
بعيد جدا من أن يطلب،
قريب جدا؛
لكى تعرف أنه غير موجود..)
…
أليجاندرا بيزارنيك
——
لا أعرف الوقت الآن. توقظني ضوضاء المكنسة الكهربائية التي تمر عبر الطرقات، شاعرة بتسارع دقات قلبي، بالدوار وبعدم الاتزان.
يسألنى ممرض بلكنة بوليفية: ها باتريسيا؟ كيف حالك؟ أأنت أفضل حالا الآن من الصباح؟ لا أعرف متى دخل، لكنه بادر بفتح ستائر النافذة؛ آملا للشمس أن تنغمس داخل روحي.
يدور في داخلي: “يبدو أنهم حاولوا إيقاظي مبكرًا، لكنهم فشلوا”. أحاول أن أفتح عيني، فلاتزال جافة من النوم، بينما أرى صورة غير واضحة لكارلوس، أخي الواقف أمام سريري، قائلا: “إنها الثالثة بعد الظهر وعلينا مغادرة الغرفة في الساعة الثالثة والنصف”.
أريد أن أستجمع قواي، أنظر إليه؛ لا أشعر بذراعي، بينما يستيقظ عقلي شيئًا فشيئًا، كان جسدي لا يزال بحاجة إلى إفاقة. يعرفني جيدا وعلى دراية بما ينتابني، تماما، لكنه يصر. يصيح وهو يحاول أن يظهر نصف ابتسامة: “هيا باتريسيا” فتعبيرات وجهه وعبوسه لا يتناسبان، أبدا، مع نبرة صوته.
يدخلون ويخرجون غرفتي وكأني غير موجودة، أو كما لو أن كل ما حدث لي لم يكن كافياً لهم؛ ليشعروا ببعض الشفقة تجاهي. ينظرون إليّ كما لو أن ذكرى باولا لا تؤثر عليهم ولا يعانون منها. إنهم يكذبون؛ يغضون الطرف، يتجاهلون ويتصرفون كأن شيئًا لم يحدث، حتى لا تسوء حالة “المجنونة”؛ لكني لست بمجنونة، بل إنهم المجانين لاعتقادهم أن ابتلاع أكثر من سبع أقراص في اليوم بإمكانها تخدير ألمي، أو لأصبح فاقدة للذاكرة؛ فالألم لا يمحى من الروح، بهذا الشكل، وبهذة السهولة، كما أنه لا يوجد طبيب نفسي يستطيع أن يمحيه ببساطة؛ لأن الطبيب النفسي القادر على تخدير روح الإنسان لم يولد بعد. أتمنى ألا يحدث ذلك، أبدا؛ لأن النفوس المخدرة لا فائدة منها، حيث تصبح أرواح مظلمة، ذابلة وظمآنة.
“نحن نفهمك يا باتريسيا، نشعر بك”.. يكررون، مرارًا وتكرارًا، وتبدأ وجوههم في التحول متلبسة نفس الأقنعة التي نرتديها جميعًا عندما نحاول محاكاة آلام الآخرين.
نقول “أنا أشعر بك”، لكنه في الواقع نتظاهر؛ لأننا في أعماقنا نعلم أن الشعور بما يعانيه الآخر أمر مستحيل، واليوم جاء دوري؛ فألمي عظيم لدرجة أنني لا أفهم نفسي.
ينظر الممرض، وفي عينيه قلق، فقد اعتقد أنه لن أستفيق تمامًا. هذا ما أثار قلقه، هو خائف لكنه يتظاهر بالعكس -لم أره من قبل- ليمنحني الطمأنينة، خوفه بهذه الطريقة، يهدئني. قلقه يجعلني أشعر بالأمان والسكينة.
يقوم عمال النظافة بإفراغ المزهريات الموجودة على أحد الطاولات في الغرفة، مبتسمين لي. أما الأطباء فيتحدثون إلى أخي، وهم يسترقون النظر نحوي؛ من ثم جعلوه يوقع ملف مليء بالأوراق.
في اللحظة التي تبدأ الممرضات في تغيير ملاءات السرير، أجبرت على النهوض. ينزعون الملاءات وكأنني لست هنا، كأنني غير موجودة.
أنهض وأخبر كارلوس أن ينتظر بضع دقائق؛ لأستبدل ملابسي ونخرج. ينظر بأريحية، حينئذ، ويتنهد، عيناه تلاحقني إلى باب الحمام. أخبره أنني أفضل الخروج وحدي، يرد بالرفض ويصر أنه سينتظر.
نسير في ممرات العيادة ذراعًى بذراعه، في صمت. تلقى علينا الممرضات التحية وتتمنى لنا السلامة. نبدو كزوجين فى طريقهم لمغادرة الكنيسة. راقني كثيرا أن ياخذ أخي بذراعي.
خرجنا إلى الشارع، صخب الناس أذهلني؛ فالواقع يربكني ولا يسمح لي بالتفكير. لا أريد أن أركب السيارة، لا أريد الاعتماد على أخي ورومينا، لكنني أعلم أن ليس لدي خيار. ظللت متعلقة بذراع كارلوس ثم تركني أصعد وحدي للسيارة.
شاحنة أخي متوقفة عند مدخل سيارة الإسعاف، بجانب الأمن؛ بينما أقترب، أتساءل كيف تجرأت رومينا على الوقوف في ذلك المكان. أنا متأكدة من أن أخي طلب منها الوقوف هنا؛ حتى يسير كل شيء بشكل أسرع ولا أضطر إلى السير حتى موقف السيارات. متأكدة، أيضا، أنهم تجادلوا بسبب ذلك لأن رومينا لا تحب كسر أي قواعد بل تحب الجدال و السجال.
يصعب علي المشي فمازلت أشعر بالضعف، لكنني لا أريد لكارلوس أن يلاحظ ولا أريد أن أثير حزنه.
مرة أخرى أفكر في الحبوب لأنها هى التي تجعلنى هكذا. هذة الحبوب المباركة والملعونة هى المسؤولة عن طحن وتخدير كل موقف أمر به. تجعلني أرى العالم من خلال زجاج تغمره مخاوفي. ذاتها، هى تلك الحبوب التى تمنحنى الدعم كواقي ضد الصدمات، بحيث يكون سقوطي الحر تجاه الواقع أقل إيلامًا.
يفتح كارلوس الباب الخلفي، يمد يده اليمنى وبتلك الإيماءة دعاني لركوب الشاحنة.
رومينا، التي تجلس في مقعد السائق -غالبا هي التي ستستمر في القياة- تدير رأسها وتغمز لي بعينها.
أجد صعوبة في الصعود بسبب حجم الشاحنة، كان علي فعل ذلك وحدي لكن ليس لدي قوة فقدماي ترتعشان، أشعر أن جسدي يخونني ولا يستجيب لأي من الحركات التي أحاول القيام بها. أخي الذي جلس بالفعل في مقعد الراكب الأمامي، يلاحظ ذلك، وينزل لمساعدتي فأشعر بالخجل، أشعر بالخجل مرة أخرى، وبالأسى على حالي.
أخيرًا، نجحت في الصعود إلى الشاحنة واستقريت على المقعد الخلفي الضخم المصنوع من الجلد البيچ، حيث تذكرني رائحة الجلد المنبعثة من المقاعد الجديدة بسيارة دفع رباعي اشتريتها في التسعينيات. أنتقل بذاكرتي، لبضع ثوان، لتلك الأوقات القديمة. أشعر أنني في العشرين أو الثامنة عشرة أو الخامسة عشرة.. مرة أخرى.
تبدأ رومينا بالتحرك ويبدو أن الشاحنة تطير. يبدو، أيضًا، أن الشاحنة تتحول إلى كبسولة لا تسمع خلالها الضوضاء.. لا شيء أبدا.
أبارك لرومينا على الشاحنة وأشكرها على مرافقة أخي إلى المستشفى. ينظر أخي لي في المرآة العاكسة ويومئ برأسه. نظرته كأنها تشكرني على هذه اللفتة. إنه يعلم أنني أفعل ذلك من أجله، كلانا يعرف ذلك. أشعر وكأنني روبوت. كل ما أفعله، أفعله بهدف وحيد هو أنهم يدركون أنني ما زلت متصلة بواقع يبدو غريبًا بالنسبة لي ولا ينتمي لي. الآن وبصرف النظر عن كوني مريضة، أشعر أنني مزيفة.
ترد رومينا: “شكرا على ماذا، باتيتا. نحن نفعل ذلك لأننا نحبك؛ لا تشكرينا على أي شيء.”، أعلم أنها لا تحبني، لكني لن أعلق أو أجادلها . لا أشعر أنني بخير، وعندما يشعر المرء أنه ليس بخير؛ لا يكون فى حالة تسمح بالمجادلة والمناهدة.
أتكئ وأميل على باب الجانب الأيمن، ظللت أنظر من النافذة. مكثت في المستشفى نحو ثلاثة أشهر. كل شيء يبدو جديدًا بالنسبة لي. الأشجار، المحلات التجارية، الشارع والناس، حقا أشعر بالغربة.
ترفع رومينا صوت الراديو وتبدأ في الغناء، تسألني ما إذا كان ذلك يزعجني وأقول لا. بينما ينتهز أخي الفرصة لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني من هاتفه المحمول، أغلق عيني لكني لا أريد النوم.
تصيح رومينا: “ها قد وصلنا، باتيتا!”.
أعتدل فى الجلوس ولا أعلم ما إذا كنت قد نمت بالفعل أم لا -لأنني لا أعرف أبدًا ما إذا كنت نائمًة أم مستيقظًه؛ حيث لا تسمح لي الأقراص بالتمييز- لكن من نافذة الشاحنة أستطيع أن أرى أننا وصلنا إلى منزلي حيث الطوب الأحمر وشجرة الليمون عند المدخل.
أريد أن أنزل، لكن لا أستطيع. أحاول فتح باب الشاحنة، لكن أقفال الأمان لا تسمح لي بذلك. يشير أخي لي أن أنتظر و ألا أنزل بمفردي، يساعدني، ويتسلل لي مرة أخرى إحساسى بالمرض، أني شخص لا فائدة منه، منتهي الصلاحية. مرة أخرى أشعر بالأسى لكلينا، تجاهه وتجاه نفسي.
بيتي على حاله، لم يمسسه شيء، ذلك المنزل، الذي كان السبب فى طردي. تخلى عني وتركنى مستلقية في سيارة إسعاف، ظهر ذلك اليوم المشؤوم من شهر كانون ثان. هو نفسه، كما هو، دائمًا. لم يغيروا أي شيء في المكان، ولا حتى منفضة السجائر، نفس الأثاث، نفس الألوان، نفس الروائح والجدران. كل شيء في نفس المكان كما هو الحال دائما، كل شيء عدا بوليتا، ابنتي، التي لا تتواجد في أي مكان.
بكل صدق، كل ما أريده الآن هو أن تنزل بوليتا لتحتضنني، كما هو المعتاد دائمًا. لكنني أعلم أن هذا لن يحدث؛ لهذا السبب، وعلى الرغم من شعوري برغبة كبيرة في الصراخ باسمها بكل حزن ويأس، إلا أنني أخفيت ذلك والتزمت الصمت. التزمت الصمت؛ لأنني أعلم أنها لن تظهر؛ وحتى لا يبدأون في إخباري أنني مجنونة أو بالأحرى، حتى لا يبدأون في التفكير بأنني أكثر جنونًا مما يعتقدون.
إن حصول المرء على تصريح خروج، وبعد ساعتين يتحدث بشكل سيء للغاية عن الفريق الطبي لمؤسسة ما، لا يصح، إضافة لكونهم لطفاء جدا معي؛ لا يستحقون منى مثل هذا الاشمئزاز.
أنا حرة..
حرة في أن أفعل ما أريد،
وهذا هو الشيء الوحيد الذي يهمني الحفاظ عليه.
أقف في منتصف الصالة لآخذ نظرة عامة. أريد لعيني أن تأكل المنزل. هذا ما يظل معنا إلى الأبد. أريد أن أمتلك ما هو بالفعل ملكي. أحتاج أن أشعر أن هذا المكان لا يزال يعيش في داخلي وأنه قادر على أن يتعرف علي وأنه كان ينتظرني.
يظل المرء، دائما، متعلقا بالأماكن التى تساهم فى تكوينه، وهم، أيضًا، لا يمكنهم التخلص منا بهذه السهول؛ فالأجواء التي (ذات يوم) كانت تؤوينا دائمًا، الآن، تفتقد جوهرنا، وجودنا وروحنا، كما لو كانوا بحاجة إلى وجودنا هذا حتى يظل ويبقى كما هو على حاله، كما لو أن غيابنا حوّلهم إلى أجزاء من أماكن وزوايا تائهة، زوايا لا يمكن أن تعتاد على اليتم. بدأت في السير ببطء، أشعر أن كارلوس ورومينا يسيران ورائي. أستطيع أن أشعر بخطواتهم على كعبي من أنفاسهم، رائحتهم. أفكر في الالتفات، سبهم، وأن أخبرهم ليتركوني وشأني، وألا يتعقبوني. وأنني بحاجة لأن أكون وحدي، لكن مرة أخرى ألتزم الصمت؛ فلا أريدهم أن يظنوا كوني مجنونة أو بالأحرى، لا أريدهم ليدركوا أنني أكثر جنونًا مما يعتقدون.
كل شيء صامت، لا أحد يتحدث. أنا لا أسيء لهم، وهم لا يبررون تصرفاتهم، فالكثير من الصمت يصيبني بالذعر، والكثير من الهدوء يصيبنى بالحزن.
بوصولى إلى النافذة المطلة على الحديقة، أشعر أني متحجرة، مشلولة في ذلك المكان؛ كأن جسدي تسمر بالأرض رغما عني. أحاول فتح النافذة، لكني لا أستطيع. ما زال كارلوس ورومينا لم ينبسوا ببنت شفة. أشعر بضوضاء تأتي من المطبخ. فأدير رأسي ببطء.
أجد ماريا متكئة على إطار الباب، تنظر إلي بأعين مليئة بالحب والاشتياق.
تردد: “فتاتي، هل تعرفين منذ متى وأنا في انتظارك؟”
وتبدأ في البكاء بحرقة.
يحدجها كارلوس بوجه ممتعض؛ فتدرك ماريا ما فعلته وتنظر بالارض. بعد بضع ثوان نظر إلي وابتسم وهو يظهر هدوءًا زائفًا مفتعلا. أشعر بالأسف والأسى لأجلها. حقا أشعر بذلك لأجلها ولي.
الآن، الشخص الذي يتفحص كارلوس بوجه ممتعض هو أنا، لاحظت ماريا ذلك ونظرت إلى الأسفل. أقترب منها وأحتضنها. أعانقها بقوة لا أملكها، لكنها دائمًا كانت تعرف كيف تحتضني. كانت أحضان ماريا، بطريقة ما، لها دائمًا وظيفة واحدة وهي إعادة بنائي؛ فكان حبها ورعايتها دائمًا مسؤولين عن تجميع أجزائي معًا وإستعادة نفسي.
ظللنا متعانقتان لبضع ثوان.
ثم تهمس ماريا في أذني: “كل شيء جاهز في الغرفة يا طفلتي”.
عندما أعانقها، أشعر أن شيئًا من رائحة باولا بقي معششا في شعرها؛ لذا لا أريد أن أنفصل عن أحتضانها، لكنه أعلم، لابد ألا أفعل ذلك. أسير نحو الدرج بينما هي تتبعني.
لا يزال كارلوس ورومينا جالسين على كرسي غرفة الطعام. ينظرون إلينا وهم ممسكين بيد بعضهما البعض ومتوترين. لا يريدوننا أن نصعد إلى الغرفة، لكن بما أنه لا يزال لديهم بعض الكرامة فآثروا الصمت، ثم هممت أنا وماريا فى صعود الدرج.
إلى أن لم يعد بإمكان أخي التحمل أكثر، وصرخ بما كان يريد أن يقوله لي منذ وصولنا.
يصيح من الأريكة: “باتو! أدخلي وأحضري الحقائب. انظري، ليس لدينا وقت، تم بيع المنزل وسيصل أصحابه في صباح الغد”.
أدير رأسي وأحدق به أو بالأحرى، أدير رأسي وأحدق بالاثنين. إلى زوجة أخى وله، ما ينفك أن يترك أخي يد رومينا ويبدأ في حك كتفه. لا أعرف لماذا يحك كارلوس كتفه دائمًا عندما يكون متوترًا.
يقول كارلوس: “لا نفعل ذلك نكاية بك أو لمضايقتك باتي؛ بل نحن نفعل ذلك لأننا نحبك، فهذا المكان يسبب لك الحزن، وأنت تعرفين ذلك”.
تضيف رومينا: “لا يمكنك أن تتخيلي مدى جمال وروعة الشقة التي استأجرناها لك، ستحبينها. اذهبي واحزمي أغراضك داخل الحقائب التي أحضرناها لك، هيا، اسرعي.”، وهي تحاول أن تبدو قوية وثابتة؛ لكن صوتها مرتعش.
لا أعرف لماذا، في تلك اللحظة تحديدا، أذكر كلمات طبيبي النفسي. تلك التي يكررها لي دائمًا في كل مرة نلتقي فيها قائلا: “لا تشعرى بالذنب، باتريسيا، الحياة أحيانًا، تفاجئنا ولا يمكننا أن نضع دائما كل شيء تحت السيطرة.”، أعلم أنه يقولها ليريحني، وأعلم أنه يقولها حتى لا أشعر أنني سيئة إلى هذة الدرجة، لكن هذه الكلمات لا طائل منها لأنه؛ في حقيقة الأمر، لا يعرف حقًا ما يقول. ليس لديه أدنى فكرة عما يقول؛ لأنه لم يمر بما مررت به. فهو ليس بمكاني. لم يدخل ليحضر كأس من العصير وعندما خرج رأى ابنته ميتة تطفو على جانب حمام السباحة.
لو كنت استغرقت وقتا اقل فى احضار العصير..
لو لم أتحرك من جانبها..
أتنفس بصعوبة، تصبح الرغبة في القيء لا تطاق. يداي باردة ومتعرقة. أتجاهل كل ذلك وأحاول ألا يبدو ذلك؛ فلا أريد لأحد أن يدرك ما يحدث لي، أستنشق نفس عميق وأذفره ببطء، من ثم أخبر كارلوس أنه قبل المغادرة أحتاج الخروج إلى الحديقة. دعني أخرج إلى الحديقة، ولو لبضع ثوان، فقط.
تنهض رومينا من على الكرسي، كما لو أن زنبرك ينفضها.
تصرخ قائلة: “لا!”؛ فيجذبها أخي من ذراعها ويسكتها ويجلسها.
ينظر إلي، أنظر إليه. يسود الصمت التام؛ بينما ماريا التى لا تزال واقفة بجانب الدرج، تقترب مني وتمسد رأسي وتقول: “دعها، سيد كارليتوس، إذا تحتاج الخروج إلى الحديقة لبرهة، دعها، فسوف أذهب معها.”
يرد أخي: “أنا أيضًا سأرافقها”.
تنهض رومينا وتسأل عما إذا كان بإمكانها أن تأتي معنا فما كان من كارلوس إلا انه أجلسها بالضغط على راسها.
تقترب ماريا من النافذة، تسحب الستائر وتفتحها بحذر. كما لو أنها لا تريد أن تفتحها، كما لو كانت النافذة ستنكسر، كما لو أن رغبتي في العودة بالزمن إلى الخلف مصنوعة من الزجاج.
أشاهد الحديقة التي تبدو غريبة بالنسبة لي. فالمساحة التي اعتادت أن تكون لي، لكنها لم تعد ملكًا لأحد، ترحب بي بقوة.
تغيرت الحديقة فعلا، حيث أصبحت الآن، مليئة بالزهور وشجيرات الورد أجمل من أي وقت مضى. أشكر ماريا على الاعتناء بها. تتأثر مرة أخرى وتبدأ في البكاء. لكن كارلوس الآن لا ينظر إليها. فقط ينظر إليّ، أخي لا يرفع عينيه عني.
تقترب رومينا قائلة: “حسنا ها قد انتهينا، باتو. يمكننا الدخول الآن” و تسألني وهي تجذبني من ذراعي: “ها، هل رأيت كم هي جميلة شجيرات الورد؟”.
يقوم أخي بإيماءة بيده طالبا منها أن تقوم بإطلاق سراحي. حمدا لله.
أواصل المشي نحو حمام السباحة، يتبعني كلا من كارلوس، ماريا ورومينا في صمت وعند الوصول، انتابتني قوة لا أعرف من أين أتت جعلتني هادئة، ثابتة، مشلولة، على حافة نفس حمام السباحة الذى كان مسؤولا عن إغراق رغبة بولا في الحياة والعيش.
يبدو البلاط الأزرق في قاع المسبح مثل السماء نفسها التي رأيتها هذا الصباح في المستشفى.
المسبح فارغ فليس به قطرة ماء.. قطرة حياة. ظللت أحدق لوهلة في الأوساخ التي تغطي الشباك ولا تسمح لها بالتنفس بينما ترقص الأشجار على إيقاع رياح مخدرة فهى بقدر ما تغرقني، بقدر ما تؤلمني.
أرفع رأسي وأنظر إلى كارلوس، ينظر إليّ. أعتذر منه، يثور ويهم بالجري، يجري، لكنه لا يصل.. أطلق النار على رأسي.
طبيبي النفسي على حق، لا أحد يستطيع أن يضع كل شيء تحت السيطرة. و.. ولا هم، أيضا، يمكنهم ذلك.
…………
*لوسيانا برودان
- صحفية وكاتبة ومذيعة بالاذاعة الوطنية ولدت في عاصمة الارجنتين بوينس آيرس عام 1977.
- اصدرت اول مجموعة قصصية لها عام 2017 بعنوان En sangre viva التى حققت صدى واسع المدى
- اصدرت ثانى مجموعة قصصية لها عام 2020 تضم 16 قصة تحت عنوان la perfecta casualidad de seguir vida المأخوذ منها هذة القصة .