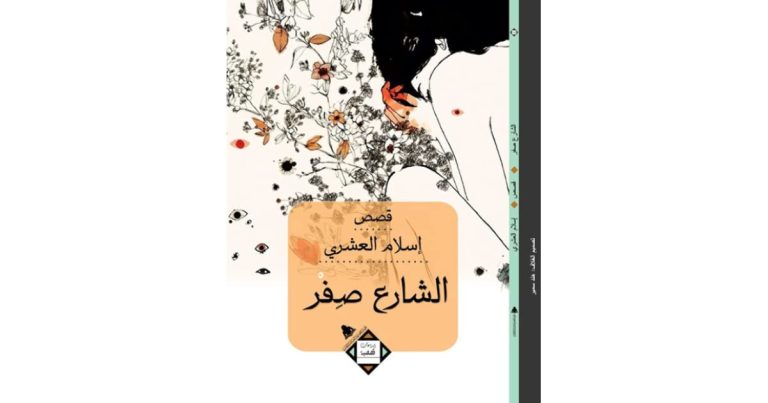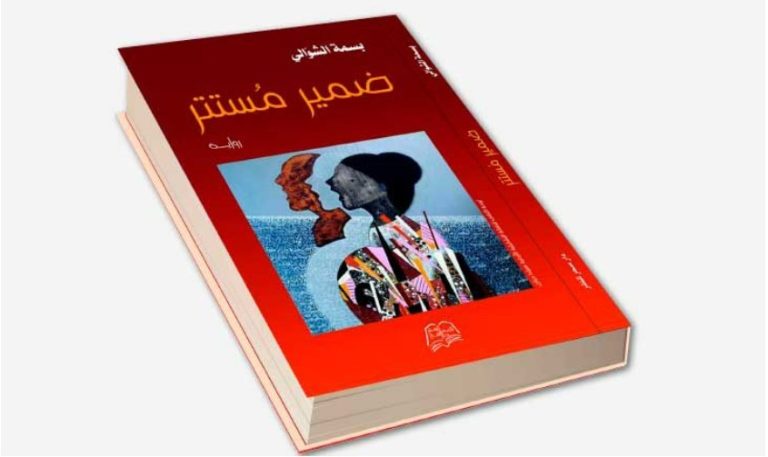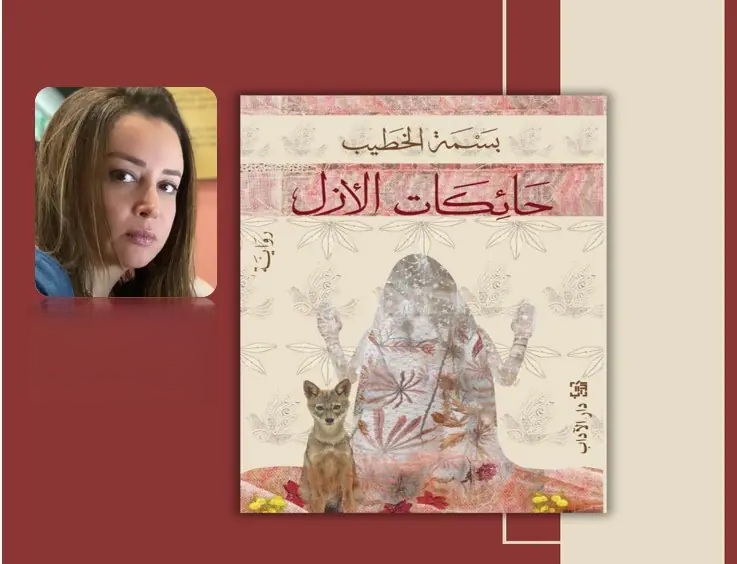حامد موسى
سردية عن الأرض والطين والأيام الخوالى
حين أستعيد طفولتي في الريف، أول ما يتبادر إلى ذاكرتي هو الطين. تلك المادة السوداء اللينة التي كانت ملعبنا ومسرح خيالنا، ننهلها من حافة الجداول كأننا ننهل من نبع سحري يمنحنا الفرح، ونغمس فيها أيدينا الصغيرة بحماسة، لا لنبني منها بيتًا أو سورًا، بل لنرشق بها بعضنا البعض في نزق طفولي بريء، ونضحك… نضحك بملء قلوبنا كأن الطين يغسل أرواحنا قبل أجسادنا.
الطين في طفولتي لم يكن مجرد تربة مبتلة، بل كان حياة كاملة. كنا نجلس في حلقات، نشكّله بأصابعنا وننفخ فيه من خيالنا، نصنع منه دمى على هيئة أبقارًا وجواميس وحميرًا، وكأننا نعيد إنتاج عالمنا الصغير بأدوات بسيطة. كان لكل تمثال صغير نصيبه من الفخر والاعتزاز، وكأننا خلقنا شيئًا من لا شيء. ولمَ لا؟ أليس الطين مادة الخلق الأولى؟ أليس الله – سبحانه – قد خلق الإنسان من طين؟ لعل هذا يفسر سر حنيننا الدفين إليه، هذا الحنان الغامض الذي نشعر به كلما لامست أيدينا الطين، كأنها تلمس أصلها.
لم يكن التمرغ في الطين مجرد لهو، بل طقس طفولي مقدس، نخلع فيه ثيابنا ونرتمي في برك الطين بأجساد عارية وضحكات طليقة، نتمرغ حتى لا يبقى فينا شبر لم تطله يد الطين. كنا نخرج من الحمام الطيني كأننا وُلدنا من جديد، كأن الطين أعاد صياغتنا، طهّرنا من صخب العالم وكبرياء الكبار.
حتى فرن الخبز كان من طين، ذاك الفرن الدافئ الذي تشع منه رائحة الخبز الساخن كأنها رائحة الحياة نفسها. بيت الطين كذلك، كان سقفًا يأوينا وجدرانًا تحضننا، لا يصدأ ولا يغدر، بل يبرد في القيظ ويحنو في البرد، وكأنه صدر أمٍّ ثانية، خُلق من نفس المادة التي خُلق منها أبناؤها.
الطين لم يكن لعبة فحسب، بل ذاكرة وروح، كان يربينا كما نلعب به، يعلمنا التشكيل، الصبر، الانتماء، ويحفر في وجداننا أولى دروس الارتباط بالأرض. وحين كبرنا، وابتعدنا عن ضفاف الجداول، وظننا أن الحياة في المدن قد أنستنا رائحة الطين، عدنا إليه على هيئة شوق، أو حنين، أو حتى حلم عابر.
فالطين، مهما بدا متسخًا في أعين الكبار، يبقى في أعماقنا طاهرًا، لأنه الأصل. هو حنان الأرض، ودفء الخلق، وسر الحياة الأول. ومنه نبدأ… وإليه نعود
لم أكن أعرف أن في الطين قلبًا… لكنه كان يدقّ كلما لمسته.
كنت أصغر من ظلّي، أركض خلف صوت الماء حين ينكسر على الحصى، وأرتمي عند ضفة الجدول كمن يعود إلى صدر أمّه بعد غياب.
لم نكن نحتاج إلى ألعاب تلمع أو أزرار تصدر أصواتًا. كان الطين كل شيء.
حين تغوص يدي فيه، كنت أحسُّ أن الأرض تبتسم لي، تنحني لتلعب معي، تسلّمني نفسها بلا خوف.
نصنع منه أبقارًا لها قرون كبيرة مثل التي تُرعبنا حين تمرّ قرب بيوتنا، وجواميس بعينين صغيرتين حزينة، وحميرًا بعنق معوجّ وضحكة مقلوبة.
كانت أصابعي تعرف وحدها كيف تُنطق الطين.
كان سعيد دائمًا يربح في النحت، يضغط بسبابته على أنف الجاموسة فيخرج كأنّه حقيقي، بينما كنت أكتفي برأس مكسور وذيل مفقود، ثم أضحك، وأرميها في الماء، لأصنع غيرها… الطين لا يغضب.
وكنا نتمرغ. آه… كأنّ الطين أمّ كبيرة فتحت ذراعيها، نخلع قمصاننا، ونرتمي فوق بطنها، نضحك، نغرق، ثم نقوم، وجوهنا مغطاة بالسواد الطيني، كأننا جنود في معركة من السعادة.
لم أكن أفهم لماذا يصرخ الكبار عندما نرجع إلى البيت وثيابنا ملطخة، كنت أظنهم لا يحبون اللعب. لم أكن أعرف أنهم نسوا…
نسوا أن الله نفسه صنعنا من طين.
كان الوقت ظهرًا، حين عدتُ إلى القرية بعد سنين طويلة.
كانت البيوت الجديدة قد نبتت من الأسمنت والخرسانة، مثل نبات غريب لا يعرف التربة.
لكن الطريق القديم إلى الجدول ظل كما هو، ملتفًّا كذيل بقرة، محاطًا بزهر الخبيزة ورائحة البلل.
مشيت عليه بخطى خفيفة، كأن الأرض قد تنكسر تحت ثقل ذاكرتي.
وفي رأسي، تدفّقت الصور كالسيل، أصوات الضحك، صراخ فوزي وهو يُرشق في عينه، وجه سعيد الملطخ وهو يحمل تمثاله الطيني كمن يمسك عرشًا.
وأنا… أنا بيدين صغيرتين، أصنع حصانًا لا يقف، وأضحك لأنه لا يقف.
جلست عند حافة الجدول.
كانت المياه أهدأ من ذاكرتي، وكان الطين… لا يزال هناك.
مددت يدي إليه.
يا الله… ما زال كما هو!
ناعم، دافئ، يلتفّ حول أصابعي كأنه يعرفني. كأنه كان في انتظاري.
عدتُ طفلًا بلحظة. لا أحد يراني. لا أحد يصرخ بي.
بدأت أشكّله بإصبع مرتعش، لا لأصنع حيوانًا هذه المرة، بل وجهًا.
وجهًا لم أكن أعرفه، لكنه يشبهني.
طفل من طين، بعينين واسعتين، وشوق لا يُقال.
كنت غارقًا في تشكيل وجهي الطيني، حين سمعت صوتًا خلفي، خافتًا… مبحوحًا:
“لسّا بتحب الطين يا واد؟”
استدرت.
كان الجد واقفًا هناك، بعصاه المعوجّة، يرتجف مثل شجرة مسنّة هزّها النسيم.
وجهه المجعّد يشبه قطع الطين اليابسة، متشققة، لكن دافئة.
ابتسمت له كأنّي لم أبتعد عنه عشرين سنة.
“هو اللي بيحبني يا جدي…”
قالها لساني، بينما قلبي كان يقول: “هو اللي لَمّني من جوّا.”
اقترب الجد، جلس على حجرٍ بجواري، بصعوبة، ثم نظر إلى التمثال الطيني بين يدي، وقال:
“كنت بعمل زيّك زمان… بس أنا كنت أشكّل من الطين وجوه الغايبين.”
نظرت إليه.
قالها وكأن الغائبين كانوا كثيرين، وكأن الطين كان يحفظ ملامحهم أكثر من الذاكرة.
ثم أردف، وهو يعبث بطرف عكازه في الطين:
“عارف ليه الطين حنون؟… عشان بيشيل كل حاجة من غير ما يتوجّع. نمشي عليه، نزرع فيه، نغرز صوابعنا، ونرجعله في الآخر… وساكت.”
صمته بعدها كان أبلغ من الكلام.
مرت لحظة.
ثم قال بهمس:
“كنت فاكر إنك مش راجع.”
فأجبتُ، دون تفكير:
“أنا ما رُحتش… كنت بدور على الطريق بس.”
مددت يدي من جديد إلى الطين، أضغطه بين كفّي كما كنت أفعل وأنا طفل، لكن هذه المرة، أحسست بشيء مختلف…
كأنني لا أُشكّل الطين، بل أستخرج منه نفسي.
كأن شيئًا نائمًا بداخلي كان ينتظر هذه العودة، هذا اللمس، هذا الذوبان في الأصل.
قال الجد وهو يراقبني:
“عارف يا محمود… ربك لما خلق آدم، كان يقدر يقول له (كن) فكان.
بس اختار الطين، مش لأنه أرخص، بل لأنه أغنى.
الطين بيشيل في قلبه كل الألوان… المطر، النار، الدموع، والبذور.
والإنسان زيه، لو ما تعرفش تحبه وقت ما يكون مُبلّل ومتّسخ ومش متشكّل، ما تستحقّوش وهو جافّ وثابت.”
سكتَّ، وسكتَ هو.
كان للصمت صوت في حضرة الطين.
ثم رفعتُ التمثال بين يدي، ذلك الوجه الطيني الذي يشبهني ولا يشبهني، يحمل عينيّ كما كنت أراها في المرآة حين كنت في الخامسة: ممتلئتين دهشة، وبراءة، وأسئلة لم أعد أعرف لها أسماء.
قال الجد:
“هتسيبه هنا؟”
نظرت إلى الوجه، ثم إلى الجدول، ثم إلى شجرة الجميز الكبيرة التي شهدت كل أعمارنا.
أجبت بهدوء:
“هأدفنه هنا… زيه زي البذور.”
حفرت حفرة صغيرة بأصابعي في الطين الرخو، ووضعت فيها الوجه الطيني برفق. كأنني أُرقد طفلاً لا يعرف النوم. ثم غطيته. لا بالحزن، بل بالحنان.
في طريقي إلى البيت، كنت أمشي ببطء.
الطين كان لا يزال بين أصابعي.
ولم أشأ أن أغسله.
أردته أن يظل هناك، ليذكرني أنني لم أُخلق من صراخ، ولا من أحلامٍ زجاجية… بل من طين.
ولأنني خُلقت منه، سأحنّ إليه كلما تعبت…
سأرجع إليه كلما تهت.
سأضع يدي فيه، ليس لألعب، بل لأطمئن.
الطين، يا جدّي، ليس أرضًا فقط.
الطين أمّنا الأولى.
وما من ابنٍ ينسى يد أمّه.
عدتُ إلى المدينة في المساء، والشمس تذوب خلف الأبراج، لا تغرب بل تنسحب… كأنها لا تحب هذه الجدران.
دخلت بيتي في الطابق العاشر، تحيطني الجدران الصامتة من كل اتجاه.
لا رائحة… لا نفس… لا ظلّ يدٍ مرّت على الجدار لتصنعه.
الإسمنت أملس، ميت، لا يسع ذاكرة.
لم أجد فيه ما يشبه البيت.
جلست على الأريكة، حدّقت في الحائط، فشعرت أنه لا يراني.
في بيتنا الطيني القديم، كانت الجدران تُحدّثني، فيها خدوش قديمة من يدي، رسمة خفية من أخي، بصمة كفّ صغيرة لأمي حين كانت تغلق الباب علينا آخر الليل.
حتى الجدار هناك… كان له قلب.
هنا؟
الحوائط تنظر إليّ بعيون باردة.
لا تحفظ صوتي، ولا تحتضن خطاي.
لا حنان في الإسمنت.
هو فقط قويّ… كقبر.
أغمضت عيني، وعدتُ بخيالي إلى بيتنا الطيني.
تذكّرت ليالي الشتاء، حين تتشقّق الجدران قليلًا فيباغتنا الهواء، لكننا كنّا نشعر أننا في حضن دافئ.
كأن الطين نفسه كان يغلق علينا بابه كي لا نتبعثر.
في بيت الطين، لم نكن وحدنا.
كان البيت يشاركنا الخبز والدعاء، والبكاء المكتوم.
وهنا؟
كل شيء معزول.
حتى الذاكرة لا تجد لنفسها مكانًا.
كأن البيوت الحديثة مصمّمة لطرد الحنين، لا لاحتضانه.
وقفتُ عند النافذة، أنظر إلى المدينة، شوارعها ممتدة كخط مستقيم لا يحني ظهره لأحد.
وأدركت فجأة أنني لم أعد أفتقد القرية فقط… بل أفتقد نفسي كما كنت هناك.
الطين، يا جدّي، لم يكن ترابًا مبتلًّا.
كان جلد البيت، وذاكرة الجدار، وقلب الأرض.
لهذا يحنّ الإنسان إليه.
لأنه منه.
لأنه فيه دفء لا تصنعه الكهرباء، وأمان لا تقيسه الأقفال.