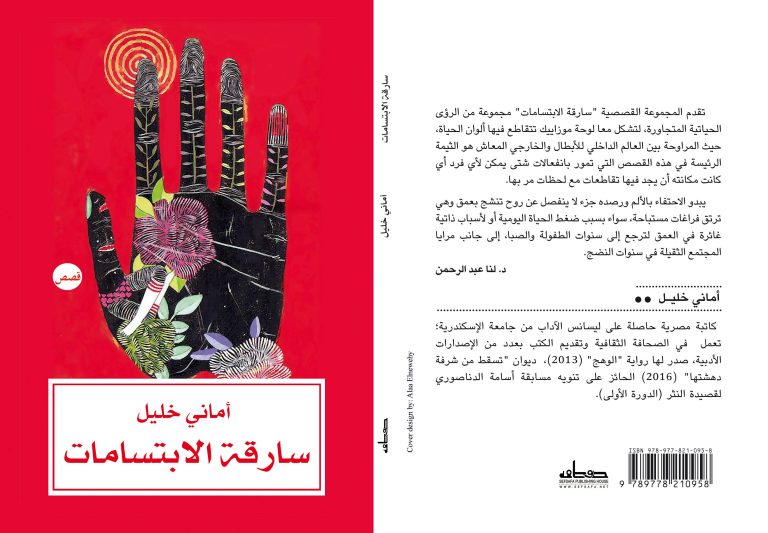ياسمين الغمري
أصبح يشبه الجدران القاتمة التي يسكنها، صوت المذياع أنسه الوحيد، رتابة الحياة لا تخلو من الاستيقاظ في السابعة صباحًا ليلتقط صحيفة “الغد” بيده اليسرى ويضعها على طاولة خشبية متهالكة، وباليد اليمنى يضع الفرشاة في صندوق الطلاء الأبيض، ثم يلتقطها وبها يمحو كل ما كُتب اليوم في الصحيفة من أخبار قتل وحرق واغتصاب أوطان، يستغرق الأمر عشر دقائق، فور انتهاءه يطلق تنهيده طويلة، الأمر أصبح على ما يرام، يأخذ الصحيفة من فوق الطاولة، ويجلس على الأرض القرفصاء، وبقلم أخضر يكتب الأخبار التي يريد قرأتها، مع تصميم جديد للصحيفة، أكثر خبر كان يكتبه (ازدهار صناعة الجرمافون في الوطن العربي) ربما لأنه في حالة حنين مع ذكريات الزمن الجميل التي ظلت عالقة معه منذ كان مراهقًا حتى كسر حاجز الثلاثين.
يوميًا يكتب الخبر بلا طائل، لا يمل ولا ييأس، فلا يوجد شيئًا أخر يفعله في يومه سوى محادثة عصفوره الجميل الذي يسكن الشجرة ذات الأغصان الثائرة أمام منزله، ما هذه الرتابة التي يرتاح فيها!
على غير العادة، دق جرس الباب في العاشرة – جرس الباب لا يدق في العاشرة ولا غير العاشرة- يتجه نحو بابٍ خشبي طويل القامة ذو مقبض نحاسي اللون، يسأل من الطارق، يجبه صوت نسائي..
ـ سارة، موظفة البريد المصري لك معي رسالة من شخص ما.
يفتح الباب ولا يعبأ بجمال شعرها الأسود المنسدل على كتفيها ولا طول قامتها وجمالها الطفولي، يأخذ المظروف ويمضي استلامه، يغلق الباب خلفه دون أن يقول لها سلامًا، هو دائما هكذا ينسى يقول وداعًا، يرحل فقط دون التفوه بكلمة، يترك المظروف وحيدًا بين أوراق كتاب يحمل اسمه، قد كتبه عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، طبعه على نفقته الخاصة، لكن سرعان ما انتهت حياته الأدبية بعد وفاة أخيه، توقف عند الموت طويلًا، أرهقته الأسئلة ومزقه الصدى، تسع سنوات مروا وهو لا يزال قابع عند الحادية والعشرين وحيدًا، وفي ظل انشغاله بترتيب مكتبته، جاء صوت المذياع يحمل خبرا سيئ.
ـ هناك توقعات بحدوث هزة أرضية عنيفة، على الجميع توخي الحذر.
علق ساخرًا وهو ينظف الأتربة العالقة بالمكتبة.
ـ ماذا عليَّ أن أفعل؟ احتضن البيت مثلا حتى لا يسقط! كم هي نشرات الأخبار سخيفة وكم هم القائمون عليها أكثر سخافة!
ما لبث الانتهاء من جملته حتى اهتز البيت وسقطت المكتبة على الأرض، فلعن الزلزال ونشرات الأخبار والكون والوجود لأن عليه ترتيب المكتبة مرة ثانية، أخذ يجمع الكتب ويرتبها وفقًا لتاريخ قارئته لها، توقف كثيرًا عند رواية الطريق لنجيب محفوظ وألقى نظرة سريعة على ورقها الذي صار أصفرًا، سقطت من الرواية قصاصة صغيرة تحمل رسالة من رأفت؛ أحد أصدقاءه الأوفياء الذين غابوا في زحام الحياة، ولا يُعرف عنه الآن أي وسيلة تواصل، قرأ كلمات صديقه ووعدهما بالبقاء معًا حتى نهاية الكون، فدمعت عيناه، وبهدوء نفس خاوية خلال خمسين دقيقة عادت المكتبة كما كانت وانتهت الهزة الأرضية، وشرعت هزة جديدة في قلبه هو، فقد خفق على غير موعد مشتاقًا إلى صديقه رأفت، فعاد إلى الرواية وأخذ القصاصة وعلقها على الجدار القاتم علها تمنحه بعض نبضات الحياة، وذهب يطمئن على عصفوره، ليجد الشجرة سقطت وانتحر العصفور، لم يفعل شيئًا سوى أنه ابتلع قرص منوم وذهب في سبات عميق.
في اليوم التالي استيقظ في السابعة كالمعتاد، انتهى من عملية طلاء الأخبار وكتابة غيرها، فكم يحب هذا الروتين الذي خصص له غرفة مهمتها الوحيدة استيعاب ألآلاف النسخ التي يعيد كتابتها! اليوم وهو يغلق باب الغرفة وقع نظره على قصاصة صاحبه، وتعجب لماذا لا يبحث عنه، فالدنيا بلا صديق مقبرة متآكلة، خاصة أنه الآن بعد انتحار العصفور أصبح وحيد مثل أسد في غابة مهجورة لا يوجد فيها سواه، وحضرته مقولة للشافعي كان صديقه دومًا يرددها “سلاما على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوقًا صادق الوعد منصفًا”، فتنهد وعزم على الاتصال بأصحابه الذين ربما يكونوا على علاقة برأفت. توجه نحو غرفته ذات السرير الواحد وخزانة ثياب صغيرة ومكتب جميل الصنعة قد ورثه عن جده يحيى باشا، وأخذ يبحث عن المُفكِّرة التي تحتفظ بأرقام أصحابه، استغرق وقتا طويلًا في البحث حتى وجدها أسفل قميص مطوي في خزانة ملابسه، كانت محملة بالتراب إثر تركها قرابة خمس سنوات دون لمس، نفض عنها التراب حتى بدت بحالة جيدة، لم تكن المُفكِّرة وحدها هي المحملة بالتراب كذلك كان الهاتف المنزلي، غض الطرف عن كل هذا وأخذ يتصل بأصدقائه الذين يُحتمل أن يكونوا على اتصال برأفت، بعد ستة أشهر من البحث الدؤوب لم يعثر على إجابة قط، ولا أي خيط رفيع يساعده في الوصول إلى صديقه. جاءته فكرة أن يكتب إعلانًا عن رأفت في صحيفة، وذهب بالفعل وأملى على الموظف صيغة الإعلان، حتى الآن هو يحتفظ فقط بالمربع المخصص لهذا الإعلان بعدما شطب الأخبار الأخرى بالأبيض وكتب غيرها.
ظل هكذا فترة طويلة من الزمن حتى كاد اليأس يتملكه، كثيرًا ما ظن أن رأفت توفى، لكن كان يطرد هذه الفكرة سريعًا، فهو جبان جدًا من أن يتقبل فكرة كهذه، لذا قرر أن يكتب كتابًا يشرح فيه علاقته بصديقة، بعد ثلاث سنوات خرج الكتاب للنور يحمل عنوان “المائل يحكي قليلًا”، وقد لاقي رواجًا هائلًا فهو يتمتع بموهبة عظيمة في الكتابة، ورغم هذا النجاح، لم يصل إلى صديقه بعد، هنا تأكد أن صديقة مات، وانهار نفسيًا وأقبل على الانتحار عدة مرات، فهو الآن وحيدًا جدًا، لكنه دومًا كان يتوقف في اللحظة الأخيرة خوفًا من مصير مجهول يقولون عنه أنه محكوم عليه بالجحيم المؤبد، أصبحت حياته أكثر رتابة من ذي قبل فقد هجر طلاء الأخبار وكتابة غيرها. فقط اقتصرت حياته على ملازمة الفراش وتناول الحبوب المنومة، وعندما ينتهي مفعولها ويستيقظ رغمًا عنه، كان يتناول وجبة خفيفة حتى يتمكن من البقاء على هذا السطح الرخو، هو لا يريد شيئا.. فقط ينتظر الموت.
ظل هكذا حتى السادس والعشرين من شهر أكتوبر 1990، في هذا اليوم دق جرس الباب، وبصعوبة بالغة ووجه شاحب وجسد هزيل، ذهب يفتح الباب ليجد صديقة أمامه، قفز كالطفل وتهللت أساريره واحتضن صاحبة بشوق أم وجدت فلذة كبدها بعد غياب مائة عام، في الجهة المقابلة ارتجف صديقة خوفًا عليه ما الذي حدث ليبدو هزيلًا إلى هذا الحد!
جلس سويًا في غرفة مكونة من منضدة كبيرة وثلاثة كراسي ما زالا محتفظين برونقهم الكلاسيكي بالرغم من كتلة التراب التي بدلت لونه فصار رماديًا مثل حال صاحب البيت، الفرحة ألجمت لسانه عن النطق وأخذ يتحسس بيد مرتعشة وجه صديقه؛ عيناه وأنفه وفمه وأذنه وملمس جلده، كل شيء ليتأكد أنه حي، لم يصدق حاله فانحنى ووضع أذنه على قلب صديقه فسمع تسارع نبضات قلبه، ثم استقام جسده وصرخ فيه معاتبًا برجفة مشروخة ظهرت جليًا في صوته، أين كنت كل هذه السنين؟، ظهر الامتعاض على وجه رأفت وقال: لقد كتب إليك كثيرًا، ألم تصلك رسائلي.
ـ اقسم لك لم يصلني شيء.
ـ هل كنت أقوم كل هذه الفترة بإرسال الرسائل إلى عنوان خاطئ!
ـ ربما، لا يهم يا صديقي الآن ما قد مضى، أخبرني أين كنت طوال هذه المدة.
ـ كنت أصارع الموت وحدي يا صديقي، كم تمنيت أن تكون بجواري، راسلتك مرارا لكن دون جدوى.
ـ لحظة، أعتذر أني أقاطع حديثك.
ذهب مسرعًا إلى المكتبة بعدما تذكر الرسالة التي تسلمها من موظفة البريد. منذ ثلاث سنوات، فتح المظروف وقرأ.
صديقي العزيز جدًا.. حسن
تحية طيبة وبعد….
أرسلت إليك كثيرًا ولم تجب عليّ، أنا مشتاق إليك، مشتاق إلى روياك بجانبي، حسن أنا أكتب إليك الآن وأنا مُلقي على فراش كئيب في إحدى المستشفيات الحكومية الفقيرة جدًا، لا أحد معي، يقولون يا صديقي أن في جسدي ورمًا ينمو يومًا بعد يوم، وأنا خائف جدًا يا صديقي، خائف لأنك لست معي، أخاف أن أموت دون أن أودعك، المرء لا يخاف الموت إذا قال ما عنده، وأنا لدي الكثير لأقوله لك، أنتظرك يا حسن لا تتركني أموت وفي قلبي كلام كثيرًا لك.
صديقك المخلص
رأفت
انتهى من قراءة الرسالة وأجهش بالبكاء، ولم يجرؤ على التوجه لصديقه ليطلب منه مسامحته عن تقصيره، كان أضعف من وردة الخريف، ففتح الباب وهرب، يمشي هائمًا في الطرقات التي تبدلت ملامحها فأنكرت وجوده، شعر بالغربة معها، فعاد بطيئًا إلى بيته، فور ولوج قدمه البيت احتضنه رأفت، وفي يده كتاب “المائل يحكي قليلًا”، وصرخ فيه لماذا تمسي نفسك (المائل)؟ أنت لست مائل أنت مستقيم، نفى “حسن” كلام صديقه بهزة رأس وقال أنا مائل لأني كنت بدونك، الآن يمكن أن تقول أني بك أستقيم، احتضانا بقوة، وربت “رأفت” على يد “حسن” وأدخله غرفة نومه وطلب منه أن يرتاح قليلًا، ثم توجه إلى غرفة إعداد الطعام ليطهو وجبه صحية لصديقه الهزيل؛ دجاج مشوي وحساء لذيذ وسلطة خضراء، فهو يعلم كم يحب صديقة هذه الوجبة الخفيفة، وضعهم على صينية وتوجه إلى غرفته، حاول حسن التفوه ببعض عبارات الاعتذار والأسف، فوضع رأفت يده على فم حسن قائلًا “لست في حاجة للاعتذار كلانا ابتعدا دون مقدمات، أنسى الأمر تناول طعامك الآن”، لاحظ رأفت ارتعاش يد صديقه فأخذ عنه الملعقة وقام بإطعامه في حنان بالغ وصمت ناعم، كانت جوارحهم هي من تتحدث؛ نظرات عيونهم بعدما خلا منها العتاب، فقط الحب والصداقة هما المتحدثان.
كلاهما كان يبحثان عن الآخر في ذات الوقت، حتى تلاقيها على شرفات الحياة، عقب انتهاء حسن من طعامه، اعتدل في جلسته وطلب من صديقة أن يقرأ عليه “المائل يحكي قليلًا”، وافق رأفت على الفور وجاءت جملة البداية “ولتعلم ما أنت ساعي إليه هو أيضًا ساعي إليك”.