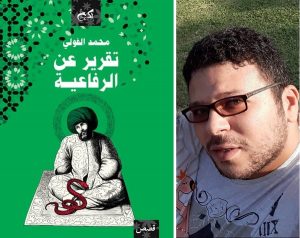طارق إمام
“كنتُ أرغب وحسب بتفتيت ذلك المكان الذي تنمو فيه الجُمل وتكبر”: هكذا تقرر ساردة رواية “أسامينا” لهدى حمد (دار الآداب)، لتضع متلقيها أمام غرضٍ “معرفي” لفعل الانتحار، يتجاوز الغرض الظاهري والأوَّلي لإقدام شخصٍ على إنهاء حياته.
اللغة في الحقيقة هي المكان الذي تنمو فيه الجمل وتكبر، هي بئر الصوت/ اللفظ، وصداه/ الإحالة أو الدلالة أو رجع المعنى، بئرٌ يسقط فيها كل من فقد الأمل في التواصل حين اغترب لسانه عن لسان الجماعة.
تفتيت اللغة إذن هو المجاز العميق لهذه الرواية، وربما بسبب ذلك تحضر اللغة هنا على لسان شخصيةٍ ميتة. الصدى وحده هو ما يبقى حياً بعد فناء الصوت، ونحن هنا بصدد رواية بطلها الوحيد هو الصدى، بترجيع ماضي الذات ليصبح حاضر الحكاية، في خطابٍ روائي هو بالكامل نص استرجاع.
ليس تفتيت اللغة، وفق التصوّر نفسه، نفياً لها، بل تخليصاً من حمولاتها الجاهزة المتوارثة، ثقافياً وإيديولوجياً، في روايةٍ جوهر سؤالها هو ذلك الموروث نفسه. وفق هذا التأويل، ليس الانتحار مغادرةً للعالم، بل صوغ لغةٍ جديدةٍ متخففةٍ من المواريث، لغة ليست وجهاً لكل سلطة وسوطاً في يد كل جلاد.
نحن أمام ساردةٍ مريضة بـ”صداع اللغة” إن جاز التعبير، ويكاد المجازي يتجسد حرفياً عبر”أزيز جُمل صاخبة ومؤذية”: “الجُمل التي لا تفقد بريقها لدقيقةٍ واحدةٍ في رأسي. الجُمل التي تدخل معي إلى المطبخ، وتنسكبُ في الشاي، وتصعد إلى غرفة النوم، وحصل ذات مرة أن تلامسنا برفق…. ولا أدري إن كان عليّ أن أقلق لمجرد أن الجمل تنتفخ في رأسي بهذا الإلحاح، لا أدري إن كنتُ مريضة”.
هكذا، تختار الساردة صمت اللغة، تعتمد الإشارة بديلاً للتحدث، وتضع مسافةً مع محدثيها، كأنما اتقاءً لخطر اللفظ: “وجدتني أنفض كل الكلام… ثم لم أعد أفكر بشيء أكثر من المحافظة على المتر الذي يقف بيني وبين الراقصات، بيني وبين العالم. إن ذلك المتر يبدو أغلى ما أملك الآن”.
تستبعد الساردة اللغة من تواصلها، تعيش بكماء، وتصبح كتابة قصتها أخيراً، طريقة وحيدة لاستحضار هذه اللغة، وليصبح الموت هو استعادة النطق.
بنيةُ المراوَحة
تنهض الساردةُ المتكلمة بالنص وهي ميتة.
نحن إذن أمام نصٍ كامل يحتله الصوت فقط، فمفهوم “الذات” يشترط مفهوماً آخر هو الحضور، فيما الذات هنا هي الغياب.
“الموت هو اللحظة التي نبدأ فيها على نحو حاسم تأمل الحياة، لأنه لا يعود هناك المزيد منها”. وفق عبارة التصدير الاستباقية هذه، يُمثِّل الموتُ ابتعاثاً للمعنى، وليس قبراً له. لا يغدو عدماً، بل فرصة (وحيدة) لإعادة قراءة مدونة الحياة.
هنا صوتٌ، يراوح بين سرد وقائع موت صاحبته، باختيارها الغرق في بئر، وبين استرجاع حياتها. وبين الزمنين تنهض الأحلام، أحلامٌ تترى بوجودٍ مستقل في مقاطع مستقلة، بلا تمهيد أو تعقيب يجرح عالمها الموازي أو يحاول تفسيرها ليفقدها قوامها أو ليجعلها محض انعكاسٍ مدرسي لمقولات الواقع. الأحلام في “أسامينا” جزء من الواقع الروائي نفسه، لا يُنظر لها بتعالي النظرة الواعية لليقظة، ففي الموت يُعمِّق الوجود من التباسه، كأن الموت مصالحة أخيرة بين الوعي واللاوعي، وإذابة نهائية لحدود الواقع والتخييل.
بلا فصول معنونة، أو مرقمة، وبتراتب كولاجي، تُذيب الساردة الفواصل في عالمٍ خرج من قبضة التدخل المنطقي، بما في ذلك الزمن الخطي التعاقبي للحكاية. لغةٌ مقتصدة، وموحية في الوقت ذاته، تتخفف من الرطانة الإنشائية بقدر ما تختزل مرويتها في الجوهري من عناصرها الدالة دون ولع بالإطناب السردي أو الاسترسال أو الاستسلام لضفاف المحكيات، ما يجعل الناتج مروية قصيرة (134 صفحة) تبدو فصولها (مزقها بالأحرى) أقرب لزفرات متراوحة الطول، يجمعها قانون التجاور بأكثر مما تتوخى الاضطراد الكرونولوجي لزمن المروية التعاقبي.
ثمة تراوح آخر، بين ضمير المتكلم المرتد داخل الذات، غائراً في الاستبطان، وضمير المخاطب، الذي يأتي بجارٍ ليجعله موضوعاً للتلقي، دون حتى أن يعتد بخلق أواصر كافية تشفع لتلك الرابطة المبهمة التي تجمع صورتين متواجهتين، كأنما إحداهما انعكاس الأخرى على صفحة مرآة. التراوح لن يلبث أن ينسحب على اللغة، التي تتخذ تلوناتها بين خارج/ داخل، كنائي/ استعاري، أو بين مشهديةٍ وتحليل. ومن خلف ذلك كله هناك المراوحة الكبرى بين خطاب الفرد، حيث المحكية الشخصية، وخطاب الجماعة المسكون بقيم الذاكرة الجمعية.
تمثل هذه البنية المراوحة، محاكاةً لصوتٍ ما يزال حياً بعد غياب صاحبه، يُراوح بدوره بين عالمين. نحن أمام مونولوج داخلي طويل موزعٌ على أشلاء حكاية يُعاد ترميمها بعد الموت بعد أن أخفقت الحياة في القيام بهذا الدور.
صوتٌ هو بالأحرى صدى، صدى الحكاية بعد انتشال الجثمان من البئر، وصدى وعي الميت بعالمٍ غائم، يمكِّن الساردة من التعرف على أمها، فيما ذهبت الأخيرة لتفعل العكس: لتتعرف على جثة ابنتها في المشرحة.
أيهما يعاقب الآخر، من ترك الآخر حياً أم من ترك الآخر يموت؟ يبدو أن الاختيار الأول هو إجابة هذه الرواية، حيث ترى الساردة، وبلا مواربة، أنه “ينبغي بطريقةٍ أو بأُخرى أن تُعاقب هذه الأم”.
الماءُ ليس نفسه
تقرر الساردة، التي تخشى الماء حد أنها تتحمم بمناشف مبللة، أن تُنهي حياتها مغمورة بالماء بالذات، غريقةً في بئر.
“إن مجرد تخيلي لأناسٍ يقفون عراة تحت انثيال الماء عمودياًعلى رؤوسهم من الدش، أو يغمرون جسدهم في حوض متوسط العمق في دورات المياه الخاصة بهم، سامحين للماء كي يحيط بهم من كل اتجاه وأن يغطي رؤوسهم، إن مجرد تصور ذلك يصيبني بقشعريرة غامضة. ولذا، فور استلامي الشقة، استأذنتُ المالك برغبتي بكسر حوض الاستحمام الواقع في حمّام غرفتي”. كيف يمكن لـ”فوبيا” من ذلك النوع أن تصبح تصالحاً نهائياً مع فكرة الغرق؟ الماء ليس نفسه. ماء “الدش” الاصطناعي، ليس هو ماء البئر القادم من جوف الأرض، المتفجر من الطبيعة. الماء الساقط من أعلى ليس كالماء النابع من أسفل، ويمكنني أن أذهب بالمعنى لحده الأقصى لأقول: الماء الغائي، بغرض التنظيف الوقتي للجسد، ليس كالماء الذي يمثل الاتحاد به تطهراً تاماً ونهائياً.
***
متى تحصل الساردة على الاسم؟ عندما تموت العمة.
تهمس به العمة للساردة لحظة أن لدغتها الأفعى، وكأن الموت هو من يمنح الاسم للحياة. على جانبٍ آخر، يبدو الاسم ترياقاً لتحمي العمةُ الطفلةَ من الطبيعة، لتخرجها من جحيمها، ربما دون أن تدرك أنها أخرجتها من فردوسها أيضاً، ولتمنحها انفصامها النهائي عن وجودها “الطبيعي”.
فبعد أن ظلت حتى تجاوزت الخامسة بلا اسم، فقط “البنت”، تحصل على “ملصق ثقافي”، وتظل مغتربةً عن اسمها حتى أنها ترتبك حين تُنادى بها كأنه لا ينتمي لها. العمة، تجسيد الوجود الطبيعي، باتصالها بالطبيعي في حياتها، (تربية الماشية وقطف الثمار)، تموت أيضاً بسم الطبيعة نفسها (ممثلةً في الأفعى)، وفي الثدي بالذات: علامة الأمومة الأمضى.
في حلمٍ لاحق، سيصبح ثدي الساردة وسيلة لإماتة رضيع، كأنه يبتسر فكرة الامتداد وقد خفتت مع دخولها عقدها الرابع، مثلما ستعيد الأفعى لدغ الساردة، كأن الحلم إعادة تدوير، ليس فقط للواقع، بل للتاريخ.
تغضب الطبيعة لاحتضار العمة، في مشهدٍ رمزي لا يخلو من سحرية، حيث “امتلأت سيح الحيول بالكلاب المسعورة، خرجت من أماكن لا نعلمها وبقيت تترصد الصغار”، وسيدعم ذلك حضور للقوى غير المرئية للطبيعة “أبواب بيتنا القليلة قرعت ليالي عديدة من أيدٍ غير معلومة”. أما البئر، التي ستشهد نهاية الساردة، فستشارك بدورها في مأتم الطبيعة: “بقينا لأيام نسمع أنيناً خافتاً يخرج من البئر ومن حفيف الأشجار، من حشرات الليل، من أكواز الذرة وسنابل القمح”. ولن تعود الطبيعة لهدوئها إلا بموت العمة، حيث عادت لها للأبد، وأصبحت جزاً من رحمها/ ثراها. في وقت لاحق، عندما تُعلّق صورة العمة على جدار البيت (وهو سلوك ثقافي لم يكن يعرفه العالم الطبيعي ممثلاً في القرية) تغضب الطبيعة مجدداً، ينحبس المطر ويحل الجفاف، حتى إن سكان القرية: “أصروا على ربط النقمة الإلهية بصورة العمة راعية الفص: كيف تعلق صور الموتى، أي جنون هذا! بدا مكوث العمة في الصورة اعتراضاً جلياً على الموت”.
وعلينا أن نلحظ أن هذا الموقف سيغدو تحولاً روائياً هاماً، إذ سيتسبب في مغادرة الأسرة للقرية “تأكد أبي أن القرية لم تعد تتسع لنا”. تطرد الطبيعةُ الثقافة، تطرد الأب الذي استقدم الكاميرا ليمنح الوجود الشفاهي تدويناً “صوَرياً”، وفور الخروج، تأتي “المدرسة”، حيث تعلن الساردة لأول مرة “أصبح بحوزتي كلمات”.
ما يوقظ ذكرى العمة سردياً هو “الحلم”، وهو اتصال آخر بالطبيعي في مواجهة العقلاني “”أتذكر الآن ذلك الصباح البعيد في سيح الخيول، حادثة منطفئة تماماً في رأسي، ولا أدري لماذا برقت الآن إثر حلم”.
***
مقابل العمة تنهض “الأم”، والتي تلعب الدور العكسي بالضبط: تُجرِّد ابنتها من الاسم.
يعمق صورة الأم مشهدٌ رمزي، حين تكتب الطفلة اسمها، كأول اسمٍ تدخل به مرحلة التدوين (الثقافة) بعد مغادرتها مرحلة الشفاهة (الفطرة). لكن الأم تواجه هذه الهدية بجفاء، بل إنها تسأل الطفلة إن كانت سرقت اللوح الذي خطّت عليه الاسم. ربما بدءاً من هذه اللحظة، ستقرر الساردة في لا وعيها إنكار جميع الأسماء. وفق الأم، فإن “الأسماء تقتل”، لها من الإخوة تسعة ذهبوا بسبب أسمائهم، وبعدم حصولها على اسم، نجت، وبسبب ذلك رفضت أن يحصل طفلاها التوأمان على اسمين. فقط عندما يموت الابن، ويُطلب منها تسميته، ترتجل اسماً، فالاسم قرين شهادة الوفاة لا شهادة الميلاد.
هل تخلت الساردة عن اسمها، الذي لن تفصح عنه أبداً في سردها، كتشبثٍ لا واعٍ بالخرافة ذاتها التي تنهض روائياً لنقضها؟ ثمة غياب كاملٍ للأسماء في نصٍ عنوانه “أسامينا”، الشخصيات تُقدم بصفاتها أو وظائفها أو جنسياتها: الأم، الأب، البنغالي، الخالة صاحبة القطط، العمّة صاحبة الفص، الرجل ذو الشعر الأحمر، فتاة الاستقبال المغرمة، صاحب البناية، الفتاة الممتنة وغيرها. وكأن انتفاء الأسماء تأكيد آخر على عالمٍ فقد اعتداده الهوياتي مختزلاً ذواته في أدوار أو وظائف.
من ناحية أخرى، فإن تغريب الاسم هو سمة تعرفها الأمثولة والحكاية الخرافية وإجمالاً يعرفها موروث الذاكرة الجمعية من الحكي الشفاهي، إذ تتضاءل أهمية الأسماء أمام الأدوار، كنوعٍ من تجريد المحكي في مقولةٍ رئيسية. تتصل “أسامينا”، انطلاقاً من مقطعها الأول الذي يعمل كتوطئة، بالمحكية المتوارثة، لتمزج بينها وبين الحكاية الجديدة التي تتخلق من رحم أسلافها، على شرف بئرٍ واحدة.
لكن الفارق أن “أسامينا”، كروايةٍ حديثة، لا تبحث عن تأكيد مقولة على حساب أخرى قدر ما تتساءل وتتشكك حد أن العثور على أي إجابة يغدو ضرباً من مستحيل.
***
باختيارها مكان موتها تنزع الساردة عن نفسها قناع الثقافة الهش: الاسم ومن بعده المدينة، كمن يخلع ملابسه ليعود عارياً كما ولد. الساردة ترتد من “مسقط”، مدينة النضج وعلامة عالم الثقافة، والتي لم تنجح في مصالحتها على فطرتها المغدورة، الفطرة التي خانتها “العمة” بموتها، والأم ببقائها على قيد الحياة.
هكذا يبدو انتحار الساردة في “سيح الحيول”، مكان طفولتها، ارتداداً رمزياً للطفولة، يجعل المهد هو نفسه المقبرة. إنها أيضاً تنضم أخيراً لأخيها التوأم، الذي مات طفلاً في الرابعة، في المكان نفسه، وأورثها ما يتجاوز اليتم: شعوراً بالذنب واتهاماً مضمراً كأنها مسؤولة عن موته، وفوق ذلك انفصاماً نهائياً عن الأم.
في اللحظة الأخيرة يختفي الوجهان: وجه العمة ووجه الأم، هو مانح الاسم ومانعه، ليبرز وجه الأب، الذي ظل طيلة السرد لاعباً هامشياً. ومثل “نرسيس” الذي رأى وجهه في ماء البئر فضاع للأبد، يؤذن ظهور وجه الأب بلحظة النهاية، كأنما في انتقام مضاعف من الأم التي اعتقدت أن الابنة سحرت للأب لفرط تعلقه بها. تتحد الابنة بمن منحها وجودها، وتودع للأبد من جردتها من ماهيتها.
الرقص: دحر الزمن
يتحرك السرد بين مكانين: سيح الحيول، ومسقط. وبينهما برزخ هو السيح الجديد.
تبدو الأمكنة هنا أكثر من أمكنة، فهي أوعية رمزية للجسد والوعي معاً.
مع مغادرة المكان الأول، يُقصر على الغرباء مقابل إيجار، وليظل محتفظاً بقوامه “الطبيعي”، فيما اختارت الثقافة المكان الجديد، ومعه أصحاب الأرض. تختار الذات الساردة أن تُنهي حياتها حيث المكان الذي لم يفقد غريزيته بعد، وفي البئر التي عادة ما تنفق فيها “القطط”، أي الموجودات الطبيعية. إنه انسحابٌ رمزي لامرأة ينهض عالمها هناك، في “مسقط”، حيث المدينة والبيت الحديث، حيث الروابط التي بدأت تذوب حتى بين أم وابنتها، مع إصرار الأولى على محو كل ما يمت للماضي بصلة، كأنها تعمل روائياً كممحاةٍ للذاكرة: “أعدمت كل شيء عندما تركنا سيح الحيول وجئنا إلى مسقط… ولم يكن هناك شيء يمكن أن يحيلنا معاً لذكريات مشتركة.. علينا أن نبقى عالقين في مسقط بلا ذاكرة”.
مُدرِّبة رقص: إنها أيضاً أكثر من مهنة، هو بحث عن تحرر الجسد من قيده، التحرر الذي سيبلغ ذروته حين يصبح الرقص، في اللحظة الأخيرة، توطئة للموت واحتفاءً به. يكتشفون آثار أقدامها المرتجلة من رقصتها، الرقصة التي صارت وسيلةٍ وحيدةً لقص الأثر.
الفارق بين الرقص والمشي جوهري، فالمشي غائي، هدفه الوجهه وأهميته تقتصر على الوصول، أما الرقص فملتفت لنفسه، للغرض “الجمالي” وليس الوظيفي. هذا ما يجعل الساردة تتأفف ممن يأتين بحثاً في الرقص عن غاية كإنقاص الوزن، لأنها تراه أبعد من أداة.
المشي أيضاً هو انتقال من نقطة لنقطة وفق حتمية خطية، أما الرقص فقائم في المكان وفق نسقٍ دائري، لذا فوظيفته الأعمق هي وظيفة شعرية. الساردة هي تلك الراقصة، التي، في تأويلٍ أبعد، لا تغادر مكانها، وترفض صيغة الزمن التقليدية.. لتفضل عليها الدائرة. الدائرة تأكيد لفكرة انعدام البداية والنهاية.. كل نقطة تصلح كبداية وكنهاية معاً. والدائرة، وهذا هو الأهم، هي دالُّ الخلود في النص الإنساني: إذا ما أصبح الزمنُ دائرياً لن يكون هناك موت. ليس مستغرباً إذن أن ينساب صوت امرأةٍ تحيا الزمن كدائرة، حتى وهي جثة.
هل حققت الساردة إذن خلودها الخاص؟ هل حققت بعثها، أو بالأحرى، بَعثَ صوتها المحتبس، باختيار البئر بالذات، حيث لا يموت الصوت ولا يفنى الصدى؟ الأكيد أن “أسامينا”، تخوض هذه الرحلة النهائية، من أجل العثور، أخيراً، على اسمٍ، اسم تختاره الذات لنفسها، وأسماء تمنحها هي للذوات والموجودات، كأنما تحصل أخيراً على حقها البديهي في تعريف العالم، دون أن يكون الاسم محض إرث، نُجبل على تعاطيه كقناع، لنفقد بالمقابل وجوهنا.