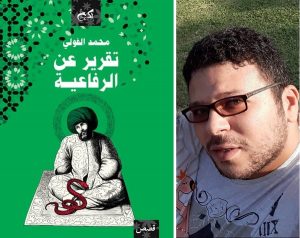طارق إمام
تؤسس المجموعة الشعرية “كُن بريئاً كذئب” للشاعرة المغربية ريم نجمي (منشورات المتوسط، ميلانو) غرضها مباشرةً، باستدعاء الاتفاقي بغية إزاحته، من داخل شرطه بالذات. سيتأسس النص الشعري كله على هذه الإزاحة التأسيسية للقيمي لصالح الجمالي. من أجل ذلك ينهض النص، ومن سطره الأول (العنوان) على انفتاح مباشرٍ على المتلقي بضمير مخاطب: إنها دعوة، لكنه أيضاً أمرٌ ما، باستخلاص البراءة من أحشاء علامتها النقيضة: الذئب. يدعم ذلك الطرح اجتزاءان أولان تغدو فيهما الشراسة موضوعاً للتشكيك، حتى أن الضحية تصبح هي جلاد هذا النص، ويغدو الحَمَل، بدلالته المستقرة، موضوع الإدانة.
هذه “المغالطة” الدلالية المتعمدة ستنسحب على تجربةٍ كاملة ترى، ربما، أن جوهر الشعر هو مغالطة الاتفاقي وفي قلبه المنطق، ذلك أن المنطق ابن الاتفاق الجمعي والخبرة المشتركة ومرجعُه العقل، فيما قصيدة نجمي هي صنو الفردية ونبذ الاتفاق والارتكان للشعور.
العرض، والفرجة، إنهما أيضاً الإنتاج والتلقي، وهما يتواطآن معاً لإذابة ثنائيةٍ قارة، يمحوها العنوانُ بداءةً، فالمخاطب هنا يقع على حافة الخطاب الشعري، حيث المتلقي نفسه هو المقصود بالنداء، قبل أن يبدل موقعه ليصير ذاتاً شعرية داخل الخطاب.
هذا النقض المبكر لثنائية الشراسة/ البراءة، ومعها ثنائية الضحية/ الجلاد، يقدم في ظني اقتراحاً شعرياً يفترض بالضرورة انزياحاً مفاهيمياً عن الاتفاق الجمعي.
ماذا لو وسم ذلك الانزياح علاقة قارة بدورها هي الحب؟ ماذا لو اختبر شكلاً “غير تخييلي” كاليوميات، وماذا لو اقترب من الشائك ثقافياً، من “المحظور”، ذلك المعبد الذي تكفي نفثةٌ هينةٌ ليسود الحريق؟ ربما هذه هي الفضاءات التي تختبرها مجموعة نجمي الشعرية، عبر صيغةٍ لا تأبه حتى بالانسجام أو التماسك، حد أن القصائد تبدو في أحيان كثيرة شذرات مقتلعة من نصوصٍ أكبر.
إعادة تعريف “الاستعمالي”
عبر الأقسام الخمسة للكتاب، تبدو نجمي حريصةً على توظيف لغةٍ استعمالية، لغة تداول لا يصعب عبورها نحو إحالاتها. لكنها تختبر مرة بعد أخرى كافة الثنائيات الجاهزة: رجل/ امرأة، وطن/ غربة، مقيم/ عابر، مسلم/ مسيحي. كافة هذه الثنائيات حاضرة هنا، وكلها تبحث عن إذابة، سواء بالتجربة الحسية أو الخبرة الثقافية أو التناص الموغل في مجادلة الذاكرة النصية الشاسعة للذات الشاعرة. يجتزئ الديوان مثلاً سيلاً من مقاطع وسطور شعرية ونثرية وفيلمية، تفرد خارطة شاسعة ثقافياً يتجاور فيها مجتزأ من محمود درويش مع رباعية “بالعامية المصرية” لصلاح جاهين مع تضرع امرأة هندوسية، وتكاد المقتطفات الحاضرة بالتواشج مع النصوص تشكل متناً حقيقياً يتجاوز دورها كعتبات أو إحالات. بل إن الذات الشاعرة تمد طرف الاجتراء إلى منتهاه، حد أن تضع مجتزأً مستقلاً لشاعر آخر هو برنارد وليامز، بوصفه قصيدة تنتمي لمتنها.
هناك أيضاً اختبار لأشكالٍ غير تخييلية داخل المتن التخييلي نفسه، كاليوميات، مثلاً، والتي هي فضلاً عن ذلك، وبخلاف النص الشعري، تُكتب لكي لا يقرأها أحد.
اليوميات خطابٌ “تأريخي”، يفترضُ تحويل مجموعة من الوقائع “اليومية، العابرة” إلى “حقائق” أو “استخلاصات”. يكتب الفرد اليوميات غير باحثٍ عن قارئ، بل على العكس، يكتبها ليصير هو قارئها الوحيد ويغدو نقض هذا العهد إفساداً لهدف الخطاب. تستعير “نجمي” بنية اليوميات في القسم الثاني لتختبر العابر والعادي، والخاص جداً (كموضوعة الأسرة) في سياق القصيدة، لكنها تفسد جوهره عمداً، بفتحه على فكرة التلقي العام.
ثمة هنا نوعين متباعدين تماماً من الذوات تلتقطهما الذات الشاعرة: شديدي الائتلاف من جهة (الأب، الأم، الزوج) وشديدي النأي على الطرف الآخر، أولئك العابرين الذين تقابلهم الذات لمرة واحدة في شارع أو وسيلة مواصلات. كأن التدوين جسرٌ بين حدي النقيض، وهو إذ يصل بينهما فإنه يمد ممشىً بين هاويتين.
أيضاً، تعتمد قصائد الكتاب أحياناً بنية قصائد/ ومضات، أقرب للإبجرامات الخاطفة، التي ما إن تومض الواحدة حتى تنطفئ، مفسحةً الطريق لتاليتها. إيقاعٌ أقرب للهاث، وقصائد كالزفرات، تتراوح فيه المناخات النفسية بحدة وهي تتنقل بين مشاعر متناقضة (المد والجذر مرة أخرى، واختلاف الفصول، وتعاقب الليل والنهار).
إجمالاً، فإن “كن بريئاً كذئب” يحتفي بالمراوحة، والتهجين، بديلاً لتأكيد الثنائيات وتعميقها، وهو فعل إذابة ينسحب على مجمل التجربة، ليصبح مظهره الشكلاني هو ذاته جوهره الرؤيوي.
الحب: تفكيك “العرض”
هل ثمة ما يناقض المنطق، أكثر من الحب؟ الحب في هذه التجربة سؤال متجاوز لقشرته الخارجية، سؤال يطمح لاكتشاف الوجود عبر اختبار مستحيلات بالمنطق الاتفاقي: الظلام شرطاً للرؤية، اختلاف الديانة شرطاً للاتصال، والهوة بين وعيين شرطاً لجسر كل هوة.
الحب: إنها العلاقة التي لن تلبث أن تترجم نفسها شعرياً في الأفق الدلالي الأشمل لهذا الكتاب الشعري، والذي ينفتح على تجربة شديدة القابلية للانزلاق في فخ “الثنائيات” بالذات، لكنه يعقد رهانه بالنجاة من مزالق “المبذول” والاستعمالي بوجدان الماشي على حبل بغية إعادة تعريفه شعرياً، وفي نصٍ نثري بالذات.
الحب نفسه ثنائية، كثيراً ما تُكرس للمفارقة بين طرفيها/ خطابيها من حيث تبغي إذابتهما، وهي لهذا، ربما، تبقى موضوعاً لاكتشاف الذات عوض أن تفعل العكس، بقراءة الآخر.
الذات الشاعرة ستلتقط من هذا الخيط جوهر وظيفتها الشعرية: “أنا ذئبةٌ عاشقة”، ودرجة نبرتها: “الصرخة”. إنها المستذئبة، وهي هنا (على نهج الميثولوجيا) تتحرك في ظل علامةٍ كبرى هي القمر، التي تحدد بدورها حركة العالم من المد والجزر لتناوب الفصول. إنه الليل أيضاً، ميقاتاً وحيداً للظهور، يتسق مع البحث عن العتمة الذي أسلفتُ إليه. وهما _ الليل والقمر، كنقيضين أيضاً بين عتمةٍ وضوء_ ما يقبض على مقاطع هذا النص، التي تتحرك فعلياً بين مد وجذر، التئام وانفصال، اقتراب هائج وانحسار خجل، حتى على مستوى اللغة الشعرية. تدخل “نجمي” تجربة الحب بدورةٍ زمنيةٍ مكتملة موزعة على الفصول الأربعة. إنها الدورة التي تمنح الحب تاريخيته كـ”قصة”، والتي عبرها يتخلّق الشعري من ثنيّات المحكي.
على جانبٍ آخر، فعندما يغدو الحب غرضاً شعرياً “ما بعد حداثي” مكانه قصيدة النثر بالذات نصبح أمام اللغة وهي تتحول إلى واقع، وليس العكس، في قلبٍ عنيف للمستقر الشعري في القصيدة التقليدية.
لا مناص، من ثمّ، من اعتماد الصورة مرجعاً وحيداً، واقعاً افتراضياً يشترك مع الواقع التجريبي شكلانياً عبر الدوال نفسها غير أنه يخون جوهره، فالواقع وجودٌ يفتقر للدلالة، فيما الحب (بوصفه سياقاً من العلامات، أي لغة) ذاهبٌ للدلالة، التي لا يدعمها الواقع بالضرورة. هنا يمكن للسينما مثلاً أن تغدو مرجعيةً للواقع الشعري، ما يجعل من خطابٍ تخييلي ما مرجعاً لخطاب آخر وواقعاً بديلاً له.
عندما تعترف اللغة بأنها عاجزة عن محاكاة الواقع، يختلف طموحها جذرياً، إذ يصبح المرجع، بالكاد، هو الصورة: الصورة بوصفها علامة وبوصفها خطاباً، وبوصفها، بالذات، الخيانة الأعمق للواقع كونها الأشد إيهاماً بمحاكاته من حيث تنفيه. يلائم ذلك الاقتراح الموضوعات الشعرية لنجمي: فكرة “العلاقة” إجمالاً، متجاوزةً علاقة المرأة بالرجل، لعلاقة الذات بالأسرة، ثم بالذوات العابرة التي تقابلها صدفة وتعرف أن علاقتها بها موقوتة بلحظات اللقاء المبتسرة.
هذا نصٌ يتخلق في الظلمة التامة لقاعة سينما، حيث يقترن التجريب بالظلام: “حقاً لا يهمني الفيلم/ أحاول فقط أن أجرب العتمة معك”. الظلام: إنه دالٌ مهيمن هنا، تمارس الذات الشاعرة البحث عنه، كأن الضوء هو العمى: “لمسته/ فازدادت الغرفةُ سواداً/ حتى إن الليل تمزق/ وسال على الوسادة”. “في انتظار الليل/ لن أتودد للشمس/ حبيبي قبلني/ احمرت وجنتاي/ وصرت الآن/ مهيأةً للغروب”. والاكتمال مع الحبيب يعني اكتمال الظلام.
ربما في الحب، فقط، يمكن أن يكون الهدف من فلسفة “العرض” إدراك نقيضها بالضبط: العتمة، بوصفها موضوعاً للرؤية، وهكذا تكون ظلمة هذه التجربة الشعرية هي، بالضبط، نورها المأمول.
نحن أيضاً أمام ذات مغتربة، تمثل الهوية نصل سكينها المرهف والمؤلم، حد أنها تلجأ لاختبار الشعري في سياقٍ من التسجيل والتوثيق (المشاهدات المتقشفة لغوياً، والمحايدة صوَرياً) لتعيد تعريف نفسها. وبالتواشج مع مفارقات المكان المتتالية، ثمة مفارقة الزمن، حيث لا تخجل القصيدة من إيقاظ محكيتها، وحيث مع كل نص شعري هنا، ثمة حكاية تحيا، وأخرى تموت.