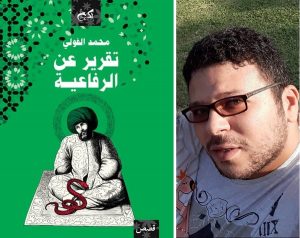طارق إمام
كأن ذاتاً لم تعد مرئية، هي من تُحيي رميمَ العالم لتردَّ إليه الشكل. لعلها مفارقة أولى في المجموعة الشعرية “قبلة الماء” للشاعرة المغربية عائشة بلحاج (دار روافد، القاهرة)، فيما تتساءل دون كلل: كيف لغير المتجسد أن يُسبغ الصورةَ على مجردٍ أو مفهوم؟
وإذا كان الإنسان هو “الكائن الوحيد المريض بذاته”، فإن بلحاج تختبر، بلا هوادة، إمكانية ابتعاث كافة الموجودات كذوات، كأنما لتخلق “وجوداً كاملاً مريضاً بذاته” فيما ترتد الذات الشاعرة نفسها في رحلةٍ عكسية، متخففةً قدر ما تستطيع من وجودها التجريبي بغية تأسيس ذاتٍ مفاهيمية.
من اللحظة الأولى نحن إزاء ذاتٍ شاعرة فقدت قوامها، أو اتخذ وجودها تمظهراتٍ مفارقة، تجعلها في خيانةٍ دائبةٍ لعنصرها الأصلي، سواءً استحالت وردةً أو عطراً، نقطةَ ماء عالقة في رتق سقف أو جثمان دمية، أو، وبالأساس، طيفاً لا يُرى ومن ثمّ يفتقر للتعريف. الذات الشاعرة في “قبلة الماء” لا تكتفي حتى بصورتها الإنسانية في المشي على ساقين، قد تخصم ساقاً لتحجل بساقٍ واحدة، أو تضيف ساقين، وحيث “تمتد يداي وأمشي بأربع: قدمان تطرقان باب الأرض، ويدان تزنان الظلام الأعمى”. ارتدادٌ للطبيعي، الحيواني، وللطفولي أيضاً، لكن بهدفٍ معرفي.
***
لعل أول ما يلفت الانتباه في صورة الذات الشاعرة، هو أن وجودها يبدأ بوجود اللحظة الشعرية نفسها. النصوصُ إجمالاً تلد ذواتها، هذا حقيقي، غير أنها تفترض أن هذه الذوات تملك على الأقل ماضيها. لكن الذات الشاعرة هنا منفصمة، بيدين خاويتين من الماضي، أخطأهما كلُّ إرث، حتى أنها تبدأ بتعريف نفسها استناداً لموقعها الشعري، ودون أي مرجعيةٍ جاهزة تنتمي لما ندعوه الواقع.
تولد الذاتُ “الآن”، انطلاقاً من توطئة سوزان سونتاج: “كل شي، بدأ من الآن. أنا أولد ثانية”، لتترجم تلك الولادة شعرياً في ستٍ وثلاثين نصاً. ولادةٌ لن تدخر الذات الشاعرة، متعكزةً على الضمير الأول المهيمن في جل القصائد، جهداً كي تمنحها غرضيتها الاستعارية: “ولدتُ لأرطب/ جفافَ ريقي/ بقبلة الماء”.
“قبلة الماء”: أهي القبلة التي يمنحها الماء للكائن أم التي يحصل عليها منه؟ إنها المراوحة التي يخاتل بها عنوان المجموعة نفسه، لتسدر على أفقٍ شعري كامل البطل المطلق فيه، هو في ظني المراوحة كمفهوم، يقترن بمفهومٍ آخر هو “الإرجاء” إذا ما استعرنا التصور الدريدي.
“كل شيء بدأ من الآن”، كأن استبعاد الذاكرة رهانٌ أخير، على استحالته، للنهوض بالنص في المضارع: مضارع العالم المتجاوز لمضارع اللغة. كأن لا وجود أبعد من “هنا والآن”، وكأن على الذات أن تلد نفسها بعد أن أخفقت ذواتٌ أخرى (الأسلاف) في منحها ذاتاً تخصها. لقد أخفق اجتماع الدم في إذابة الحدود بين الملامح المتباعدة والمعزولة للأسلاف، فبقي كل منها في عزلته لتتسلم الذاتُ جسدها “جرنيكا” من الملامح العاجزة عن الانصهار في سياق جديد. عينا أم، حزن أب، أو ثنية فم جدة، ملامح يبقى كل منها على حدة، في وجهٍ آخر: “مرهقٌ أنني أمي/ التي امتزجت بأبي/ ولم أكن/ ما أرادا”. هكذا يتحتم على الذات الشاعرة أن تُشكِّل ماهيتها بنفسها، دون استنادٍ لمرجعيةٍ تُبقي بالكاد كل ملمحٍ في سجن صاحبه الأصلي، ليشير إليه دون أن يحيل لمن ورثه.
وبدورها، حين تجمع التذكارات “كقاتلة متسلسلة هذه المرة”، ستبقيها في عزلاتها، ككولاج يفتقر إلى ما يمنحه السياق: “شفاهٌ، آذان، أصابعٌ،خصورٌ، أصواتٌ، روائحٌ، أنفاسٌ، قلوبٌ، أمخاخٌ/ أشياء أجمعها في علبِ وقيدٍ تتراكم في رأسي”. هذه ذات ترفض أن ترث وأن تورِّث، عالقةً بلا امتداد يرتد للخلف حيث الأسلاف أو يتقدم للأمام نحو اللاحقين.
هوياتٌ مراوحة
في حين تُمثِّل الهويةُ مفهوماً تأطيرياً، يمنح ذاتاً أو جماعة تعريفاً نهائياً غير قابلٍ للدحض، تبدو قصيدة بلحاج كأنما تطمح للعكس بالضبط: تكثير الذات المفردة إلى ذوات عديدة، تُبدِّل بينها متنقلةً بين أدوارٍ لانهائية، مشفوعة بحيوات تنسخ إحداها الأخرى، ومعها هوياتٌ مراوحة: “هي آخر ذواتي/ وخيّرتني:/ من تعدد ملامحكِ اختاري وجهاً للموت،/ مثلما كنتِ سخيةً مع العدم الذي أوْلد وجوهك”.
يبدو هذا التكثير للذات الشعرية، متسقاً تماماً مع استحضار “ألبرتو كاييرو”_ أحد ذوات فرناندو بيسوا _ فضاءً لقصيدة، تتجاوز نفسها لتشير إلى مجمل رؤية بلحاج في ما يخص تجاوز الذات الضيقة لحدودها التي يستحيل عبورها أو توسيعها.
وبنظرةٍ أشمل، فإن بيسوا نفسه حاضر كمناخ شعري في “قبلة الماء”، وهو يطل كأحد الآباء البارزين في “الجين الشعري” لقصيدة بلحاج. إنه “التقمص” أيضاً، وهو سؤالٌ مُلحٌ هنا، إذ لا تطمح قصيدة بلحاج لاستعارة قناع مفارق بطريقة القصيدة التقليدية، يجعل من الشاعر نبياً أو رائياً أو صوتاً مفارقاً ينوب عن جماعة، لكنها أقنعة تعمق من هامشية الشاعر ونسبيته وتفتت فرديته نفسها إلى فرديات منثورة في التيه.
الهويةُ هي مديح العنصر المهيمن، وتبئيره لإزاحة الشوائب من عناصر خاملة أو يمكن العثور عليها لدى عناصر أخرى، ذلك أنه بذلك التأطير، يمكن خلق “الآخر”، فلا هوية تكتمل دون أن تخلق عدوها. لكن الهوية هنا، في مفارقةٍ جديدة، تبدو فعل إنكارٍ لما هو قار، فهي ليست ميراثاً، ولا تعبأ بالاتصال أو المشترك الجمعي: “أقول ضوء، وأفكّر في العتمة”. ومن ثم، فإن “الآخر” وفقاً لقصيدة بلحاج، يغدو هو الذات نفسها.
منسجمةً مع الولادة الجديدة، تؤسس الهوية هنا للقطيعة من جهة، ولمجافاة النقاء من جهةٍ أخرى، عبر إنكار كل ما من شأنه أن يحيل لمفهوم “النقاء” أو “الاتساق” أو “التماسك”. لكن الأخطر في نص بلحاج هو استبدال الهوية الواحدة بهويات تتبادل الحلول في ذاتٍ واحدة، ما يمثل تقويضاً عنيفاً للمفهوم نفسه.
هكذا يغدو بمقدور الذات الشاعرة أن تنقسم، بسلاسة، إلى ضميرٍ أول وضميرٍ ثالث، يسيران في الطريق ذاتها، متصالحيْن مع انقسام الهوية على نفس الدرب: “أخذنا نفس الطريق/ وكانت أجمل./ يدُها دافئة، وفي صدرها/ العناقُ عميقٌ/ ولو أننا نلتقي لأولِ مرة”.
الهوية هنا تبحث في الهامش الجمالي أيضاً. تبحث “قبلة الماء”، كقصيدة نثرٍ، في هوية الشكل المهمش باعتباره، في ذاته، دلالة. يبدو بناء القصيدة هنا أقرب لفعل الترميم: موادٌ تنافر المادة الأصلية لموجود مهدد بالمحو أو الاندثار، قادرة على حفظه بصورة لا تجافي مظهره، غير أنها تبقى مادةً مفارقة لمادة قوامه الأصلي. الترميم أيضاً فعلٌ مابعد حداثي، يمثل اعترافاً بأن لا استمرارية لهويةٍ ما دون خدش نقائها المفترض، تماماً كماء هذا الكتاب الذي تنسحب زرقة سطحه لصالح خضرة أعماقه. الخضرة قرينة الغرق، والماء هنا ليس موضوعاً للفرجة أو النجاة. وللمفارقة فإن العمق/ الغرق هو الدلالة، فيما السطح/ الطفو هو بالكاد الدوال كعلامات ظاهرية مرجأة المعنى. “قبلة الماء” تحل محل “قبلة المحاياة”، والأخيرة تمثل طوق نجاةٍ من الغرق بالذات.. وكأن هواء الغرق هذه المرة، في قلبٍ عنيفٍ أيضاً للدلالة الاتفاقية، هو النجاة من اختناق البر.
في سبيلها هذا، لا تكتفي بلحاج بإحكام نصٍ شعري إيهامي، بل تحطم ذلك أيضاً، بحيث يمكن للنص أن يكون تفكيراً في نص يبحث عن الطريقة الأنسب لكتابته: “يُفترض أن يكون هذا النص عني، لكن بسام الحجار هنا: كتب عن السجائر، النساء، النبيذ وأشياء تخص الرجال”. القصيدة نفسها ليست هوية تامة تنتظر فضاً آلياً من متلقيها، وفعل الكتابة هو نفسه فعل التلقي.
حافة القيامة
تتصل الولادة بالموت، لتغدو وفق مقتضيات العالم الشعري، بعثاً.
ربما هذا ما يبرر المناخ “القيامي” لنص بلحاج: “لسنا في النهاية سوى الذين ماتوا وتركوا أشياءً عالقة، نرثها بالفطرة/ ونترك أشياءنا”. إنه أكثر من سطرٍ شعري، إنه تصور يمسك بالمقول الشعري ولا يكف عن تقليبه. الذاتُ هي الشبح، والحياة تالية على الموت وليست سابقةً عليه: “إنها قيامةُ الأيام هذه الأشياء التي نرجو نسيانها”.
تؤنسَن المقبرة، لتصبح “جارة”، وحيث ينهض عالمٌ من الرفات، يهيمن على مقدرات العالم الشعري: “من المقبرة التي خلف بيتي/ يمشي الموتى تجاه نوافذي”.
يتأسس العالم القيامي، عالم البعث، انطلاقاً من النص الأول، حيث تنهض الذاتُ في برزخ بين الدنيا ووجودٍ قائمٍ خلف “الجدار”: “ردت الجدران: أبوك ينوء بأحماله”. الجدار يتحدث، يملك إذن صوتاً شعرياً مباشراً، دون حاجةٍ لاستنطاقه عبر الوعي الإنساني. امتلاك اللغة يعني امتلاك ذات، ما يعني أن العالم الشعري لبلحاج، مثلما أسلفت، هو عالمٌ كل موجود فيه يتوفر على ذاته ولغته، حتى أن الوردة تتحول بعد الفناء إلى هيكل عظمي، كأنها جسد وجثمان.
نص الحاضر، للمفارقة، يعج بدوال الإرث، التذكارات، الاسترجاعات إجمالاً، غير أنه لا يفعل ذلك استجلاباً لغنائيةٍ متاحة، فنصوص بلحاج تميل للقصر وتجافي الإطناب وتبدو حذرةً حيال فخاخ العاطفية المنصوبة هنا وهناك.
في الأخير، تنتج القراءة الشاملة للحلقات الشعرية لـ”قبلة الماء” ذاتاً تعمل على ترميم صورتها، مغدورة في الواقع، الذي لم يعد أكثر من بيتٍ جرى تقويضه. وفي سبيلها، تستحضر صور الغياب كافة، وذواته التي تجرّدت إلى علامات، بدءاً من الأب وليس انتهاء بالمدينة.
في “قبلة الماء” تتحد العناصر الشعرية على شرف جوهرٍ واحد، سيميوطيقي، حيث تُوحّد العلامةُ بين الذات الإنسانية والموجودات، لتذيب الثنائيات القارة للأبد، وليغدو كل موجودٍ لغة.
……………………………..
* عائشة بلحاج (طنجة 1981) شاعرة وكاتبة وإعلامية مغربية. “قبلة الماء” هي مجموعتها الشعرية الثانية بعد “ريح تسرق ظلي”، الصادرة عن منشورات بيت الشعر بالمغرب، 2017.