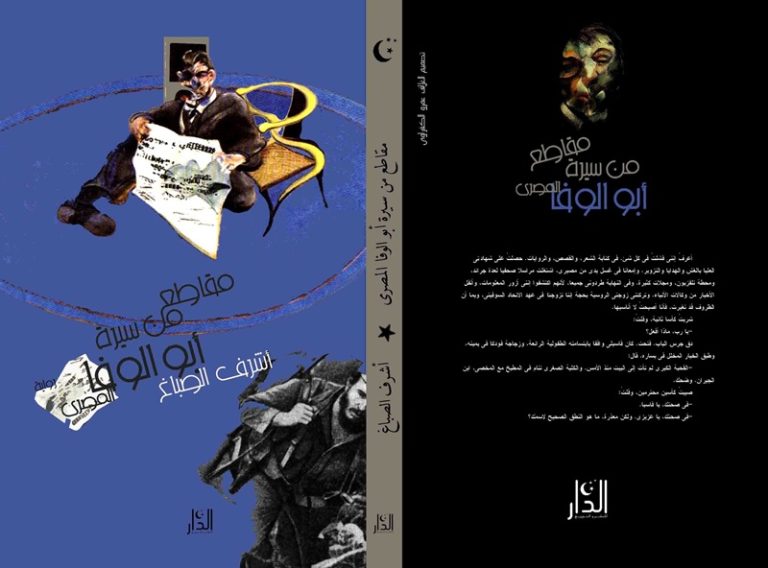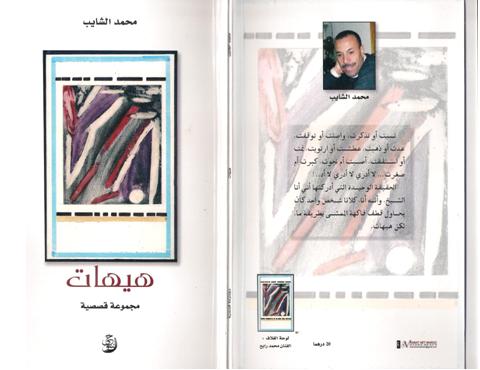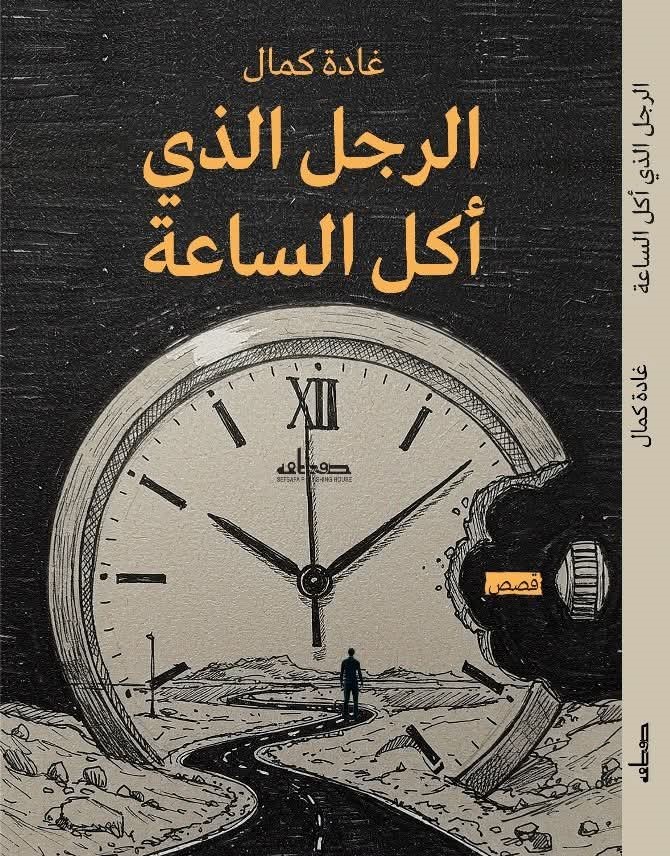في دلالة العنوان
اختارت “دعاء إبراهيم”* عنوان “فوق رأسي سحابة” لروايتها التي صدرت عن دار العين عام 2025، وهو -العنوان- جملة اسميه مكتملة: سحابة مبتدأ مؤخر مرفوع، وشبه جملة “فوق رأسي” خبر مقدم في محل رفع، مكون من جار ومجرور، إضافة إلى أن “فوق” ظرف مكان يفيد الارتفاع، أو علو شيء على شيء، وهنا علو السحابة على الرأس، وهو تعبير مجازي، فالسجابة التي في السماء ليست فوق رأس شخص ما بعينه، لكنها فوق كل شيء على الأرض، والمقصود هنا ثقل أو ضغط “السحابة” على الرأس، كأن نقول “فوق رأسي مصيبة”، أو “فوق رأسي حمل ثقيل”.. والسحابة قد تكون رمزًا للخير لأنها مصدر المطر والمطر مصدر النماء، وقد تكون رمزًا للشر إن كانت مصحوبة ببروق ورعود وما يحمله المطر الكثيف “السيول” من هدم وتدمير.
والعنوان بصيغته المكتملة جاء في متن الرواية مرتين: “ليتني كنت مكانك، أرتدي حذاءك، أركل به المجرمين أمثالي وألعنهم. لكنني للأسف وُلدت وفوق رأسي سحابة، لا شمس مضيئة راعية” (ص172)، السحابة هنا بمعنى التشرد والضياع وغموض المستقبل، ضد الشمس المضيئة الراعية، والتعبير هنا يخص الساردة “نهى” (التي ذُكر اسمها مرة واحدة حين نادتها الجدة “نهى افتحي.. شكله خالك” (ص25)). والمرة الثانية جاءت جملة العنوان في المتن محرَّف قليلًا “وتحركت يدها على ذراعي العاري بخفة، انتابتني قُشَعْريرة، وشعرت بوخزة أسفل ظهري. أدركت وقتها أن الموقف أكبر من سفر أولادها وحنينها إليهم. أدركت أن فوق رأسها سحابة” (ص126)، والحديث يخص “تومودا سان” أو السيدة تومودا/ تومودا هانم (لأننا سنعرف من السياق أن “سان” لفظ تفخيم في اليابانية).
“تومودا” شخصية رئيسية كذلك في رواية “فوق رأسي سحابة”، تعمل في مطعم يملكه والد الساردة “نهى”، وبحكم أقدميتها صارت رئيستها “قبل أن آتي، كانت ”تومودا سان” تعمل “الأي شيء”. وحين أتيت صارت بحكم جهلي رئيسة لي” (ص85)، ثم أصبحت شريكتها في السكن، لا تدفع شيئًا مقابل أن تعلمها اللغة اليابانية قراءة وكتابة، ثم اكتشفت الساردة أنها تحبها وتحاول لمسها والالتصاق بها دائمًا، وحين رفضتها وطردتها انتحرت بإلقاء نفسها من النافذة، ثم سيحدث أن تُتهم الساردة بقتلها، سواء بشكل مباشر بدفعها من النافذة، أو بإعطائها مهدئات أثرت على تركيزها ودفعتها للانتحار.. والساردة لا تنكر مسؤوليتها، لكنها مسؤولة بشكل غير مباشر، بالرغبة في حدود الفعل وليس بالتحرك لإنفاذه -مثلما تمنت موت كل من تكرههم فماتوا بالفعل-: “حتى لو كانت هناك كاميرا، لن تلتقطني وأنا أدفع روحها. أنا لم أدفع جسدها النحيل الرجولي” (ص156)، هذا الاتهام الذي ستذهب إلى السجن بسببه، احتجاز تحت التحقيق، سنعرف أنه يمكن أن يمتد لعشرين عامًا، لأن المحققين في اليابان، بصرامتهم، حين لا يكون لديهم أدلة ملموسة، يضغطون على المتهم لإيصاله إلى الاعتراف، الذي سيكون أهم دليل، حتى لو حصلوا على اعتراف كاذب، يُدفع إليه المتهمون ليخلصوا أنفسهم من الإجراءات العقابية القاسية في السجن، وحتى لو لم يُستخدم الأذى البدني المباشر.
“أدركتْ أن فوق رأسها سحابة”، سحابة هنا أيضًا لها نفس الحمولة السلبية، أن رأسها مثقل بالهموم التي تفوق مشكلات زوجها وأولادها. وغير هاتين الصيغتين المتطابقتين مع العنوان، جاءت كلمة “سحاب” مرتين أخريين “على أطراف المدينة تحمل الجبال فوق رأسها قطع الثلج؛ قبعات بيضاء تشق السحاب، كقبعات الساحرات العجائز” (ص75) و”حين خرجنا إلى الشارع شهدنا تصدعات الأسفلت وانهيار أعمدة الإنارة. كانت ناطحات السحاب تهتز حولنا” (ص141)، ودلالتها متراوحة كذلك بين الحماية والعلو، مع ما تمثله من سحر الساحرات وخطر الانهيار.
هذه الثنائية التي ترمز إليها كلمة “سحابة” هي لب مضمون الرواية كما أرادتها الكاتبة، فالخير ليس صافيًا تمامًا، يتخلله بعض الشر، والشر كذلك ليس صافيًا، وكذلك الألم واللذة متجاوران ومختلطان في الفعل الواحد. فالساردة قاتلة تحب ضحاياها وتتعاطف معهم/ معهن، قاتلة بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحرفي، تحبُّ أن يموت الذين تكرههم، جميعهم، تحمل فوق رأسها غرابًا ينبئها بأن أحدهم سيموت، فتتخيل نفسها تحقنه بسائل شفاف باهت، فيموت بالفعل، فتبكي عليهم.
تعاني -منذ كانت طفلة- من هجرة الأب إلى اليابان وراء امرأة أخرى أحبها، تاركًا زوجته وابنته التي لم تولد بعد، دون أن يراها ودون أن تتمكن من نطق كلمة “بابا”، ومن تقلب الأم بين أحضان الرجال كعاهرة، وفي سبيل رغباتها تهمل ابنتها وترسلها إلى بيت جدتها، وترسلها هذه الأخيرة إلى بيوت أخرى وقت مرضها خوفًا عليها من العدوى.. وتعاني من خالتها التي لم تكن تطيق وجودها في بيتها لأن زوجها لا يريدها، ومن خالها الذي يعاشرها منذ كانت في الثانية عشرة حتى حملت منه وأسقطت حملها، ومن الممرضات في المستشفى لأن الممرضة التي أسقطت حملها كانت خشنة وكادت أن تقتلها..
الرغبة في موت الآخرين تصاحبها “خسة” تعترف بها الساردة في معرض تقييمها السلبي لشخصيتها ومشاعرها “ربما أحمل نذالته أيضًا” (ص37)، “لكنني لم أرث منها سوى الكراهية فحسب” (ص37)، “لولا جدتي، لكنت شخصًا أسوأ. هل هناك أسوأ مما أنا عليه؟!” (ص41)، مع تلك المعاناة والرغبة في موت من تكرههم، ومع تقييمها السالب لشخصيتها، فإنها كانت تتعاطف معهم “بكيت عليه كأنه ابني، ابني الذي لن أنجبه أبدًا” (ص61)، “أصحو من الكابوس لأسأل نفسي هل فعلت ذلك حقًّا؟!” (ص72)، “لم أفرح لموته، والعجيب حقًّا أنني بكيت، لم أتمكن من معرفة حقيقة شعوري. مَنْ أنا؟! بماذا أشعر؟! ولِمَ؟! لا أدري. ستبقى الأسئلة بلا إجابة. أنا ما أنا عليه وحسب” (ص190)، “أنا أحب ما يحبه خالي، حتى دون أن أدري، أراني بين عينَيْ رجل حَنْون يخلع ثيابي بخفة ونعومة لا تليق بقاتل، ويكسو جسدي بجسده العاري” (197).
هذا التراوح في بناء شخصية “نهى/ الساردة” ليس غريبًا في بناء النص كله وشخصياته، وسوف أفصِّل ذلك بعد قليل حين أتعرض للبناء الفني ودلالاته.
“التداعي الحر“: الانتقال بين العوالم بخفة فراشة
تنتقل الرواية مع بطلتها/ الساردة “نهى” من مصر إلى اليابان، بالتحديد من الإسكندرية في شمال مصر على البحر الأبيض المتوسط إلى كوماموتو جنوب اليابان في المحيط الهادي، ثم تنتقل داخل كوماموتو من شقتها الصغيرة التي استأجرها لها أبوها وكان يدفع إيجارها، وتشاركها فيها صديقتها ورئيستها في العمل “تومودا سان”، إلى السجن في المدينة الصغيرة نفسها، احتجاز رهن التحقيق، لكنها لم تخصص فصولًا مستقلة بشكل متصاعد أو حتى متشظٍّ لكل حكاية، بل جاء الحكي متداخلًا، بتقنية “التداعي الحر”، بحيث حين تحكي موقفًا من حياتها في مصر يذكِّرها بكوماموتو، تنتقل إليه مباشرة، ثم تعود إلى حكايتها الأولى، وأحيانًا تلضم الحكايات الثلاث معًا في فقرة واحدة، دون نظام محدد إلا هذا التداعي.
“التداعي الحر”، أو ما يعرف بـ”تيار الوعي” أو “سيل الوعي” هو مصطلح فلسفي صاغه الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي “وليام جيمس” (1842- 1910) عام 1890 في كتابه مبادئ “علم النفس”، لوصف العلاقة بين العقل والعالم، وكان له تأثير كبير على الأدب والفن الطليعي والحداثي لا سيما في حالة جيمس جويس، الذي تعد روايته الشهيرة “يوليسيس” أشهر نماذج هذا النوع، بما فيه من استحضار معقد للحالات الذهنية لشخصياته، وتدفق الأفكار والمشاعر بشكل متواصل وغير منظم في شكل مونولوج داخلي عشوائي، ومن أبرز كُتَّاب “تيار الوعي” أيضًا: فرجينيا وولف وويليام فوكنر ومارسيل بروست وإيتالو سفيفو.
في كتابه “علم النفس” يصف “ويليام جيمس” تيار الوعي بقوله “الوعي، إذن، لا يبدو لنفسه مقطَّعًا إلى قطع صغيرة. كلمات مثل ‘سلسلة’ أو ‘قافلة’ لا تصفه بشكل مناسب كما يظهر للوهلة الأولى. إنه ليس شيئًا مفصليًّا؛ بل يتدفق. ‘نهر’ أو ‘تيار’ هما الاستعارتان اللتان يُوصف بهما بشكل أكثر طبيعية. وفي الحديث عنه من الآن فصاعدًا، دعونا نسميه تيار الفكر، أو تيار الوعي، أو تيار الحياة الذاتية”(1).
أما لورانس بولينج، في مقال بعنوان “ما هي تقنية تيار الوعي”، فقد عرَّفه بأنه “اقتباس مباشر للعقل، ليس فقط من منطقة اللغة، بل من الوعي بأكمله، بما في ذلك الأحاسيس، والعواطف، والأفكار العشوائية، والذكريات، والخيالات، وكل ما تبقى. إنه محاولة لتقديم تمثيل مباشر وفوري لتدفق الحياة الداخلية للشخصية. المعيار الوحيد هو أن يقودنا مباشرة إلى الحياة الداخلية للشخصية، دون أي تدخل من خلال تعليق أو تفسير من جانب المؤلف”(2).
هذا ما تفعله الكاتبة في هذه الرواية، حيث تتنقل بين عوالمها بسلاسة دون فواصل ودون ضوابط كذلك، إلا لعبة التذكر نفسها، في صفحة (76) مثلًا، في معرض حديثها عن ابتسامات اليابانيين المُرَحِّبة والودود، تتذكر عالمها المقابل والمضاد في الإسكندرية “كانت ابتسامتهم تحملني على ظهرها، وتطير بي لأعلى سماء. حيث أجدني للمرة الأولى مُرحَّبًا بي. حتى إنني نسيت صوت خالتي الذي اعتدت عليه، وهي تتبرم من مكوثي عندها، لأن زوج أمي لا يريدني وجدتي مريضة. أتنقل من بيت لآخر، ملجأ متنقل يختلف في قطع الأثاث، لكنه يبقى واحدًا في الغربة واليتم، والأسوأ أنه يتم بلا قبر”، وفي (ص82، 83) تصف معاناتها في السجن وعدم قدرتها على النوم لأن النظام يمنع السجين من إطفاء إضاءة الكهرباء، ثم تنتقل برشاقة إلى قصة أسطورة قابيل وهابيل عبر كلمة مفصلية هي “حرب”: “تمددت على السرير بعد أن ابتلعت خمسة أقراص مهدئة. عشر دقائق وتحجرت في مكاني بأطراف غير قادرة على الحركة. جثم الظلام على عيني بينما تعلو ضربات قلبي، كدقات حرب. كانت هناك حرب منذ قليل، وبعدها هدأ الكون في ذهول. لم تكن حربًا بالمعنى الحقيقي. كانت معركة من طرف واحد. أخ يضرب والآخر مستسلم تمامًا!” الأخوان هنا إشارة إلى أسطورة قابيل وهابيل.
وفي ص107، 108 تتنقل بين ثلاثة عوالم في فقرة واحدة، في البداية في اليابان حين علمت بنقل أبيها إلى المستشفى لأنه يعاني من جلطة في القدم: “تسلحت بما قد أحتاجه داخل حقيبتي. وأمرت الغبي الذي يلعق وجهي بنظراته أن يتبعني ]تقصد الغراب[. نعق وهو يردد:
– تومودا سان ستموت أيضًا.
– أتساومني؟
تركته وانطلقت. لكنه لحق بي. فردت جناحيَّ وطرت بين الإشارات، بسرعة جنونية، وسط ضحكاتي المنتشية، كأنني ذاهبة إلى مقابلة حبيب”.
كلمة “حبيب” ستنقلها إلى فكرة الارتباط العاطفي في مصر، فتنتقل دون فواصل “لم أحظَ طوال حياتي بسيرة حب ألوكها بين زميلات العمل أو المدرسة. لم أخبرهم باستمتاع أن فلانًا يعاكسني”. وهنا ستنتقل إلى المستوى الأسطوري، إلى قصة الحب المتخيلة بينها “كممرضة قاتلة”، وبين “قابيل” القاتل الأول الذي قتل أخيه ليفوز بأخته الجميلة، تتساءل “هل كنت أعلم أنني البنت التي أحبها القاتل الأول منذ آلاف السنين؟”.. ثم تعود مرة أخرى إلى حكاية الأب “أصبحت أمامه خلال دقائق قليلة. لا أعرف هل دخلت من الباب أم الشباك! كان أبي بكامل صحته”.
وفي ص129، 130 ستنتقل في الفقرة نفسها أيضًا بين عالمين في اليابان، خارج السجن وداخله، ستبدأ من الداخل حيث تتعرض للعقاب بالجلوس على ركبتيها ناظرة للجدار من التاسعة صباحًا إلى الخامسة عصرًا لا تفعل أي شيء، لا تتحرك ولا تتكلم ولا تأكل ولا تشرب، مما يتركها في حالة توهان “كنت كومة بلا معنى، بلا رغبة في شيء سوى انقضاء الوقت، كومة تهتز للأمام والخلف في حركة آلية بلهاء، كفرع شجرة تحركه الريح”، فعل الاهتزاز سينقلها إلى خارج السجن: “تذكرت نزولي كل يوم من البيت بعد وفاة أبي. أجلس في الحديقة المجاورة على أرجوحة تجعلني أتطوح للأمام وللخلف. أنظر إلى السماء أثناء ارتفاعي، ثم ألقي نظرة مبتسمة على الستيني الجالس أمامي، والذي يحاول جاهدًا ألا ينظر نحوي”.
في الفقرة التالية ستنتقل إلى وصف حال الستيني “ياسو سان” -سآتي إليه لاحقًا-: “عرفتُ من مراقبتي له أنه يجلس كل يوم في الحديقة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة (لاحظ أنها نفس فترة العقاب في السجن، كأنه يعاقب نفسه على فعل اقترفه)، كأنه في دوام عمل كامل”. ثم، هذا العدد لساعات العقاب ستعيدها إلى السجن مرة أخرى دون الحاجة إلى فقرة جديدة، هي تسترسل بشكل طبيعي “الساعات لا تمر هنا، فهمتُ وسيلتهم للضغط على المتهم. يقودونه للانهيار”.
لكنها في أماكن أخرى تفعل شيئًا مغايرًا، حيث توقف السرد في موضوع ما وتُعرِّج على موضوع آخر لفقرة كاملة، ثم تعود إلى حكايتها الأولى، أو تنتقل إلى حكاية ثالثة: “لكن ذلك لم يمنعهم من فهمي. وبمساعدة لغة الجسد، وإنجليزية المدارس الحكومية وجوجل ترانسليت صارت الأمور أفضل” (ص86). ومن بداية الفقرة التالية (ص87) ستنتقل إلى عملها كممرضة في المستشفى في الإسكندرية “افتقدت زميلات المستشفى، على الأقل كن يخترقن وحدتي بجرأتهن على السؤال. يندسسن داخل روحي ويفتشن عن أخبار جديدة. لم أكن مثلهن”، الرابط هنا بين الفقرتين هو علاقات العمل بين الزملاء، كيف كانت متداخلة فيها الكثير من الفضول والحشرية والادعاء والنميمة في مصر، وأصبحت نظامية محدودة متحفظة في اليابان، بما يعكس اختلاف الثقافة بين الشعبين العريقين.
في الفقرتين التاليتين ستستكمل علاقات المستشفى “أنتقل من مستشفى لآخر”، “دومًا يختار الغراب حالات حرجة” (ص87)، ثم تعود إلى المطعم في اليابان في الفقرة الجديدة “في المطعم نتبادل كلمات قليلة. أغلب العاملين من الباكستانيين. لم أكن أسمع منهم سوى: “السلام عليكم”. (ص88)
هذا النوع من التداعي فيه اختلاط للوعي وتداخل للزمن وللشخصيات، يقول عنه روبرت همفري “رواية تيار الوعي هي نوع من الروايات التي تُركز بشكل أساسي على استكشاف مستويات الوعي ما قبل الكلام، بهدف -في المقام الأول- الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات. ومن ثم، يجب ألا يُخلط بين الوعي و’الذكاء’ أو الذاكرة”(3).
وعلى الرغم من الخلط لدى كثيرين من النقاد والدارسين بين “تيار الوعي” و”المونولوج الداخلي”، فإن قاموس أكسفورد للمصطلحات الأدبية يفرق بينهما نفسيًّا وأدبيًّا “من الناحية النفسية، يشير مصطلح تيار الوعي إلى مادة الموضوع (مضمون التفكير نفسه)، بينما المونولوج الداخلي هو التقنية المستخدمة لتقديم تلك المادة. أما في سياق الأدب، في حين أن المونولوج الداخلي يعرض دائمًا أفكار الشخصية «بشكل مباشر» من غير تدخل واضح من راوي ملخِّص أو منتقٍ، فإنه لا يخلط بالضرورة تلك الأفكار بالانطباعات الحسيَّة والإدراكات، ولا ينتهك بالضرورة قواعد النحو أو المنطق، ولكن تقنية تيار الوعي تفعل أحد هذين الأمرين أو كليهما”(4).
صراع العقد النفسية: تعدد الأصوات الداخلي
العقدة الرئيسية في رواية “فوق رأسي سحابة” أن البطلة/ الساردة “نهى” لم تجد الحماية الأسرية اللازمة في طفولتها، فأصبحت عرضة لاضطهادات كثيرة لم تستطع دفعها، مثل اضطهاد أزواج الأم الذين يدفعون مقابل الحصول على “عاهرة” بدون أطفال تحدُّ من متعتهم، واضطهاد الأم نفسها التي تريد التخلص منها، ونذالة أب انقاد وراء رغبته دون أن يفكر في مصيرها، لكن الاضطهاد الأكبر كان اعتداء خالها عليها جنسيًّا “الماء الذي بللني وأنا ابنة الثانية عشرة جعل خالي يلتصق بي، في الماء لا أثر للمساته التي تحفر في جسدي. لا دليل!” (ص21)، “وقفت مكاني بينما يعتصر خالي صدري بين يديه. تسمرت في استسلام، وأنا أنتظر اللحظة القادمة” (ص36)، “أحكم قبضته على صدري، يعتصره ويخرجه خارج مهده الذي يخبئه”. (ص81)
الصراع النفسي داخل البطلة يظهر في ملمحين متضادين تجاه فعل الاغتصاب، الأول هو الصمت بدافع الخوف لأنها تتصور أنها شريكة في المسؤولية “كان من الممكن أن أذهب لأمي وأخبرها. لكنني شعرت أن ثمة خطأ من جانبي” (ص36)، الغريب أنها كانت تخاف أن يفشي هو السر ويفضحها كأنها المخطئة الجانية، كأنها عاهرة بالفطرة، لذلك كانت تستجيب له لكي لا يفعل! “ما سلمتيش عليَّا ليه… ما وحشتكيش؟ أرتعش وأردد “مش هتجيب سيرة لجدتي!” (ص26)، ”جدتك مش هتعرف حاجة طالما بتسمعي الكلام” (ص80).
في عمق تفكيرها ترى أن اعتداءات خالها عقابٌ تستحقه، بالضبط كما رأت بعد ذلك أن عقابها في السجن باليابان كان مستحقًّا، وثمة ربط (لغوي) بين العقابين “أرى خالي وهو يغلق الحجرة من الداخل، يفتح الراديو على إذاعة القرآن الكريم -لاحظ اختيار إذاعة القرآن الكريم بالتحديد كغطاء لفعل فاحش- كي لا تسمع جدتي، يقيدني بقيود السجن في عمود السرير، بعدها ينشغل بمعاقبتي، كنت أطيعه، دائمًا، لكن الطاعة لم تُنجِّني يومًا من العقاب” (ص186).
هذا القبول (للعقاب)/ الاغتصاب، وإحساسها بأنها شريكة بشكل ما، انبنى على أنها تحب المغتصب/ خالها: “أمام جدتي وأمي كان أبًا رائعًا، وفي حجرتنا المغلقة رجل آخر”، هي نفسها تصفه بالأب الرائع، وحين تتحدث عن اختلائه بها تستخدم مفردة “حجرتنا”، كأنها حجرة زوجية طبيعية يتشاركانها، ليست حجرتها هي، وهو يقتحمها دون حق.. هي نفسها الطفلة التي تحتاج أبًا، والعاهرة التي تحتاج عشيقًا “لم تعرف الطفلة هل تحبه حقًّا أم تكرهه، ولم تعرف العاهرة أيضًا ما عليها فعله بالضبط” (ص112).
فكرة الأب والعشيق المتجسدان في شخصية خالها، وأنها لا تكرهه، وقد تكون تحبه، تلخصها الساردة في جملة دالة “لقد مات خالي موتة طبيعية في سريره الدافئ. وقالوا إنه كان يبتسم عند الموت، عندما رأى الملاك ينزع روحه، يبتسم كأمي وأبي”، فموت الشخصيات التي تكرهها جاء دائمًا كعقاب، وكانت طرفًا رئيسيًّا فيه، كانت تلعب دور القاتلة، متسلحة بشماتة كبيرة وواضحة، لكن خالها مات ميتة طبيعية مثل الناس، و(قالوا) أنه كان يبتسم، يعني أنها لم تحضر موته، حتى تنفي تمامًا فكرة الشماتة وتمني موته، بل إنها حزنت عليه وبكت “لم أفرح لموته، والعجيب حقًّا أنني بكيت، لم أتمكن من معرفة حقيقة شعوري. مَنْ أنا؟! بماذا أشعر؟! ولم؟! لا أدري. ستبقى الأسئلة بلا إجابة. أنا ما أنا عليه وحسب” (ص190).
هذا بناء نموذجي لشخصية مضطربة نفسيًّا، لا تعرف من هي ولا ماذا تريد، فخلقت داخلها مجموعة من الشخصيات، تتحاور معها وتستمع إلى أوامرها وتنفذها، مثل الغراب الذي يلازمها، وقابيل القاتل الأول، هذا ما يعرف في علم النفس بـ”اضطراب الهوية التفارقي (DID)”، وهو “حالة نفسية معقدة تنجم غالبًا عن صدمة شديدة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، عادةً ما تكون إساءة جسدية أو جنسية أو عاطفية متكررة وشديدة. يطور الفرد هويات متعددة أو ‘تغيرات’ تتحكم في السلوك في أوقات مختلفة، وغالبًا ما تكون لها ذكريات وخصائص متميزة. قد تعمل هذه التغيرات كآليات حماية، تحتفظ بذكريات أو عواطف صادمة محددة، مما يمكِّن الفرد من العمل من خلال تجزئة التجارب المرهقة”(5).
كذلك فإن علم النفس يشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطهاد أو الصدمات قد يلجؤون إلى تخيل سيناريوهات انتقامية كوسيلة لاستعادة الشعور بالسيطرة أو القوة، ما يعرف بـ”الخيال الانتقامي”: “غالبًا ما يكون خيال الانتقام انعكاسًا للذاكرة المؤلمة، حيث تنعكس أدوار الجاني والضحية. وغالبًا ما يتسم بنفس الطابع الغريب والجامد والصامت للذاكرة المؤلمة نفسها. يُعد خيال الانتقام أحد أشكال الرغبة في التطهير. تتخيل الضحية أنها تستطيع التخلص من الرعب والعار والألم الناتج عن الصدمة بالانتقام من الجاني”(6).
هذه الخيالات قد تتضمن شخصيات متخيلة تمثل جوانب مختلفة من الذات (مثل الشخصية القوية أو العدوانية)، ووفقًا لعلماء النفس مثل فرويد وكارل يونج، قد تعكس هذه الخيالات صراعات داخلية بين أجزاء الشخصية (مثل الأنا والهو عند فرويد، أو الظل عند يونج).
هذا بالضبط ما فعلته “دعاء إبراهيم” في روايتها “فوق رأسي سحابة”، حيث الشخصية الرئيسية “نهى” مضطربة نفسيًّا، تتشارك داخلها شخصيات وأصوات أخرى، مثل الغراب رمز الموت في الثقافة الشعبية المصرية، والذي علَّم الإنسان الأول كيف يدفن موتاه، و”قابيل” القاتل الأول، أو القاتل الأكبر، أبو القتلة.. وتشاركت معهم في أفعال انتقامية بقتل ظالميها: الأم والأب اللذين تخليا عنها وتركاها فريسة لخالها، حارس البوابة الذي ترى فيه ظل شخصية خالها من حيث انتهاك جسدها والرغبة في معاشرتها (علمًا بأن خالها مات وهي صغيرة)، الطفل الصغير الذي رأت فيه صورة طفلها المجهض، مريض الحجرة (1)، وتومودا سان وآخرين.
كل هذه الشخصيات أخبرها الغراب بموتها قبل أن يحدث، يقول “ستموت اليوم”، تكررت ثمان مرات، أو “سيموت اليوم”، تكررت ثلاث عشرة مرة، عندها تهرع إلى الحالة وتحقنها بسائل شفاف باهت يعجِّل بموتها، وهي تتشفى فيه.. أو تتخيل أنها تفعل.
ففي حالة الأم، ورغم أنها كانت ترى نفسها امتدادًا لها، عاهرة مثلها، ترتدي قميص نومها البرتقالي وتقف أمام المرآه فتراها هي، فإنها انتقمت منها -نفسيًّا- بطريقة واضحة، في البداية منعت عنها برشامة الذبحة الصدرية التي تنقذها كل مرة “تركتكِ تنتظرين برشامة الذبحة الصدرية التي لن تأتي”، “مغفلة، لأنك ظننتِ أن ابنة مثلي ستنقذكِ” (ص13)، “ألقيتُ البرشام في الحوض، وتركت خلفه الماء ليذوب” (ص15)، وللإمعان في ترتيب الموت والتعامل معه بآلية “قلت: لو أتى المُعزُّون سيجدون البيت متسخًا. يحتاج الأمر لبعض الترتيبات” (13)، ثم يأتي مشهد القتل المتخيل “أجس ذراعها وأحقن بداخله سائلًا شفَّافًا، أدفعه ببطء، لأقطع ابتسامتها إلى نصف ابتسامة ثابتة ميتة، وأريحها وأريحني من السؤال الصعب”. ليس ذلك فقط، ولكنها تحدثها بضمير المخاطب “كنتِ بتضحكي يومها.. يوم كنا في البحر يا ماما” (ص27)، “كنت أتسمع وأراقب ما يدور في حجرتكِ” (ص43)، “رأيتكِ طوال الوقت مقززة وحقيرة؛ كبائعة هوى تعرض نفسها على مَن يملك” (ص45).. وليس غريبًا أنها حزنت عليها بعد موتها “انطفأتُ بعد موت أمي كسيجارة ملقاة على الرصيف” (ص52)، لأنها شخصية منقسمة كما بينت.
انتقام الساردة من الأب أيضًا -نفسيًّا- كان بسبب تخليه عنها، هي في الأساس لا تشعر ناحيته بعاطفة من أي نوع، وتراه مجرد وسيلة، عليها أن تتصنع قربًا منه حتى تتمكن في حياتها الجديدة في اليابان “عليه أن يؤدي دوره معي، أن يوصلني إلى الشاطئ ويعطيني صنارة، سأتعلم الصيد وحدي”، وعندما تتمكن لن تحتاجه “بعدها يمكنني أن أطويه تحت جناحي وأطير به، وحين أصل إلى أعلى نقطة أفلته في أقرب صندوق قُمامة” (ص35).. حتى يأتي مشهد الموت الذي ستتخيل فيه أنها انتقمت منه بنفس طريقة الحقن “أمسكتُ ذراعه، لم يكن معي الدواء القاتل. استعضت عنه بالهواء. خمسون مليميترًا من الهواء قادر على قتلك. سأحتاج فقط لملء السرنجة عدة مرات. وللتأكد من موتك سأزيد عن الكمية المطلوبة” (ص113) -بضمير المخاطب أيضًا-، وأيضًا ستتعامل مع الموت بآلية كأنها لا تهتم، فتخرج هاتفها وتلتقط لهما صورة سلفي، الأولى والأخيرة، وأيضًا ستحزن عليه “لكنني لا أفهم لماذا أحزن، وأغضب، وأكتئب بعد ما تحقق ما أريد دون أي خطأ؟!”. (ص122)
“حارس البوابة” هو ضحيتها الثالثة، كرهته لأنه يذكرها بخالها، كرهته وأحبته وتركت نفسها له كذلك مثلما كرهت خالها وأحبته “وجدت حارس البوابة جواري (…) رَبَّت على كتفي، واعتصر جسدي في حضن عظيم. تحسس خلاله سلسلة ظهري عظمة عظمة (…) ارتخت أعصابي، وأنا أتذوق برودة دقاته، قدرتها على الانغماس في لحمي” (ص42)، “يتعرق جسدي مع لمسات يد الحارس الخشنة الباردة، فتنبعث عن جسدي رائحة عرق خفيفة، تدور في الهواء حتى تصل أنفه. يتشممها في لذة” (ص45)، “مع حارس البوابة لا أشعر بقبحي، برائحة ثقبي الغائر” (ص46)، إلى أن يجيء مشهد القتل المتخيل “غرست الحقنة في ذراعه، وضغطت على السائل ليجري في وريده ببطء”. (ص48)
مشكلة مريض حجرة (1) أنه ازدرى الساردة وأهان أنوثتها “حين لمحني للمرة الأولى في طرقة الاستقبال ابتسم ولمعت عيناه. لكن نظرته تفحصت ساقي، كأنه يوقظ عقله من غفلته. بعدها طفت نظرة ممتعضة على وجهه” (ص66)، المدخل الجنسي نفسه الذي تعاقب الجميع -في خيالها- بسببه، لذلك ستؤلمه “جنسيًّا أيضًا “خلعت البالطو الأبيض فرأيتُني بالقميص القرمزي” -صورة أمها كعاهرة-، “هناك مشكلة أيضًا في الكُلَى، وقسترة خارجة من عضوه النائم” (65)، “تحسست السرنجة، ملأتها بالسائل الشفاف، نظرت إلى المريض المسكين المستسلم وأعدت السؤال: “هل لامست امرأة من قبل؟!”، “ابتسمت له في تردد وأنا أتخفف من ثيابي” (66)، “أسرق ساقيه بجلدته الزائدة، ألتهمها في الليل بعد أن ينام الجميع. أمص ما فيها من رمق وحياة (ص103)، “”هنا شامة لم يرها أحد قبلك” زججت السائل ببطءٍ وتَروٍّ. وددت أن أبقيه معي لفترة أطول. سيتحرك الدواء ببطء لأعلى ذراعه، منه إلى قلبه مباشرة”. (ص66)
أما الولد الصغير، أو “الشيطان الصغير” كما تسميه، فكان يتعمد إذلال الممرضات والسخرية منهن، يبكي ليثور أبوه في وجوههن، وبالتأكيد سيكون صورة من أبيه حين يكبر، لذلك يجب أن يموت “أراني أكشف ذراع الولد منتهزة غياب الأم داخل الحمام، أضغط ضغطة بطيئة على السائل الباهت، أرى الطفل المدلل وهو يتوقف عن البكاء، يتوقف عن كونه محظوظًا”. (ص60)
ما يعزز فكرة أن الحقنة والإذلال والتشفي والسائل الباهت الشفاف القاتل كلها أوهام وخيالات، أن الساردة/ الممرضة، هي أول من يهرع نحو الحالة لإنقاذها، بالمحاليل والحقن وتدليك القلب والصدمات الكهربائية وغيرها، بتفانٍ ملحوظ يعرفه عنها كل زملائها وزميلاتها، وكل المرضى ومرافقيهم، حتى إنهم يطلبونها بالاسم، ويودونها بعد أن تخرج “الحالة” من المستشفى، سواء شفيت أو ماتت، وأنها تحصل دائمًا على لقب “الممرضة المثالية” في أي مكان تعمل به.
التشكيل باللغة: استخدام المفردات ودلالاتها
الرواية التي تتكون من 29113 كلمة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم اسم: موت أول، ميلاد، حياة أخيرة، تنقسم إلى فصول أصغر مرقمة تصاعديًّا، 14 فصلًا، تبدأ من صفر وتنتهي بصفر أيضًا، وبينهما (12) فصلًا، لا يتأثر تصاعدها ببدايات ونهايات الأجزاء الثلاثة، (4) فصول في القسم الأول، (3) في الثاني، و(5) في الثالث والأخير. القسم الأول 9201 كلمة، الثاني 4729 كلمة، والثالث 15025 كلمة، وباقي العدد موزع على إهداءين، أحدهما في بداية الرواية، والآخر في نهايتها وتصدير قصير.
كما سبق أن ذكرت فإن أحداث الرواية تدور في مكانين: الإسكندرية بمصر وكوماموتو في اليابان، وبالتالي هناك مجموعة من الشخصيات المصرية، ومجموعة أخرى يابانية.. لكن الملاحظ أن (جميع) الشخصيات المصرية ليس لها أسماء ما عدا الساردة “نهى” التي ذُكر اسمها مرة واحدة عَرَضًا، وتُعرَّف بقية الشخصيات بعلاقتهم بالساردة: الأم، الأب، الجدة، الخال، زوج الأم.. أو بوظائفهم: حارس البوابة، الطبيب، الممرضات، المريض، والدة المريض، والد المريض.. إلخ، بينما الشخصيات الرئيسية، غير النمطية، في اليابان لها أسماء محددة، وهي أربعة شخصيات: ساتو سان زوجة الأب، تومودا سان رفيقة السكن والرئيسة في المطعم، ياسو سان الرجل الستيني الذي يجلس في الحديقة، يوكو زوجته (ورد اسمها يوكو خمس مرات، بينما ورد مرة واحدة ياكو “لماذا حظيت ياكو بكل هذا الحب” ص179)، بينما تأتي الشخصيات الأخرى بوظفائها: الحارس، المحقق، القاضي..
لكن، على الرغم من أن غالبية الأحداث دارت في اليابان، فإن الرواية خلت تمامًا من ذكر للأماكن وأوصافها، مثل تقاطعات الشوارع، والسوبر ماركت، والحانات، وفنادق الحب ذُكرت كوصف فقط، دون تفاصيل فندق بعينه، عنوانه أو عدد طوابقه، وشكل معماره.. حتى المطعم ليس له أوصاف، كل ما ذكر عنه أن غالبية عماله من الباكستانيين الذين لا يعرفون من اللغة العربية إلا “السلام عليكم”.
وغير ذكر اسم العاصمة “طوكيو” التي هبطت فيها الطائرة، و”كوماموتو” التي سكنت وعملت بها، وسجنت فيها أيضًا، والأسماء اليابانية الأربعة، فإنها أدخلت مجموعة من مفردات اللغة اليابانية داخل سياق السرد، دون أن تشرح معانيها ليقوم القارئ بهذه المهمة، كلمات مثل: فوتون، الفراش الياباني التقليدي/ جومي، قمامة/ هيرو جوهان، وجبة الغداء/ الكاروشي، الموت من فرط العمل/ الساموراي، المحارب الياباني التقليدي/ الأوفرو، حوض الاستحمام/ إيتشي.. ني، واحد.. اثنان/ الساكورا، أزهار الكرز اليابانية/ كونيشتوا، مرحبًا أو نهارك سعيد.
***
اللغة عند دعاء إبراهيم في الرواية تمتاز بكثافتها الشعرية وقدرتها على التعبير عن الصدمات النفسية عبر الجسد والرموز، والجمل المتقطعة تعزز الإحساس بالقلق، وتجعل القارئ يلهث وراءها ولا يستطيع أن يتركها ببساطة، تناسب تمامًا تجربة حوار داخلي “مونولوج”، أو صوت خافت يتردد داخل أنثى غريبة، تعرضت لمآزق كثيرة منذ طفولتها، شكَّلت علاقة غير عادية بينها وبين نفسها وجسدها والعالم والناس، علاقة مترددة ومتمردة وغريبة، ستنعكس من خلال المفردات الشائعة التي ترددت بكثرة داخل العمل.
مفردة “رائحة”-مثلًا- وردت في الرواية (33) مرة: رائحة، رائحتي، رائحتك، رائحة الطعام، رائحة الدم: (أشتمُّ رائحة عرقك البائت/ رائحة ثياب أمي المعطرة/ لا يحمل رائحة البحر رغم أن المحيط جوارنا”.. إلخ، لتشي بأنها واحدة من الانشغالات المهمة لدى الكاتبة، خاصةً أن بطلتها/ الساردة “نهى” تتنبه مبكرًا إلى رائحة أمها في قمصان النوم، وإلى رائحة جسد خالها الذي يعاشرها منذ كانت طفلة، ورائحة جسدها هي نفسها وقت المعاشرة وبعدها، ثم إنها ستعمل ممرضة بعد ذلك، بين الأجساد المتمددة على الأسرة بين الحياة والموت، لا تستطيع تنظيف نفسها فتنطلق من بين ثنياتها روائح عفونة، مختلطة بروائح الأدوية والمطهرات وعرق الزوار الذين يجلسون في الشوارع في الحر والبرد، لأنهم لا يملكون أجرة فندق رخيص.. غير أنها -هي ذاتها- ستقضي في الحبس فترة طويلة، بكل ظروفه القاسية، بين نساء من جنسها، لا تدفع المرء إلى الاهتمام بنفسه وجسمه ورائحته.
وهناك فقرة واحدة مكونة من (157) كلمة، وردت فيها كلمة “رائحة (14) مرة، تقول: “فتنبعث عن جسدي رائحة عرق خفيفة، تدور في الهواء حتى تصل أنفه. يتشممها في لذة وهو يقول: “رائحتك جميلة”. أضحك ثانية بخفة، بقلق، برعب./ “حقًّا”./ قلتها بتعجب هل رائحتي جميلة حقًّا؟! أم أنها محاولة منه لإثارة غضبي، ولفت نظري إلى انبعاث رائحتي النتنة. بعدما يفرغ خالي من جسدي، أتشمَّمُنِي وأكتشفُ أن هناك خطأ ما بجسدي، رائحة أتعرف عليها للمرة الأولى، بين يديه أراني قبيحة جدًّا، أشبه أمي ببقعتين دَكْناوين بين فخذيَّ، ورائحة لا تُطاق. هل هي رائحته المنطبعة على عريي الملطخ ببقع دَكْناء سوداء؟ أحشر يدي بين شامتَيَّ، وأتشمم رائحة عرقي وعرقه مندمجين. وقتها لا أتمكن من منع نفسي من إفراغ كل ما في معدتي. ليؤكد لي السائل الحمضي أنني أتمتع بالنتانة نفسها من الداخل والخارج. للموت رائحة أخرى. رائحة الدم، قطرات البول في الثياب، اللعاب المر على الوجه. والأسوأ رائحة تعفُّن الداخل. أنا والموتى نتمتع برائحة العفونة نفسها، لكن رائحتي أقل وطأة يمكن مداراتها بكريمات ترطيب الجسم. مع حارس البوابة لا أشعر بقبحي، برائحة ثقبي الغائر” (ص46).
يرتبط بهذا، بدرجة عالية، أن مفردة جسد وردت (143) مرة، أغلبها بصيغة (جسدي)، وبعضها بصيغ مثل: الجسد، جسده، جسدها، جسد أمي، ثم تأتي مفردات تفصيلية للجسد، مثل “الفخذ” التي تكررت (7) مرات، (4) منها “فخذي” أو “فخذي”، و”فخذيك” مرة واحدة، و”فخذ” مرتان، تشيران إلى “عظمة” فخذ “ياسو سان” إثر سقوطه في شقته. وهذه الإشارات إلى الفخذين تأخذنا للإشارات إلى الأعضاء الجنسية لدى المرأة والرجل، منها عند المرأة “ما بين فخذيَّ”، “ثقبي الغائر”، “ثقب حواء”، “ثقبها”، “داخلي”. وعند الرجل “عضوه”، “الجلدة الزائدة”، “وتده/ وتدك”. وهذا طبيعي، فالجسد بحمولته الجنسية هو مركز الرواية، حيث يُجسد الألم، الصدمة، والعقاب. يُستخدم كمسرح للصراعات النفسية (الشعور بالذنب) والخارجية (العنف والحبس).
من بين الكلمات التي تكرر بكثرة تأتي مفردة موت التي تتكرر (178) مرة: موت، موتها، موته، ستموت، سيموت، ستموتين.. وهذا بالطبع يناسب ممرضة تعمل في مستشفى بين مرضى قريبين من الموت، مقابلها كلمة (حياة) التي تتردد (98) مرة بصيغ مختلفة أيضًا، وصوت (51) مرة، مع ملاحظة أن “صوت الغراب” لازمة ترافق الموت في طول الرواية، ثم كلمة ألم (40) مرة، ودم (35) مرة، وقلب (27) مرة.
أيضًا فإن كلمة (أم) بصيغها المختلفة هي الأكثر ترددًا بين الأسماء، وهذا يدل على أن أم الساردة هي مشكلتها الرئيسية، حيث كانت تضحك وسط أخوتها حين تعرضت الساردة للاغتصاب من خالها للمرة الأولى حين التصق بها في البحر وأدخل أصابعه في ثقبها، لذلك تقرن لفط الأم أحيانًا بصفات سيئة، مثل أمي العاهرة وضحكة أمي الغنجة. أيضًا كلمة (أب) تتردد (72) مرة، لأنها تحمِّل أبيها جزءًا كبيرًا من مشكلتها حيث تركها قبل أن تولد ولم يسأل لها، ثم سيأتي اسم الغراب (65) مرة، والخال (32) مرة، قابيل كمخلِّص لها من الآلام (44) مرة، وتومودا صديقتها ورئيستها التي أحبتها وانتحرب (57) مرة، رغم أن أول تردد لاسمها كان صفحة 82.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ولدت الكاتبة فى مدينة الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس الطب من جامعتها. صدر لها: “نقوش حول جدارية” مجموعة قصصية 2013 هيئة قصور الثقافة، “جنازة ثانية لرجل وحيد” متتالية قصصية 2015 منشورات الربيع، وأربع روايات: “لآدم سبع أرجل” منشورات الربيع 2017، “ست أرواح تكفي للَّهو” منشورات إبييدي 2019، “حبَّة بازلاء تنبت في كَفِّي” عن دار العين 2023، و”فوق رأسي سحابة” دار العين 2024.
1- جيمس، ويليام. مبادئ علم النفس. ترجمة غير محددة (النص الأصلي بالإنجليزية، الاقتباس من الطبعة الأصلية). نيويورك: هنري هولت آند كومباني، 1890. الفصل 9، ص239- 240. متاح على:
https://tinyurl.com/4efr9v6j (تم الوصول إليه في 8 سبتمبر 2025).
2- بولينج، لورانس إي، “ما هي تقنية تيار الوعي؟”، مجلة الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (PMLA)، المجلد 65، العدد 4، يونيو 1950، ص333– 345. JSTOR، doi:10.2307/459573.
3- همفري، روبرت. تيار الوعي في الرواية الحديثة. بيركلي: دار نشر جامعة كاليفورنيا، 1954، ص4.
4- كريس بالديك، قاموس أكسفورد لمصطلحات الأدب. الطبعة الثالثة. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2008، مدخل “تيار الوعي”.
5- هادوك، ديبورا براين. كتاب مصادر اضطراب الهوية التفارقي. شيكاغو: ماكجرو هيل، 2001، ص3.
6- هيرمان، جوديث لِويس. الصدمة والتعافي: ما بعد العنف- من العنف المنزلي إلى الإرهاب السياسي. نيويورك: بَيْسِك بوكس، 1992. انظر(PDF)، ص134– 135.