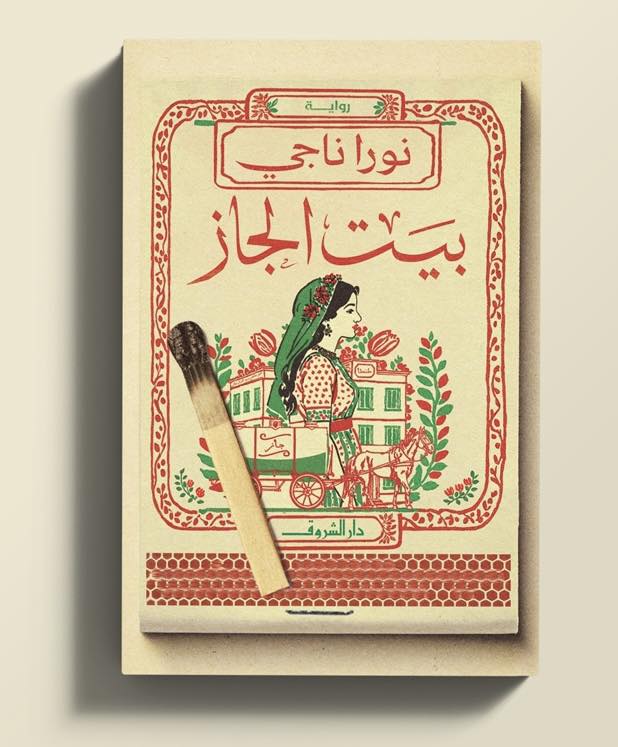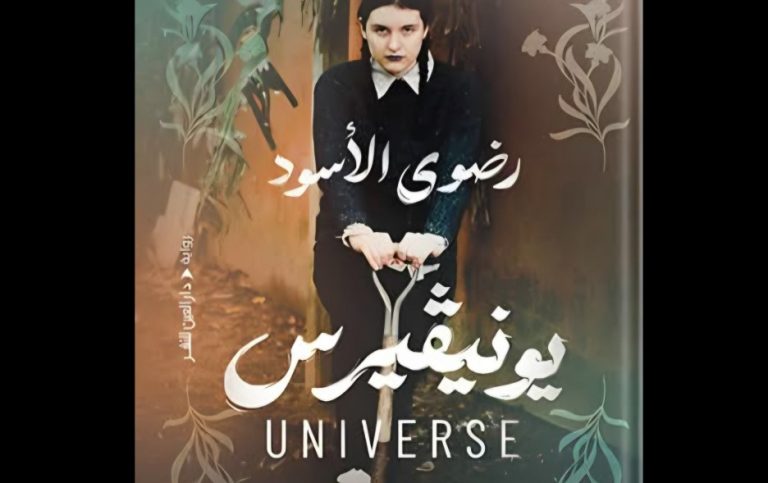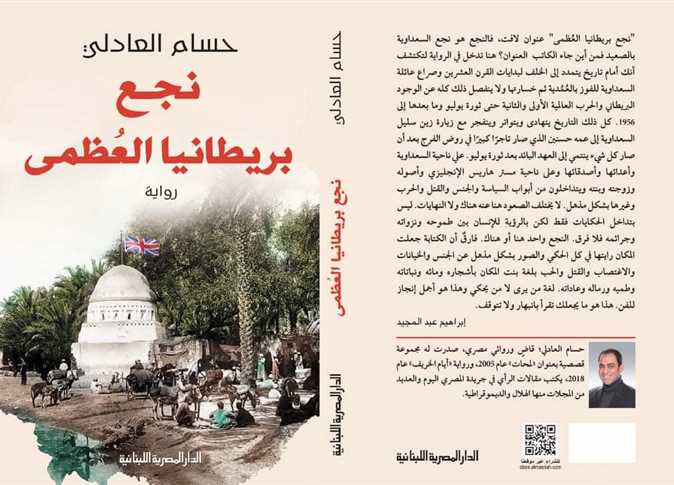محمد المسعودي
من يطلع على ديوان “من يقرأ للسحابة فنجانها؟” للشاعر المغربي رشيد شوقي يلفت نظره اشتغال المتخيل الشعري من خلال اتخاذ الطبيعة أفقا رمزيا ومكونا جوهريا في تشكيل بلاغة البوح. فكيف يوظف الشاعر الطبيعة رمزيا؟ وكيف تسهم الصور الفنية المستمدة من الطبيعة في بناء المتخيل الشعري؟ وكيف تسهم في تحديد قسمات بلاغة البوح؟
ستنطلق قراءتنا لديوان “من يقرأ للسحابة فنجانها؟” من هذه الأسئلة لنكتشف عوالمه الفنية، وهذا العمل هو باكورة الشاعر رشيد شوقي التي تشي بمدى تمكن مبدعه من أدواته الفنية، وقدرته على بناء نصوص إبداعية محكمة قوامها التصوير، وأسسها خلق عوالم شعرية محلقة في أبهاء الإبداع الجميل.
يطالعنا الاشتغال بالطبيعة منذ النصوص الأولى في الكتاب، ففي “تراتيل” التي اشتملت على أربعة مقاطع مرقمة نلمس أن ثلاثة منها وظفت بعض مناحي الطبيعة رمزيا، واتخذتها أفقا للبوح الشعري، يقول الشاعر في المقطع الأول:
“يناجيك رذاذ المطر
كي يرسم تفاصيل الحكاية
وبارتعاش الوجل
يُسلمك السبيل إلى السبيل” (الديوان، ص.6)
هكذا يبوح الشاعر بتيهه وارتحاله بين الطرق والسبل، حيث لا يناجيه سوى رذاذ المطر يرسم على جسده تفاصيل حكاية التيه وآثارها. وهكذا كانت الطبيعة مجسدة في المطر رمزا للشاهد المطلع على رحلة التيه والمعاناة: تيه الحياة والسير في دروبها المتعبة على وجل وفي قلق.
ويقول الشاعر في المقطع الثاني من نفس النص:
“لا يُبقي عين الليل متقدة
غير فضول الصمت
وأنين أشباهك” (نفسه، الصفحة نفسها)
بهذه الكيفية يبدو الليل الساهر سوى فضولي يحب الصمت، أو يؤرقه أنين أولئك الذين يعانون، أو يذوقون قسوة الحياة وما تلقيه في سبلهم من آلام وما تعترضهم من انكسارات. وبهذه الشاكلة أشرك الشاعر الطبيعة في لعبة البوح، وجعل من الليل رمزا للمعاناة، وأفقا للتعبير عن الذات.
ولا يكتفي الشاعر رشيد شوقي بتشخيص الطبيعة على سبيل الاستعارة والمجاز لتشكيل رمزيته ولبناء متخيله الشعري، بل إنه يستحضر في بعض النصوص رموزا أسطورية، ويتخذها منطلقا للبوح، غير أنه يربطها دائما بالطبيعة، كما نرى في استدعائه “نرسيس” و”سيزيف” من الميثولوجيا الإغريقية. يقول في نص “ضياع”:
“صعد الجبل
عله يجد أناه الضائعة
يفاجئه سيزيف
وهو يتبع صخرته
إلى المنحدر”. (الديوان، ص 73)
هكذا كانت صورة الانحدار والاندفاع وراء الصخرة مقابلا للصعود والبحث المضني عن حقيقة الأنا الضائعة التائهة في دروب الحياة، وفي متاه المعاناة. وبهذه الشاكلة كانت الصورة الرمزية التي اتكأت على الأسطورة، وعلى رمزية الجبل أفقا للبوح بمعاناة الذات الشاعرة، وبجعل الرمز أساسا لشعرية تتخذ من البوح مدارا لتشكيل متخيل شعري شفيف يقول معاني كثيرة في إشارات مكثفة.
وتكثر في الديوان مثل هذه الصور الشعرية المكثفة التي تبوح بالكثير من منطلق توظيف الطبيعة وجعلها بابا نحو الإفضاء بمكنون الذات، ونقل رؤية الشاعر لما يجري له، وحوله الآن هنا، ولما تستشرفه روحه الشعرية. ومن ثم، فإن نصوص الكتاب لم تقتصر على تصوير المعاناة، فحسب، وإنما رصدت ارتباط الشاعر بالآتي، وانفتاح شعريته على الأمل، وإمكان الخروج من متاهات الآني وثقله. يقول على سبيل المثال في نص “ميلاد”:
“فتحت القصيدة
كي أتنفس ميلادا جديدا
ألفيت خلف سرب السحاب
قوس قزح يسرج خيوله” (الديوان، ص. 49)
هكذا وراء ركام السحاب وسربه تتبدى خيول قوس قزح المسرجة المقبلة، إنها خيول لا شك ستهزم السحاب القاتم المظلم بألوانها المتعددة الزاهية، وبالبهاء الذي تشعه في الكون، وغور الروح. بهذه الكيفية كانت هذه الصورة غناء للآتي وتطلعا نحو غد زاه مشرق يكسر فلول المعاناة والألم. وبهذه الشاكلة كانت هذه الصورة المتكئة على الطبيعة رمزية بامتياز، وقد كانت رمزيتها شفيفة يمكن للقارئ تمثلها ولا تتطلب منه جهدا مضنيا لإدراك مراميها وأبعادها.
من خلال كل ما سبق يمكن القول إن الشاعر جعل من الطبيعة منطلقا ومدارا لبوحه الشعري، وأفقا لبناء شعريته المحكمة التي تُنبئ عن تمكن واقتدار، ونرجو أن يطور هذه التجربة ويغنيها في دواوين أخرى لاحقة.
………………..
* رشيد شوقي، من يقرأ للسحابة فنجانها؟، منشورات الراصد الوطني للنشر والقراءة، طنجة، 2019.