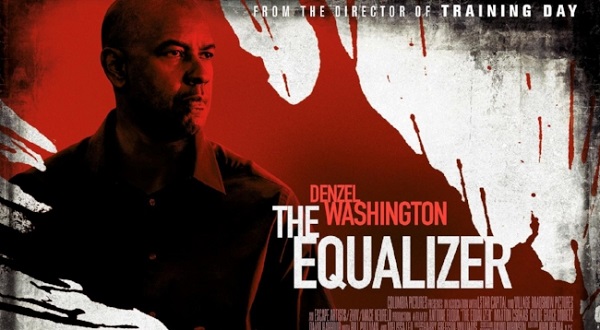عادل محمود
في مشهد الثقافة المصرية المثقل بأوزار المحظورات، ظهر فيلم “الملحد” كقنبلة موقوتة وعدت بإثارة النقاش حول أحد أكثر الموضوعات حساسية. الفيلم من كتابة إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، ويحكي قصة طبيب شاب (يحيى) يعلن إلحاده، فيواجه والده الشيخ السلفي الذي يسعى لـ”استتابته” تحت وطأة التهديد والوعيد وصولا إلى التلويح بحكم قتل المرتد.
لكن الفيلم، بعد رحلة مضنية من الجدل والمنع دامت أكثر من عامين، خرج إلى النور ليس كعمل فني جرئ يستفز العقل والضمير، بل كـ”نص مشوه” تعرض لعمليات اقتطاع وتشويه أفقدته روحه الأصلية. هذا المقال النقدي لا يحاكم الفيلم فقط على ضعف بنيته الدرامية، بل يقرأه كـ”ظاهرة ثقافية” تكشف عن تناقضات خطيرة: التناقض بين الضجة الإعلامية والنتاج الفني الهزيل، وبين الطموح لـ”كسر المحرمات” والخضوع لشروط رقابية أفقدت العمل تماسكه، وبين ادعاء طرح السؤال الفلسفي والاكتفاء بالإجابة الجاهزة. نحن أمام حالة دراسية مثالية لفشل “السينما الوظيفية” التي تضع الرسالة فوق الفن، والخطاب فوق الدراما، والضجة فوق الجودة.
لا يمكن فصل تجربة مشاهدة “الملحد” عن رحلته الطويلة نحو الشاشة، فهي جزء لا يتجزأ من النص الموازي. حصل الفيلم على تصريح بالعرض الجماهيري من الرقابة في منتصف أغسطس 2024، لكن رحلته توقفت عند عتبة المؤسسة الدينية التي لم تصدر قراراً بالرفض المباشر، لكنها أيضاً لم تصدر قرار السماح. هذا الموقف “اللاموقف” يعكس حالة من التردد والخشية من تحمل المسؤولية.
اضطر المنتج للجوء إلى القضاء، حيث حصل على حكم قاطع يلزم الجهات المعنية بالسماح بتداول المصنف الفني، في سابقة تؤكد تعدد وتناقض السلطات الرقابية في مصر. وزير الثقافة نفسه، الدكتور أحمد هنو أعلن فشله في تقريب وجهات النظر بين الرافضين والمؤيدين. هذه الحرب البيروقراطية والقضائية حول الفيلم خلقت له هالة من “التأهيل المسبق”، فقد تم تسويقه على أنه عمل شديد الخطورة والجرأة، مما رفع سقف توقعات الجمهور والنقاد إلى مستوى خيالي، مستوى لم يكن الفيلم المشوه والمقصوص ليصل إليه أبداً.
يبدأ الانهيار من لحظة الاختيار الأولى: العنوان. “الملحد” يعتمد منذ البداية على العنوان كأداة استفزاز وإثارة للجدل، لا كمفتاح تأويلي أو سؤال مفتوح. العنوان هنا لا يعمل كـ”أفق توقع” يدفع المتلقي للتأمل، بل كـ”وسم أيديولوجي” يحدد الموقف مسبقا. الشخصية الرئيسية لا تقدم كإنسان مركب يعاني أزمة وجودية، بل كـ”حالة مرضية” أو انحراف فكري جاهز للتفنيد والعلاج. وهنا تكمن المفارقة الأولى: فيلم يحمل عنوانا مستفزا ينتهي بدعوة صريحة للإيمان، حيث يعلن البطل في المشهد الأخير: “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”.
يعاني الفيلم من تفكك سردي واضح، ينتقل بين مشاهد لا يجمعها رابط عضوي واضح، وكأن هناك أجزاء أساسية قد تم اقتطاعها. ربما كان ذلك نتيجة حتمية لتدخلات رقابية متلاحقة. الصراع الأساسي المفترض بين الإيمان والشك لا يتجسد من خلال أفعال ومواقف درامية معقدة، ولكنه يأتي في حوارات تقريرية مباشرة أقرب إلى المناظرات المدرسية.
الخط الدرامي للبطل خط نمطي : شك ← ضياع ← انكسار ← عودة إلى الإيمان. وهو خط يقوض مبدأ “التطور النفسي” الذي يعد أساسا للكتابة السينمائية الجيدة.
تتحول الشخصيات في “الملحد” إلى أصوات أيديولوجية مجردة من إنسانيتها:
الأب “الشيخ حافظ السروطي / محمود حميدة” يمثل صوت السلفية المتشددة والتطرف الديني، وهو تصوير نمطي تكرر في أعمال إبراهيم عيسى السابقة. رغم أن أداء محمود حميدة كان قويا إلى حد الإقناع، إلا أن الشخصية تظل مجرد فكرة مجسدة، تفتقر إلى الدوافع النفسية العميقة التي تجعل من تشدده مأساة إنسانية وليس مجرد شرير درامي.
الابن “يحيى / أحمد حاتم” الملحد الذي يبدو أداؤه باهتا وغائبا. إلحاده يظهر كرد فعل نفسي على قسوة الأب وبيئته المتشددة، وليس كمسار فكري فلسفي مستقل. السيناريو يتجنب الخوض في الأسئلة الفلسفية العميقة، معتمدا على أسئلة بدائية يمكن لطفل في سن الدراسة التعامل معها.
الأم “صابرين” الشخصية الأكثر درامية نسبيا، تقدمها صابرين بأداء عميق. لكن دورها يختصر في التوسل للابن بالتظاهر بالإيمان، وهو ما يعكس فشلا من السيناريو في تقديم حجة عاطفية أو فكرية مقنعة من منظور الأمومة.
هنا يقع الفيلم في أكبر فخاخه: فخ “المقال السينمائي”. الحوارات تتحول إلى خطابات مباشرة، تخالف القاعدة الذهبية “أرني ولا تخبرني”. اللغة تفسيرية وشعارية، تفتقر إلى الإيحاء.
على المستوى البصري، يظل الإخراج تقليديا. يستخدم المخرج محمد العدل الإضاءة والألوان بشكل وظيفي – ألوان قاتمة في المنزل مقابل ألوان مضيئة في الخارج – لكن الصورة تبقى تابعة للنص بشكل كامل، دون رؤية بصرية تعبر عن العزلة أو الفراغ الوجودي، على عكس أفلام عالمية تناولت موضوعات مشابهة.
تتجاوز قيمة “الملحد” كفيلم سينمائي إلى قيمته كـ”وثيقة اجتماعية” على صراع ثلاثي الأبعاد: الفن والدين والدولة.
فمن ناحية الدولة، يعكس مسار الفيلم إشكالية تعدد جهات الرقابة في مصر. الفيلم لم يمنع من الرقابة الفنية كجهة مختصة، بل تم منعه من خلال الأزهر ممثل الرقابة الدينية. وثمة اعتقاد إن خطرا كبيرا يهدد الفن عندما تتعدد الجهات الرقابية، وأن العمل الفني لا يمكن أن تتم تجزئته، فيعرض جزء منه على الرقابة وآخر على دار الإفتاء.
ومن ناحية الدين، هناك سؤال جوهري يطرحه الفيلم، وإن كان بشكل سطحي: هل الإيمان الناتج عن الخوف هو إيمان حقيقي؟ الفيلم يلامس فكرة أن “الملحد” في المجتمعات المحافظة قد يكون ضحية لصورة مشوهة عن الدين، وليس بالضرورة رافضا لفكرة الإله في ذاته. لكن الطرح يبقى في منطقة آمنة، فهو لا يهاجم الدين بل “يهاجم التدين الشكلي والإرهاب الفكري” المستمد من تفسيرات بشرية.
و من ناحية الفن، الفيلم الضعيف يحمل قيمة. مجرد عرض فيلم بعنوان “الملحد” في دور السينما المصرية يرفع من سقف الحرية النسبي ويخلق نقاشا يتخطى محتوى الفيلم نفسه. فهو يفتح الباب، ولو بشق، لمناقشة قضية “حرية المعتقد” التي تظل من المسكوت عنه في الخطاب العام.
يمكن تشبيه البنية السردية لفيلم “الملحد” بجسد تعرض للبتر. التدخلات الرقابية المتتالية قصمت ظهر الحبكة الدرامية. النهاية، التي تعود بالابن إلى الدين بعد وفاة والده، تظهر كمفروضة من خارج النص، ربما لإرضاء جهات رقابية أو لتخفيف حدة الطرح. هذا القطع يجعل النهاية غير منسجمة مع المسار السابق، ويدمر أي إمكانية للتطور النفسي للبطل.
البناء القائم على الثنائيات الحادة (ملحد/مؤمن، متشدد/معتدل، عقل/نقل) يخلق عالما دراميا مسطحا يخلو من مناطق الظل والتناقضات الداخلية التي تميز الشخصيات الحقيقية. غياب الصراع الداخلي المعقد لدى يحيى، واستبداله بصراع خارجي مع الأب، يحول القضية الفلسفية الوجودية إلى مجرد نزاع عائلي على السلطة والتقاليد.
في النهاية، لقد أضاع الفيلم فرصة تاريخية لتقديم عمل جاد يناقش إشكالية الإيمان والكفر في عصر الأزمات. بدلا من أن يكون فيلما “يقلق”، اختار أن يكون فيلما “يقنع” بوجهة نظر جاهزة. قيمته الحقيقية لم تعد تكمن في كونه عملا فنيا مكتملا – فهو ليس كذلك بتاتا، وتقييمه الفني لا يتجاوز 5/10 – بل في كونه ظاهرة ثقافية اجتماعية تكرس عدة حقائق مرة:
– أن الفضاء العام المصري لا يزال حاجزا أمام مناقشة حرة وعميقة لقضايا العقيدة.
– أن “الجرأة” في السينما المصرية قد تتحول أحيانا إلى سلعة واستعراض، خاصة عندما تفتقر إلى عمق فني حقيقي.
– أن الصراع الحقيقي لم يكن حول أفكار الفيلم، بل حول حق الفيلم نفسه في الوجود، وهو انتصار هش قد لا يتكرر.
“الملحد” فيلم كان يمكن أن يكون مهما، لكنه خرج مشوها. ربما يكون أهم ما يقدمه لنا اليوم هو كونه انعكاسا لأزمتنا: أزمة حوار، أزمة حرية، وأزمة صناعة سينمائية تبحث عن التوازن المستحيل بين الإبداع والخط الأحمر.